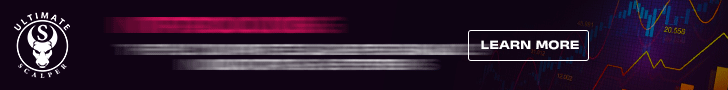في ذكرى اللاهوتي والمفكر والمناضل الحقوقي

Friedrich Schorlemmer فريدريش شورلمر
(16 مايو 1944 ــ 9 سبتمبر 2024 )
إلى حامد بشري وصديق الزيلعي، والاِلتزام الراسخ والعين الفاحصة والصبر الجميل في زمن العواصف.
تقديم وترجمة حامد فضل الله / برلين
وُلد فريدريش شورلمر في عام 1944 في مدينة بريغنيتس بألمانيا الديمقراطية، وبسبب أصوله (كأبن لقس)، مُنع من الالتحاق بالمدرسة الثانوية، لكنه حصل على شهادة الثانوية العامة عن طريق مدرسة تعليم الكبار، ثم درس اللاهوت في جامعة مارتين لوثر هاله ــ فتنبرج، بعد أن قضى بناء جدار برلين عام 1961 على أمله في الدراسة بجامعة برلين الحرة، تم أصبح قساً طلابياً وعضو في المجلس الكنسي على مستوى الكنيسة المحلية وألمانيا الشرقية. ، ثم مدير الدراسات الأكاديمية الاِنجيلية في منطقة ساكسونيا ــ أنهالت. شارك في عام 1968، في أنشطة ضد الدستور الجديد لألمانيا الشرقية وضد قمع ربيع براغ من قبل قوات حلف وارسو. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كان عضوًا في حركة السلام وحقوق الإنسان والبيئة. أشتهر بالبلاغة وبرؤيته الثاقبة، وكلاهوتي كان يجمع بين الوضوح والبصيرة والقلب. كانت خطبه البارعة والبسيطة في نفس الوقت هبة فريدة وبمثابة بوصلة وإرشاد للعديدين نحو عالم أكثر عدلاً واستدامة. وخلال مسيرته، كانت موضوعات المصالحة والسلام خيطًا مشتركًا، من رفضه للخدمة العسكرية في عام 1962 إلى خطابه البارز في المظاهرة الكبرى في 4 نوفمبر 1989، قبل خمسة أيام من سقوط جدار برلين، أمام مليون شخص في ساحة ألكسندر بلاتز. قائلا “إذا كنا نعيش بالأمس أجواء الركود الخانقة، التي كانت تحبس الأنفاس، فإننا الآن نشهد تغيرات تخطف الأنفاس أيضاً، سيتم إلغاء دائرة التجنيد وإدخال الخدمة المدنية”.
اتفق شورمير مع حداد لنحت شعار “المحراث بدل السيف” وهو اقتباس جزئي من الكتاب المقدس (الإنجيل) وقدمه في يوم الكنيسة الاِقليمية في فيتنبرج” وفي “مجموعة دائرة السلام”، التي كونها بنفسه
ويشرف عليها. ويعبر الشعار عن هدف السلام الدولي بين الشعوب، من خلال نزع السلاح العالمي وتحويل الصناعات العسكرية إلى مدنية. جلب هذا الشعار شهرة واسعة له خارج نطاق ألمانيا الديمقراطية وتبنته أجزاء من حركة السلام في ألمانيا الغربية.
وشارك في تجمع الاحتجاج أمام عمود النصر في برلين في فبراير 2003 ضد حرب العراق. نشر أكثر من 20 كتاباً وشارك في إصدار عدة مجلات وعضو في هيئة تحرير المجلة الشهرية الهامة “أوراق للسياسة الألمانية والدولية” وحصل على عدة جوائز، منها جائزة السلام السنوية من اتحاد بورصة الكتاب الألماني في فرانكفورت. وكان مؤيداً ومدافعاً لسياسة المستشار الألماني الأسبق فيلي برانت، التي عُرفت والتي كانت النواة، التي أنتجت توحيد الألمانيتين. “، Ostpolitik “باسم سياسة الشرق (
انتهت مع سقوط جدار برلين، تصورات فريدريش شورلمر المتعلقة بإصلاح جمهورية ألمانيا الديمقراطية. انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وطُلب منه كعضو بارز الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه رفض ذلك، قائلا: “أعرف نفسي جيدًا بما يكفي لأدرك أن ذلك كان سيحطمني. لست مؤهلًا لذلك. ولا أريد أن أكون جزءًا من سياسة أضطر فيها باستمرار إلى البحث عن كيفية تجميع أنصاري حولي ضد الآخرين.” لقد أراد أن يعبر عن موقفه من خلال كتاباته للتصدي للمخاطر المحتملة. كان يرى نفسه مصلحًا، وكان خطيبًا وواعظًا بارعًا.
كتب شورلمر في نعي صديقه المفكر الكبير، وأستاذ علم البلاغة في جامعة توبنغن ألمانيا الاتحادية، فالتر ينز الذي عانى من مرض الزهايمر، “نادرًا ما يحدث أن يفقد الإنسان شخصًا قبل وفاته”.(نعي شورلمر لصديقه قبل وفاته، هي إشارة إلى مرض الزهايمر ــ المترجم).
تُوفى فريدريش شورلمر عن عمر يناهز 80 عاماً في برلين، وقد عانى أيضًا في نهاية حياته مثل صديقه من مرض الزهايمر( الخرف)، بالإضافة إلى مرض باركنسون (الرعاش). إنها أمراض قاسية تهاجم الجسد والعقل على حد سواء.
“بالنظر إلى التطورات الدراماتيكية، ليس فقط في شرق الجمهورية، نشعر أكثر بغيابه: صوته مفقود. بصيرته. جاذبيته كعالم لاهوتي، بعيد النظر وبقلب مُفعم بالإنسانية”. ( فقرة من رثاء بتينا رُودر، رفيقة درب شورلمر) (المترجم)
قامت مجلة “أوراق للسياسة الألمانية والدولية” في عددها الصادر في أكتوبر 2024 “في ذكرى شورلمر” ، بإعادة نشر مقالين له، نشر الأول في عام 1990 والثاني في 2019 ،أقدمهما هنا،
المقال الأول:
اكتشاف الأهلية
ما سيبقى “من جمهورية ألمانيا الديمقراطية” هو تجاربنا وذكرياتنا، التي تشكل سلوكنا اللاحق. أعتقد أن العملية التي نعيشها حاليًا، أي التعرية السريعة كأننا نخلع ملابسنا ونستحم، إن محاولة غسل جمهورية ألمانيا الديمقراطية لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل. وسوف تعود الكثير من الأمور لاحقاً. سنكون في وقت لاحق أشخاصًا يحملون بصمات مختلفة، لمدة عشر إلى عشرين عامًا أخرى. وسينعكس هذا على سلوكنا أيضاً، على الرغم من أنه يبدو في الوقت الحالي كما لو أننا ننغمس في ثقافة الكوكا كولا، ونتبنى ببساطة كل شيء ، وننسى التاريخ. يجب على المفكرين في بلدنا أن يدعموا هذه العملية. ولذلك سنحتاج إلى الوقت. أتذكر هنا أن كريستا فولف ــ ( روائية مشهورة من المانيا الديمقراطية ومدافعة عنيدة عن حقوق الاِنسان. المترجم) ــ لم تتمكن من تأليف كتابها العظيم “نمازج الطفولة” إلا في عام 1974، وببساطة، لفهم ذلك فنحن بحاجة إلى فترة زمنية.
إذن ستكون قصتنا بأكملها قريبة جدًا، وكأنها حدثت بالأمس. كما نحتاج حقاً لأنفسنا، إلى نوع من التطهير النفسي. هذا جانب من الأمر، وهو أشبه بعملية نفسية سياسية. أما الجانب الآخر، فلا أعتقد أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت لها وعي تضامني معين، بمعنى شعور بالظلم عندما يتم توزيع الملكية الاجتماعية بشكل غير متساوٍ بحيث يعيش البعض تحت مستوى الكفاف بينما لا يعرف الآخرون ماذا يفعلون بما لديهم، بأن هذا كله كان مجرد خرافة. وكما كانت هناك أيضاً نظرة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية لمشاكل العالم ككل. ولكن هذا كله مغطى حاليًا تمامًا، من خلال السؤال الوحيد والأساس: كيف يمكننا الحصول على المال؟
ونملك كذلك وعياً تضامنياً موجهاً نحو الجار ومصيره، وحقه في العيش والعمل والسكن والغذاء… والالتفات نحو الناس في نيكاراغوا أو موزمبيق. ونرى في عين الوقت، أن المشاكل التي كانت موجودة بالفعل مثل كراهية الأجانب كانت من المحرمات لدرجة أنها انفجرت الآن بشكل مفاجئ. وسوف تظل هذه مشكلة كبيرة في ألمانيا الموحدة. إن الميل نحو التطرف اليميني لدينا أكبر مما هو عليه في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأخشى أنَّ يكون هذا الأمر جزءاً مما سنساهم به. كلمة “المساهمة” هنا هي المفتاح. أعتقد أننا سنساهم في إدخال ثقافة معينة. بغض النظر عن أن الكثير هنا قد انهار، كما كنا نمتلك مفهوماً مختلفاً للثقافة حيث يمكن للشخص البسيط (العادي) الحصول على الثقافة الرفيعة وبأسعار زهيدة أيضاً.
صحيح أن اشتراكات المسرح، على سبيل المثال، التي كان على العمال الحصول عليها، لم تُستغل فعليًا. لكن نسبة كبيرة من ما يُسمى بـ “الناس البسطاء” كانت تذهب إلى المسرح. وكنا أيضًا أمة قارئة. أما الآن، فنحن على الأرجح سنصبح أمة مولعة بالكتب السطحية ومشاهدة التلفاز، والتحديق في الألوان الجميلة التي كانت محجوبة عنا من قبل. وسنكون تحت رحمة هذا تماماً كما هو الحال في العالم الثالث.
ولكن في طبقة أعمق، ظهرت بين مجموعات واسعة حاجة حقيقية للأدب الرفيع. وأعتقد أن لدينا ما نقدمه في هذا الصدد. وبالمناسبة سنساهم أيضا في إعطاء درجة أعلى من الوعى السياسي.
في الواقع إن هذا مخفي في الوقت الحاضر. أو نقول ببساطة، إنه يتم غمره من صناعة الترفيه. في الزوايا الخاصة ، التي لجأ الناس اليها، كثر الحديث في السياسة. ثم نزلت هذه السياسة إلى الساحة العامة خلال الأشهر الأخيرة. لكنها عادت الآن إلى تلك الزوايا. هذا ظاهرة معقدة جدًا. ينبغي إجراء دراسة دقيقة لمعرفة ما يحدث الآن في تلك الزوايا. إذن: هل يمكن إعادة هذه السياسة إلى الساحة العامة؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فلأي غرض؟
ما لدينا لنقدمه هو في النهاية تجربة ثورة سلمية وقعت في خريف العام الماضي، واكتشاف أنه بعد سنوات عديدة من القمع، يمكن لأي شعب أن يكون ناضجا بالغاية، وقادرًا على التفكير في شؤونه الخاصة وإدخالها في الخطاب العام.
ومن سوء حظنا أن المسألة الأكثر أهمية في تاريخ ألمانيا وهي المسألة الوطنية على وجه التحديد قد لحقت بنا وتجاوزتنا والآن اجتاحتنا.
لكنني أعتقد أننا في هذا الصدد ربما نعود إلى العقلانية أيضاً.
كيف تم إجهاض حلم المجتمع الاشتراكي
كانت السنوات الأربعون من عمر جمهورية ألمانيا الديمقراطية، في الأساس، مشروعاً للاتحاد السوفييتي، القوة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي حاولت أن تُرسخ الاشتراكية أو الشيوعية في موطنها الفكري أو الروحي. لقد كانت، بطريقة ما، محاولة للعودة إلى ما قبل لينين، أي إلى وجهة النظر القائلة بأن الثورة ستندلع في البداية في أكثر بلدان أوروبا تطوراً… لكنها لم تندلع هناك. بل على العكس من ذلك: لقد حدثت هناك أكبر حركة مضادة للثورة. وكان لا بد من هزيمتها أولاً. وأنني أعتقد بأن الشيوعيين أرادوا تحقيق حلمهم هنا. بأن الحلم الألماني بمجتمع اشتراكي يجب أن يصبح الآن حقيقة واقعة.
لكن هذا لم يتطور بشكل طبيعي، بل تم فرضه وتم تنفيذه بالدبابات الروسية. أعتقد أن هذا كان خطأً كبيرًا. خاصةً بأن نظامنا المناهض للفاشية والذي يمكننا تسميته بذلك عن حق لم يحدث أي إنجاز حقيقي مع الماضي. لأنه لم يُحاسب سوى أولئك الذين اعترفوا بجرائمهم بشكل واضح، ولم يكن ذلك من خلال عمليات قانونية حقيقية. بل إن كثيرين لقوا حتفهم مجددًا في معسكرات الاعتقال، أو طردوا إلى الغرب، أو رحلوا من تلقاء أنفسهم.
لا اشتراكية بدون حرية
لم يتم إجراء مواجه حقيقية ومستقلة مع الماضي. ولم يتم استيعاب الأفكار الاشتراكية بشكل حقيقي أيضًا. لقد كان ذلك نظامًا اشتراكيًا مفروضًا وأعتقد أن الاشتراكية بدون حرية لا يمكن أن تنجح.
لقد تم تكريس المزيد من الجهود للحفاظ على السلطة وأن حمايتها كما كان هيرمان أكسن يقول دائمًا، كما لو كانت “حدقة العين” بدلاً من السعي بصدق للحصول على تايد المواطنين الحر. كان ذلك سيعني التخلي عن الهراء الأيديولوجي حول الحزبية والانحياز إلى الحقيقة.
السؤال هو: هل ستنجو المفاهيم والقيم مثل الاشتراكية مما تم فعله باسمها؟ أعتقد أنه، ولأسباب تتعلق بالنقاء اللغوي، لا يمكننا حاليًا استخدام بعض الكلمات في هذا البلد. لقد تم تشويهها إلى درجة كبيرة جدًا…
على سبيل المثال، كلمة “اشتراكية” أصبحت حاليًا لم تعد تُستخدم. لكن: يجب أن يبقى ما يرتبط بهذه الكلمة في دائرة النقاش، وليس فقط في النقاش، بل أن نجعلها فعالة في تشكيل المستقبل. إذا كنا نريد حقًا عالمًا أكثر عدالة.
يوجد في الواقع عدد أكبر من الناس مما كنا نعتقد وهذا عندما اتصفح رسائلي، في حد ذاته أمر جميل جداً ــ كان هناك المزيد من الناس، وخاصة من الشيوعيين، الأصغر سنًا منهم وأيضًا كبار السن الذين لا يفكرون مطلقًا في التخلي عن مبادئهم ووضعها في طي النسيان. ولكنهم لا يقولون ذلك بدافع من عناد مقدس: “الآن أكثر من أي وقت مضى!” بل يدخلون المرحلة الجديدة متطهرين ويقولون: “لقد أخطأنا، نحن مذنبون، نحن شركاء في الذنب. لم نبذل جهدًا كافيًا.!”
نريد أن نتحمل مسؤولية هذا الذنب ولكننا نريد مناقشته ديمقراطيًا مع أناس صادقين كشركاء حوار صادقين. نريد أن نوضح أين تكمن أهدافنا من أجل مجتمع أكثر عدالة وكيف يمكننا تحقيقها معًا بطريقة إنسانية. لا يوجد طريق للديمقراطية الديمقراطية هي الطريق. لا يوجد طريق للسلام السلام هو الطريق. ليست هناك حقيقة واحدة مطلقة، بل هناك فقط الطريق المشترك نحو الحقيقة، والذي يجب أن نتجنب فيه ضرب رؤوس بعضنا البعض. علينا أن نستنزف عقولنا في البحث عن الحقيقة ـ! إذا كانت هذه هي القاعدة، فإن لدينا فرصة. وأرى عددًا من الشيوعيين الشباب الذين يمكن أن يكون الحوار معهم مثيرًا للاهتمام.
أنني لست من أولئك الذين لا يحبون النظر في التاريخ وهو يحدث ويقولون: “انظروا، هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الأمور! لا يمكن إيقاف ذلك بعد الآن! علينا فقط أن نرى كيف يمكننا أن نلحق بالركب”!.
أنني من أولئك الذين يحاولون أن يدركوا بأكبر قدر من الوضوح ما يحدث، ثم يتساءلون: ماذا يمكنني أن أفعل لدعم شيء ما أو لوقف شيء ما؟
حاليًا، أشهد انتشارًا متزايدًا للشعور بالشفقة بالذات بين أولئك الذين يستسلمون مبكرًا جدًا. خاصةً في صفوف اليسار الديمقراطي. ثم يتشتتون في صراعات داخلية حول من هو المسؤول، وأي طريق يجب أن نسلكه الآن، أو ما الذي أصبح بالفعل في عداد المفقود.
نهاية الانشغال الذاتي بالشرق الألماني! نحن نعيش في عالم واحد.
عندما يعود المرء إلى النظر في ذلك، لن يصل المرء إلى الكثير.. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أعتقد أن لدينا نحن الألمان الشرقيين (أبناء جمهورية ألمانيا الديمقراطية) ميلاً حاليًا بالانشغال الذاتي بشكل مفرط، لأننا حتى الآن لم يُسمح لنا بالنظر إلى أنفسنا بشكل كافٍ. لدي انطباع بأن الألمان الغربيين أصبحوا أكثر أوروبية بكثير مقارنة بالألمان الشرقيين. وتقع من جهة أخرى، علينا نحن الألمان الشرقيين مهمة خاصة تتمثل في أن نقول للألمان الغربيين: تعالوا، دعونا معًا نلتفت الآن نحو الشرق ونرى كيف يمكننا أن نقدم مساهمة مشتركة هناك، بينما نرتب شؤون بيتنا الداخلي. ليس بروح تبشيرية، وإنما انطلاقًا من إدراكنا أن فرصتنا التاريخية الآن تكمن في أن نصبح الجسر الذي يربط بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية. وبالتالي، يمكننا أن نقول للألمان الغربيين: كم كان من الغرور أن تقولوا “ألمانيا” متجاهلين وجودنا نحن أيضًا، فإنه من الغرور أيضاً، يأن أوروبا الغربية أن تطلق على نفسها “أوروبا”. أعتقد أن ما يمكن لليسار الديمقراطي أن يقدمه هو، أولاً وقبل كل شيء، نوع من “الأممية الأوروبية”.
أولاً، يجب على المرء ترتيب بيته الداخلي،، ولكن ليس من أجل عزل أو اغلاق أنفسنا عن العالم الثالث، بل لننظم هذا البيت حتى تكون لدينا القوة لمساعدة هذا العالم أيضاً حيث من المرجح أن يكون مناطق الصراع الرئيسية، على الأقل فيما يتعلق بإشكالية السلام؛ والتي لم تعد بين الشرق والغرب فحسب، بل بين الشمال والجنوب؛ وكلنا متفقون على ذلك من الناحية النظرية، ولكن يجب الآن ترجمته إلى سياسة عملية.
ليس لدينا خيار سوى تنظيم الشراكة الأمنية على مستوى العالم. ولن يكون لنا مستقبل على الاِطلاق إذا لم نفهم الأمن باعتباره أمناً مشتركاً. لقد قدمت الدول المتعاقدة في وارسو في وقت مبكر من عام 1987 مفهوم شراكة الأمن البيئي. يجب علينا أن نستوعب ذلك: سنتحرر من الانشغال الذاتي، عندما ندرك أننا نعيش على نفس المياه التي نشربها، ونتنفس نفس الهواء سواء في هذه القارة أو في هذا العالم. إن من مصلحتنا الحيوية أن نبتعد عن التفكير الانعزالي. لأننا نعيش في عالم واحد. الطبيعة لا تسأل عن حدودنا السياسية أو الأيديولوجية.
* نشر هذا المقال في مجلة ” أوراق للسياسة الألمانية والدولية” عدد 6 1990،
Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe 6 / 1990
المقال الثاني:
“الويل إذا أطلِقوا بلا مقاومة يتكاثرون”
أن الأحداث مثل تلك التي وقعت في مدينة كيمنتس عام 2018 وأخشى أن لا تكون الأخيرة من نوعها ــ (تجمع في 26 أغسطس 2018، متطرفون يمينيون في كيمنتس وهاجموا المهاجرين. وتبعت ذلك مظاهرات استمرت حتى سبتمبر، شارك فيها آلاف الأشخاص. بجانب قادة من الحزب اليميني “البديل من أجل ألمانيا” جنبًا إلى جنب مع النازيين الجدد، مثيري الشغب، ومواطنين عاديين في المدينة. وذلك على خلفية ما يُقال بأن الشاب السوري علاء س، مع عراقي أخر (لم يتم القبض عليه بعد)، بمهاجمة وطعن مميت لدانيال هيليغ الألماني من أصل كوبي أثناء مهرجان المدينة. نفى علاء س. تورطه في طعن هيليغ، لكن المحكمة لم تصدقه، وبرغم تراجع العديد من الشهود عن أقوالهم ووقعوا في تناقضات، صدر الحكم: بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف.(المترجم) تجعل كل ديمقراطي يشعر باليأس، ويكاد يصمت. الأشخاص الذين تجمعوا هناك لم يعودوا قابلين للوصول لرأي سياسي متحضر. إنهم يتفاعلون مع العالم المعقد بأنماط تفكير شديدة التبسيط. وكلما كانت أكثر بساطة، كانت أكثر فعالية.
يجتمع أناس ومعظمهم من الرجال مع أحكام مسبقة قديمة لم تعد عرضة للتساؤل النقدي. إنهم في الغالب أناس محدودو التفكير، غير واعين سياسيًا، مشحونون عاطفيًا، يفكرون ويشعرون بطريقة قومية أو حتى قومجية. لا شك أن من بينهم أشخاص يعانون من عدم استقرار اجتماعي أيضاً، أو من لم يحظوا بتقدير إنساني كافٍ، ويخشون على مستقبلهم الاجتماعي ويبحثون عن كبش فداء لكل هذا.
المسؤول عن كل ذلك، حسب رأيهم، هم المهاجرون. هناك صور نمطية عدائية متجذرة بشدة، وكأن الأجانب الذين لجأوا إلينا سوف يأخذون بلدنا بطعنات السكاكين والتحرش بالنساء. كما أن النظام هو المسؤول أيضًا. لكن من يتحدث عن ديمقراطيتنا باعتبارها “النظام” يجب أن يعرف ما يقوله:: فقد كان هذا أحد الشعارات المركزية للنازيين ضد جمهورية فايمار، التي تم التشهير بها على أنها “عصر النظام” وكان يُشار إلى برلمانها على أنه “مجرد مكان للثرثرة فقط.
إن الغوغاء المنفلتة، التي تحركها طاقة ديماغوجية مدمرة، لديها القدرة على تسميم الأجواء الاجتماعية في بلادنا بشكل دائم، وتشجيع أعمال العنف، وإشعال نار الكراهية من خلال الفعل ورد الفعل بشكل متصاعد وبالتالي اختطاف ديمقراطيتنا في نهاية المطاف.
تُعطينا ثقافة النقاش المشحونة إلى حد لا يطاق لمحة مسبقة، عما يدور في بعض برلمانات الولايات بشرق ألمانيا. يسود فيه الجدال والصراخ بدلاً من الحوار والهتافات المملة بدلاً من الحجج المفصّلة، والمشاعر المتكررة بدلاً من المعلومات الدقيقة. أن السياسة في النظام الديمقراطي، كما علّمنا ماكس فيبر قبل مئة عام، هي “حفر الألواح الصلبة بشغف وحس في الوقت ذاته.” لكن لا أحد من الذين “يتفاهمون” بالصراخ فقط، سواء في الشوارع أو في البرلمانات، يشارك في ندواتنا العديدة حول الديمقراطية.
اليوم، وخاصة في شرق البلاد، خليط غامض بين الخوف الاجتماعي، والثقة بالنفس الجريحة والمستقبل الغامض، الذي يتم التعبير عنهم في سلوك قومجي باهت. وهذا الخليط يمكن شحنه وتأجيجه في أي وقت، خاصة في عصر “وسائل التواصل الاجتماعي” التي توفر قدرة تعبئة سريعة وفعالة يتم استغلالها بلا ضمير.
يحتفل، الخاسرون التاريخيون، أو أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من الخاسرين، بسردية التهميش: “يستولي المهاجرون على كل شيء، وعلينا أن ننظر ماذا سيتبقى لنا. أنهم لم يساهموا حتى في صناديقنا الاجتماعية، ومع ذلك يحصلون على كل شيء مجاناً. إذن لابد من التخلص منهم”. هنا، يحدد الحسد المليء بالخوف معالم رفض الأجانب. وتتحول حادثة طعن “ألماني من أصل كوبي”، كما حدث في مدينة كيمنتس، إلى فرصة مرحب بها لإثارة الذعر العميق في الرأي العام الألماني.
استعادة السيادة على تفسير الأحداث
إن السرعة الكبيرة في التعبئة وعدد مجموعات العنف التي تتجمع اليوم بين مثيري الشغب في كرة القدم أو في إطار مبادرات مثل “برو كمنيتس” أمر مقلق بالفعل. يبدو أنهم كانوا ينتظرون إشارة كهذه وما زالوا ينتظرونها مرارًا وتكرارًا. ولكن ما هو طبيعة الفكر الذي يحمله المبادرون والتابعون الذين تجمعوا بالآلاف في كمنيتس ودريسدن مجهزين باتهامات عامة ضد جميع المواطنين الأجانب (“مهاجرو السكاكين”) وشعروا أن هناك ما يبرر إجبارهم على المغادرة؟ كما من قبل في بداية التسعينيات، وعلى أية حال تعبر عن انقسام عميق في مجتمعنا.
لا شك أن الاندماج المنظم لعدد كبير من الناس ومن ثقافات مختلفة ليس مشروعًا سهلاً. ولهذا السبب تحديدًا، يجب أن لا يتم تجاهل المشكلات طويلة الأمد، خصوصًا في شرق البلاد، بعد 40 عامًا من ديكتاتورية الحزب الاشتراكي الموحد، و30 عامًا من الديمقراطية التي نجحت جزئيًا فقط. يجب أخذ كل هذا في الاعتبار، وبعد ذلك يمكن ويجب الحديث والتقييم.
يجب على ممثلي الشعب أن يسعوا بشكل أكبر إلى الاقتراب من ناخبيهم. وليس عندما تكون هناك تحديات طارئة فقط، بمعنى: عندما تكون المشكلة قد وقعت بالفعل. لأنه في هذه الحالة، سيتم تكرار ما حدث في كمنيتس. يجب على السياسيين الديمقراطيين، بالتعاون مع وسائل الإعلام الجادة، أن يستعيدوا السيادة على تفسير الأحداث لصالح العدالة والشرطة والسياسة المسؤولة. ويصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، حيث لا تُقدم الحجج والتي لم يتم التحقق من صحتها، وجهًا لوجه، بل من خلال رسائل محرضة عبر الإنترنت، و تأثيرها المدمر ــ ولعلنا نتذكر اليوم قصيدة “الجرس “لفريدريش شيلر التي يصف فيها الآثار المروعة للنار ولهيبها، إذا لم يتم إخمادها ــ ( يتخذ شورلمر بيتاً من القصيدة بعنوانها اللافت، عنواناً لمقاله:
“الويل إذا أطلِقوا بلا مقاومة يتكاثرون”
Die „ Glocke,
„Wehe, wenn sie losgelassen / wachsend ohne Wiederstand“
ويستخدم هنا مفردة النار مجازاً، للإشارة إلى العواقب الكارثية المحتملة عندما تخرج المشاعر أو الأهواء أو الاضطرابات الاجتماعية عن نطاق السيطرة. المترجم).
ــ نعم، عندما تُطلق شرارات الكراهية والاحتقار والحسد، ونظريات المؤامرة وأوهام التدمير.
كتب صديق دانيال هيليغ، الذي قُتل في كيمنتس، على فيسبوك في لفتة عظيمة إلى جميع الأصدقاء: “أطلب منكم شيئاً واحداً، لا تحولوا حزنكم إلى غضب وكراهية. هؤلاء اليمينيون الذين يستغلون هذا كمنصة، كنا نتشاجر معهم في الماضي لأنهم لم يعتبرونا ألماناً بما يكفي”.
أننا نحتاج إلى مثل هذا الموقف إذا أردنا الدفاع عن ديمقراطيتنا الحرة والمفتوحة والمتسامحة باعتبارها شريكاً موثوقاً لجميع الدول الديمقراطية في أوروبا والعالم. أما اللامبالاة بالديمقراطية أو العزوف عنها أو ازدراؤها، فإنها تقود في النهاية إلى الحنين إلى شكل من أشكال الحكم الاستبدادي وفي أسوأ الأحوال إلى الخضوع (أو الاستسلام) لمختلف “القادة”، مقترناً بوحدة قومجية متشددة ضد كل ما هو أجنبي وكل الأجانب.
يحتاج المجتمع المفتوح إلى مواطنات ومواطنين يعتبرون الدستور أساسًا ملزمًا لكل تصرف ولكل حل للنزاعات. أي: نزاع منظّم وفصل موثوق للسلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية. رقابة برلمانية ومساواة في الحقوق للجميع. بناءً على تجارب القرن الماضي، نعلم أن الديمقراطية ليست أمرًا بديهيًا؛ إنها دائمًا قيد الاختبار. الديمقراطية تعتمد على قناعات المواطنين الذين يعززونها ويدافعون عنها عند الضرورة. إنها تقوم على الوعد المتبادل بين المواطنين وتستمر في الاعتماد عليه.
الديمقراطية الحقيقية تعني:، لا غنى عن البرلمانات المنتخبة بحرية والأحزاب المتنافسة (حيث تساهم الأحزاب “في تشكيل الإرادة السياسية للشعب” (المادة 21 من القانون الأساسي)، لكنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشكيل الإرادة السياسية).
ومع ذلك، فإن محاولة استعادة المواطنين الغاضبين، الذين يمكن الوصول اليهم، إلى صف الديمقراطية لن تنجح إلا إذا تم إيجاد حلول للمشاكل الملموسة. أنظر فقط في الحالة المزرية للعديد من المدارس، في إهمال المناطق الريفية، في هشاشة الخدمات الصحية أو في أولئك الذين ما زالوا عالقين في نظام هارتس 4 *
* “يشير مصطلح “هارتس 4 إلى قانون يقوم بتنظيم الحقوق المالية للأشخاص الذين يعانون من البطالة لفترات طويلة” (المترجم).
لذلك، فإن الحزم اللازم للدولة عند أو بعد وقوع الهجمات العنصرية لا يجب أن يكون الرد الوحيد. البلاد تحتاج إلى مواطنين ملتزمين، قادرين على النقاش الحضاري ومتمكنين. مواطنون شجعان، وليس غاضبين فقط. إذا تحقق ذلك، فلن يكون لدينا ما نخشى عليه بشأن حالة ديمقراطيتنا رغم كل شيء”.
*عندما نقرأ اليوم هذين المقالين ــ وفارق الزمن بينهما 29 عاماً ــ ونتابع حالة الاحتقان السياسي الآن والمد اليميني وصعود حزب اليمين المتطرف “حزب البديل من أجل ألمانيا” بحصده للأصوات في الانتخابات الأخيرة للبرلمانات المحلية، التي تمت في 3 ولايات في شرق ألمانيا، “، نرى مدى بُعد نظر هذا العالِم الجليل، ونفاذ بصيرته، فمما جاء في المقالين لايزال حاضراً اليوم، وربما بأكثر مما مضى وأشد أثراً.
المصدر: صحيفة الراكوبة