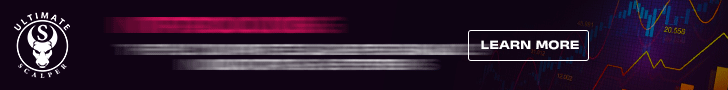في الخرطوم.. أكيد ح نتقابل


في الخرطوم.. أكيد ح نتقابل
أماني أبو سليم
كانت المرة الأولى التي أواجه فيها أني انتمي إلى هنا. لم اكن اعرف، انتصف عمري ويزيد وأنا لا اعرف ان انتمائي الدقيق، والداخلي جداً ينتمي لهذه المدينة، التي لا اميز هل هي ابنتي ام امي، هي كل ذاك هي انتماء وصلة تجمع البنوة والامومة والاخوة والصداقات والجيرة للناس والاماكن.
حين الهدنة الاولى تشجعت بأخي وذهبنا لجلب اغراضنا كنت واولادي ببيت اهلي يوم اندلاع الحرب. في الطريق البائس الخالي من المارة من جنوب الخرطوم لوسطها، في التقاطع الكبير، أبو حمامة، وهو يتفرع عصرني الشعور المترامي داخلي بالانتماء، انا انتمي لهنا، لهذه المدينة. هنا ميلادي ونشأتي، وذاكرتي. هذا طريقي لأن انتصف عمري ويزيد، الى مدرستي وجامعتي وعملي، وكل امري.
حتى تلك اللحظة، كنت اظن لو سألوني الى اي جزء من السودان تشعرين بالانتماء اكثر، لرددت بلا تردد الى منطقتي الام، ارض السكوت، قريتيّ فركة وسركيمتو. فرغم اني زرتهما مرات معدودة لا يتجاوز طولها مجتمعةً الاربعة اشهر، إلّا ان الارتباط بها لا يتعلق بكم قضيت بها من زمن، ولكن بأي قدر انفعل بها، باحداثها، وانسانها، وعاداتها، ولسانها. وغنائها ورقصها، ورغم كل ذلك هزمتْ الخرطوم مدينتي، وحبيبتي كل انتماء.
كنت حينها كأم سقط وليدها منها، او ابن يفجع في ابويه، اي صمت وأي بؤس، وأي مصاب، اين صوت مدينتي، اين زحامها وزخمها.
بعد دخولنا الشقة بدقائق سمعنا اصوات اطلاق الرصاص، المكان قريب من القيادة العامة ولا يبعد عن القصر الجمهوري. صوت الرصاص كان يكفي لاضطرابٍ أنسانا ما جئنا اليه، وقع من يديّ ما كنت احمل واسرعنا بالخروج وقد اكتفينا بما جمعناه بالحقيبة الصغيرة. لنعود لتفتيش واستجواب نقاط تفتيش الدعم السريع ثم نقاط ارتكاز الجيش جنوباً، ووصلنا بيت اهلي جنوب الخرطوم سليمي الجسد، مجروحي الروح، مكسوري النفس.
ازداد الامر سوءاً، وازدادت الروح جروحاً، والنفس كسوراً. والايام تتوالى والحرب تستعر، ومدينتي، تصرخ من الاوجاع والألم، وأعرف اكثر انتمائي لها وانتماءها لي. حبيبتي انا آسفة اني ما كنت اعرف. بعد ايام وفي مجموعة الواتس اب لسكان العمارة رأيت كيف اقتحم الدعم السريع عمارات المجمع وشقوا ابوابها. كيف استباحوا بيتي، الحتة الدقيقة لانتمائي اليك.
رغم المخاطر كان لابدّ من الذهاب مرة اخرى، في هذا العالم لا شئ يثبت وجودي غير الاوراق، وفي الجزء الشرقي منه، لا شئ يثبت ولايتي على اولادي إلّا الاوراق.
انا لا اجازف بمشاهدة افلام الاكشن والعنف، اكتفي بافلام ودراما الحوار، استمتع بالصورة والحوار، ما شهدته يومها كان واقعاً مكتمل العنف والرعب.
الطريق خالٍ، والهواء ثقيل كأنك تراه، وقد توقف عن التحرك. ارتكازات الجيش في الطريق الرئيس، حتى منطقة جنوب وسط الخرطوم ومنها تلقفتنا ارتكازات الدعم السريع كل عدة امتار. نُسأل ونجيب، يسألون اكثر سائق الركشة، حتى وصلنا المجمع، خالٍ تسمع فيه صوت ذرات الهواء وهي تتساءل اين ذهب الناس. السيارات في الموقف مهشمة الزجاج، مفتوحة الابواب، داخل العمارة المكان مظلم رغم شمس النهار. عبر الطوابق صعوداً الابواب مشقوق بها فتحات تدخل راشداً مكتمل الهيئة. اشيائي بشقتي وجدتها بمكانها، ولكن ليس كما عرفتها وعرفتني. اخذت اوراقي واغراضي المهمة التي يستحيل التحرك بدونها. لم يخطر ببالي اني ساخون كتبي يوماً. اتركها كلها هناك، إلّا واحداً. حتى وهي تعرف حين كنت بينها اني لا اعدل بينها، لا اظنها تخيلت اني قد اخونها يوماً، اتركها لمجهول. كنت اتخيل اني سارفع لوح السرير وارصها تحته فلا يراها احد، فيؤذيها، لكن الرعب والخوف في الواقع لا يعبأ بالخيال. كنت من وقت لآخر اوزع منها ما لن اقرأه مجدداً، امنحه، لمن سيعتني بها اكثر، لمن سيبادلها الحوار فيؤنسها، اختار بعناية من سامنحها له.
تركت منها ما كان بالطاولة قرب سريري، ما لم يكتمل حواري معهم رغم مرور زمن طويل على قراءتهم، تركت منهم ما كان يشارك ملابسي الارفف، لأني لا زلت اريدهم قربي، تركت اعمدة مكتبتي الصغيرة بالصالة، الذين لا استغني عنهم ولا اتحمل فراقهم مهما كانت عناية ومؤانسة الآخرين لهم، تركت كتباً اعودها كل حين، تركت اخرى اطمئن لوجودها بعيني كل حين، تركت كتباً ما ان ارى جلدتها حتى تتدفق اسطرها وصفحاتها في خيالي كأني اطالعها. تركت كتباً تزينها اهداءات ابي لي. تركت مجموعات من كتبه جهزتها وقد اوسمتها اهداءات من الاسرة لاصدقاء ومعارف ومهتمين احياءً لذكراه في ذكرى رحيله هذا العام.
من سيقنع كتبي اني ما خنتها، ومن سيقنعني انا.
اتمهل انا كثيراً في اتخاذ القرارات، استوثق من رضا نفسي فامهلها ما يطمئنها فترضا، يومها كان اخذ غرض ما او تركه لا يتجاوز كسر الكسر من الثانية. سريعاً رميت بالحقيبة ما يعين نفسه على حمله وما يعينني على حمل نفسي واولادي. وأنا ارمي الاوراق والمستندات بالحقيبة لمحت ان كان على الطاولة قرب سريري ثلاث كتب، في اقل من كسر كسر الثانية كان واحد منهم داخل الحقيبة، اغلقناها سريعاً وهرولنا نهبط الدرج على طول الطوابق، في النهار المظلم ذاك. في الموقف سيارتي مع الاخريات هموا بسرقتها تركوها هناك مجبرةً على فتح ابوابها وادراجها. تركتها هناك كمن يترك للماء مركباً لا يملك زمامه، تعودت انا على الخيانة، لا اصدق.
في كسر الكسر من الثانية كنت قررت اي الكتب الثلاثة من على الطاولة ساقذف به في الحقيبة، كتاب الدكتور النور حمد، العقل الرعوي في استعصاء الامساك باسباب التقدم، الكتاب الذي يناقش الاسباب التي منعت السودان من التقدم. يعرض فصولاً من تاريخ السودان ما ان يستتب الاستقرار والحياة المدينية فيه حتى تجتاحه مجموعات تحمل العقل الرعوي (بدو وسكان مدن، متعلمين وغير متعلمين، قديماً او حديثاً) يحيلونها خراباً.
تلقفتنا ارتكازات الدعم السريع مرة اخرى، اكثر قسوة وعنف هذه المرة، يسألون عن الحقيبة ومحتواها، انزلوا سائق الركشة وفتشوه واستجوبوه عدة مرات. كان حكيما رابط الجأش بما يكفي ان نعبر، حتى في المرة التي اعترضت طريقنا العربة رباعية الدفع واشهر من نزل منها السلاح في وجوهنا مهددينا بالقتل انّا لم نتوقف حين اشاروا بذلك، وإن لم نرَ، وحين صرخوا: نقول ليك اقيف ما تقيف تموت بس، تموت بس. كنا في مواجهة الموت، وقد علمنا للتو ان حياتنا بما مضى وبما نحلم، لا تساوى شروى نقير عند من يملك قراراً بسلاح. نفدنا بسلطان الله، ان ما زال في عمرنا بقية مما قضى لنا.
في بقية ذلك اليوم واليوم الذي تلاه لم تقوَ نفسي على فتح الحقيبة ورؤية ما احضرت. قصصت على من بالبيت ما لاقينا وكأني استعيده من شاشة، مفصولةً عنه حتى ادركت انه وقع لي وما شاهدته كما الافلام فبقيت اياماً تالفة الاعصاب، مسحوبة الذهن، راجفة الاوصال.
البيت، قصراً كان او كوخ، هو لاصحابه الملاذ، بيتي هو ابني وابي اعتني به ويحتويني. كل غرض فيه اخترته لا لجماله او جودة صناعته بل لراحتي وابنائي، اغيّر فيه واصلح ما يجعله اكثر راحة وما يجعله يواكب تغيراتي وحاجة اولادي، ما يعين سهولة التناول وراحة المرقد، ما يجعل نكهة الطعام نكهتنا، ما يجعل الملابس تشبهنا، ما يجعل الاسِرة تفتقدنا، ما يجعل البلاط يتلون بخطونا. ما يجعل ابنائي يهتفون ان عدنا بعد غيبة: يا بيتنا مشتاقيييين.
حين فتحت الباب فاحت رائحة غير رائحتنا، الهواء كان كما الجماد، توقف منذ زمن يتساءل اين هو وما الذي جرى. تركت بيتي وهربت من اصوات الرصاص القادمة من مكان غير بعيد، تركت راحتي، لا اشيائي. البيوت لا تحتوي اشياءنا وممتلكاتنا، هي تحوي امننا ودفئنا، حبنا وانتماءنا، تحوي الواننا ووجداننا، تشاركنا اشواقنا وحتى سخطنا، سعادتنا وحتى احباطنا، تستسلم لايدينا لتتخلص مما يعكر صفوها، وتضجر منا وتمل حين صمتِنا، تتألق حين نهتم بها. تعود طفلة حين ندللها فتلاعبنا باخفاء اشيائنا حين نريدها وتعيدها حين ننساها. آخر النهار استعجل العودة لبيتي لكل ذاك، بيتي انتمائي الصغير، تركته مكسورة النفس، نفسٌ لا تملك ان تبقَى او تبقِى على ما تحب فيه.
المصدر: صحيفة التغيير