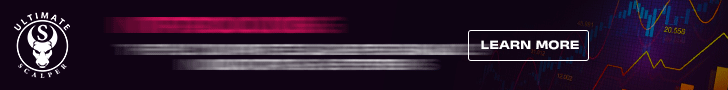دَوِي السلاح وصخب الساسة: الراهن والثورة في السودان


دَوِي السلاح وصخب الساسة: الراهن والثورة في السودان
قصي همرور
(1)
كوامي توري، أحد رموز النضال ضد الامبريالية في افريقيا وضد العنصرية في أمريكا، وأحد رموز الجيل الثاني من الحركة الافروعمومية، قال في بعض كتاباته ومحاضراته، في تسعينات القرن الماضي، إننا أصحاب مواقف ومبادئ، وبالتالي لدينا انحيازات، لكن ذلك لا يعني أن لا نقرأ التاريخ ونستنبط ديناميكاته بموضوعية. مثلا، من المؤكد أن الافروعموميين ضد النازية، قلبا وقالبا، لكن عندما نقرأ التاريخ نفهم أن ظهور هتلر ساهم في إضعاف القوى الاستعمارية الأوروبية عبر الحرب العالمية الثانية، وذلك هيّأ الأوضاع أكثر لحركات التحرر الوطني في افريقيا وآسيا كيما تضغط لنيل استقلال بلدانها، بالسياسة أحيانا وبالسلاح أحيانا؛ وبعد الحرب العالمية/الأوروبية الثانية تولّد مناخ عالمي أكثر قدرة على التعامل مع مطالب الاستقلال بانفتاح. وفق ذلك فإن صعود النازية في ألمانيا، وما تلى ذلك من تواصل وتراكم، خدم مآرب لحركات التحرر الوطني ولقضايا استقلال شعوب افريقيا وآسيا، بل وحتى قضايا الأقليات في جهات أخرى في العالم. هذه قراءة موضوعية، ثم من غير المنطقي أن تعني أن علينا أن نشكر هتلر أو ألمانيا النازية، أو نتخندق معها باعتبار “عدو عدوي هو حليفي”، أو نقول إن الجندي الألماني البسيط الذي لا يُعتَبر مشاركا في مخططات هتلر وبطانته ولكنه ينفذ فحسب استحق دعمنا المعنوي في حربه ضد فرنسا وبريطانيا لأن هؤلاء استعمرونا وآذونا أذية مباشرة (مع تذكر أن ألمانيا نفسها مارست التسلط والتجبر الاستعماري في مناطق حول العالم، كناميبيا)…. هذا تمييز لا ينبغي أن يفوت على أواسطنا في الوعي السياسي، أو كما قال بعض الكتَاب مؤخرا فإن الحرب بين الأشرار ربما تأتي ببعض النتائج الايجابية (وإن كانت مكلّفة) لغيرهم، لكن ذلك لا يعطي أي طرف في تلك الحرب فضيلةً تجعل أصحاب المبادئ والدوافع المختلفة، اختلافا جذريا، يركنون مواقفهم مؤقتا ويصطفون معه.
(2)
قراءة ما يجري في السودان الآن يحتاج لمقارنات تاريخية واسعة، ويحتاج كذلك للتمييز بين مستويات الباطل، كما جاء في حديث كثيرين، لكن بحذر. عبر النقاش والكتابة، في دوائر محدودة، ساهمنا كغيرنا في تناول المسائل المتعلقة بهذه الأحداث والتراكمات، واسترجعنا كغيرنا كتابات مستمرة منذ سنوات تتناول هذا الوضع وتعقيداته وسيناريوهاته المحتملة (مثل مقالة نشرناها في أواخر أغسطس 2019 تحدثنا فيها عن التناقضات الموروثة في بنية طرفي المجلس العسكري الانتقالي والتي قد تؤدي لانفجار داخلي في المكوّن العسكري نفسه). في تلك القراءة، هنالك عملية مستمرة من النظر الموضوعي للواقع والتاريخ، بأدوات فهم وتحليل وتركيب، تتضافر مع عملية من الاستثمار في أجندتنا في ذلك الواقع والتاريخ، فمن كانت أجندته ضيقة المصالح فذلك قد يظهر (ولو بعد حين) في خلاصاته ومواقفه، ومن كانت أجندته مرتبطة أو تحاول التماهي مع مصالح الشعوب وطموحاتها فذلك قد يظهر كذلك في خلاصاته ومواقفه؛ وبينما لا يكون الواقع الآني حَكَما مميّزا جيدا، فإن التاريخ حَكَمٌ أفضل وأوسع استقصاء.
النظرة الأوسع، والمنظور الديلكتيكي، لمثل هذه التراكمات التاريخية، فيهما متسع لما هو أعمق وأجدى من اختيار أحد خيارين لا ثالث لهما، أو توفير مظلة أخلاقية مفقودة لأي من المعسكرين. وفي تلك النظرة فرصة للاستثمار في ما هو أكثر بقاء واستدامة من نتائج صراعات مصالح ليس في أيهّا خير كبير يرجى قريبا، سوى ربما خير أن يُضعِف كلا الطرفين الآخر بتلك الصراعات، وأن يفتح ذلك الفرصة لاحتمالات أفضل وأعلى مشروعية.
(3)
مع كل قتامة الحاضر، ومرارة تراكمات الماضي، فإن سيناريوهات الخير المستقبلي للشعب تبقى قائمة، وتبقى مُلهِمة للاستمرار في العمل ونبذ اليأس. ما ينبغي أن يشغلنا الآن، كأولوية، هو (١) موقف السند الإنساني والتضامن العملي مع شعبنا المتضرر من سخائم الطرفين المتحاربين، و(٢) الاستمرار في جهود تقوية واستحصاد الثورة الشعبية، فكرا وتنظيما. الانشغال الأول فرضته تراكمات الواقع والتاريخ، والانشغال الثاني هو الخط الثوري الأصيل، الذي تلاطمته أمواج كثيرة في مسيرته، لكنه بقي صابرا، متناميا، متعلّما من الدروس ومتسلحا بالشكيمة.
(4)
في ظل أوضاع كهذه، يتكرر الحديث عن بعض البديهيات وكأنها خلاصات قوية وغائبة عن نظر الآخرين، مثل مقولة إنه كيما تكون لدينا دولة ديمقراطية لا بد أن تكون لدينا دولة في الأساس. هذه المقولة صحيحة بداهة (فما دمنا نتحدث عن ممارسة الديمقراطية في إطار/سياق الدولة العصرية فلا بد أن تكون لدينا دولة عصرية، مثلما أنك بحاجة لـ”زير” كشرط لأن يكون عندك “موية زير”) مع العلم أن الديمقراطية عموما لا تشترط وجود الدولة حتما، إذ يمكن ممارستها على عدة مستويات وفي عدة سياقات وليس فقط في إطار الدولة بيد أن هذه المقولة البديهية تُستَعمل كسهم منطقي يشير إلى صحة الحجة التي تقول إن الصراع القائم حاليا إنما هو بين طرفين أحدهما يمثل الدولة والثاني يمثل اللادولة أو الفوضى، وبالتالي فإن “الاصطفاف” وراء الطرف الذي يمثّل الدولة هو الموقف السليم (وبعضهم يقول إنه الموقف الوحيد “الوطني”، كمزايدة فوق ركام المزايدات).
عموما، سواءٌ أكُنّا من المعجبين بنموذج الدولة العصرية أم لا، فهو معطى من معطيات الواقع التاريخي، بمعنى أن أي مجتمع معاصر بحاجة لنظام دولة عصرية كيما يستفيد من ميزات العصر الحالي في الكوكب ويتقيّد بشروطه؛ وكما قلنا من قبل فحتى لو كانت لدينا مشاكل مع نموذج الدولة العصرية ونريد تجاوزه، فإن تجاوزه يمر بدرب استعماله جيدا حتى يستنفد غرضه، فهنالك شروط بنية تحتية وفوقية في المجتمعات الحديثة نحتاج لنموذج الدولة العصرية لتحقيقها، حتى تصبح مجتمعاتنا مؤهلة لمناقشة وتجريب نماذج أخرى (أحدث ربما، أو أفضل) من التنظيم الاجتماعي الحديث. لذلك فالدولة العصرية مهمة، ووضع اللادولة، أو تفكك الدولة، لا يخدم أهداف التنمية والتحرر والاستقرار لشعوبنا.
لكن السودان ليس مهددا بمرحلة تفكك الدولة، إلا ربما مجازا أو إمعانا، لأنه فعليا وصل تلك المرحلة مسبقا، والتحدي القائم الآن هو كيفية إعادة بناء الدولة وليس الحفاظ على الحد الأدنى منها، فنحن أصبحنا دون ذلك الحد الأدنى منذ فترة. في كتاب “ممكنات السودان” (2021، جوبا) تناولنا جانبا من شروط الدولة العصرية وكيف أن السودان حاليا لا يستوفي الحد الأدنى منها، ما يجعلنا نواجه الواقع بأن نقول إننا في مرحلة ما تحت الصفر من حيث مقاييس الدولة الكفؤة. ومن مشاكل إعادة بناء الدولة هو أن هنالك، ما تزال، بقايا مظاهر دولة، تجعل البعض يظن أن هنالك دولة، ومن ثم يتحدث عن “إصلاح” تلك المؤسسة أو تلك القوانين، من إجل إنقاذ الدولة، بينما الواقع يقول إننا تجاوزنا فرصة “الإصلاح” تلك وحاليا علينا التفكير في المراجعات الشاملة، في إعادة الهيكلة، في إعادة التعريف، وذلك يختلف عن مجرد الإصلاح، أو بعض التغييرات على مستويات الشكليات والمناصب القيادية والقواعد الإدارية.
لذلك، فإن ما يسمى بقوات الدعم السريع، أو مليشيا الدعم السريع، ليست تهددنا بأن تكون سببا في تفكك الدولة، إنما هي في الواقع نتيجة لتفكك الدولة، ومؤشر من مؤشرات فشل وغباء السلطات المتعاقبة على السودان، وشتان بين السبب والنتيجة.
(5)
من البراهين الواضحة على أن وجود الدعم السريع إنما هو نتيجة لتفكك الدولة السودانية وفشل سلطاتها، ومن المفارقات المحزنة في واقع الدولةاللادولة السودانية، أن هذه القوات أو المليشيا، رغم وجودها المؤذي وغير المنطقي في الحاضر السوداني، إلا أنها ذات وجود قانوني وتُعتَبر قانونيا من مؤسسات الدولة ذات الاختصاص. الوصف الأقرب للدقة، بخصوص الدعم السريع، وفق تاريخه ونشأته، هو أنه (Paramilitary group) أو مجموعة موازية للجيش. وهو مجموعة موازية بصورة قانونية، ذلك لأنه تم إنشاؤه بواسطة سلطة دولة وتم تقنينه بموجب قانون دولة (أي قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017)، وتلقى في البداية تدريبا مباشرا من الجيش، ودعما مباشرا من سلطة الدولة، وضوءا أخضر ليحارب نيابة عن الجيش أو بالأصح كوحدة من وحداته ذات استقلالية في مواقع مختارة، وجُعِلت موارد تحت إمرة قيادته بموافقة الدولة (أي بموافقة سلطة الدولة) وعدم ممانعة لكي يمارس تعاقدات مع جهات خارجية.
هذا من ناحية، وأما من حيث المجادلة بأنه فاقد المشروعية بسبب تاريخه الدموي ضد المواطنين، فذلك صحيح، لكن المشكلة أنه فيما يتعلق بالتاريخ الدموي وقهر الناس العزّل وتجاوز قواعد الحرب المتفق عليها، فالجيش السوداني له السبق في كل هذا، بل ربما تاريخ الجيش السوداني كمؤسسة وطنية بالاسم فقط وتحتاج لمراجعة شاملة كيما تستحق هذا الوصف يوما ما فيه إجمالا من رصيد الولوغ في دماء السودانيين وخرق القواعد الدولية والمحاذير الإنسانية ما هو أكبر من رصيد الدعم السريع. وفي الفترة منذ 2019 وقبل بضعة أيام، تضخم الدعم السريع كمَا ومقدارا، فتضاعف عدد المنتسبين له، وزادت قواعده في شتى أنحاء البلاد، وزادت ترسانته ومبانيه وأعماله وتدخلاته في شتى شؤون البلاد، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع قيادة القوات المسلحة والحكومة الانتقالية، بل بمباركة واضحة منهما، (مع سماعنا لبعض التذمر وسط ضباط وجنود الجيش لكن لا نرى له أثرا على الواقع وإنما فقط نرى جبروتهم الموجّه نحو الجماهير عندما يأمرهم قادتهم بذلك)؛ فأين كان الانتباه لخطورة هذا الجسم الغريب ونموّه غير المفهوم طيلة هذه الفترة؟
الإجابة الشافية على هذا السؤال لن نجدها عند قيادة القوات المسلحة، ولن نجدها عند الجهات السياسية التي شاركت في السلطة الانتقالية، وبالتأكيد لن نجدها عند الساسة الذين توددوا للدعم السريع بذريعة البراغماتية السياسية، إنما سنجدها عند عناصر الثورة ذات الأصالة، وهم الذين رفعوا مسبقا شعار ومبدأ “الجنجويد ينحل” (كما رفعوا شعار ومبدأ “العسكر للثكنات”). وجود ما يسمى بالدعم السريع وجود غير منطقي وغير مستدام، ذلك لأنه قوة مسلحة أسِّست على الباطل، وعلى ما هو ضد قوام الدولة العصرية ومرجعية المواطنة. هذه هي المشكلة التي تقضي بأهمية زوال الدعم السريع. لكن لا يغيّر ذلك من حقيقة أن هذه القوة صنعة الدولةاللادولة السودانية نفسها ونتيجة من نتائج فسادها وتفككها، أي نتيجة أخطاء وغفلة السلطات الغاشمة وضيقة الأفق التي حكمت السودان طيلة السنوات الماضية (ولا ننسى أن تسليح الجماعات الموازية للجيش ومنحها تصريحا لممارسة القتل والحرب داخل الدولة، لم تبدأه حكومة الكيزان الاولى، بل بدأ قبل ذلك، كما وثّق لذلك منصور خالد في كتابه “السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام”،2003 ).
(6)
لا ينبغي أن نكون بحاجة للمجادلة بخصوص البديهة التي تقول إن مؤسسة القوات المسلحة جزء من تكوين الدولة العصرية (مع التفاوت في هياكلها وأحجامها ومدى اختصاصاتها، ومع إمكانيات تطويرها وتغيير جوانب فيها)، بينما ليست هنالك دولة كفؤة تحتاج لقوات موازية (خاصة لو حاولت الاستقلال عن سلطة الدولة). وفي حالة السودان، لا نحتاج أن نؤكد أن السودان لا يمكن أن يتقدم باصطحاب ما يسمى بالدعم السريع، وهذا أمرٌ متفق عليه بصورة واسعة وسط المهتمين بدراسة الشأن السوداني واستشراف مستقبل هذه البلاد؛ إنما نحتاج لأن نسأل أسئلة صعبة ومهمة: كيف نثق بالجهات التي شرعنت لوجود الدعم السريع، ولتضخمه، ولممارساته ضد المواطنين السودانيين وضد الأمن الوطني، في شتى أرجاء السودان، وصمتت طيلة هذه الفترة عن التهديد الخطير الذي يمثله، ثم فجأة صارت تقول ما قاله أهل الثورة مبكرا ولقوا جراءه القمع والقهر والإزاحة، وصارت تبدي العداوة تجاه نفس حليفها السابق فقط عندما ظهر تضارب المصالح السلطوية وليس التضارب مع مصلحة الشعب؟
نفس العقلية التي أنجبت الدعم السريع وجعلته يتوسع بهذه الطريقة، كيف لنا أن نظن، ببساطة، أنها ستحل (وتحسم) هذه المشكلة فقط لأن مصالح الجنرالات ومصالح قيادة الجنجويد أصبحت الان مصطدمة تماما، بينما لم تتغيّر أي عوامل أخرى كعقلياتهم وطموحاتهم وضمائرهم؟
مثل هذا السؤال يقودنا للحديث عن قلة الوعي التاريخي، وضعف الحدس الثوري، في محاولات نسيان أو تقليل خطورة أحد طرفي الصراع المسلح الجاري الآن ومحاولة التركيز على شيطنة الآخر فحسب (وكثير من صنّاع الرأي في السودان حاليا متورطين في هذا)، وكأن الفرق بينهما شاسع، بينما هو في الواقع فرق ضئيل جدا، خاصة في مستوى الأثر على حيوات المواطنين، ومستوى استسهال واسترخاص حقوق وحيوات الناس، الأمر الذي لم يظهر في الحرب الدموية التي طرأت مؤخرا فحسب وإنما عبر سنوات من قصف القرى في دارفور وترويع وامتهان الناس فيها وفي مناطق أخرى وعبر أربع سنوات من قتل وجرح المتظاهرين السلميين في مدن السودان بدون أي محاسبة. ومن ضعف الخيال الثوري أن يختار الناس بين اثنين من أهل المصالح المغايرة تماما لمصالحهم، فقط لظنهم أن أحد الطرفين أخف قسوة ودمارا من الآخر، وأن هنالك فرصة ما لأن يعود أحد أولئك الطرفين فجأة إلى رشده ويقدّم مصلحة البلد. ذلك بينما كل الأمواج الجدلية في هذا الشأن تنكسر عند صخرة الواقع الذي يقول، على لسان الكاتب الافروامريكي جيمس بولدون: “لا يمكنني تصديق ما تقوله، لأني أرى ما تفعله.”
I can’t believe what you say, because I see what you do
لا نحتاج في مثل هذه الأوقات للتذكير بأنه، في بعض الحالات التاريخية الاستثنائية، يضطر بعضنا لاختيار أخف الضررين، لغياب أي خيارات أخرى متوفرة. هذه ليست إحدى تلك الحالات الاستثنائية، لأن لدينا في هذا السياق، وهذا الزمان، قوى ثورية محلية كبيرة، تعمل وتستحصد منذ سنوات، وتنمو في وعيها وتنظيمها منذ سنوات، عبر مخاض عسير من الامتحانات الصعبة وإبراز الصمامة النادرة. هذا خيارٌ ثالث متوفر، على الأقل، لا يخيب من ينصره ولا يسعد من يخذله.
(7)
أما بالنسبة لموازين القوى، وما يمكن أن تُنبئنا بخصوص مآلات الحرب الجارية، فكون الجيش أكبر قوة عسكرية من “الدعامة” ربما يعطي سيناريو انتصار الجيش نسبة أعلى من غيرها، لكن لا يفيدنا بالضرورة بأن المعركة ستُحسم تماما لصالح الجيش، أي أن الأوضاع الأمنية والسياسية ستعود إلى سلطة موحدة ومستقرة (حتى لو كانت غير ديمقراطية أو حتى مشروعة). ذلك لأنه في حرب المدن وحرب العصابات، فإن القوة العسكرية الأصغر يمكنها استنزاف القوة الأكبر وتمديد فترة الحرب وزيادة الخسائر العامة، وإحداث الكثير من الزعازع، بدون أن تحصل غلبة مباشرة، الى ان يقود الأمر للمفاوضات أو تغيّرات في خارطة الانحيازات والتدخلات (محليا وعالميا) وأشياء كذلك. هذا سيناريو وارد على أي حال، إلا لو أثبت الجيش أن لديه خبرة كافية تجعله ينهي الحرب قبل حدوث كل ذلك (فهذا الجيش على أي حال لم يستطع حسم حربه مع حركات مسلحة أخرى أقل حجما وعتادا من الدعم السريع، وعلى مدى سنوات، بل إن فشله ذلك كان أحد مبررات إنشاء الدعم السريع؛ ذلك رغم أن تلك الحركات تختلف هيكليا وتاريخيا من الدعم السريع، وهذا شأن آخر). لنتذكر أن التاريخ الحديث يرينا كيف قامت حركات مسلحة أصغر بغلبة جيوش نظامية أكبر وفق قواعد حرب العصابات، كما قامت بالضغط على الجيوش النظامية حتى ساقتها للمفاوضات (مثل ما قامت به الحركة الشعبية في اتفاق السلام الشامل). لكن، ربما يكون هنالك دور لعامل مهم، وهو أن قوات الدعم السريع لا تنافح من أجل قضية سياسيةتاريخية تعطيها دفعا ذاتيا وأسباب نضال متجاوزة للمصالح الضيقة (لكن ذلك لا يدعونا للاستهانة بقدرتها على خلق حالة واسعة من الارتباك والضرر في البلاد، فحتى لو تم التخلص من الجسم المسمى الدعم السريع فإن الكثير من سلاحه ومسلّحيه سيبقون لأمد غير قصير ليحدثوا مشاكل غير قليلة). عموما يمكن كذلك قراءة ما كتبه ماوتسي تونغ وتشي قيفارا حول حرب العصابات (Guerrilla warfare) وهما خبراء فيها، ونجحا قبل ذلك في هزيمة جيوش نظامية، (كما حصل ذلك بجوارنا في إثيوبيا ويوغندا أيضا).
لذلك فسيناريو أن تتمدد آثار هذه الحرب في الزمان والجغرافيا لتحيل معظم أرجاء البلاد إلى مناطق كوارث ورعب أي إلى الوضع الذي عانت منه بعض جهات السودان لسنوات، بل لعقود، بينما الجهات الأخرى كانت غافلة عن هذا الواقع بحيث لم تستطع شعوبها تخيّله بما يكفي من سعة الخيال ليس سيناريو مستبعدا، للأسف (رغم أنه ليس حتميا). وحتى لو استطاع الجيش أن يحسم خصمه حسما تاما، فلنا أن نتخيّل ماذا يعني ذلك لقوى الثورة وممثليها في الشعب بعض أن تخلو الأجواء لقيادة القوات المسلحة الذين نعرفهم جيدا وبعد أن ينتشوا بنصرٍ عسكري جبار كهذا…. في مجمل الأحوال، من السذاجة توقّع أن آثار هذه الحرب لن تبقى معنا لعدة سنوات على الأقل.
على المستوى العام، يتمنى المرء أن يقول إنه يثق في القوات المسلحة التي تنتمي لدولته، ويقول إنه يتعاطف مع جميع الجنود الذين يخوضون غمار الحرب باسم حماية بقية الشعب (فهم أيضا، أي الجنود، جزء من الشعب)؛ هذا ما يتمناه المرء. لكن مع تعاقب وتراكم ميراث الشعب السوداني المرير مع المؤسسة العسكرية عبر العصور، فإن هذه للأسف رفاهية لا نملكها حاليا. كثيرا مثلا ما نسمع عن وجود “شرفاء الجيش”، من الضباط وضباط الصف، الذين تتناقل الأخبار عن أنهم غير مسؤولين عن قرارات وأفعال قيادات الجيش من كبار الضباط، وأنهم سينقذوننا يوما ما من قبضة هؤلاء، وبدون أن نجادل في وجود هؤلاء الشرفاء وفي مدى شرفهم فعلى العموم نحن لم نستفد منهم شيئا حتى الآن وعلى مدى سنوات بل عقود من تحكم المتسلطين القساة بالقوات النظامية للدولة، فوجودهم ما زال افتراضيا فحسب، بل كل ما جرّبناه في الواقع هو أن جملة الجنود والضباط ينفذون أوامر قياداتهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الجماهير في شتى أنحاء البلاد ثم نسمع بأن لا حيلة لهم. هذا حديث لا قيمة له، فإن كانوا غير قادرين على البروز فعلا ولجم مؤسستهم عن البطش بالأبرياء، وعلى جعل مؤسستهم وطنية وشريفة بما يكفي، فلا يستحقوا من الشعب أي تذكّر أو عذر، بل الأصح أنهم يتحملون المسؤولية مع قادتهم أو يتبرأوا من الانتساب لتلك المؤسسة. أم إن ظهروا فعلا، وأثبتوا وجودهم وصدقهم بالفعل لا بالقول، فلكل حادث حديث. (وهنالك كتابات سابقة، سودانية وغير سودانية، حول أهمية المراجعة الهيكلية لقواعد الطاعة ومشاركة المسؤولية عن تنفيذ القرارات في القوات المسلحة، فهذه إحدى الجوانب ذات الإشكال العميق في بنيان الجيوش الحديثة).
(*8)
مع كل ذلك، نكرر: ما ينبغي أن يشغلنا الآن، كأولوية، هو (١) موقف السند الإنساني والتضامن العملي مع شعبنا المتضرر من سخائم الطرفين المتحاربين، و(٢) الاستمرار في جهود تقوية واستحصاد الثورة الشعبية، فكرا وتنظيما. الانشغال الأول فرضته تراكمات الواقع والتاريخ، والانشغال الثاني هو الخط الثوري الأصيل، الذي تلاطمته أمواج كثيرة في مسيرته، لكنه بقي صابرا، متناميا، متعلّما من الدروس ومتسلحا بالشكيمة.
عملية إعادة بناء الدولة جزء من مشروع استرداد وتغليب كرامة الإنسان في السودان، وهذا المشروع يتضمن أيضا التنمية، والتحرر، والتحول الاجتماعي نحو العدالة ونحو تفجير طاقات الابتكار والحضارة والجمال، والتضامن الإنساني الواسع. هذا مشروع فيه جوانب فكرية، فنية، علمية، كبيرة، وفيه جوانب شعورية عميقة ونبيلة، وفيه حاجة لتخطيط وتنفيذ كبير ودؤوب ومتفاني. مثل هذا المشروع لا يقوم به الذين يتبدلون مع التبدلات السريعة للمصالح والمخاطر، كما لا ينبغي أن يعتمد في مجمله على كوادر ضعيفة الخيال، مستعجلة للنتائج، أو سريعة التخندق والاختزال للأوضاع في حالات الكوارث. هذا مشروع يحتاج لعقول غير متهافتة، ولسواعد مستقلة…. وللحديث شجون.
قصي همرور، 22 أبريل 2023
المصدر: صحيفة التغيير