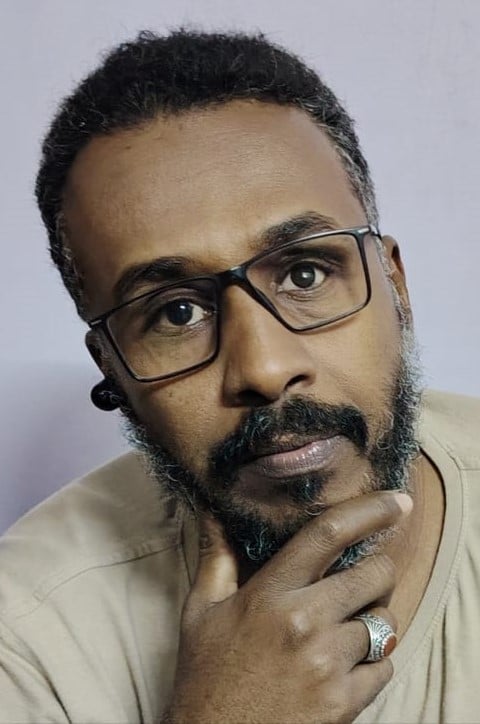✍️ محمد هاشم محمد الحسن
في لحظة يتداخل فيها الألم الشعبي مع الشعارات الثورية، يتصدر المشهد خطاب خليل الحية من الدوحة، ليُعيد إنتاج معادلة مقلوبة، قيادة تنعم بالأمان تُسيّر قراراتها من خارج ساحة المعركة، وشعب يُدفن تحت الأنقاض دون أن يُستشار في مصيره. مما يجعلنا نطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى الخطاب حين يفصل نفسه عن الواقع، ويتحوّل من مشروع تحرري إلى أداة تعبئة تنظيمية. وبينما تُوظَّف المقاومة في غزة بوصفها غاية مشروعة، تُستخدم التنظيمات العقائدية في السودان ضمن مسارات مشابهة من التمكين والاحتكار، ولكن تحت لافتة الحكم البديل لا التحرير. وفي الحالتين، يُختزل الشعب في سردية التعبئة، وتغيب فكرة الوطن لصالح التنظيم، ويُصاغ القرار من خارج الوجدان الشعبي. فهل لا تزال المقاومة تعني الناس؟ أم أنها باتت تعني التنظيم فقط، وإن اختلفت تسمياته؟
ما جاء في خطاب خليل الحية لا يمكن تناوله بوصفه مجرد اجتهاد إعلامي في لحظة استثنائية، بل هو مدخل لفهم أزمة مركّبة تطال البنية العقلية للقيادة الإسلامية المعاصرة، وتكشف عن تموضع رمزي وتنظيمي يفتقر للواقعية السياسية، ويُفضي إلى استنزاف شعبي لا تحكمه أطر مساءلة أو مراجعة. الخطاب، الذي أُلقي من العاصمة القطرية الدوحة، بعيدًا عن أنقاض غزة المنكوبة، مثّل نموذجًا صريحًا للفصل بين القيادة والمنكوبين، ليس جغرافيًا فحسب، بل معرفيًا ووجدانيًا، حيث تعيش القيادات واقعًا آمنًا، وتُصيغ سرديات البطولة من بين ركام مدن لم تطأها أقدامها. هذا الانفصال لا يُنتج إلا قرارات مشوبة بالتعنت، ويُسهّل تلقي الدعم الخارجي دون أي مساءلة داخلية حقيقية من الشعب الذي يُفترض أن يُشارك في القرار لا أن يُعبّأ لتنفيذه.
هذا التوصيف يُفضي بنا إلى واحدة من المفارقات البنيوية في الخطاب القيادي، إذ يُقدَّم كمُمثل للمقاومة، لكنه يُمارس سلوكًا سلطويًا يكرّس احتكار القرار باسم الشرعية الثورية، ويُعيد إنتاج النموذج الذي شهدة السودان في حقبة الإسلاميين، حين اختُزلت الدولة في التنظيم وأُلغيت المؤسسات لصالح الولاء العقائدي. بهذا المعنى، يصبح المشروع التحرري واجهة لتنظيم مغلق، لا لشعب يُفترض أن يُشارك في القرار.
في جوهره، لا يعكس خطاب الحية أي حس نقدي تجاه الاستراتيجيات التي أوصلت غزة إلى واحدة من أبشع الكوارث المعاصرة. بل جاء مفعمًا بالمناشدات والاتهامات، وكأنه يعرض المأساة الفلسطينية في السوق التفاوضية، لا باعتبارها كارثة إنسانية تستدعي مراجعة شاملة ومساءلة صارمة. رفض مراجعة الحسابات السياسية والميدانية تجلّى في تعنت الحركة في المفاوضات، حين ربطت مصير مليونَي فلسطيني بمصير 150 قياديًا من حماس، الأمر الذي منح الاحتلال ذريعةً إضافية لمواصلة عملياته تحت ادعاء أن الطرف الفلسطيني غير جاد أو يتلاعب بالمطالب. هذا السلوك يشبه تمامًا تعنّت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، الذين عطّلوا مساعي إنهاء الحرب وحملوا الشعب تبعات خياراتهم العقائدية. في كلا السياقين، تستفيد القوى المضادة من هذا التعنت لتقويض أي وحدة داخلية، وتُستخدم المآسي كمنصات دعائية لا كبؤر لإنهاء المعاناة.
وفي هذا الإطار، تبرز إشكالية أخرى مرتبطة بكيفية توظيف المعاناة، حيث يتحوّل الألم الجماعي إلى أداة تعبئة لا إلى منطلق للمراجعة. كما حدث في السودان، لم تكن الحرب نقطة تأسيس أو بناء دولة، بل وُظّفت كوسيلة
لإعادة التمكين التنظيمي واسترداد السلطة، لا لاستعادة المجتمع أو حماية الناس. ويبدو أن المشهد يتكرّر في غزة، بخطاب يُستخدم لتثبيت القيادة لا لتصحيح المسار أو إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الجامع.
الخطاب أيضًا لا يغيب عنه التحريض المبطن ضد الأنظمة المجاورة، إذ خاطب الحية شعوب الأردن ومصر بعبارات تستدعي تاريخًا من الانقسام والمواجهات، متجاهلًا دروس الماضي وموقع الشعوب والأنظمة من الأمن القومي العربي. حين دعا الأردنيين لاستئناف الحشد الشعبي، استحضر تجربة دامية تجاهلت أن فصائل المقاومة نفسها هي من سعت إلى تقويض الدولة الأردنية وإنشاء كيانات موازية، ما أدى إلى صدامات دفع ثمنها الشعب والجيش، واضطُرت القيادة الأردنية إلى التعامل مع تلك التهديدات بالتنسيق مع إسرائيل لحماية البلاد من الفوضى. هذا التجاهل للوقائع التاريخية يعكس عقلية لم تتعلم شيئًا من الماضي، بل تعيد إنتاجه بأدوات جديدة.
أما خطاب الحية تجاه مصر، فقد جاء مفككًا، خاطب فيه مكونات الدولة المصرية كلٌ على حدة: الجيش، القبائل، العلماء، الكنائس، الأزهر، النخب، وكأن مصر كيان هش لا تحكمه سلطة موحدة، بل مجموعات مستقلة يمكن استمالتها فرديًا. هذا النمط من الخطاب لا يهدد العلاقات فحسب، بل ينطوي على تصور مُتقادم للدولة، وهو ما يُشبه دسّ السمّ في اللبن، إذ يُحفّز المواطنين ومؤسسات الدولة على الاصطفاف ضد النظام القائم، ويُفسّر في إطار تقويض الأمن القومي لا تعزيز الروح المقاوِمة.
وتكمن الخطورة أيضًا في أن الخطاب لم يُشر من قريب أو بعيد إلى أي تصور عملي أو مبدئي لما بعد الحرب، لا رؤية لإعادة الإعمار، ولا مراجعة لخطاب الممانعة المتآكل، وكأن معطيات الواقع لا تتطلب سوى الاستمرار في تدوير المعاناة. هذا المنطق يكاد يتطابق مع ما يحدث في السودان، حيث يُستثمر الانهيار الشامل في محاولة لإعادة إنتاج السلطة على أنقاض الدولة، وتُختزل الوطنية في شعارات عقائدية لا تستند إلى أي مشروع مؤسسي أو مدني. لا حديث عن التعليم، الصحة، البنية التحتية أو النسيج الأهلي، وكأن شروط الحياة تُؤجل إلى ما بعد النصر الرمزي.
وفي تناول قضية المساعدات، استخدم الحية خطابًا مرتبكًا، أدان من وصفهم باللصوص، دون توضيح لآليات توزيع الإغاثة أو الجهات المتورطة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول تورط الحركة أو غضّ الطرف عن عمليات نهب ممنهجة، تُشبه ما تقوم به مليشيات الإسلاميين في السودان حين تستحوذ على الإغاثة بزريعة السيادة الوطنية والأمن القومي، فتتحول المأساة الإنسانية إلى سلعة تُعزز النفوذ وتُرسّخ الولاء.
أما الادعاء بأن حماس تحتفظ بـ80٪ من قدرتها العسكرية، فقد عكس لهجة تنظيمية متعالية ترى في الشعب حاضنة لا شريكًا، فلم يأتِ الخطاب على ذكر الانهيار الاجتماعي أو الدمار الشامل، بل ركّز على قوة التنظيم وصموده، وكأن النصر يُقاس بعدد الصواريخ لا بحياة الناس. مرة أخرى، يتكرّر مشهد السودان، حين تُبرَّر الحرب بالمحافظة على الهوية، بينما الهوية تتآكل مع كل طلقة.
وتزداد المفارقة عندما يتجاهل الخطاب جذور التأثير الإقليمي، إذ لا يُذكر أي دور حاسم لقطر أو تركيا أو إيران في صياغة القرار، بل يُكتفى بتوجيه رسائل شعبوية إلى مصر والأردن. هذا التجاهل يُعيد إلى الأذهان ممارسات الإسلاميين في السودان الذين ركّزوا على الهجوم على الجوار العربي، وتغاضوا عن التمويل
الخارجي الذي شكّل عُمقهم الاستراتيجي. هنا يُفقد الخطاب صدقيته، ويظهر كأداة ضمن مشروع خارجي لا كصوت فلسطيني مستقل.
وفي نهاية خطابه، قال الحية للفلسطينيين (فداكم حبات عيوننا ومهجنا)، وهو في واقع الأمر يقيم في قطر بعيدًا عن جحيم الحرب والدمار، ما يُبرز التناقض العميق بين الخطاب والواقع، بين الادعاء بالفداء والمكوث في الملاذات الآمنة. هذا التناقض هو شهادة دامغة على أزمة قيادة تُجيد إنتاج المأساة وتثبيتها، لكنها تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأنها شريك في صناعتها. وكما في السودان، حين تتحوّل الحرب من غاية إلى وسيلة، تنكشف هشاشة القيادات التي لا تجد لها موضعًا في وجدان الشعوب، لأنها ببساطة لا ترى فيهم شركاء في البناء، بل أدوات للتمكين العقائدي. وبغياب المشروع المدني، وتفكك الدولة، تتحوّل المقاومة إلى مظلة لتنظيم مغلق، ويُختزل التحرر في سردية تنظيمية لا وطنية، ويغيب السؤال الأهم، من يُحرّر الإنسان من خطاب التحرير؟
المصدر: صحيفة الراكوبة