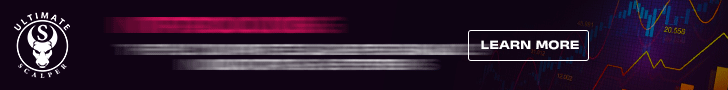الإماء في الإسلام : مرآة الصراع بين الحرية والتقاليد وموروث الجاهلية الذي يثقل كاهل الإسلام

ابراهيم برسي
عندما نتأمل تاريخ الإماء في الإسلام ، نواجه تناقضًا عميقًا بين المبادئ الداعية إلى العدالة والحرية ، وبين واقع اجتماعي يقنن العبودية.
الإماء ، وهن جمع “أمَة”، لم يكنّ مجرد نساء مستعبدات تحت وطأة الحاجة والقهر ، بل كُنّ انعكاسًا لأنظمة فكرية واقتصادية تُشرعن السيطرة والهيمنة ، محوّلات الإنسان إلى سلعة تُباع وتُشترى.
الإسلام ، وفق النصوص الدينية ، لم يبتكر نظام العبودية ، بل وجده متجذرًا في البنى الاجتماعية الجاهلية. ومع ذلك ، فإنني لا أحب استخدام مصطلح “الجاهلية” لوصف تلك الحقبة ، إذ أراه اختزالًا وتبسيطًا لعصر كان ، رغم جوانبه السلبية ، زاخرًا بالثقافة والشعر والنظم الاجتماعية. تلك الفترة التي وُصفت بالجاهلية ، كانت غنية بنظم وقيم أثرت حتى في الثقافة الإسلامية اللاحقة ، مثل نظام الدية وقوانين حماية الضيف ، واستغرابي يكمن في الإقصاء الكلي لهذه الحقبة ، وكأنها كانت ظلامًا مطلقًا ، بينما هي في الحقيقة تحمل ملامح من النور الذي ساهم في تشكيل الحضارة العربية.
أقر الإسلام العبودية ضمن نظام “ملك اليمين”، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى تحرير الرقاب كقربة إلى الله. قال تعالى : “فَكُّ رَقَبَةٍ” (البلد: 13) ، وقال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) : “من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار” (رواه البخاري). هذه الدعوات لتحرير العبيد تعكس تناقضًا واضحًا. فمن جهة ، الإسلام يدعو إلى إنهاء العبودية ، لكنه في الوقت ذاته يقننها ضمن أطر اجتماعية واقتصادية لم يتم تفكيكها جذريًا.
لماذا أقر الإسلام العبودية؟
هذا السؤال يتطلب تفسيرًا فلسفيًا واجتماعيًا عميقًا. النظام الذي أقره الإسلام كان جزءًا من توازن اجتماعي واقتصادي معقد. تحرير العبيد بشكل كامل في ذلك العصر كان سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي ، ما جعل الإسلام يقدم حلاً تدريجيًا : تقنين العبودية من جهة ، وتشجيع العتق من جهة أخرى.
لكن هذا الحل التدريجي يعكس تنازلاً أمام الواقع الذي يخدم مصالح طبقة معينة ، أصحاب النفوذ والمصلحة الذين استفادوا من استمرار هذا النظام.
لكن ، كيف يمكن تبرير القهر باسم الضرورة؟ الفلسفة تعلّمنا أن العدالة لا تقبل التقسيط. كما قال جون ستيوارت ميل : “القمع باسم العدالة هو أقسى أنواع القمع ، لأنه يحمل قناع الفضيلة.” إن تبرير استمرار العبودية بحجج اقتصادية هو خيانة للقيم المثلى ، لأن العدالة الحقيقية هي التي تُحقق بغض النظر عن تكلفة تحقيقها.
“الإنسان محكوم عليه أن يكون حرًا”، كما قال سارتر. ومع ذلك ، فإن الإماء في الإسلام لم يُمنحن حتى فرصة الحلم بهذه الحرية.
أدوارهن كانت محصورة بين الخضوع كخادمات ، والإذعان كمحظيات ، أو استغلالهن كأدوات للإنجاب. لم يُمنحن الاعتراف الكامل بإنسانيتهن.
وكانت قيمتهن مرهونة بما يقدمنه من خدمة للأسياد أو بإنجابهن لأبناء يعيدون إنتاج النظام نفسه.
الأبناء الذين وُلدوا من الإماء عاشوا واقعًا معقدًا ومزدوجًا. فهم أبناء لأسيادهم ، لكنهم في الوقت نفسه لم يُعاملوا معاملة الأبناء الشرعيين.
فالبنت المولودة من أمة ، على سبيل المثال ، كانت تعيش ازدواجية طبقية تجعلها أقل شأنًا من أبناء الزوجة الحرة.
هؤلاء الأبناء كانوا يحملون عبء هويتهم المزدوجة ، كأنهم يعيشون بين عالمين لا ينتمون لأي منهما بشكل كامل.
هذا التناقض الطبقي يعكس فجوة اجتماعية عميقة ، وهي جزء من نظام أعمق يعيد تشكيل الوعي.
ويمكن ربط هذه الفجوة بحالة “التكيف القهري” التي تعيشها الإماء.
علم النفس يفسر هذا الخضوع كآلية دفاعية.
الإماء كنّ يرين في خنوعهن وسيلة للبقاء ، حيث أقنعن أنفسهن بأن ما يقمن به هو طاعة لله أو امتحان إلهي. غسيل المخ الجماعي الذي تعرضن له جعلهن يعتقدن أن دورهن في خدمة الأسياد هو جزء من مشيئة الله. هذه الحالة النفسية هي مثال على ما وصفه فروم بـ”الهروب من الحرية”، حيث يختار الفرد القبول بالقيود لأنه يخشى مواجهة العبء الذي تحمله الحرية.
أما الأبناء ، رغم الفوارق الطبقية ، فقد ظلوا يدورون في فلك الأسياد.
فقد كبر هؤلاء الأطفال وهم يرون أنفسهم جزءًا من نظام يستحيل كسره.
هذه الحالة النفسية تُفسر كحالة اغتراب ، حيث يشعر الفرد بأنه غريب عن نفسه وعن محيطه ، لكنه مضطر للتعايش مع هذا الاغتراب.
وفي نظام الميراث الإسلامي ، كان أبناء الإماء يرثون فقط إذا اعترف بهم آباؤهم.
وهذا الاعتراف لم يكن دائمًا سهل المنال. بل وحتى إذا أراد الأب أن يمنحهم حقوقًا أثناء حياته فإن قواعد الشريعة تقيّده.
قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “لا وصية لوارث” (رواه الترمذي)، مما يضع الأب في معضلة أخلاقية عميقة.
وهذا التمييز يظهر جليًا في نظام “أم الولد”. الأمَة التي تنجب من سيدها تصبح “أم ولد”، وتنال حريتها تلقائيًا عند وفاته. لكن هذه الحرية كانت حرية مؤجلة ومشروطة ، تأتي في وقت تكون فيه حياتها قد استُنزفت بالكامل في خدمة النظام الاجتماعي.
مارية القبطية ، التي أهداها المقوقس إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، تقدم مثالًا بارزًا على هذا التمييز. رغم حب النبي لها وإنجابها لابنه إبراهيم ، ظل وضعها أدنى مقارنة بزوجاته الحرائر.
وريحانة بنت زيد ، التي رفضت الزواج بالنبي واختارت البقاء على دينها اليهودي ، تمثل حالة أخرى من التعقيد ، حيث تداخلت الحرية الفردية مع قيود النظام الاجتماعي.
فرج فودة يرى أن استمرار نظام العبودية في الإسلام كان نتيجة لتوازنات اجتماعية فرضت نفسها على النصوص الدينية ، بينما يرى سيد القمني أن “ملك اليمين” كان ضرورة تاريخية لا يمكن اعتبارها جزءًا من الشريعة الدائمة.
لكن ورغم ريادتهم في تناول هذه القضايا ، إلا أنهم لم ينتقدوا هذه الظاهرة بالشجاعة الكافية. ربما لأنهما ، مثل غيرهم من المفكرين ، كانا محاصرين بحدود الخطاب الديني والاجتماعي السائد، الذي لا يزال يرى في النقد الجذري تهديدًا للاستقرار الفكري والاجتماعي.
الإماء لم يكنّ مجرد نساء مستعبدات بل كنّ انعكاسًا لعجز الإنسان عن تحقيق العدالة التي يدعيها. العبودية لم تكن نظامًا اقتصاديًا فقط ، بل كانت نظامًا فكريًا يعيد تشكيل الوعي ليجعل من القهر شيئًا مقبولًا ومبررًا.
في النهاية ، الإماء لسن مجرد شخصيات من الماضي ، بل فكرة تعيش في كل نظام يفرق بين الناس بناءً على الطبقة أو الجنس.
ربما نعتقد أننا تحررنا من العبودية ، لكننا في الحقيقة نعيد إنتاجها بأشكال جديدة.
لننظر إلى الأنظمة الاقتصادية الحالية التي تسخر الإنسان لخدمة رأس المال ، إلى الطبقية التي تفرق بين الناس بناءً على الثروة ، وإلى التمييز الذي يجعل من البعض أحرارًا ومن الآخرين عبيدًا لأشكال جديدة من السلطة.
الحرية ليست مجرد كلمة تُقال ، بل هي صراع أبدي بين الطموح والواقع. الحرية التي ندّعيها ، ما تزال حبيسة أغلال الماضي ، تنتظر لحظة تحرر حقيقية لم تأتِ بعد.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة