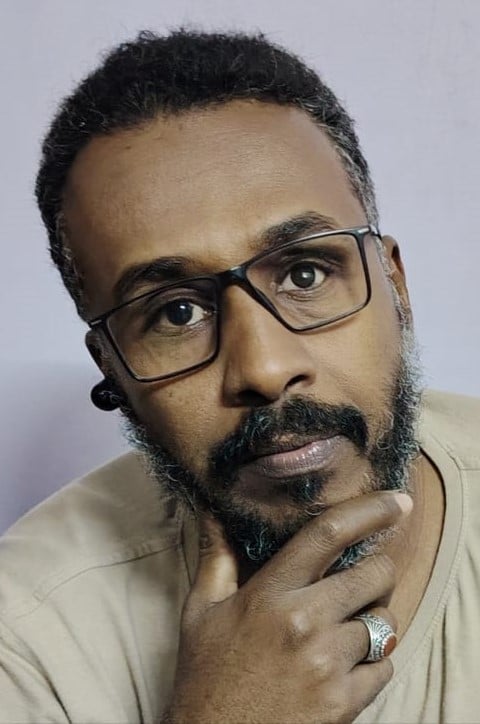✍️ محمد هاشم محمد الحسن.
في مشهدٍ كان يُنتظر فيه أن تتبلور إرادة دولية قادرة على تحريك المياه الراكدة في الأزمة السودانية، جاء إلغاء اجتماع الرباعية في واشنطن ليُفصح عن ارتباك عميق لا يمكن عزله عن طبيعة الاصطفافات الإقليمية والدولية المتشابكة. القرار، الذي صدر دون إيضاح رسمي، لم يكن مفاجئًا لِمن يراقب ديناميكية هذه الملفات، لكنه كان كاشفًا، بلا شك، عن هشاشة ما يُسمى بالتوافق الدولي، وغياب الإرادة السياسية الموحدة، سواء داخل الرباعية أو في المشهد السوداني نفسه.
فالرباعية التي جمعت الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، لم تكن تملك منذ اللحظة الأولى رؤية جامعة لسودان ما بعد الحرب، بل عكست اختلافًا بنيويًا في فهم الأزمة وتحديد أولويات معالجتها. وتجلّى ذلك بشكل حاد في ما طُرح في مسودة البيان الختامي من قبل الإمارات، الذي نصّ على استبعاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أي دور سياسي خلال الفترة الانتقالية، كمقترح لضمان مدنية السلطة المقبلة. هذا الطرح، رغم كونه يتناغم ظاهريًا مع مطالب قوى مدنية واسعة، واجه اعتراضًا قاطعًا من القاهرة، التي اعتبرته تهديدًا لبنية الدولة السودانية، ومحاولة غير محسوبة للتفكيك السياسي في لحظة انهيار ميداني.
رفض مصر لهذا البند، المدعوم أميركيًا، لم يكن مجرد تحفظ تقني، بل موقفًا استراتيجيًا نابعًا من حرصها على بقاء المؤسسة العسكرية كضامنٍ لمصالحها، لا كضامن للاستقرار. وهو ما أدى عمليًا إلى تعطيل الاجتماع قبل انعقاده، وتحوّله إلى محطة فارغة، تزيد من تعقيد الملف بدلاً من دفعه نحو انفراجة.
وفي السياق ذاته، تشير تقديرات تحليلية إلى أن مشاورات الرباعية لم تكن معزولة عن مناخ إقليمي متشابك، إذ جرت استعدادات الاجتماع في ظل تصاعد التوتر حول ملفات محورية مثل سد النهضة وغزة والملف الليبي. هذه القضايا، وإن لم تُدرج رسميًا على جدول الأعمال، كانت حاضرة في الخلفية السياسية، خصوصًا في اللقاءات التمهيدية بين القاهرة وواشنطن، ما أضفى طبقة إضافية من التحفظ على الموقف المصري. فرفض القاهرة للمقترح الإماراتي لا يُفهم فقط من زاوية داخلية، بل من ضمن حرصها على عدم فصل الملف السوداني عن أولوياتها الأمنية والاستراتيجية الأوسع، في لحظة يُعاد فيها ترتيب التوازنات الإقليمية وتُختبر فيها قدرة الدول على تثبيت مصالحها دون الدخول في منطق المقايضة بين الجبهات.
أما واشنطن، فرغم كونها صاحبة الدعوة، خرجت من المشهد بقرار تأجيل لم يرتبط بأجندة جديدة أو مسار بديل. إذ لم يعد الملف خاضعًا لإدارة أميركية موحدة، بل انقسم بين توجهات داخل وزارة الخارجية تسعى لتوسيع مظلة الوساطة عبر ضم قطر وبريطانيا، وبين تيار داخل الكونغرس يدفع للإبقاء على الهيكل الرباعي لضمان تماسك النفوذ التقليدي دون إدخال عناصر جديدة قد تربك ميزان القوى. هذا التباين لا يعكس ضعفًا أميركيًا بقدر ما يُظهر أن القرار لم يعد محصورًا في يد جهة واحدة، وأن إدارة الملف تخضع لاعتبارات متداخلة بين الأمن والدبلوماسية والتوازنات الإقليمية.
غياب الأطراف السودانية المتنازعة عن الاجتماع لم يكن نتيجة تجاهل أو ضعف تنسيق، بل جاء بقرار أميركي مقصود، لتقليص عدد المشاركين وحصر النقاش في الدول صاحبة التأثير المباشر. إلا أن هذا الخيار، وإن كان مفهومًا دبلوماسيًا، يُعيد طرح سؤال جوهري، هل يمكن معالجة الأزمة دون حضور أطرافها المركزية؟ وهل يملك المجتمع الدولي تصورًا واقعيًا لإشراكهم لاحقًا في عملية تفاوضية جدية؟ فالوساطة، وإن بدت قوية شكليًا، تظل ناقصة وظيفيًا إن لم تستوعب من بيدهم قرار الحرب والسلم داخل السودان.
القوى المدنية، بدورها، كانت الطرف الأكثر تهميشًا في سياق الاجتماع، فقد علّقت آمالًا كبيرة عليه، واختبرت مرة أخرى قسوة استبعادها من محافل يُفترض أن ترسم مستقبل السودان السياسي. هذا الواقع، رغم قسوته، لا يجب أن يُكتفى برصده بل أن يُستثمر كمحفّز لإعادة بناء الاستراتيجية المدنية، من خلال تطوير خطاب تفاوضي أكثر قدرة على مخاطبة مخاوف ومصالح الفاعلين الدوليين، بما يُمهّد لاختراق دبلوماسي حقيقي يفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي فعلي. لا يتعلق الأمر بضعف التمثيل، بقدر ما يتعلق بالحاجة إلى أدوات تُحدث تأثيرًا في طاولة لا تُفسَح عادةً للمنطق الثوري دون غطاء وظيفي يُراعي تعقيدات المصالح.
وبالرغم من تباين المصالح داخل الرباعية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو ذلك المتعلق بنا نحن السودانيين، هل نحن متفقون فعلًا على إنهاء الحرب؟ وهل ما زال يمكن افتراض وجود إرادة جماعية تقف وراء نداء السلام؟ المؤسف أن الإجابة تميل إلى النفي، في ظل مشاهد احتفال بإلغاء الاجتماع لدى بعض الأطراف، كما حدث عند انهيار منابر تفاوضية سابقة. بل إن جزءًا من المشهد بات يُوظف فكرة السيادة الوطنية كذريعة لعرقلة أي وساطة، فيما تُوظف فرص التفاوض كمساحة لمناورة عسكرية، أو كمنصة لتغليب الذات السياسية على مصلحة الوطن. وفي هذا كله، تتقاطع الهشاشة الداخلية مع ارتباك الخارج لتنتج ما يُشبه فراغًا مُرًّا، تتسرب فيه آمال الناس كما يتسرب الغبار من جدران البيوت المهدّمة.
هذا التحليل لا يرصد حدثًا إداريًا، بل يُعيد مساءلة بنية الوساطة الدولية نفسها، ويفكك ادعاء الحل الشامل في ظل تباين المشاريع، ويعيد النقاش إلى موقعه الأخلاقي والسياسي الحقيقي هل ما زال السودان قضية جدّية لدى من يتحدثون باسمه؟ وهل يمتلك من في الداخل الجرأة الكافية ليقولوا إن الحرب لم تَعُد خيارًا؟ أم أن كل طرف ينتظر لحظة الانتصار على جثة الدولة، ولو عبر بيان لم يُصدر، واجتماع لم يُعقد؟
المصدر: صحيفة الراكوبة