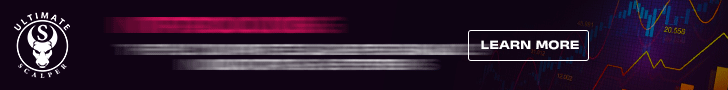كوكاس يستعرض تفوق عالم المال والتكنولوجيا على الفكر السياسي التقليدي

استعرض الكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس التغيرات التي جعلت المال والتكنولوجيا يتقدمان على الفكر السياسي التقليدي، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجالي السياسة والاقتصاد، موردا أنه في ظل هذا التوجه الجديد، أصبح رجال الأعمال مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك رموزًا للمرحلة القادمة، حيث تتجاوز السياسة التقليدية حدودها لتصبح مرتهنة بمصالح اقتصادية ضيقة.
وأورد المصدر ذاته أن هذا التحول يؤشر على بداية انهيار المنظومات الفكرية التي قامت عليها الديمقراطيات الغربية، ويعكس بداية نهاية عصر القيم الإنسانية التي كانت تشكل دعائم السياسة العالمية.
وقارن كوكاس في مقال توصلت به هسبريس بين النظام السياسي التقليدي الذي كان يعتمد على مفاهيم العدالة والمساواة، وبين النظام الجديد الذي يقوده رجال الأعمال والشركات الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التحول في القيادة السياسية لا يمثل فقط تهديدًا للفكر السياسي التقليدي، بل قد يعمق التفاوتات الاجتماعية ويزيد من الاستقطاب السياسي، ليجعل العالم أمام تحديات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية التي رسمتها الديمقراطية الغربية.
نص المقال
“ليس العنف ضروريا لتدمير حضارةٍ ما؛ كلّ حضارة تنهار إثر لا مبالاتها بالقيم الفريدة التي قامت عليها”، الفيلسوف الكولومبي نيكولاس ڠوميز داڤيلا.
يدل نجاح ترامب للولاية الثانية وعودته إلى البيت الأبيض بنصر كبير، على أن الديمقراطية ومعها كل الأنساق الفكرية الكبرى التي كبرنا في أحضانها وعشنا على تمثلاتها، تبحث لنفسها عن جنازة تليق بها، ذلك أن التصريحات التي حملها خطاب الرئيس الأمريكي وسلسلة التهديدات التي أطلقها حتى قبل تنصيبه، وكمّ وحجم القرارات التي وقّع عليها في ظرف قياسي منذ 20 يناير الماضي، تؤشر على أن السياسة كما اعتدنا ممارستها بالأساليب التقليدية سوف لن يبقى لها وجود. العالم الذي تقوم قيامته الآن، لم يعد محكوما فقط بما كان يسميه ريجيس دوبريه “السيطرة اللامرئية” التي تجتاح الدول والأمم، غابة من الأشباح غير المرئيين يتحكمون في تفاصيل توجيه القرن، بل بقوى مرئية لم تعد تخفي نفسها، قوامها المال والإعلام والآلة العسكرية والتكنولوجية الحديثة، يعكسها هذا الثنائي: دونالد ترامب وإيلون ماسك كعتبة عليا لقيامة العالم.
نهاية الوسائل التقليدية للسياسة، المال أولا والديمقراطية مغص أخلاقي بدون شك سنكون شهودا على فترة تراجيكوميدية في السياسة، فأبرز التحولات الجارية في العالم تؤكد أن السياسات التقليدية قد تكون على وشك التحول إلى شيء جديد. في الواقع، نحن نشهد تغييرات جذرية في كيفية فهم السياسة وتطبيقها، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. هناك بداية لمرحلة جديدة قد تتجاوز الحدود التي كانت تحدد مفهوم السياسة سابقا، نحن شهود على بروز نزوعات قومية جديدة ترى أن الداخل أولى من الخارج، التحديات المستقبلية لم تعد هي الديمقراطية وحقوق الإنسان، التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية والمساوة والحرية… بل هي: التنمية، الهجرة، والقيم المحافظة في المجتمعات المتقدمة ذاتها، التي يرى قادتها أنها تتطلب أشكالًا جديدة للسياسة تتجاوز الطرق التقليدية في التفكير والإدارة، حتى إن بدت لنا مجنونة إلى حد بعيد.
نعيش في زمن يبدو فيه أن الاقتصاديين الجشعين والمؤسسات المالية الكبرى أصبحوا يؤثرون بشكل أكبر في السياسة مقارنة بالفكر السياسي التقليدي. جزء من هذا التحول هو نتيجة للتركيز الكبير للعولمة والتقدم التكنولوجي والتغيرات السريعة في الأسواق المالية. كثير من القادة السياسيين اليوم يفضلون اتخاذ قرارات تعتمد على نتائج اقتصادية قصيرة المدى أو حتى على حسابات مالية ضيقة، بدلًا من المبادئ السياسية التقليدية التي تستند إلى الفكر الإيديولوجي العميق.
من جهة أخرى، يظهر أن الزعماء السياسيين الجدد في العالم يبدون أكثر اهتماما بالإدارة اليومية للأزمات الاقتصادية أكثر من الاهتمام بتطوير رؤية سياسية طويلة الأمد. وهو ما يجعلهم عرضة للضغط من قبل قوى اقتصادية وأحيانا يعرضهم للانتقاد بسبب نقص الوعي بالفكر السياسي العميق أو الفهم الشامل للمشاكل المعقدة.
ليس ساركوزي وماكرون، والقادة الجدد بمختلف الدول الأوروبية وباقي دول العالم، وصولا إلى ترامب، سوى علامة على هذا التحول في القيادة السياسية الذي يعكس تآكل المبادئ الأساسية للفكر السياسي التقليدي، فعندما يصبح الاقتصاد هو المحرك الرئيس في السياسة، فإن هذا يعني انهيار المنظومات الفكرية والسياسية التاريخية التي تأسست عليها معظم الأنظمة السياسية مثل العدالة، المساواة، حقوق الإنسان، والتحرر والاستقلالية الفكرية، والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الحسابات الاقتصادية البحتة.
عندما تصبح الأولوية لأرقام الاقتصاد وأرباح الشركات والتوازنات المالية، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى تغليب المصالح الضيقة على المصالح العامة والقيم الإنسانية والكونية المتوارثة. وهذا يساهم في تحجيم دور الفكر السياسي العميق في مواجهة القضايا الكبرى مثل الحريات المدنية، العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الثقافية… كما أن هذا التحول الدراماتيكي، بالنسبة لنا كجيل باعتبار ما نشأنا عليها، يقوض الاستراتيجيات السياسية التي كانت تعتمد على المساومات والتفاهمات بين مختلف التيارات والأيديولوجيات، بالشكل الذي يجعل السياسة أكثر استجابة للمصالح الفورية بدلًا من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.
إذا كانت السياسة بالأمس تجر وراءها تاريخا من الفكر والغنى الثقافي والمدارس الفلسفية العديدة، من أرسطو إلى ميكيافيلي حتى مونتيسكيو فتوكفيل وريجيس دوبريه وجان بودريار، فإن السياسة اليوم يقودها رجال أعمال وأثرياء التكنولوجيا الحديثة، في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا التي ستشد لها العالم مع ترامب الثاني بمسلسل مليء بالتشويق والميلودراما، ومعها سيسير النظام العالمي حتما نحو قيامته التي نحن شهود على إحدى عتباتها المتقدمة.
الجنون فنون.. وفي السياسة مغامرة
يمر العالم بتحولات كبرى على صعيد السياسة والقيم المؤسسة للممارسة السياسية. هناك الكثير من التغيرات في موازين القوى، سواء على مستوى العلاقات الدولية أو السياسات الداخلية للدول. هذه التحولات بعضها مرتبط بالتقدم التكنولوجي، التغيرات المناخية، وبالتحديات الاقتصادية العالمية الجديدة، وبالأزمات الداخلية المتتالية التي جعلت الأفراد والجماعات يتشرنقون داخل هويات متوحشة، مع رفض الآخر واعتباره مصدر كل الشرور.
أصبح للتوجه الكوني الجديد الذي يجسد ترامب الثاني علامته البارزة، في مجال التدبير السياسي والعلاقات الدولية، منظرون من طينة هؤلاء المجانين الجدد الزاحفين على المسؤوليات الحكومية وقيادة الدول، ويمثل كيرتيس يارفين أبرزهم، رجل أعمال سابق في مجال التكنولوجيا أصبح أكثر المفكرين تأثيرا في اليمين المتطرف الذي يشكل الرئيس الأمريكي الجديد نموذجه الأعلى، هو من ينظر للخطة السياسية الجديدة، التي لا علاقة لها بخطة روزفيلت NEP أو الصفقة الجديدة NEW DEAL، ففي مقابلة له مع صحيفة “نيويورك تايمز” دافع كيرتيس يارفين عما أسماه الأيديولوجية الجديدة “التنوير الظلامي”. وكان نيك لاند هو من كتب مانيفستو “التنوير الظلامي” عام 2012. قائلا: “أنا لا أؤمن بالحق في التصويت وأعتقد حتى أن الديمقراطية ضعيفة وعفا عليها الزمن”. ويرى أن الديمقراطية الأمريكية يجب أن تُستبدل بما يسميه “الشركة الخاصة التي يديرها المدير التنفيذي”، المعادل الموضوعي للدكتاتور في الأنظمة التوليتارية.
ويعتقد أن المؤسسات التي تشكل قلب الحياة الفكرية الأمريكية، مثل وسائل الإعلام السائدة والأوساط الأكاديمية، استولى عليها التفكير الجماعي التقدمي ويجب أن يتم حلها. والأكثر إثارة للجدل أن المدون الأمريكي الشهير المبشر بـ”التنوير الظلامي” لا يقدم مقولات ولا مذهبا فلسفيا كما ماركس أو توكفيل وحتى فوكوياما، بل مزيجا مشوها من التبسيط المفرط، وانتقاء الحقائق، والتفسير الشخصي المقدم كحقائق. بالإضافة إلى ما يبدو لنا سذاجة سياسية، لكن الجمهوريين يرون فيه فيلسوفهم الأنواري الذي لا يشق له غبار.
لقد صحّت النبوءة المشرقة للباحث المستقبلي الأمريكي هاري جونستون، “إذا كنا قد شهدنا، باحتفالية صاخبة، نهاية التاريخ، فعلينا الآن أن نُعد لقداس جنائزي آخر: إن الجغرافيات تدنو من النهاية”، فالعالم يسير نحو تحولات جذرية تشبه تلك الانتقالات التي تمس خرائط التفكير وبنيات المفاهيم والتصورات، والأكثر صدامية هو تحول الجغرافيات التي اعتدنا رسمها باطمئنان لسفننا ورحلاتنا وتبدلاتنا وانتقالاتنا وأحلامنا، إن القرن الواحد والعشرين يسير بالعالم نحو التشرنق القنفوذي بدل الانفتاح الكوني، وبقدر ما غدا العالم قرية صغيرة بسبب التكنولوجيا الحديثة، تندفع القوميات لتطل برأسها، دون أن يعود للأسئلة الكبرى مكان وللمؤسسات الوسيطة وللمنظمات الأممية أي دور.
فالتحالف القائم اليوم بين دونالد ترامب وإيلون ماسك يمثل تحولًا لافتًا في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. ماسك، الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والفضاء، وترامب الذي له تأثير قوي في السياسة الأمريكية، يجسدان بشكل ما تزاوج عالم المال والتكنولوجيا مع السياسة. هذا التحالف يعكس التوجه نحو مزيد من التركيز على الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الحر، حيث يبرز دور الشركات الكبرى في تحديد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي.
ماسك، على سبيل المثال، يعمل على مشاريع طموحة مثل “تسلا” و”سبايس إكس” التي يمكن أن تغير من شكل الصناعات العالمية، بينما ترامب يُبرز قدرة رجال الأعمال على التأثير في السياسات العليا وعلى خرائط العالم.
نهاية الأوليغارشية الديمقراطية
لم يعد سادة العالم الجدد حاملي أمجاد، أبطال حروب التحرير الوطني والقومي، قائدي إصلاحات كبرى، متزعمي ثورات قادت أحلام الملايين، لم يعد رؤساء الدول وقادة الحكومات منشغلين بالهم الجماعي الذي زرعوه في نفوس الأتباع، مناضلين وقادة عسكريين لمعارك تحرير كبرى، أبطالا قدستهم شعوبهم لأنهم احتضنوا طموحاتها، أمثال غاندي، تشرتشل، سيدار سانغور، شارل دوغول، فرانكلين روزفيلت، أبراهام لنكولن، لينين أو تشي غيفارا أو ما وتسي تونغ وهوشي مينه أو جمال عبد الناصر أو ياسر عرفات، أو محمد الخامس…
بل جامعي ثروات ورؤساء شركات تجارية، كما أن الديمقراطية التمثيلية خلقت متمرسين محترفين في مجال صناعة الرأي العام والتمثيل الانتخابي، حتى ذابت مقولة “حكم الشعب بنفسه”، وأصبحنا أمام أوليغارشة ديمقراطية، نعم إنها حقا قادمة من التصويت الحر والنزيه، لكن ليس لبعد الاستحقاق والمردودية السياسية، بل للألاعيب الجديدة التي سمحت بها التجربة الديمقراطية الغربية أساسا.
يقول المفكر الألماني هانس كوكلر: “تستند نظرية الديمقراطية الحالية إلى الوهم القائل بأن البرلماني قادر بشكل مثالي على تمثيل الإرادة الجماعية للشعب، وليس إرادته الخاصة أو إرادة حزبه. لكن ما ينتج عن هذا في الواقع هو هيمنة جماعات الضغط ومجموعات المصالح. ومع ذلك، يصر المرء على تسمية هذا الواقع الأوليغارشي الفعلي بمصطلح ‘الديمقراطية’، لأن لهذا طابعا قانونيا أقوى تجاه السكان أكثر من المصطلح الفعلي ‘الأوليغارشية’ أو ‘البلوتوقراطية’”.
وتحت غطاء هذه الديمقراطية كانت الدول الكبرى ترتكب فظاعات في الدول الضعيفة بادعاء عدم احترامها حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية والقيم الإنسانية الكونية، وخلقت لذلك منظمات دولية تندد بما يقع من انتهاكات صارخة فقط خارج الدول الكبرى، فلم يعد لمقولة “تصدير” الديمقراطية أي إغراء وانكشفت “اللعبة التي تقيس بمعايير مزدوجة وتشير بالأصابع إلى ‘النقص’ الديمقراطي فقط حيث تسمح به المصالح الاستراتيجية لهذه الدول النافذة. هذا ما حدث في ‘الثورات الملونة’ (color revolutions) بأوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة”، وما حدث ويحدث في العالم العربي.
اليوم لم تعد لقضايا العدالة والحرية والمساواة التي قامت عليها فرنسا ومعها باقي الدول الأوروبية، وأمريكا، اللتين بني نظامهما السياسي بعد ثورة رسخت نظاما ديمقراطيا على أسس قيم أصبحت كونية، أي جاذبية، وحتى الرأي العام الأوروبي لم يعد معنيا سوى بضرورات العيش والبحث عن الرفاه الشخصي في ظل تقلبات السوق وارتفاع تكلفة الحياة عدا الاضطرابات الكبرى التي مر بها العالم من الحروب والأوبئة والأزمات الاقتصادية الضاربة بقوتها عبر جل بقاع العالم مع العولمة المهيمنة.
ولم ينجح الفكر السياسي في تجاوز مآزق الديمقراطية التمثيلية، خاصة مع تحلل الإيديولوجيات وبروز تيارات اليمين المتطرف في بقاع عديدة من العالم الديمقراطي ذاته.
لديك مطرقة كبيرة، اضرب كيفما اتفق.. فالمسامير في كل مكان
يقول المثل الفرنسي: “عندما تكون لديك مطرقة كبيرة، ترى المسامير في كل مكان”، هو ذا ما حدث بالضبط للولايات المتحدة الأمريكية، فمع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، انتقلنا من نظام القطبية إلى نظام القطب الواحد وما يسمى “النظام العالمي الجديد”، الذي تحددت معالمه الأولى مع اتفاقية الكات عام 1994، لم يعد للعم سام أي منافس على وجه البسيطة، فساد لوحده وبسط هيمنته إلى أبعد مدى، حيث عاضد التقدم العسكري تفوق اقتصادي وإعلامي وتكنولوجي غير مسبوق في تاريخ البشرية، وحازت الولايات المتحدة الأمريكية مطلق السيطرة على العالم بدون منازع، خاصة مع خضوع جزء كبير من القوى الأوروبية العظمى لمخططات “الأخ الأكبر” في البيت الأبيض.
تضخم الجسد الأمريكي الذي أصبح بحكم موقعه في إدارة العالم، يصول ويجول لوحده، فقد ناصر إسرائيل برغم قرارات مجلس الأمن، وأغمض عينيه على كل جرائم الكيانات الموالية له، وظل يتدخل في أنظمة أمريكا اللاتينية بلا حسيب ولا رقيب، وفي اللحظة التي بدا له ضرورة وضع اليد على حقول النفط في الخليج العربي، اختلق أزمة امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل لغزو العراق الذي لا زال يصارع من أجل لملمة جراحه، وبدأ يصنع خرائط الدول وفق مصالحه وخارج أي قانون دولي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تحكم العالم لوحدها، ومن يملك مطرقة كبيرة سيبدو له ما حوله مسامير يجب أن تضرب بقوة حتى في غير مكانها المناسب، هذا ما لاحظناه في العراق وأفغانستان وسوريا وفي جل دول أمريكا اللاتينية.
فالسلطة حين لا تضبط تتحول إلى حماقة في يد صاحبها، ويعتبر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الجديد، نموذجا صارخا لسلطة المطرقة الكبرى والمسامير، فالرجل حتى قبل تنصيبه أطلق تصريحات حول ضم الجزيرة الدانماركية غرينلاند وبنما وكندا، حمل ترامب الثاني المطرقة الكبرى ليدق بها رؤوس مسامير دول النفط، التي عليها أن تدفع لحماية بقائها في الحكم، أو تتعرض للتأديب ولفرض العقوبات لمجرد أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي اللازم لحماية أمنها في منطقة ملتهبة، تتغير فيها الخرائط والولاءات بشكل سريع حتى قبل أن يجف مداد الحبر الذي رسم بها، أو يدق بها مسمار تركيا التي تبحث عن استعادة أمجاد العثمانيين، أو يخلق ما أسمته مكاتب الدراسات التابعة لمؤسسات الاستخبارات المركزية الأمريكية “الفوضى الخلاقة” التي سميت ربيعا عربيا.
وفي اللحظة التي بدأت قوى جديدة تطل برأسها عاليا متحدية مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الصين التي امتلكت أسباب القوة والتفوق الاقتصادي والعلمي خاصة، بدأ حراس البيت الأبيض يتحدثون عن التهديدات القادمة مع التنين الصيني/الشيوعي الذي يشكل تحديا للعالم الحر الذي ترفع شعاره الديمقراطيات الغربية.
فالمخاطر المترتبة عن العودة إلى عالم تتصرف فيه القوى العظمى وعملاؤها دون خوف من العقاب، سيزيد من زعزعة استقرار عالم يعيش على اللايقين. هذا التحول سيعمق الفجوات بين القوى الاقتصادية الكبيرة والفئات الأقل حظًا، ويزيد من الانقسامات على مستوى العالم. فالتوجه الجديد الذي تهيمن فيه الاعتبارات الاقتصادية فقط، قد يصل في النهاية إلى نقطة الاستنفاد. فالاقتصاد مهما كانت قوته لا يمكن أن يحقق الاستقرار السياسي أو الاجتماعي على المدى الطويل إذا لم يكن هناك توازن مع القيم والمبادئ السياسية التي تعزز العدالة والمساواة. كما أن التركيز المفرط على الجوانب الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية وغياب التضامن بين فئات المجتمع المختلفة، مما يمكن أن يخلق استقطابًا سياسيا غير صحي.
إذ مع مرور الوقت، ستبدأ الدول والشعوب في الشعور بآثار هذا التحول، سواء في شكل تزايد الاحتجاجات الشعبية أو بروز مشاعر الإحباط من السياسات التي لا تلبي احتياجات الناس الأساسية سوى من خلال أرقام مالية باردة. قد تؤدي هذه الاستجابة إلى عودة الاهتمام بالأفكار السياسية القديمة التي تركز على الإنسان أولًا، ومن ثم تنشيط الأيديولوجيات التي توازن بين الاقتصاد والحقوق السياسية، أو إبداع شكل ومفهوم جديد للممارسة السياسية.
المصدر: هسبريس