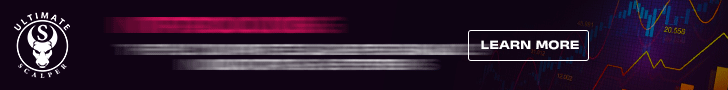كتاب “السياسة اللسانية” لبوكوس يهتم بوضع “السوق اللغوية” بالمغرب

سَيَّر رشيد العبدلاوي، المدير السابق لمركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد الملكي للثقافة، الأربعاء، حفل تقديم كتاب “دراسات في السياسة اللسانية” لأحمد بوكوس وترجمة عزيز لمتاوي، الذي تولى “إيركام” إصداره سنة 2025. وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بمشاركة المؤلّف والمترجم، إلى جانب الباحث الأكاديمي في علم الاجتماع سعيد بنيس.
كتاب مرجعي
مترجم الكتاب، عزيز اللمتاوي، أفاد بأن “الكتاب يتناول موضوع السياسة اللسانية”، معتبرا أنه “في حقيقة الأمر ليس ثمة سياسة لسانية واحدة؛ إذ يعكس هذا العنوان الجامع، الذي يرد بصيغة الإفراد، تعددا كبيرا وتركبا في طرائق مطارحة المسألة اللسانية التي تقع في قلب السياسة اللسانية”، وزاد: “يُعدّد المؤلف هنا ويحدد أربعة أنماط من السياسة اللسانية يستدعي كل واحد منها لأجل أن تكون فعالة وعقلانية”.
وقال إن “النقاش الدائر حول المسألة اللسانية بالمغرب منذ الاستقلال إلى الآن، اتسم بتجاذب أربعة أقطاب يتبنى كل واحد منها خطابا متميزا قد تتداخل ضمنه أحيانا سمات القطب أو الأقطاب الأخرى؛ إذ لا وجود لقطائع مطلقة بين هذا القطب أو ذاك، غير أننا نفصل بينها بحسب العنصر أو العناصر المهيمنة، وهذه الأقطاب هي: قطب الخطاب الرسمي، قطب الخطاب العلمي، قطب الخطاب الحقوقي وقطب الخطاب الإيديولوجي”.
وأثناء عرضه لـ”عين الترجمة”، سجّل أن “ترجمة نصوص أحمد بوكوس ليست بالأمر الهيّن واليسير، إذ هي نصوص عصيّة تحتاج إلى الكثير من الجهد والأناة، بالنظر إلى تركيبها ونهلها من مرجعيات فكرية متعددة، ومطارحتها العديد من الإشكالات المتداخلة”. وقال: “ساعدنا على تذليل الصعوبات التي واجهتنا في نقل هذا المؤلف إلى اللسان العربي، العودةُ إلى القواميس المتخصصة، والمؤلفات ذات الصلة، بالإضافة إلى الجلسات العلمية التي جمعتنا بالمؤلف”.

وكشف اللمتاوي أن “هذه الصعوبات تتجلى في اللغة التي تلين أحيانا إلى حد الاقتراب من التعبير الشعري المحمل بالإيحاءات التصويرية، وتحتد أحيانا أخرى أثناء المرافعات ذات الطابع الحقوقي وتغرق في ثنايا الصياغات النظرية المحملة بالتصورات والمصطلحات العلمية المتخصصة التي تنتمي إلى حقول معرفية متباينة، مما يستدعي التحلي بالجرأة في صياغة مقابلات لها وحل المشكلات التي تتصل بها”.
يُضاف إلى ذلك، حسب المتحدث، “الجملة الطويلة المركبة على مستوى المبنى والمعنى، مما يتطلب تفكيكها وإعادة بنائها حتى يتسنى للذات المترجمة القبض على المعنى الكامن، والانتقال به إلى الضفة الأخرى دون حوادث سير قد تكون مميتة على طريق الترجمة المليء بالمطبات، رغبة منها في أن تكون ترجمة هذا المؤلّف إضافة نوعية في مجالها تثير نقاشا وتفتح مسارات بحث”.
وقال: “هذه اختياراتي في اللغة، وفي النفس، وفي الجملة، وفي المصطلح، قد أكون مصيبا في بعضها ومخطئا في بعضها الآخر، لكنها تفضي، في الحالتين معا، إلى ترجمة أعتقد أنها صالحة هنا والآن في هذا السياق الذاتي والموضوعي”، وتابع: “لكنها قد تشيخ في زمن آخر بحسب تعبير بيرمان الذي يرى أن الترجمات تشيخ بخلاف النصوص الأصلية، فتدفعنا إلى إعادة ترجمتها ولم لا كتابتها بألسنة أخرى. وقد لا تشيخ، وهو ما أتمناه بخلاف ما يذهب إليه بيرمان، ويطول عمرها مثل العديد من الترجمات التي أصبحت وسما للآثار بدل مؤلفيها”. فثمة، إذن، “في النظر وفي إعادة النظر في الترجمة وفي إعادة الترجمة، سعي الذات وتوقها الدائم إلى بلوغ النقاء والأمانة والتحرر من كل الآثام. وهي مفاهيم في حاجة إلى الكثير من الدقة والتمحيص”.

مسار واسع
سعيد بنيس، الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، أورد أن “أهمية الكتاب تكمن في أنه يشكل حصيلة تراكم اشتغال تفوق أكثر من 50 سنة تهم الوضعية اللسانية بالمغرب”، مشيرا إلى أن “أحمد بوكوس كان أول من ناقش أطروحة دكتوراه حول اللغة الأمازيغية”، وواصل: “إنه مسار أكاديمي وتجربة علميّة يعكسان غنى مواد الكتاب التي تنتقل بنا من مصفوفة مفاهيم تمثل أساسيات الاشتغال في اللسانيات”.
وأورد بنيس أنها ترتبط كذلك بـ”المرتكزات المحورية لضبط رهانات وتحديات السياسة اللسانية من داخل حقل التخصص البحثي، ألا وهو اللسانيات الاجتماعية، التي تظهر جليًّا في أطروحة عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، وزاد: “ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية رصينة ودقيقة، وتمكنت من الإمساك بالمضامين والدلالات النظرية للمفاهيم، من داخل حقل يجمع بين علم اللسانيات وعلم الاجتماع، وتتداخل فيه عدة توجهات تحيل عامة على منهجية العلوم الاجتماعية”.
واعتبر الأكاديمي المغربي أن “الكتاب يطرح سؤال السياسة اللسانية من خلال عدة زوايا متقاطعة ومتكاملة”، أولاها “ترتبط بالترسانة المفاهيمية التي تمكن من الإمساك بمفهوم السياسة اللسانية وتوظيفاته المتعددة بالنظر إلى عدة عناصر، منها على سبيل المقال لا للحصر الإطار النظري والإجراء المنهجي”، بالإضافة إلى “الاهتمام بترابطات مقولة سلطة اللسان بالمتغيرات الاجتماعية وعلاقة حركية التمدن بسوق الألسنة، أي السوق اللغوية”.

كما تطرق الباحث ذاته إلى “تداخل بيّن ومباشر بين مقولات الحفاظ والتغير والتهيئة في علاقتها بالسياسة اللسانية في شق التمثلات والمنافسة والتأهيل اللغوي”، و”الإحالة على دراسة الحالة المغربية من خلال تحقيب تاريخي تناول إشكالية التعريب ومراحل النهوض بالأمازيغية”، وكذا “طرح سؤال الوضعية اللغوية الراهنية في علاقتها بسياسة لسانية تروم تهيئة اللغة الأمازيغية في سوق لسنية تهيمن فيها الفرنسية والدارجة”.
وذكر سعيد بنيس كذلك “ما يرتبط بمخرجات السياسة اللسانية وتمفصلاتها بحقوق الإنسان والترسانة القانونية، وكذلك العقد الاجتماعي في شقيه المتعلق بالعيش المشترك والرابط الاجتماعي”، مبرزا أن “الحاجة ماسة للإجابة على عدة تساؤلات تهم خاصة تفعيل السياسة اللسانية بالمغرب في علاقتها بعدة اختيارات، منها بناء الهوية المواطنة بموازاة الهوية اللغوية، لأن اللغة عنصر من عناصر بناء المواطنة الإيجابية وكذلك العيش المشترك”.

أسئلة متواصلة
كان أحمد بوكوس، الباحث البارز عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، آخر من تناول الكلمة، وأشار إلى أن الترجمة هي مساعدة للتعريف بإنتاجه في مجال البحث، مشددا على أهمية “العمل التشاركي بين واضع النص ومترجمه، لتسهيل نقله من لغة أخرى ومن ثمّ من مخيال إلى آخر”، وزاد: “المترجم اللمتاوي متمكن من اللغة العربية والفرنسية، ومطلع جيد على البحث في مجال اللسانيات الاجتماعية، وهو ما يسّر التشابك والترجمة”.
وسجل بوكوس أن “الكتاب يتناول بصورة حصرية الإشكالية العامة المتصلة بالسياسة اللسانية في المغرب المستقل، وذلك بالتوقف عند مراحل تكونها، وعرض التصورات التي صيغت حولها، وبسط سيرورة تفعيلها منذ ستينات القرن الماضي إلى غاية إقرار دستور 2011 واستصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة”، مبرزا أن “بنيان الكتاب يقوم على فحص المعطيات الرئيسة التي تنهض عليها الوضعية اللسانيةالاجتماعية السائدة في البلاد، المتمثلة في تشكل سوق ألسنة، وفي ديناميتها التي تعمل على تجسير الاتصال بين الأمازيغوفونية والعربوفونية والفرنكفونية وتعزيز المنافسة فيما بينها”.
وقال بوكوس إن “البعض يرى أن السياسة اللسانية التي تنتهجها الدولة الوطنية منذ استقلال البلاد تتطلب إعادة صياغة في ضوء التطور الذي يشهده العالم ويعيشه المجتمع المغربي، وبالخصوص في مجال التربية والتعليم والتطور التقني والعلمي الذي عرفته تهيئة الألسنة”، موردا أن “المطالب الثقافية واللسانية الأمازيغية التي انبثقت عن المجتمع المدني انطلاقا من ستينات القرن الماضي، هي عموما تلك التي اعتمدتها الدولة انطلاقا من سنة 2001 مع خطاب العرش والخطاب الملكي بأجدير، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

يضاف إلى ذلك، وفق المتحدث، “اعتماد البرلمان عام 2003 مشروع إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية”، كما ذكّر بـ”اعتراف الإصلاح الدستوري لعام 2011 بالأمازيغية لسانا رسميا إلى جانب العربية الذي يُلزم الدولة بمسؤولية تعزيز التنوع اللساني والثقافي، وحماية الألسنة الرسمية وتطويرها، وكذا إصدار قانونين تنظيميين: يتعلق القانون 1626 بتحديد سيرورة تفعيل طابع الأمازيغية الرسمي، وطرائق إدماجها في التربية والحياة العامة، ويتعلق القانون 1604 بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويحدد اختصاصاته وتركيبته وطرائق اشتغاله”.
وتابع: “لقد أثيرت ملاحظات هامة بشأن الإعمال الفعلي للسياسة اللسانية والثقافية الجديدة، تهم دور الدولة ومؤسساتها الضامنة لتفعيل المقتضيات الدستورية وأداء هيئة الحكامة الديمقراطي والفعال، ونقصد بها المجلس المذكور، واختصاص الهيئة التقنية، وهي في هذه الحالة الهيئات المنتسبة إلى مؤسسات التهيئة اللسانية، وتوفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية الملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة”.
وكما طرح في مستهل المؤلف بعض أسئلة البحث، ختم عميد “إركام” مداخلته ببعض التساؤلات الرئيسة التي تؤرق المراقبين والمحللين والحركات الاجتماعية المعنية على حد سواء. يتعلق التساؤل الأول، بحسبه، بطبيعة الحكامة المجالية: “كيف يمكن تدبير الطابع الرسمي المتعايش على المستوى المجالي من حيث الحقوق الشخصية مقابل الحقوق المجالية؟ في حين إن التساؤل الثاني هو ذو طبيعة إجرائية: كيف ندمج مكتسبات الاشتغال على الأمازيغية المعيار ضمن السياسات العمومية في القطاعات المختلفة حسب التدابير والإجراءات المعلن عنها في ثنايا القانون التنظيمي 1626؟”.

أما التساؤل الأخير، يقول بوكوس، “فهو ذو طبيعة استراتيجية وسياسية: كيف ندرج ‘مشروع مغرب اللغات والثقافات’ ضمن رؤية حقوقية ديمقراطية تؤكد مصداقية “النموذج المغربي’ من حيث تدبير التنوع اللساني والثقافي؟”، خالصا إلى أن “التطرق لهذه التساؤلات وغيرها قد يتطلب التفكير في مشروع بحث متعدد التخصصات يأخذ بعين الاعتبار المستجدات السياقية”.
المصدر: هسبريس