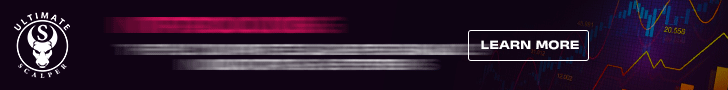صدور العدد الثاني من مجلة تمييز
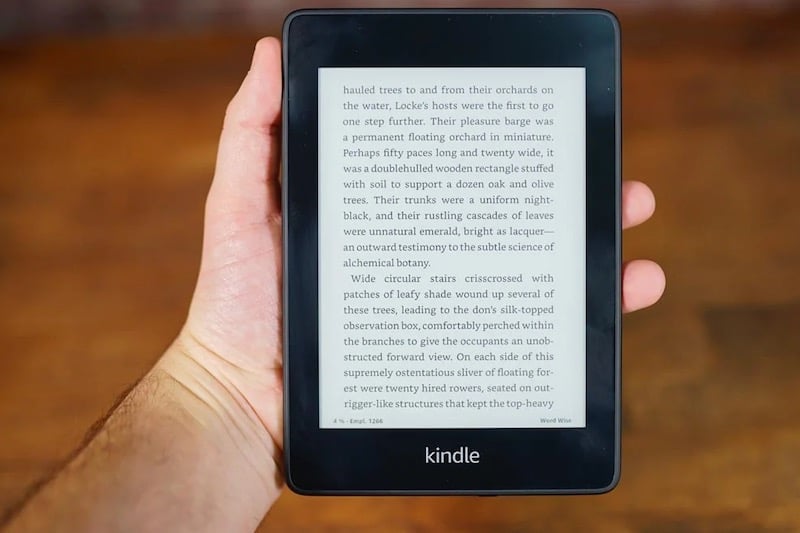
صدر العدد الثاني من المجلّد الأوّل من مجلّة تمييز، مجلّة تاريخ الأفكار العلميّة والفلسفيّة. وقد جاءت موادّ هذا العدد في أبواب ثلاثة: أوّلا، باب الدراسات الذي اشتمل على خمسة بحوث بالعربيّة والإنجليزيّة في موضوعات مختلفة من تاريخ الأفكار الفلسفيّة والعلميّة. ثانيا، باب الترجمات الذي تضمّن نصّا واحدا نقل من الإنجليزيّة إلى العربيّة. وثالثا، باب مراجعات كتب ضمّ ثلاث مراجعات. وتناولت هذه الأعمال موضوعات مهمّة تغطّي مباحث الفلسفة والفلك والرياضيات والكلام والفقه والتصوف والأخلاق وغير ذلك، وأعمال فلاسفة وعلماء من قبيل يحيى النحوي والخوارزمي وابن الهيثم وابن رشد والآمدي وابن عربي ومارتا نسباوم وغيرهم.
ففي باب الدراسات المكتوبة بالإنجليزية، درس براين رايت مسألة فقهيّة في غاية الأهمّية، تتعلّق بحكم تخفيف عقوبة القتل في قضايا دفاع الاستفزاز الشديد في ”القضايا التي يجد فيها رجل زوجته في حالة زنا فيقتلها هي فقط أو هي ومَن معها “، وذلك في دراسته المعنونة: “بين الحفاظ على المجتمع والصحة النفسية للفرد: الدفاع بسبب ’الاستفزاز الشديد’ في الشريعة الإسلامية”، يدافع عن فكرة أنّ هذا التخفيف ليس مصدره القوانين الحديثة، بل يجد أصوله في الفقه الإسلامي في القرن الخامس الهجري تزامنا مع تطوّر نظريات المصلحة والمقاصد في أصول الفقه. ”وفي حالة الاستفزاز الشديد، رأى الفقهاء أنّه يجوز تخفيف العقوبة إذا تبيّن أنّ الجريمة حدثت نتيجة فقدان مؤقّت، مُبَرَّر، لضبط النفس بسبب الاعتداء على شرف الفرد“. وقد استمرّت هذه الأصول والمفاهيم الإسلامية في النظم القانونية الحديثة في العالم الإسلامي.
وفي باب الدراسات المكتوبة بالعربيّة، وقف سعيد البوسكلاوي عند ”المقالة الأولى من كتاب يحيى النحوي ’في الردّ على برُقلُس‘ وتلقّيها في العربيّة“، دراسة وترجمة. وقد أبرز في دراسته ”أهمّية الأدلّة الواردة فيها، وبعض صيغ تلقّيها عند فلاسفة الإسلام، وما حُفظ منها في العربيّة“، وبيّن كيف ”أنّ هذه المقالة تكاد تختصر كلّ الكتاب؛ إذ عرض فيها النحوي أبرز أدلّته الفلسفيّة على حدوث العالم“، وكيف حظيت باهتمام كبير من قبل الفلاسفة والمتكلّمين “استثمارا وتوظيفا وردودا”، وأوضح كذلك ”كيف أنّ الجزء المفقود من هذه المقالة، في أصلها اليونانيّ، قد حُفظت مقاطع منه في نصوص كلاميّة مختلفة“، وقارن بين بعضها بغرض استعادة العنصر المفقود من هذا النصّ. وعلاوة على كلّ ذلك، قدّم ترجمة/تلخيصا لهذه المقالة في الملحق.
وفي دراسة بعنوان ”سياسة العلم بين دعم الرعاة ورغبة العلماء (بغداد في القرن التاسع الميلادي)“، سلّط سيد محمد أحمد المصطفى الضوء على الفاعلية العلميّة والأسر العلميّة ومدى التعاون أو التنافس بين العلماء، مركّزا على ”بعض المؤثّرات الاجتماعيّة والسياسيّة التي تخلّلت سيرورة الفاعليّة العلميّة في القرن التاسع“، وقد أوضح ”أنّ غاية هذا التنافس لا تنفصم، في كلّ الأحوال، عن التقدير الاجتماعي والمكافآت والجوائز، وأنّ التنافس كان يبنى على حسابات النفوذ والقرب من البلاط، وانتشار الصيت، وهذه كلّها مكاسب اجتماعيّة سعى إليها هذا العالم أو ذاك“، وقدّم أمثلة عديدة عما ينتج عن التنافس من حظوة أو أثر ماديّ أو رمزيّ أو عكس ذلك من حرمان ممّا سبق ذكره أو فقدان لامتياز ما.
من جهته، قدّم بنّاصر البُعزّاتي دراسة مفيدة حول ”ابن الهيثم والكوسمولوجيا“، أبرز فيها أهمّ معالم مراجعة ابن الهيثم للنظرية الفلكية البطليمية، وأوضح كيف أنّ لابن الهيثم فهما عميقا للمشكلات التي طرحها علم الفلك، علاوة على شكوكه القويّة في الحلول التي اقترحها بطليموس ”مثل حركة الإدبار واختلاف سرعات بعض الأجرام السماوية ومواقع بعضها من بعض، باستعمال آليتي فلك التدوير والفلك الخارج المركز“، وقد بيّن صاحب المقال أيضا كيف أنّ ابن الهيثم أتى بأفكار جديدة معتمدا على أرصاد جديدة و”آليات رياضية أبين وأوثق من تلك التي في المَجِسْطي“، سمحت له بإعادة بناء نظرية بطليموس الفلكية في نسق أقوى. غير أنّه في آخر المطاف ظل حبيس الإبدال السائد، وأدار ظهره للأفكار غير البطليمية، في نظر الباحث.
وتحت عنوان “ابن رشد بين أخلاق أرسطو وسياسة أفلاطون“، حاول محمد مزوز تقديم قراءة مغايرة للجانب العملي في فلسفة ابن رشد. تتبّع حضور أخلاق أرسطو وسياسة أفلاطون في المتن الرشدي، وتحديدا تلقّي كتابي تلخيص أخلاق أرسطو وجوامع سياسة أفلاطون عند ابن رشد، وفحص السياق السياسي والاجتماعي المضطرب الذي ألف فيه ابن رشد الكتابين، كما أعاد النظر في فرضية الربط بين تلخيص ابن رشد لكتاب أفلاطون في السياسة وحادث نكبته.
وفي موضوع غير بعيد عن أفلاطون، نقرأ لنجيب طبطاب دراسة بعنوان ”المشاعِر عندَ مارتا نسباوم: إِصلاح الحب الأفلاطوني“، وهي مقالة تركيبيّة عرض فيها رأي مارثا نسباوم (Martha Nussbaum) في الحبّ الأفلاطوني، مناقشة للآراء التي انتقدت نظرية الحبّ عند أفلاطون وإبرازا لأهمّية المشاعر الأخلاقيّة عموما، والحبّ بالخصوص، في الحياة العملية. وقد بيّن ”أنّ نسباوم قد رأت في محاورات جورجياس والجمهورية والمأدبة وفيدروس، تطوّرا ملحوظا ومعبّرا عن تغيّر موقفه من الحبّ الإيروسي، وأنّها قد وصلت إلى قناعة مؤدّاها أنّ أفلاطون قد عجز عن رؤية الطبيعة الحقيقية لهذه العاطفة الأساسية، على الرغم من أنّه ظلَّ غير بعيد عن الاعتراف بقوّته العمليّة الأخلاقية“.
وفي باب الترجمات، نقرأ دراسة لمينسو فولكيرتس (Menso Folkerts)، بعنوان “النصوص المبكّرة عن الحساب الهنديعربي”، نقلها إلى العربية محمد حيلوط. وهي دراسة مفيدة حول الحساب الهندي وانتقاله من الهند إلى أوروبا مرورا بالكتابات العربيّة. ويركّز على أقدم عمل حول الحساب الهندي بتأليف الخوارزمي. غير أنّ المشكلة هي غياب أيّ مخطوط عربي لهذا النصّ، و”كلّ ما نعرفه عنه هو إعادة صياغة مبكرة لترجمة لاتينية، قبل بضع سنوات [من 2001]، لم تكن هاته المخطوطة معروفة سوى جزئيا ويعود عهدها للقرن الثاني عشر (Cambridge, UL, Ii.6.5). ولم يتوفّر نصّها الكامل إلا عبر مخطوطة أخرى أتاحت دراسة أدقّ لعمل الخوارزمي (نيويورك، الجمعية الإسبانية الأمريكية، HC 397/726)“. هذا العمل يدرس هذا المخطوط الأخير، يعرض مضمونه ويناقش طريقته في العرض.
وفي باب مراجعات كتب، نقرأ ثلاث مراجعات: أوّلها، قراءة بنّاصر البعزّات يفي تحقيق كتاب “دقائق الحقائق: قسم المنطق” لأبي الحسن الآمدي، وهو في جزأين، حقّقه السيّد فاضل عليّ المُوسوي في مجلّد واحد، عن مخطوط جامعة برنستن الأمريكيّة. وقد بيّن كيف أنّ هذا التحقيق تشوبه هفوات وأخطاء كثيرة، منها: أخطاء لغوية، ”لكن ذات صلة مباشرة بمشاكل دلالية ومعرفية“؛ ومنها ما يتعلق بعدم إلمام المحقّق بموضوع الكتاب ومصطلحاته، ومنها ما هو نتيجة تقصير المحقّق في البحث وعدم الحرص والتسرّع. وقد قدّم صاحب المراجعة أمثلة كثيرة عن كلّ ذلك.
ثانيهما، مراجعة رمضان بن منصور لكتاب مصطفى العليمي “معجم كشّاف للمفاهيم والاصطلاحات الصّوفيّة لدى ابن عربي، الفلسفة الروحيّة في أفق محيط بلا ساحل”. وهي مراجعة نقدية لمعجم صوفي لابن عربي اعتمادا على بعض مصطلحاته الواردة أساسا في الفتوحات المكيّة. تنقسم المراجعة إلى قسمين: قسم أوّل شكليّ يتعلّق بملاحظات تمسّ بعض ملامح المعجم من جهة إخراجه النهائي (العنوان، ترتيب المصطلحات، تنظيم عناصر ومحتوياته). وقسم ثان مضمونيّ يتعلّق بمناقشة بعض محتوياته المعرفية (علاقة ابن عربي بسياقات عصره العلمية والفلسفيّة، منزلته في الحضارة العربيّة الإسلامية الكلاسكية والثقافة الكونية الراهنة من منظور التلقي الغربي المعاصر).
وأخيرا، راجع توفيق فائزي عمل مارثا نسباوم (Martha C. Nussbaum) “هشاشة الخيريَّة، الاتِّفاق والأخلاق في التراجيديا اليونانية والفلسفة”، وعرَّف بدعوى الكتاب وهي أنّ التراجيديا تشارك الفلسفة في الجواب عن مسألة السعادة، وتقترح علما خاصّاً بطريقة العيش. وقد أطْلَع على ما يوجد في الكتاب من أجزاء، بعضُها خُصِّص لتحليل الكيفية التي تُسهم بها أعمال تراجيدية وهي أغاممنون لإسكيلوس وأنتغون لصفوكليس وهيكوبا ليوربيدس في رسم ملامح خيريَّة تعترف بهشاشتها. وخُصِّصت أجزاءٌ أخرى لإظهار ما تختصُّ به الرؤية الأفلاطونية للسعادة، من خلال تحليل بعض محاورات أفلاطون. وبيَّن ما الذي تتميّز به الرؤية الأرسطيّة، وصلاتها بالرؤية التراجيدية، والتنافر الذي بين الرؤية التراجيدية والرؤية الأفلاطونية في بعض محاورات أفلاطون، وليس في جميعها؛ إذ تُستثنى محاورة فيدروس. وختم ببيان بعض حدود العمل الذي تخيَّر من فلسفة أرسطو مظاهرها العملية دون النظرية، وأقام تقابلا حادّاً بين فلسفة أفلاطون وأرسطو شكَّك فيه الباحث، ذلك التقابل الذي لولاه لما استقام لمارثا نسباوم الكثير من أحكامها.
مواد المجلّة متاحة للقراءة والتحميل على الموقع التالي:
https://journals.imist.ma/index.php/Tamyiz/index
المصدر: هسبريس