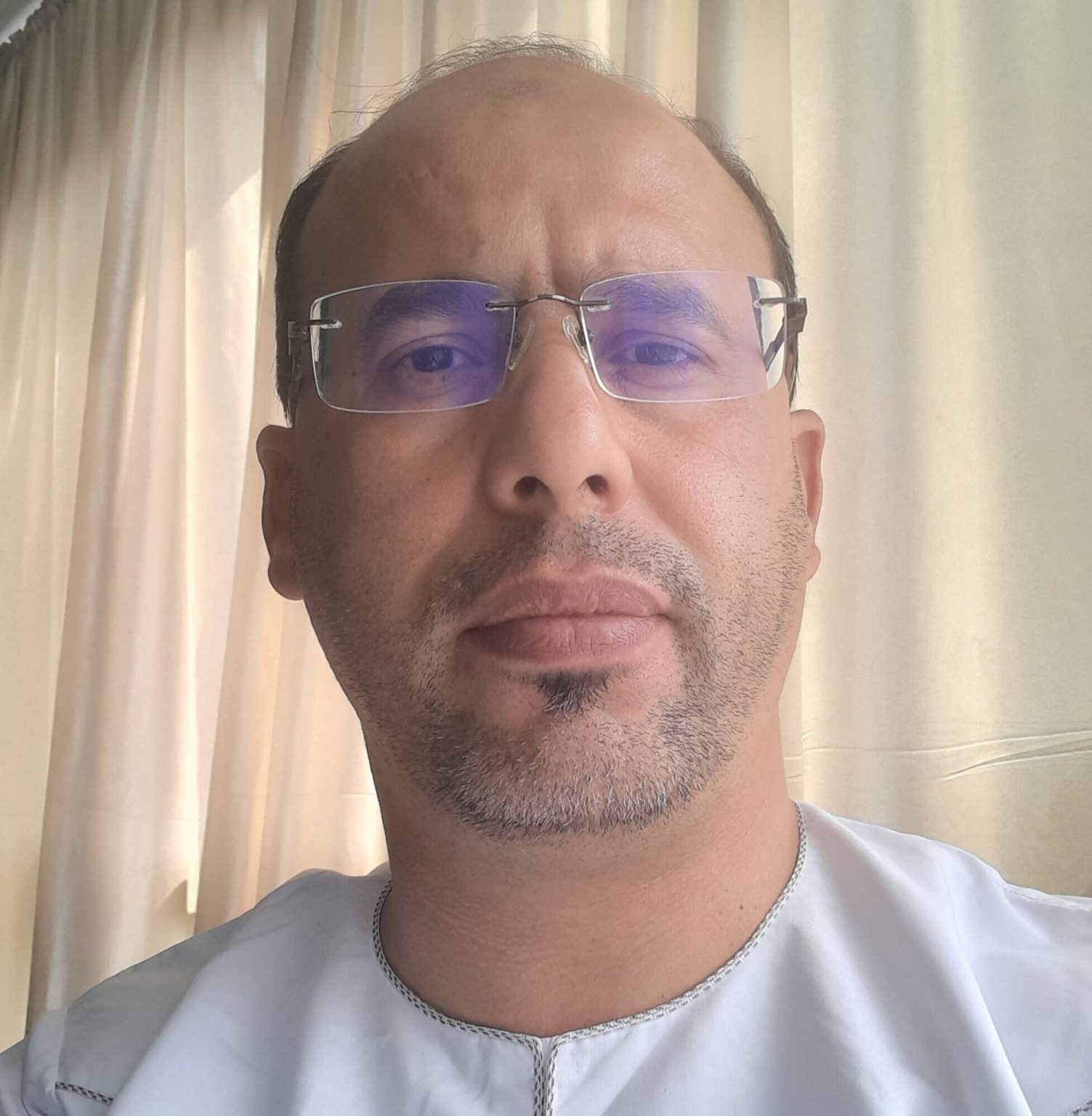قد يصيب المرء في تحليله للأوضاع القائمة سياسيا و اجتماعيا و قد يخطئ في التقدير بميزان ما يتضمنه تشخيصه من منهجية و تقدير للسياقات و استيعاب لما وراء الظاهر و الظواهر من انفلات و مسافات و تحديات. لكن تكرار الظواهر و سطوع مظاهر الانحراف و الزيغ تدفع لا محالة الى مقاربة الواقع مقاربة تفكيكية تكشف و تستكنه المجهول أي ما يراد إخفاءه أو فرضه من خيارات قد تبدوا
حداثية ظاهريا لكنها قاتلة اجتماعيا و حضاريا تضعنا من حيث لا ندري خارج التاريخ.
اجتماعيا، يرصد الملاحظ أن غالبية الأسر تقارب أولى نتائح تقييم أبنائها الدراسي في بدايات مسارهم التحصيلي بأسئلة تحاصر على الأقل محاور ثلاث: أولا، العلامات المحصل عليها في التقييم أو الاختبارات، ثانيا الرتبة أو الترتيب و ثالثا تعزيز الجهد من أجل تحصيل المراتب الأولى . هذه الأسئلة و غيرها تبدوا طبيعية في ظاهرها بل حتى صحية، هي في جوهرها ذات تأثير شديد على مستوى الادراك لأنها تحدث التغيير الذي يبني فهمنا للتحصيل و مقاربتنا لنوع العلاقة المفروض أن تحكم تصوراتنا الأنطولوجية
و تفاعلاتنا الاجتماعية مع الآخر (زملاء القسم في هذه الحالة و زملاء العمل لاحقا). فالطفل/ الانسان ليس مشروعا استثماريا و اقتصاديا بقدر ما هو مشروع بناء مجتمعي و حضاري. فهذه الأسئلة بالرغم من بديهية منطلقاتها هي ما يشكل الوعي في بداية تبلوره لدى الطفل. فالأهم و أولوية الأولويات هي العلامة و الترتيب بدل القيم و العلم و المعرفة، ما يضع الأبناء و هم في أولى خطواتهم داخل دوائر مغلقة برؤى مغلوطة حول طبيعة العلاقة بين الذات و الآخر و يرمي بهم في أتون التسارع و الجري و المنافسة ضد الآخر و ليس معه ما ينحت بل و يبرر في دواخلهم نوازع الأنانية و دواعي الذاتية و يدفع بالجميع نحو حالة الاستلاب الفكري
و السلوكي (الارتقاء المجاني، الغش أثناء التحصيل و السرقة الفكرية فيما بعد… ). أعتقد أن المفكر و الاقتصادي الفرنسي “جاك جنيرو” نجح في نقده للمجتمع الغربي و مقاربة إشكالية انتصار المنافسة و التسارع و الفردانية على حساب قيم التضامن و التعايش المجتمعي في ثلاثيته الجديرة بالقراءة (السقوط الكبير نقيض المجتمع المجتمع الآخر).
يقول عالم النفس و المفكر الفرنسي “بوريس سيريلنيك” في إحدى حواراته : ” إن في المجتمعات التي تحكمها ثقافة السرعة خصوصا بآسيا و الولايات المتحدة يصبح الأطفال أكثر قلقا لأنهم يعيشون في بيئة ذات حركية مفرطة”. (مجلة علم النفس رقم 414).
إن خطورة اضطراب و قلق الصغار تكمن في تجذير اضطرابات و اختلالات و أمراض الكبار النفسية و العقلية و مدى تمثلهم في هذه الحالة لمفاهيم الزمن و التسارع. لكن ماذا عن حال بيئة ازداد فيها التسارع و الاغتراب بل و تغييب للنقاش الجاد و الرؤى و المقاربات و خصوصا البنى التحتيةو الفوقية لتدبير المعاناة و الاضطرابات بكافة أشكالها. يكمن الخطأ حد المصيبة في استنساخ فكر ليبرالي بتصور غربي دون تقييم شروط و سياقات التنزيل و فرضها على المجتمع بمبرر الوصاية و بهدف التحكم. و إلا فمع من نتنافس و أين يكمن الإنجاز شعبيا في بناء أطول قنطرة (العبور عليها بمقابل) أو أعلى برج قاري (مشروع استثماري) بينما
الأجدر أن تتحمل الدولة أدوارها في بناء الانسان السليم عقليا و نفسيا و جسديا و المسؤول أسريا و مجتمعيا و وطنيا و من ثم بناء المجتمع المتضامن طبقيا و أفقيا و المتناسق قيميا و ثقافيا و معرفيا يكون قنطرة و برجا ساميا لبناء الدولة الوطنية القوية سياديا و استراتيجيا و ديمقراطيا و اقتصاديا و التي تستوعب الجميع دون تمييز. لكنه الاستلاب ينخر في صمت و على جميع المستويات و الأصعدة.
فالاستلاب اصطلاحا من السلب و السلبية و لغويا يعني الانتزاع أو الانسلاخ اللاإرادي من الشيء بنعومة و سلاسة أو حتى بقوة التجريد بالمعنى القانوني. و ثقافيا، الاستلاب هو الاغتراب الثقافي عن الذات في علاقتها مع الآخر و هو موضوع
يستدعي أسئلة حرجة من قبيل (الثقافة، الهوية، النهضة، الرؤية الاستراتيجية، الشرعية في الممارسة، ….) لعل أبرزها سؤال الهوية و الثقافة ليس بكونهما مفاهيم مقحمة في نص ممنوح لكن كقضايا مصيرية يحكمها واقع مركب و معقد يشكل اللاوعي الجمعي في تطوره و يؤطر الممارسات الفردية و الجماعية في علاقاتها و تفاعلاتها مع هوية و ثقافة الآخر و تحكم أيضا مدى امتلاك المجتمع و تملكه لأدوات و آليات تعاطيه الطارئ و اعتماده على رؤية مستقلة في تدبيره لقضاياه بعدم سقوطه في التيه و الاغتراب.
فالاستلاب يعد من المفاهيم القليلة التداول لكنها تظل مركزية في كشف
الغطاء عن حقيقة العلاقة التي تربط ثقافة المجتمع بثقافة الآخر أي المثاقفة و مدى تأثر المجتمع و أفراده في إطار حركيتهم عبر تمثلاتهم لمعاني و مضامين و غايات ما يراد أن يستشربوه بوعي أو بلا وعي لأن التقليد البليد و السريع قد يكون سببا للانسلاخ من الذات حين تستوطنها عاهة الميوعة و التبعية العمياء لثقافة الاستهلاك و الركض وراء الأشياء.
إن الاستلاب المركب للمنظومة و الفرد قد يعني مثلا أن التطبيع السياسي للدولة مع الكيان الصهيوني رغم خطورة جرائمه (إبادة الأطفال و جرائم فظيعة ضد الانسانية) لم يكن ليمر و يمرر بسرعة و تسارع لو لم يسبقه تطبيع من نوع آخر في المجتمع مع السلبية و الانتهازية و
الوصولية و الولاء بمحرك الريع و الامتيازات و جميعها تتغدى و تغذي نوازع الذاتية و ثقافة الفردانية. الاستلاب هو ما يفسر الفارق في التعاطي حد التمييز العنصري بين طفل و طفل كون الطفولة واحدة. فالطفل “ريان” رحمه الله و “أطفال غزة” آواهم الله هم في البراءة سيان.
و لم يكن التطبيع ليمرر أيضا لولا الإمعان في تمييع و تلويث العقيدة (القبورية، الزوايا، المواسم) و ضرب القيم و تهميش الابداع و العمل على تدجين الطبقة الوسطى و الفقيرة على الخوف و الاستهلاك و التعايش مع الفساد الإداري و الغش و الرشوة و التباهي بكافة أشكاله. هذا يفسر سبب سيطرة المتنفذين و رجال الأعمال و ليس رجال الفكر على دواليب
القرار و التشريع و المراقبة و كأن منهجيتهم الاستلابية تماثل حرفيا “التدجين الإجرائي” بمنطق التعزيز كما جاء به “فريدريك سكينر”.
معلوم أن في مجتمعات الفرجة و الاستهلاك نقيض مجتمع العلم و المعرفة هي “مجتمعات تستهلك الوقت و تنتج القمامة” كما قال ” جان بوديار”، يصير الاستلاب حالة اعتيادية ينزل فيه الانسان الى مستوى الأشياء يستهلكها و يتباهى بها على الآخر رغم أنه لم يبدعها فيستحيل حينها أسيرا في قفص يتحرك به في حدود مصطنعة بتصورات مقلوبة تدور أطوار حياته من خلاله بين قفصين ذو رمزيتين :
أولا، رمزية ” القفص الفولاذي” كما تحدث
به المفكر الألماني “آرتموت روزا” في مؤلفه ” الاستلاب و التسارع”. يقول روزا: “إنّ الوقت الزمنيّ، أو الوقت على مدار السّاعة لا يتغيّر. هو لا يسير بسرعة ولا ببطء، اليوم أربع وعشرون ساعة، والعام ثلاث مائة وخمسة وستّون يومًا. لذا فإنّ الشعور بأنّ الوقت يمرّ بسرعة لا بدّ من تفسيره بأسباب نفسيّة، إنّه ظاهرة نفسيّة. لكن هذه الظاهرة لها أسباب اجتماعيّة”.
بالنسبة لروزا، فدوران العقلانية الغربية حول مفهومي التقنية و الليبرالية أفرز تجوهرا ذاتيا حول المتعة و المال كإحدى أشكال التعويض عن الإيغال في العمل لينحصر أفق الرؤية في ما هو آني و يصير العمل أيضا قيمة مادية تصرف مقابل الوقت. كلما أراد العامل الرفع من قيمته
المهنية فعليه الغوص في الزمن و الاستزادة منه (الساعات الإضافية، العمل خارج الوقت) فينتج عن ذاك التسارع المدمر للإنسان و للمجتمع : التسارع التقنيّ، التسارع في التغيّر الاجتماعيّ، و التسارع في إيقاع الحياة اليومية.
و الرمزية الثانية هي رمزية “القفص الذهبي” يعيشها المستلب عقليا في عوالم افتراضية و خيالية غريبا و بعيدا عن الواقع و هذا المعنى العميق هو ما أشار له الطبيب البولاندي “استيفان بنديك” في كتابه “الانسان و الجنون”. لقد نجح بنديك في علاج المرضى العقليين بواسطة العمل و جعل العمل و الانشغال و المعاملة الطيبة في مصحته “الجرانج” أساس و ركيزة العلاج الطبي تروم إلى أنسنة الممارسة عبر
العلاقة الصارمة/الصادقة مع المرضى. اليوم، صار العمل و مجال العمل عندنا كالقنبلة الموقوتة و كأحد أهم مسببات صناعة الاكتئاب و الأمراض النفسية و العقلية و استلاب إنسانية الانسان (إسألوا الأخصائيين) و صارت الصحة قطاع ينأى بثقل الارتزاق و الربح المادي يسهم في تكريس المرض كمادة أولية لرفع الدخل بدل رفع المعاناة و تخفيف الآلام.
اليوم حين نمعن جيدا في وضعية الانسان، قد نعتقد أن يساعد التطور التقني السريع (السيارة، الطائرة، البريد الإلكتروني، الآلات المنزلية، ….) في توفير الزمن الحر لاستطعام شيء من الحرية ، لكن ما نعيشه يوميا من ضغوط و كثافة الأعمال و كثرة الأشغال يجعل الزمن يبدوا سريع
الانقضاء و غير كاف أو متاح لإتمام الجري اليومي الذي يتم تأجيله للغد و في الغد لبعد غد و هكذا و دواليك. و هذا بالضبط هو الاستلاب اليوم عن طريق التسارع الزمني فصله المفكر السعودي ابراهيم السكران في كتابه ” الماجريات”.
فهنا نحن لسنا دعاة التباطؤا بقدر ما ندعوا للقصد و التوازن في القول و الفعل و عدم الإفراط في تضييع الزمن في تفاهات الفرجة و اللهو و الرداءة باعتبارها من تمظهرات الانحراف و الاستلاب لتختزل الوطنية في مشاهدة و ليس ممارسة كرة تقدف بأقدام. فأول أشكال الاستلاب كان في روما القديمة حيث يتم تدجين العقول بمشاهد الدماء بعد توزيع الخبز على الجمهور في حلبة “الكوليزي” الشهيرة.
إن مقاربة التربية من منطلق روح العقيدة و ثقافة النقد و الخطأ و الحوار مع مراعاة صحة العقول و الأبدان و قدسية الحقوق كفيل أن يجعل من مجتمعنا نمودجا للتعايش و التضامن يناقض روح التفرد و نزعة الفردانية. فالزمن ليس فائضا بلا قيمة بل أنفاس و دائرة العبودية لله تعالى خارج صنمية المال و وثنية الذات هي ما يقابل الأنانية و المادية لأن لا وزن و لا قيمة للأنا بعيدا أو بدون الآخر الذي هو ضرورة و جسرا نعبر به من الذات نحو الآخر و نعود عبره نحو أنفسنا لاستيلاد ذات جديدة أبلغ حكمة و إيمانا بغاية و أكثر إشراقا و نقاءا بوجود و أعمق معرفة بحقيقتها و ثقة بخياراتها. انتهى///.
المصدر: العمق المغربي