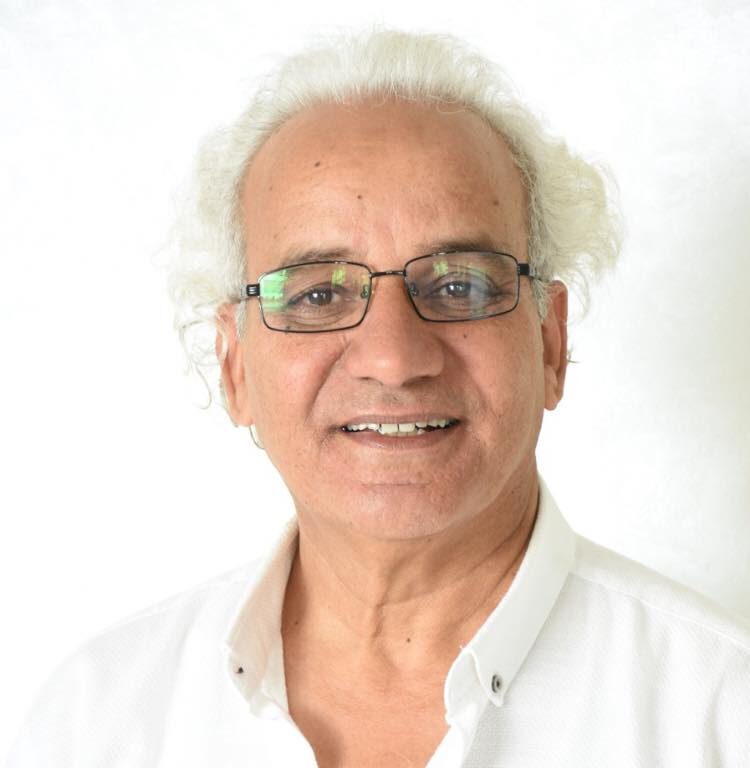وأنا طفل صغير، كنت أفرح كثيرا بحلول ضيف عندنا. كانت فرصة للاستمتاع بطعام غير معتاد، وفرصة للجلوس على أفرشتنا الجديدة، وداخل البيت المعروف، والمسمى بيت “الضياف” أو بلغة عصرية “الصالون”. كانت فرصة أحتمي بها بالضيف أو الضيوف الذين يحلون ببيتنا، لأنهم هم من كانوا يوجهون لي الدعوة بعد الإطلالة عليهم من فج باب البيت، وإن كنت أعرف مسبقا، أن “سلخة” تنتظرني بعد ذهابهم وصاحبتها دوما، أمي رحمها الله، لأنها كانت ترى في دخولي للبيت وجلوسي مع الضيوف “قلة الترابي”، لكن الرغبة في أكل طعام الضيوف وعدم انتظار بقاياه، كانت لذة لا تقاوم، بل كان طعام الضيوف لذيذا ينسيني تلك “السلخة”.
بمجرد خروج الضيوف، يتم تنظيف بيتهم (وليس بيتنا)، وإغلاقه بشكل دائم إلى أن يعودوا مرة أخرى. بيت الضيوف، في منازلنا المغربية، وربما الشيء نفسه في كل المنازل العربية، كانت له وظيفة اجتماعية مهمة، في زمن كان “عيبا” الأكل خارج البيت، بل في زمن كان الصبي الذي يحمل خبز السوق في يده وهو ذاهب لبيتهم، بمثابة رسالة مشفرة، معناها أن أمه مريضة أو غير موجودة في البيت، وبالتالي على الجارة القريبة منهم القيام باللازم، أي تخصيص خبزة أو أكثر لأطفال جارتها إلى أن تعالج أو تعود إن كانت مسافرة..
اليوم تغير الحال كثيرا، بل أصبح من النادر أن نستقبل ضيوفا في بيوتنا. معظم الدعوات لتناول وجبة طعام تتم خارج البيت. بل حتى أعراسنا اليوم هي خارج البيت، وفي قاعات مخصصة لهذا الغرض والتي تناسلت حتى داخل مدن صغيرة، في حين كانت الأعراس سابقا تقام في الخيام وفوق سطوح البيت.
على الرغم من تغير أحوالنا وطباعنا وركوبنا موجة التحديث الظاهري، وليس موجة الحداثة بمعناها الثقافي والفكري والعلمي، الخ، لكن “الصالون” المغربي ظل الركن الثابت في منازلنا. هو بمثابة ضريح، قد نطوف حوله مرات قليلة ونادرة جدا، وقد تكون بمناسبة الأعياد الدينية فقط، وقد يبقى على مر العام مغلقا في انتظار فتحه “والتعبد” داخله.
هو اليوم شبيه بضريح. وفي كل بيوتنا المغربية هذا الضريح موجود، ونصرف عليه أمولا طائلة دون الاستفادة منه وبشكل دائم، في زمن يتميز بقلة الضيوف وبتحولات اجتماعية رهيبة نعيشها داخل عولمة مبضعة للحياة وراغبة في تعليب كل شيء وبيعه، وتحويل الإنسان إلى كائن استهلاكي بامتياز.
بيت “الضياف” أو “الصالون” المغربي الجميل والذي تصنعه وتبدعه أياد مغربية جميلة، أصبح مكلفا جدا. وعلى الرغم من هذا الثمن الجد مرتفع، نحوله إلى مزارأو ضريح نطوف حوله مرات قليلة وبمناسبة بعض الأعياد الدينية أو غيرها. ويبقى السؤال متى من الممكن خلخلة صورة هذا الضريح وتحويله إلى بيت عاد يستفيد منه الجميع؟ .
بيت “الضياف” أو “الصالون” المغربي، مكان نوليه اهتماما كبيرا، بل نصرف عليه مبالغ مالية كبيرة وفي معظمها بمثابة دين، لاسيما من لدن الفئات المحدودة الدخل أو المتوسطة، هو بمثابة خطاب اجتماعي قابل للتفكيك، ووفق مرجعيات منهجية عديدة. طبعا ذكرياتنا تتأسس أيضا بناء على البيت الذي عشنا فيه، وداخله البيت/الضريح المتحدث عنه، نسجنا العديد من العلاقات كأطفال صغار داخله، وحتى ونحن نتقدم في العمر، بقينا على صلة به. اليوم نعيش في زمن آخر، وحياة جديدة تتأسس خارج البيت. طعام الجدة والأم والخالة والعمة والزوجة، قد بدأ يعوضه صاحب المطعم، وما يحمله صاحب الدراجة النارية في صندوقه العجيب الحامل للأكل السريع، والذي يباع عبر الاتصال الهاتفي المعدم للتواصل العائلي الحميمي. تحولات رهيبة نعيشها اليوم، لاسيما من لدن من تعود على أكل طعام جدته وأمه وزوجته وخالته وعمته، الخ.. بينما من ازداد ووجد ما وجد أمامه، فقد يعتقد أنه أمام حياة عادية، لأن المسكين لم يجرب أعراس البوادي في الخيام وفوق السطوح في المدينة، وكيف كان العنب يخرج مباشرة من صندوقه ليضع الموزع نصيب كل مائدة فوقها. لم يعش عالم الشيخات والرما ومولاي السلطان و”روحوا بابا العريس روحوا مولاي السلطان” و”المرقه” و”السفه” و”الحنة” وانتظار الجميع للحظة الفجر..
العالم تحول فعلا.. الحياة تغيرت فعلا.. ضريحنا ثابت شاهد على زمن راح.. أصبح باردا في الشتاء، وساخنا في الصيف، ورائحة الغبار من شدة عدم فتحه علامة مميزة لزمن “اللاضيف”..
كل عام وطوافنا على أضرحتنا ليس بألف خير..
المصدر: العمق المغربي