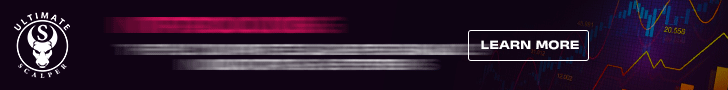ترف الديمقراطية التشاركية مع استمرار أعطاب الديمقراطية التمثيلية
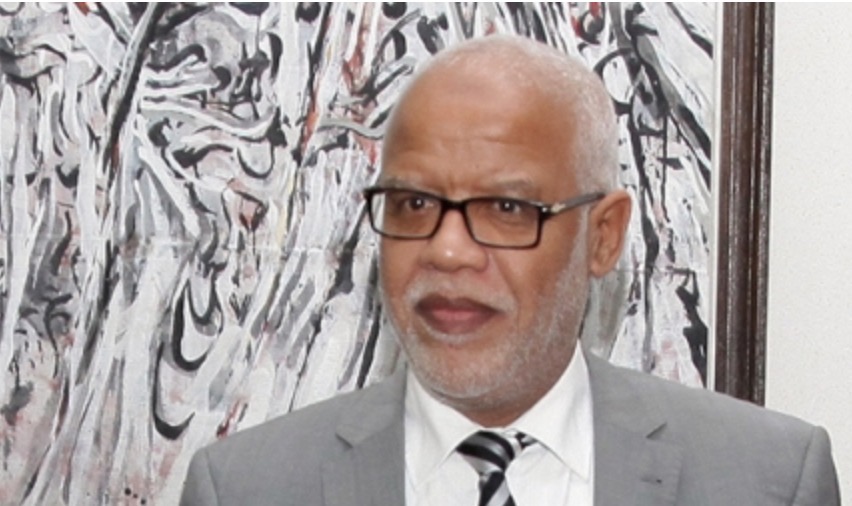
بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية
إذا كانت الديمقراطية فكرة وقيمة ونظاما ، إبداع إنساني مكن المجتمعات الغربية في العصر الحديث من الانتقال إلى حالة من الاستقرار الاجتماعي من خلال فكرة العقد الاجتماعي ، ومن حكم الفرد إلى التدبير الجماعي للسلطة إلى دولة المؤسسات والتداول على السلطة من خلال آلية التمثيل وظهور المؤسسات التميثلية ، إلا أن الممارسة العملية قد كشفت عن مظاهر عدة من القصور والنقص ، استدعت التفكير في صيغ جديدة للممارسة الديمقراطية ، تمكن من تجاوز الثغرات المذكورة و من الرجوع إلى جوهرها كقيمة وثقافة ، وهو ما قاد إلى بلورة ما سيعرف بالديمقراطية التشاركية .
ومن مظاهر ذلك القصور والنقص يمكن تسجيل ما يلي :
أن الديمقراطيات التمثيلية قد آلت من الناحية العملية إلى حكم الأقلية وإلى نوع من جديد من الاستبداد يسميه البعض ب “ديكتوقراطية ”
لقد انتهت الديمقراطية التمثيلية من الناحية العملية إلى انقلاب على الجوهر الأصيل للديمقراطية أي المشاركة الشعبية الخ …..بحيث لم تعد الديمقراطية التمثيلية تختلف في حقيقتها عن أي نظام لحكم الأقلية فتحولت في كثير من الأحيان إلى شكل من التسلط باسم شرعية التمثيل الديمقراطي ، يبنما أصبحت الاغلبية أصبحت خارج دائرة الفعل والقرار وفي وضعية مشارك سلبي ومتفرج
إنه لم يعد هناك تلازم بين معطى الانتخاب ومعطي التمثيل لأسباب عديدة منها : فقدان الهيئات الحزبية لمصداقيتها ومن ثم لشرعية التمثيل ، والعزوف الواسع عن المشاركة الانتخابية وإدلاء المواطن بصوته
ما ألت إليه الديمقراطية التمثيلية والنظام النيابي سواء مستوى التركيبة أو على مستوى الممارسة وضعف القدرة على العمل والفعل الناجع والمفيد مما جعل النظام النيابي التمثيلي فاقدا لقدرته على التمثيل والوساطة .
فقدان الآليات التنظيمية للوساطة من كثير من قدرتها وجاذبيتها في القيام بأدوارها والحلول التدريجي لعدد جديد من وسائل التأطير والتأثير في الرأي العام مما جعل البعض يتحدث عن عصر ما بعد الديمقراطية وخاصة من خلال تقنيات ووسائل التواصل والتأثير في الرأي العام
ويزداد الأمر تعقيدا حين يتعلق في أوضاع غير ديمقراطية أو ناقصة الديمقراطية التي تفتقد فيها أدنى شروط إنتاج تمثيلية ديمقراطية حقيقية , حيث تفتقد العملية الانتخابية نزاهتها ، وتفتقد الديمقراطية المؤسسات المنتخبة وظيفتها التمثيلية ، حيث يشتغل ” المنتخبون ” أساسا من أجل خدمة مصالحهم الشخصية ويتخذون قراراتهم ويمارسون وظيفتهم” الانتدابية ” بعيدا عن الناخبين ، وأصبحت حركات غير مؤسساتية منصات للاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية والفئوية ، وتزايد العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية وصناعة خريطة التمثيلية ،
لكن هل هناك إمكانية لقيام ديمقراطية تشاركية دون بناء ديمقراطية تمثيلية ؟ بصورة أخرى هل استنفذت الديمقراطية التمثيلية أغراضها خاصة في مجتمعات ناقصة الديمقراطية أو في طريق الانتقال الديمقراطي أو تعاني من صعوبات في تحقيق الانتقال المذكور ؟
بصورة أخرى هل يمكن أن ننقل ترف الحديث عن أزمة الديمقراطية التمثيلية إلى مجتمعات لم يتحقق فيها بعد انتقال ديمقراطي حقيقي ، ولم تتمكن بعد من بناء دولة حديثة كاملة المعالم كما هو الشأن في الغرب ، ونقصد بذلك دولة مؤسسات ؟
نجد أنفسنا من جديد في حاجة إلى قراءة مفهوم الديمقراطية التشاركية في سياقه التاريخي ، وأن نحذر من الاستعارات التي لا تراعي السياق التاريخي لتطور الديمقراطية التشاركية .
فمن المعلوم أن تطور الديمقراطية التشاركية قد جاء بعد مرحلة طويلة من تطوير حكم المؤسسات وتفعيل الديمقراطية التمثيلية والتحقيق العملي لمبدأ فصل السلطات ، وذلك يعني أن الديمقراطية التشاركية قد تطورت نتيجة حصول نوع من الإشباع في ممارسة الديمقراطية التمثيلية واستنفاذها لقوتها التعبوية ، وفقدانها لبريقها بسبب ما دخل عليها من ممارسات حولتها عن مقاصدها الأصلية ،
فبالنسبية لمجتمعات ما تزال تبحث عن بناء دولتها الحديثة ، دولة المؤسسات وتسلك من أجل ذلك مسالك صعبة ، فإنه قد يكون من المغامرة التشكيك في جدوى الديمقراطية التمثيلية ، كما يصبح طرح الديمقراطية التشاركية بديلا عنها تزييفا للوعي وإمعانا في إضعاف دولة المؤسسات ، وتمييعا لمفهوم التمثيل باعتباره أساسا للعملية الديمقراطية ، وإسهاما في تكريس تغول بعض السلط على بعضها الأخر ، وإضعافا للمؤسسات المنتخبة وتكريسا لصورة سلبية عنها ، خاصة إذا كانت منبثقة عن عمليات انتخابية تتوفر فيها معايير النزاهة والمصداقية ، وإفراز خريطة حقيقية للتمثيلية السياسية ,
بصورة أخرى إن الوعي التاريخي كما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذا الكتاب يقتضي أن ندرك أن الانتقال للديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يتم دون تحقيق ديمقراطية تمثيلية حقيقية قائمة على انتخابات حرة ونزيهة ، وهو ما يقتضي وجود أحزاب سياسية حقيقية أي حزب بمرجعية فكرية وبرامج سياسية واجتماعية وتنمية واضحة وقائمة على أكتاف مناضلين عضويين ، وذات قدرة تأطيرية فكرية وسياسية ,
وذلك بعني أن الحديث عن ديمقراطية تشاركية لا تستند على ديمقراطية تمثيلية حقيقة لا يمكن إلا أن يكون جزءا من عملية تزييف الوعي ومواصلة التحكم في العملية السياسية ، وعاملا من عوامل تأخير عملية تحديث الدولة والمجتمع ، وتكريسا للاعقلانية السياسية .
وقد نبه الدكتور عبد العروي في كتابه : ” العرب والفكر التاريخي ” على هذا المعنى عندما انتقد الماركسيين العرب الذين وقفوا موقفا مناهضا من الليبرالية معتبرا أن استيعاب الليبرالية مرحلة أساسية في التطور نحو الحلم الذي بشر به كارل ماركس ، ولذلك تساءل قائلا : كيف يمكن للفكر العربي أن يستوعب مكتسبات الليبرالية دون أي يستوعب سؤال الحداثة، المتمثلة حتى الآن في الفكر الليبرالي للقرن قبل (وبدون) أن يعيش مرحلة ليبرالي ,
وكما تبين فإننا لا نرى في استيعاب الحداثة استنساخا بليدا لها ، تماما كما لم ير العروي في استيعاب اللبيرالية ما يناقض الانتقال إلى الماركسية .
إن العروي لم يكن لييراليا ولكنه كان يرى أن لا محال لاستيعاب وفهم الماركسية والنضال من خلالها إلا عبر اسيتيعاب الليبرالية ، الاستيعاب باعتباره أحد العمليتين الديناميتين للتكيف كما وضحه جان بياجي سواء في مجال السيكولوجيا و الإبستمولوجيا ، ‘إلى مجال علم الاجتماع الثقافي أي الذكاء بمعناه التاريخي والحضارى أي باعتبار استيعابا وتلاؤما جماعيين أي ذكاء اجتماعيا وحضاريا ،
في الراهنية المتواصلة للنضال من أجل البناء الديمقراطي
وبالرجوع إلى المسار التاريخي للنضال من أجل بناء الديمقراطية نجد أنه اتخذ في الغرب مسارا صراعيا تميز بصراع حاد ضد النظام الإقطاعي ، وتنامي فكر الأنوار في مواجهة الفكر الديني الكنسي الذي تحالف مع الاستبداد ، ومن ثم كان صراعا يهدف إلى أنسنة الدولة وتخليصها من سيطرة الكهنوت وإيديولوجيته الثيوقراطية ـ أي الحكم الذي يستمد شرعيته حسب ادعائه من التفويض الإلهي وهذا يقتضي التعامل مع الحداثة وتوابعها ولوزمها تعاملا يقوم على ذكاء حضاري ، الذكاء كما عرفة جان باجي باعتبارها علاقة باعتبارها إبداعا متواصلا ، بما يستتبعه مفهوم الإسيتبعاب. من نلاؤم وملاءمة … أي الحاجة للذكاء المعرفي والحضاري ….
بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية
إذا كانت الديمقراطية فكرة وقيمة ونظاما ، إبداع إنساني مكن المجتمعات الغربية في العصر الحديث من الانتقال إلى حالة من الاستقرار الاجتماعي من خلال فكرة العقد الاجتماعي ، ومن حكم الفرد إلى التدبير الجماعي للسلطة إلى دولة المؤسسات والتداول على السلطة من خلال آلية التمثيل وظهور المؤسسات التميثلية ، إلا أن الممارسة العملية قد كشفت عن مظاهر عدة من القصور والنقص ، استدعت التفكير في صيغ جديدة للممارسة الديمقراطية ، تمكن من تجاوز الثغرات المذكورة و من الرجوع إلى جوهرها كقيمة وثقافة ، وهو ما قاد إلى بلورة ما سيعرف بالديمقراطية التشاركية .
ومن مظاهر ذلك القصور والنقص يمكن تسجيل ما يلي :
أن الديمقراطيات التمثيلية قد آلت من الناحية العملية إلى حكم الأقلية وإلى نوع من جديد من الاستبداد يسميه البعض ب “ديكتوقراطية ”
لقد انتهت الديمقراطية التمثيلية من الناحية العملية إلى انقلاب على الجوهر الأصيل للديمقراطية أي المشاركة الشعبية الخ …..بحيث لم تعد الديمقراطية التمثيلية تختلف في حقيقتها عن أي نظام لحكم الأقلية فتحولت في كثير من الأحيان إلى شكل من التسلط باسم شرعية التمثيل الديمقراطي ، يبنما أصبحت الاغلبية أصبحت خارج دائرة الفعل والقرار وفي وضعية مشارك سلبي ومتفرج
إنه لم يعد هناك تلازم بين معطى الانتخاب ومعطي التمثيل لأسباب عديدة منها : فقدان الهيئات الحزبية لمصداقيتها ومن ثم لشرعية التمثيل ، والعزوف الواسع عن المشاركة الانتخابية وإدلاء المواطن بصوته
ما ألت إليه الديمقراطية التمثيلية والنظام النيابي سواء مستوى التركيبة أو على مستوى الممارسة وضعف القدرة على العمل والفعل الناجع والمفيد مما جعل النظام النيابي التمثيلي فاقدا لقدرته على التمثيل والوساطة .
فقدان الآليات التنظيمية للوساطة من كثير من قدرتها وجاذبيتها في القيام بأدوارها والحلول التدريجي لعدد جديد من وسائل التأطير والتأثير في الرأي العام مما جعل البعض يتحدث عن عصر ما بعد الديمقراطية وخاصة من خلال تقنيات ووسائل التواصل والتأثير في الرأي العام
ويزداد الأمر تعقيدا حين يتعلق في أوضاع غير ديمقراطية أو ناقصة الديمقراطية التي تفتقد فيها أدنى شروط إنتاج تمثيلية ديمقراطية حقيقية , حيث تفتقد العملية الانتخابية نزاهتها ، وتفتقد الديمقراطية المؤسسات المنتخبة وظيفتها التمثيلية ، حيث يشتغل ” المنتخبون ” أساسا من أجل خدمة مصالحهم الشخصية ويتخذون قراراتهم ويمارسون وظيفتهم” الانتدابية ” بعيدا عن الناخبين ، وأصبحت حركات غير مؤسساتية منصات للاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية والفئوية ، وتزايد العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية وصناعة خريطة التمثيلية ،
لكن هل هناك إمكانية لقيام ديمقراطية تشاركية دون بناء ديمقراطية تمثيلية ؟ بصورة أخرى هل استنفذت الديمقراطية التمثيلية أغراضها خاصة في مجتمعات ناقصة الديمقراطية أو في طريق الانتقال الديمقراطي أو تعاني من صعوبات في تحقيق الانتقال المذكور ؟
بصورة أخرى هل يمكن أن ننقل ترف الحديث عن أزمة الديمقراطية التمثيلية إلى مجتمعات لم يتحقق فيها بعد انتقال ديمقراطي حقيقي ، ولم تتمكن بعد من بناء دولة حديثة كاملة المعالم كما هو الشأن في الغرب ، ونقصد بذلك دولة مؤسسات ؟
نجد أنفسنا من جديد في حاجة إلى قراءة مفهوم الديمقراطية التشاركية في سياقه التاريخي ، وأن نحذر من الاستعارات التي لا تراعي السياق التاريخي لتطور الديمقراطية التشاركية .
فمن المعلوم أن تطور الديمقراطية التشاركية قد جاء بعد مرحلة طويلة من تطوير حكم المؤسسات وتفعيل الديمقراطية التمثيلية والتحقيق العملي لمبدأ فصل السلطات ، وذلك يعني أن الديمقراطية التشاركية قد تطورت نتيجة حصول نوع من الإشباع في ممارسة الديمقراطية التمثيلية واستنفاذها لقوتها التعبوية ، وفقدانها لبريقها بسبب ما دخل عليها من ممارسات حولتها عن مقاصدها الأصلية ،
فبالنسبية لمجتمعات ما تزال تبحث عن بناء دولتها الحديثة ، دولة المؤسسات وتسلك من أجل ذلك مسالك صعبة ، فإنه قد يكون من المغامرة التشكيك في جدوى الديمقراطية التمثيلية ، كما يصبح طرح الديمقراطية التشاركية بديلا عنها تزييفا للوعي وإمعانا في إضعاف دولة المؤسسات ، وتمييعا لمفهوم التمثيل باعتباره أساسا للعملية الديمقراطية ، وإسهاما في تكريس تغول بعض السلط على بعضها الأخر ، وإضعافا للمؤسسات المنتخبة وتكريسا لصورة سلبية عنها ، خاصة إذا كانت منبثقة عن عمليات انتخابية تتوفر فيها معايير النزاهة والمصداقية ، وإفراز خريطة حقيقية للتمثيلية السياسية ,
بصورة أخرى إن الوعي التاريخي كما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذا الكتاب يقتضي أن ندرك أن الانتقال للديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يتم دون تحقيق ديمقراطية تمثيلية حقيقية قائمة على انتخابات حرة ونزيهة ، وهو ما يقتضي وجود أحزاب سياسية حقيقية أي حزب بمرجعية فكرية وبرامج سياسية واجتماعية وتنمية واضحة وقائمة على أكتاف مناضلين عضويين ، وذات قدرة تأطيرية فكرية وسياسية ,
وذلك بعني أن الحديث عن ديمقراطية تشاركية لا تستند على ديمقراطية تمثيلية حقيقة لا يمكن إلا أن يكون جزءا من عملية تزييف الوعي ومواصلة التحكم في العملية السياسية ، وعاملا من عوامل تأخير عملية تحديث الدولة والمجتمع ، وتكريسا للاعقلانية السياسية .
وقد نبه الدكتور عبد العروي في كتابه : ” العرب والفكر التاريخي ” على هذا المعنى عندما انتقد الماركسيين العرب الذين وقفوا موقفا مناهضا من الليبرالية معتبرا أن استيعاب الليبرالية مرحلة أساسية في التطور نحو الحلم الذي بشر به كارل ماركس ، ولذلك تساءل قائلا : كيف يمكن للفكر العربي أن يستوعب مكتسبات الليبرالية دون أي يستوعب سؤال الحداثة، المتمثلة حتى الآن في الفكر الليبرالي للقرن قبل (وبدون) أن يعيش مرحلة ليبرالي ,
وكما تبين فإننا لا نرى في استيعاب الحداثة استنساخا بليدا لها ، تماما كما لم ير العروي في استيعاب اللبيرالية ما يناقض الانتقال إلى الماركسية .
إن العروي لم يكن لييراليا ولكنه كان يرى أن لا محال لاستيعاب وفهم الماركسية والنضال من خلالها إلا عبر اسيتيعاب الليبرالية ، الاستيعاب باعتباره أحد العمليتين الديناميتين للتكيف كما وضحه جان بياجي سواء في مجال السيكولوجيا و الإبستمولوجيا ، ‘إلى مجال علم الاجتماع الثقافي أي الذكاء بمعناه التاريخي والحضارى أي باعتبار استيعابا وتلاؤما جماعيين أي ذكاء اجتماعيا وحضاريا ،
في الراهنية المتواصلة للنضال من أجل البناء الديمقراطي
وبالرجوع إلى المسار التاريخي للنضال من أجل بناء الديمقراطية نجد أنه اتخذ في الغرب مسارا صراعيا تميز بصراع حاد ضد النظام الإقطاعي ، وتنامي فكر الأنوار في مواجهة الفكر الديني الكنسي الذي تحالف مع الاستبداد ، ومن ثم كان صراعا يهدف إلى أنسنة الدولة وتخليصها من سيطرة الكهنوت وإيديولوجيته الثيوقراطية ـ أي الحكم الذي يستمد شرعيته حسب ادعائه من التفويض الإلهي وهذا يقتضي التعامل مع الحداثة وتوابعها ولوزمها تعاملا يقوم على ذكاء حضاري ، الذكاء كما عرفة جان باجي باعتبارها علاقة باعتبارها إبداعا متواصلا ، بما يستتبعه مفهوم الإسيتبعاب. من نلاؤم وملاءمة … أي الحاجة للذكاء المعرفي والحضاري ….
المصدر: العمق المغربي