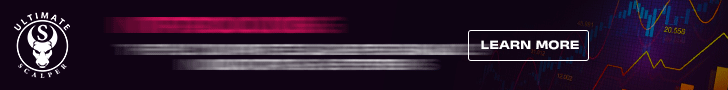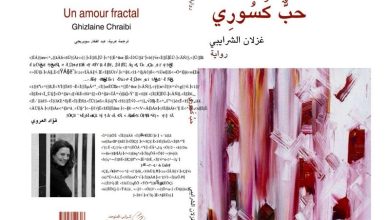القانون التنظيمي للإضراب بين الضمانات الدستورية وحسابات “الأغلبية”

لاشك أن المشرع الدستوري وهو ينسج الوثيقة الدستورية لسنة 2011، قد أخذ بعين الاعتبار الأوضاع المرتبطة بانتفاضات شعوب المنطقة ضد أنظمة حاكمة سلطوية وقمعية، حكمت شعوبها بالحديد والنار، وسخرت المال والسلطة والقانون لكبت وخنق كل صوت معارض أو ناقد أو مطالب بحق من الحقوق، لكن كل ذلك لم يمنع من سقوط هذه الأنظمة، سواء عبر ثورات سلمية كما في تونس ومصر أو التحول لثورة مسلحة كما حصل في ليبيا و سوريا. وبغض النظر عن المآلات، فإن الدرس المستفاد من كل ما حدث هو أن الدولة التي تتأسس على توافقات كبرى تستطيع ضمان وجودها واستقرارها وتنميتها، وهي الأهداف الثلاثية الذهبية التي وجدت الدولة لخدمتها. كما أن الحكومات التي تجعل التشريعات والقوانين في خدمة مواطنيها، هي الحكومات الجديرة بثقة الشعوب لا تلك التي تستخدم مقدرات الدولة وأدواتها القانونية والتشريعية لخدمة مصالح طبقية. وإذا كانت الدولة دائمة ومطلوب من مجموع مواطنيها الدفاع على وجودها واستقرارها وتنميتها، فإن الحكومات عابرة، ولا يحق لأي حكومة أن تشرع حسب هواها بما يضر بالسلم المجتمعي، وبما يمس بحريات وحقوق مواطني الدولة.
لقد التقطت الدولة المغربية الإشارات التي أطلقها ربيع الشعوب في 2011، واستبقت الأحداث بالدخول في مسار الإصلاح الدستوري، قد يختلف تقييم قوى المجتمع لكيفيات ومسارات ونواتج هذا الإصلاح، لكن المهم أنه جنب المغرب مآلات غير مرغوبة، وحافظت به الدولة على توازن مجتمعي قد يكون هشا فثمة من يرى أن الاصلاح أو التغيير لم يبلغ المدى المطلوب، لكنه على الأقل جنب البلاد الأسوء، وإذا كانت من ايجابيات دستور 2011، تخصيص بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية من خلال 22 فصلا، ومن بينها الحقوق المنصوص عليها في الفصل 29 الذي ينص على أن ” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته” فهذه القاعدة الدستورية ضامنة لحقوق الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والعمل المدني الجمعوي والانخراط في العمل النقابي والسياسي، وأحال على المشرع الدستوري على المشرع الأدنى الاضطلاع بالتقنين، ووضع القواعد التنظيمية لممارسة هذه الحريات والحقوق، وحيث إن المتعارف عليه ضرورة أن يكون عمل هذا المشرع الأدنى مؤطرا بالنص الدستوري بوصفه القانون الأسمى، إذ القوانين تشكل بناء من طبقات، يمثل الدستور الطبقة الأعلى فيها، ولكي تبقى الطبقة الأعلى محافظة على وجودها وتماسكها وروحها، فيجب أن تكون الطبقات الأدنى على قدر عال من التوافق مع روح الدستور ومقاصده، لا أن تسعى لخرقه وتفريغه من محتواه، فكما يقول الفقيه هانس كلسنHans Kelsen فالمطلوب من البناء القانوني في تراتبيته أن” يؤدي في مجمله إلى القاعدة القانونية التي تتربع في قمة هرمه (الدستور) حيث تخضع لها جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة في هذا النظام القانوني”
وبما أن المناسبة شرط، فإن لجوء حكومة الباطرونا ورجال الأعمال في بلادنا إلى محاولة فرض قانون تنظيمي للإضراب، بعقلية المغالبة لا المشاركة، والإرغام لا الإقناع، يستحث الباحثين على النظر في هذا المشروع، للوقوف على مدى البون الشاسع بين ما يشكله الدستور من ضمانة للحقوق والحريات الأساسية، ونوايا حكومة الباطرونا، التي تستغل مواقع النفوذ والامتياز التي تتيحها المراكز القانونية داخل السلطة التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحها الطبقية، ولايخفى على عين الناظر والباحث في أبواب وفروع ومواد هذا المشروع، طبيعة الأفكار الطبقية والأنانية للأغلبية العددية التي شكلت قوام هذا النص القانوني المكبل، والمجرم لممارسة حق مضمون دستوريا. فأي روح تلبست مشروع القانون التنظيمي 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؟ هل هي روح الدستور أم روح المصالح الطبقية؟ أي شيء يتبقى من روح القاعدة الدستورية إذا كان مشروع القانون التنظيمي بشروطه ومسطرته وعقوباته يفرغ القاعدة من مضمونها ومحتواها؟
إن المشرع الدستوري في الفصل 29 المذكور وهو يتحدث عن الحق في الإضراب وحقوق مجاورة له؛ كحقوق الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والعمل المدني الجمعوي والانخراط في العمل النقابي والسياسي. يبين مدى الصلة بين هذه الحقوق، فالاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والانخراط في المؤسسات النقابية، حقوق يستلزم بعضها بعضا، وسنرى كيف أن المشرع باسم “الأغلبية العددية” قد سعى لتقليص دائرة ممارسة هذه الحقوق.
إذا كانت المادة الأولى ضمن الأحكام العامة للمشروع تعتبر حق الإضراب مضمونا ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، وتنص على أن كل تنازل عن هذا الحق يعد باطلا، فإن البابين الثاني والثالث الخاصين على التوالي بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب، وبالجزاءات، يجعلان ممارسة حق الإضراب من الممنوعات بعد أن كان من الممكنات في حالة الضرورة، فقد تعلمنا في النقابة أن الإضراب أبغض الحلال، ولا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، وإن إحاطته بعدد من الشروط والمساطر البيروقراطية، والعقوبات. يهدف في النهاية إلى منعه بل وتجريمه مادام أن ممارسته لا تتم إلا بما يتوافق وهوى الحكومة المستقوية بأغلبيتها العددية، وشهوة أرباب العمل.
وذا كان القانون قد حدد الجهة المخول لها الدعوة للإضراب في المادة 3 ضمن التعاريف، فإنه يقيد عمل هذه الجهة بشرط أن تكون في “وضعية قانونية سليمة” ومن شأن هذه المادة شرعنة التدخل في شؤون الهيئات النقابية لمراقبة هذه الوضعية القانونية، خاصة في ظل عدم وجود قانون متوافق عليه للنقابات، مما يمكن معه تأويل هذا المقتضى بما يوافق هوى السلطة التنفيذية، خاصة وأن المشرع هنا تدخل في حالة الإضراب في المقاولة أو المؤسسة في تحديد نسب الجموع العامة، وعدد الموقعين في محضر الدعوة للإضراب.
وعندما يحدد مشروع القانون الأسباب الداعية للإضراب في ثلاث حالات وهي: الملف المطلبي، القضايا الخلافية، وجود خطر حال. فإن هذه الأسباب الثلاث لا تشمل كل دواعي الإضراب الممكنة والحقيقية، خاصة وأن الأعمال والمهن والحرف والوظائف غير محصورة ومشاكلها لا يمكن حصرها في ثلاثة أسباب واستبعاد كل الدواعي والأسباب المعقولة.
وبخصوص الآجال فهي آلية قانونية تمكن من تدارك أوضاع معينة يمكن تداركها، من خلال التفاوض، قبل ممارسة حق الإضراب. إلا أن الآجال المحددة في هذا القانون مبالغ فيها، وتعطي الامتياز للحكومة وأرباب العمل والمشغلين على حساب العمال على اختلاف أوضاعهم، فبعد تقديم الملف المطلبي على المستوى الوطني في القطاع العام والخاص يجب الانتظار 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوم ليصبح المجموع 60 يوما، وبالنسبة للمقاولة أو المؤسسة 15 يوم تمدد مرة واحدة ليصبح المجموع 30 يوما. وكان الأولى بالمشرع في هذه النقطة تحديد آجال بدء التفاوض بخصوص الملفات المطلبية بمجرد تسلمها أو في الحد الأقصى في أجل معقول لا يتعدى 15 يوم وطنيا، و7 أيام في المقاولة أو المؤسسة، فالمقصود تفادي الاضطرار للإضراب ولا يكون ذلك إلا بحمل المشغل على التفاعل الايجابي مع مطالب العمال، والدخول في التفاوض بما يتيح بسط الملف المطلبي، ويعطي للمشغل إمكانية اقتراح الحلول المتاحة والصعوبات المطروحة، وبناء التوافقات الممكنة.
وفيما يتعلق بتبليغ قرارالإضراب بوصفه من مقتضيات النظام العام، ويتيح للسلطات اتخاذ المتعين لحفظ النظام العام، فإن تنصيص المادة 14 على تعدد الجهات التي يلزم تبليغها، يثقل كاهل الجهات الداعية للإضراب بإجراءات شكلية، فمثلا على الصعيد الوطني يطلب من النقابة قبل 7 أيام من التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب تبليغ رئيس الحكومة، والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالتشغيل، والقطاع المعني. والمطلوب أن يكون هناك مخاطب واحد، عوض تعدد جهات التبليغ، وأن يتم تحديد وسائل التبليغ وحصرها درء لحدوث أي خلل في شكلية التبليغ. أضف إلى ذلك مرفقات قرار الإضراب مثل الملف المطلبي أو نسخة من القضايا الخلافية، أو نسخة إثبات الخطر الحال، أو المحضر بتوقيعات 25 في المئة من الأجراء، بعد جمع عام يحضره 35 في المئة من الأجراء في المقاولة أو المؤسسة.
وبخصوص الجزاءات فيسجل أولا في شكلية سرد مقتضياتها، أنها وردت في الباب الثالث الذي تضمن 9 مواد، أقرت عقوبات جديدة تضاف إلى العقوبات الواردة في تشريعات أخرى كالمادة 288 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. فعوض أن ينهي قانون الإضراب مثل هذه العقوبات القاسية المجرمة للعمل النقابي، مازال مشروع القانون التنظيمي يحتفظ بعبارات فضفاضة من قبيل؛ عرقلة حرية العمل، ورفض القيام بالأنشطة الضرورية، ورفض توفير الحد الأدنى من الخدمة، واحتلال أماكن العمل، والمشاركة في إضراب غير مشروع، زد إلى ذلك مضاعفة العقوبة في حالة العود، والمتمثلة في الغرامة المتراوحة بين 1200 و8000 درهم، والإكراه البدني في حالة عدم الأداء، مالم يثبت العجز عن الأداء بالوسائل المقررة قانونا.
والملاحظ أنه بقدر ما شدد المشرع في الشروط والمساطر والجزاءات المتعلقة بممارسة حق الإضراب، فإنه أغفل قضايا جوهرية تتعلق بأدوار السلطة الحكومية في إلزام المشغل باحترام حقوق العمال، وغياب أي مقتضيات زجرية في حالة عدم التفاعل الايجابي مع مطالبهم، أو في حالة عدم تطبيق المقتضيات القانونية، أو ربط الامتيازات(منها الضريبية) التي تقدمها الدولة للمقاولة بالالتزام الكلي بالمقتضيات التي تنص على حقوق العمال وواجبات المشغل تجاههم، كما أن المشرع نسي أو تناسى الإشارة للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وجهاز تفتيش الشغل وأدوارها المعطلة، وغيرها من أجهزة الوساطة التي يجب أن تعطاها الوسائل الضرورية لممارسة مهامها في حماية حريات وحقوق العمال.
وأمام تعقد شروط ومساطر وجزاءات عدم الامتثال للقانون التنظيمي وما سيتبعه من نصوص تنظيمية، لممارسة حق الإضراب، وإذا تعذر الوصول لأي حل بسبب تعنت المشغل، واضطرار العامل للإضراب فإنه وبموجب المادة 6 فإنه يعد في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر، ولم يكلف المشرع نفسه عناء التفكير في إقرار إجراءات مواكبة للتعويض، ولا مسطرة للاقتطاع من الأجر، مما يجعل الإضراب مفرغا من محتواه فاقدا لمبدأ المشروعية.
ويبقى الأمل في المحكمة الدستورية التي أناط بها المشرع الدستوري النظر في دستورية القوانين التنظيمية، لتقويم اعوجاج هذا النص القانوني، بما يتناسب وروح الفصل 29من الدستور، لأن عدم انسجام القانون التنظيمي مع روح القوانين، المتمثل في تحقيق العدالة والإنصاف، يفتح الباب لطغيان منطق المصالح الطبقية للمسيطرين على الأغلبية الحكومية، وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكره ما يثار من شبهات حول تورط وزراء وبرلمانين في مخالفات تتعلق بتنازع المصالح، فهذا يجعل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في تعارض تام مع شعاراتها ووعودها. ومن الأجدر إعادة النظر في طريقة الاشتغال عوض اللجوء للتخوين، فأن يعتبر رئيس مجلس النواب انسحاب مجموعة من المستشارين احتجاجا على فرض مشروع قانون الإضراب بعقلية المغالبة، خيانة للسيادة الوطنية هذه التهمة المبتدعة أمر خطير ولا مبرر له، وهومن قبيل التصريحات المهددة للسلم الاجتماعي، وأخيرا نهمس في أذن كل ذي مسؤولية عامة.
فلا تسلك طريقا فيه بغي**طريق البغي يأتي بالشرور.
المصدر: العمق المغربي