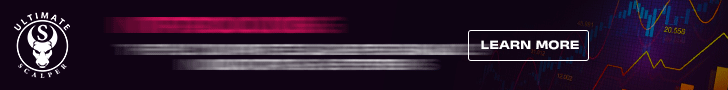الفساد في المغرب.. ارتهان الحاضر بالتاريخ، في الحاجة إلى الابتكار المؤسساتي

في الوقت الذي تتوالى فيه قضايا الفساد داخل المؤسسات العمومية والمنتخبة خصوصا، ويزج بشخصيات سياسية في أتون متابعات قضائية لا تنتهي، فيما ينتظر آخرون دورهم ويفلت البعض من الحساب والعقاب، في مشهد أشبه بقصص سريالية متكررة، أمام رأي عام اعتاد على تلك المشاهد، بمشاعر يمتزج فيها الانتقام بالتسلية، تتكرر الأسئلة الحارقة ذاتها : لماذا لم ولا ننجح في محاربة الفساد؟ هل تكفي المحاكمات المعزولة لإحداث التغيير نحو الأفضل؟ من يتحمل المسؤولية عن تمييع الحياة السياسية والتهام المال العام والإثراء الفاحش على حساب حق الشعب في العيش بكرامة؟ وهل نحن بصدد مكافحة فساد أم بصدد إعادة إنتاجه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن أن تجد جوابًا شافيًا ما لم نغُص عميقًا في جوهر الإشكال، المرتبط، حتما وليس احتمالا، بالبنية المؤسساتية التي تؤطر الحياة العامة بالمغرب، والتي تعود جذورها، كما سنوضح، إلى نموذج إداري موروث من زمن الحماية الفرنسية.
إن الفساد المستشري اليوم لا يمكن فصله عن سياق مؤسساتي مزمن. إنه ليس فقط انحرافًا سلوكيًا لأفراد، بل تجلٍّ لنظام مؤسساتي مأزوم، يكرس ممارسات لامنصفة، مبنية على الولاءات الشخصية والزبونية وتكرس مقاربة سلطوية تهيمن على تسيير الشأن العام. فالنموذج المؤسساتي المغربي، في جوهره، لا يزال أسيرًا لعقل كولونيالي صيغ على مقاس الحماية الفرنسية، حيث لم تُبْنَ الإدارة على أساس المواطنة، بل على منطق المراقبة والانضباط.
حين نطالع النموذج المؤسساتي القائم “le paradigme institutionnel en vigueur” من حيث نشأته وخلفيته الفلسفية، نجده يعود إلى معاهدة فاس أو معاهدة الحماية، وهو ظهير سلطاني، أرسى الحماية الفرنسية بموجبه نظام حماية، لتتولى فرنسا إدارة الشؤون الخارجية والعسكرية والمالية والإدارية للبلاد، في حين يُبقي السلطان على سلطته الرمزية والدينية. فهذا الظهير أسس لنموذج إداري استعماري “Modèle administratif colonialiste”، يميز بين نخبة من المحميين ومغاربة مقموعين، لينتج لنا بيروقراطية على النمط الفرنسي الخاص بالمناطق المستعمرة، موجه أساسا للضبط والرقابة وليس لخدمة المواطنين، فقد ورث المغرب، غداة الاستقلال، نمطًا إداريًا سلطويًا يتسم بـ مقاربة إذعانية جعلت من المواطن كائنًا خاضعًا لا شريكًا. فبدل أن يكون الجهاز الإداري في خدمة المواطن، أصبح المواطن هو من يُستنزف لخدمة منطق السلطة، دون أن يُمنح مكانة اعتبارية تعترف بعطائه أو تُكرم إنسانيته. لقد نُسجت البنية البيروقراطية على منطق “انضباط الطاعة” لا على روح “التمكين والمشاركة”، وحين يُنتج الفساد في هذا السياق، يصبح مجرد نتيجة منطقية لنسق لا يُحاسب، ولا يعترف بالعطاء، ولا يمنح شعورًا بالانتماء.
في الفلسفة السياسية الحديثة، تُعتبر الكرامة والاعتراف من الأسس الجوهرية للمواطنة الفاعلة. حين يُحرم الفرد من التقدير والاعتراف به كإنسان وكمواطن، ويُهمّش صوته، وينظر إليه كمجرد رقم في معادلة أمنية واقتصادية، يفقد الرابط المعنوي الطبيعي الذي يربطه بالدولة. في مثل هذا السياق، تمتزج مشاعر الغبن والقهر بانسداد الأفق، لتتولد ثقافة العنف المعنوي والمادي في المجتمع كرد فعل لا واعيًا في كثير من الأحيان على الإقصاء المؤسساتي، أو كوسيلة لتعويض غياب العدالة التوزيعية والاحترام المتبادل.
لقد ورث المغرب، بعد الاستقلال، إدارة بنيت في فلسفتها وصيغت لخدمة “الدولة الحامية” وليس الدولة الوطنية. لم تُبنَ مؤسسات تُعبر عن روح العقد الاجتماعي الجديد، بل استمرت تلك المؤسسات في أداء وظيفة ضبطية، تتعامل مع المواطن وكأنه حبيس دائرة طوق وليس كفاعل في دينامية متجددة. إن هذا التناقض البنيوي بين خطاب الدولة التنموي وطبيعة مؤسساتها التقليدية هو ما يفتح الباب واسعًا أمام ممارسات الفساد، من قبيل الريع، الإفلات من العقاب، النهب، ممارسة السياسة من أجل الإثراء، ناهيك عن الفشل في صناعة سياسات عمومية ناجعة، لتتراكم الاختلالات وتتداعى تأثيراتها على المجتمع أفقيا وعموديا، تحاصر حاضره وترهن مستقبله.
من هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة مختلفة، مقاربة تقوم على “الابتكار المؤسساتي”. فالابتكار لا يقتصر على اعتماد تكنولوجيا جديدة أو رقمنة الإدارة، بل يتعداه إلى إعادة تصميم القواعد والروابط والممارسات التي تنظّم الحياة المؤسساتية، بشكل يُعزّز التعلُّم ويقوّي أواصر النسق المؤسساتي، بما يمكن من خلق ديناميكية ولادة للفرص الاقتصادية المنتجة، حيث تشيع تلقائيا روح المسؤولية والشفافية، ويُعيد الاعتبار للفاعلين المحليين، ليجعل من المواطن محور عملية الإصلاح وهدفها الأسمى.
فالابتكار المؤسساتي ينطلق من تشخيص معمّق لأوجه الخلل البنيوي، ليبدأ من الاعتراف بالفشل في النموذج الحالي، والانتقال من منطق السيطرة إلى منطق الشراكة، ومن التراتبية العمياء إلى دينامية أفقية تسمح بالتفاعل والتعلّم المؤسسي. هذا التحول لا يمكن أن يتم فقط عبر إصلاح القوانين وإضافة تعديلات من هنا وهناك، بل يتطلب ثورة قيم داخل الإدارة والسياسة والمجتمع، بحيث يروم إلى إعادة تعريف أدوار المؤسسات وفق قيم جديدة : المشاركة، التعلم، التقييم الممارسات الفضلى والتجريب، بما يراعي قيم الديمقراطية الحقة، فلا يبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار، بل يصبح جزءا من ثقافة تنظيمية تُؤمن بالشفافية وتراهن على الكفاءة والإبداع والتجديد، وهي العوامل الضرورية لتحقيق التغيير المطلوب.
لذلك، ما نراه من حملات موسمية لمحاربة الفساد، رغم أهميتها، تبقى ذات أثر محدود إذا لم تُدرج ضمن رؤية مؤسساتية شاملة، لأن الإصلاح الحقيقي لن يتأتى فقط عبر المحاكمات، بل عبر إصلاح النمط المؤسساتي ذاته، الذي استحال إلى آلة لصناعة وإعادة إنتاج الفساد. وهذا يتطلب رؤية وإرادة سياسية واضحتين، وإشراكًا حقيقيًا للمجتمع المدني، وتحريرًا للصحافة، وتمكينًا للقضاء.
على النخب السياسية والإدارية أن تعي أن التغاضي عن إصلاح النموذج المؤسساتي الحالي هو حكم باللاجدوى على أي نموذج تنموي، كيفما كان طموحه وعبقرية صانعيه. كما أن الدعوة إلى دولة اجتماعية أشبه ما تكون بالصيحة في واد، لا يمكن أن تتحقق دون إطار شفاف، ديمقراطي، يعترف بالمواطن، ويمنحه فضاءً للتعبير والمشاركة الفعالة.
لذلك، لا يمكننا الحديث عن محاربة الفساد دون مراجعة عميقة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، والتي لن تتأتي إلا عبر إعادة النظر في هندسة النسق المؤسساتي، لكي يتحدث بلغة الانخراط الإيجابي بدل الإذعان، بالعرفان والاعتراف عوض الجحود والنسيان، بالتوجيه والنصيحة لا القمع والفضيحة، يصون الكرامة بدل إهدارها، يكرّس ثقافة التعاون عوض الإقصاء، ويؤمن بالمحاسبة لا بالانتقائية.
لقد آن الأوان أن نُغيّر زاوية رؤيتنا، لننتقل من مقاربة تقتصر على إدانة الأشخاص إلى مساءلة المنظومات التي تشكل حاضنة للفساد، لننتقل من الحديث عن الفساد كظاهرة مجتمعية إلى الفساد كنتاج لنمط مؤسساتي قاصر. من محاربة الأعراض إلى علاج الجذور. من هذا المنطلق، يصبح الابتكار المؤسساتي مدخلا جوهريا لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن. فالإبتكار المؤسساتي ليس ترفا فكريا ولا خيارًا إداريًا منعزلا، بل ضرورة تاريخية.
وحده الابتكار المؤسساتي، بما هو فعل تأسيسي جديد ومتجدد، قادر على إعادة بناء الثقة، وإطلاق دينامية نهضوية وتنموية شاملة، تُعيد للمواطن كرامته وطموحه وفعاليته، وتجعل من الدولة حاضنة لا حارسة، شريكًا لا خصمًا. هكذا نستطيع شق مسار ديمقراطي حقيقي، يعيد الأمل في مغرب يتسع للجميع، ويُكرّم مواطنيه، لا يُذلهم.
فلنضع الابتكار المؤسساتي في صلب نقاشنا العمومي، ولنبتكر مؤسساتنا لنُعيد كتابة عقدنا الاجتماعي، عقدًا يليق بشعب عريق… وبمستقبل يستحق أن يُصنع لا أن يُنتظر.
دمتم طيبين…
*أستاذ باحث في الاقتصاد وناشط حقوقي
المصدر: العمق المغربي