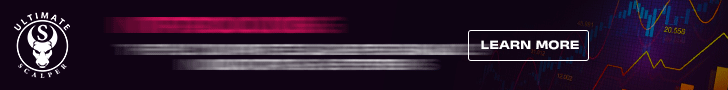أما بعد.. “الأمن الغذائي” تحدٍ يفرضه المناخ وتضمنه السيادة والعدالة

في ظل توالي سنوات الجفاف في المغرب وارتفاع مخاطر التغيرات المناخية، أصبح “الأمن الغذائي” و”الفلاحة المستدامة” يعدان من القضايا الاستراتيجية التي تزداد أهميتها وتستدعي دق ناقوس الخطر، خاصة إذا ما تم ربطها بالتحديات البيئية والديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها البلاد شأنها شأن معظم دول العالم، والتي أصبحت مؤثرة على مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها مسألة “الغذاء” التي تعد من ركائز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والصحة العامة.
لا يمكن تصنيف الغذاء بمجرد سلعة تباع وتشترى أو بضاعة تغني السوق ولا مجرد رقم في عالم الاقتصاد، فهو عنصر حيوي في بناء المجتمعات واستقرارها وعامل مؤثر في الصحة العامة وركن لا تستقيم به الحياة اليومية للمواطنين، مما يوجب أن يكون في صلب السياسات العمومية، ويفرض أن يتعامل معه وفق مقاربة شمولية ومنسقة توازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
فـ”الأمن الغذائي” الذي بات شعارا لمختلف الأحداث والتظاهرات الوطنية والدولية، لا يعني “توفير الغذاء بكميات كافية” وفقط، بل يشمل القدرة المستدامة على الإنتاج، ويشمل أيضا التوزيع العادل الذي يضمن لجميع شرائح المجتمع الحصول عليه بكرامة.
ولم يعد خافيا على أحد أن الأمن الغذائي بات أحد أكبر التحديات التي تواجه المغرب وتهدد مستقبله، رغم توفره على موارد طبيعية مهمة وتقاليد فلاحية عريقة، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف وتزايد أزمة ندرة المياه وتنامي تأثير التغيرات المناخية، وضغط النمو السكاني والتغيرات الديمغرافية في البوادي والحواضر، ناهيك عن تقلبات الأسواق العالمية واختلالات سلاسل الإمداد وكل لحق جائحة “كوفيد 19” وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث الدولية.
هذا التحدي الذي يواجه المغرب وقفت عليه تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أشارت في “التقرير الإقليمي حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024” إلى أن “التغيرات المناخية، وندرة المياه، والاعتماد على استيراد الحبوب، تشكل تحديات رئيسية للأمن الغذائي في المغرب”، ثم دقت ناقوس الخطر بشأن مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالمنطقة بما فيها المغرب، باعتباره من بين أكثر المناطق تعرضًا لتأثيرات التغير المناخي،
كما سبق لمنظمة “الفاو” في تقريرها لعام 2022، تسجيل المغرب ضمن الدول المعرضة لمخاطر الأمن الغذائي، بفعل تبعيته للاستيراد، خاصة من الحبوب الأساسية كالقمح والشعير، التي تشكل العمود الفقري للنظام الغذائي المغربي، ونظرا لهشاشة المنظومة الغذائية، خصوصاً خلال فترات الجفاف أو التوترات الجيوسياسية العالمية.
بالمقابل، لا يمكن نكران ما شهده المغرب خلال العقدين الأخيرين، من تحولات عميقة في بنيته الفلاحية، تمثلت في تبني سياسات كبرى لإصلاح القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية والبيئية، من أبرزها “مخطط المغرب الأخضر” الذي أُطلق سنة 2008، و”استراتيجية الجيل الأخضر 20202030″ التي جاءت لتكمل وتطور المكتسبات السابقة، وتفتح آفاقًا جديدة نحو فلاحة أكثر عدلاً واستدامة.
فقد كان لمخطط المغرب الأخضر دور محوري في إعادة هيكلة القطاع الفلاحي المغربي، حيث تبنى مقاربة مزدوجة تهدف من جهة إلى تطوير فلاحة عصرية موجهة للتصدير، ومن جهة أخرى إلى دعم الفلاحة التضامنية في المناطق الهشة، كما استهدف المخطط رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وتحسين ظروف عيش الفلاحين، وجلب الاستثمارات، وتعزيز سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
ولعل من أبرز إنجازات هذا المخطط مضاعفة القيمة المضافة الفلاحية بنسبة فاقت 60٪ بين 2008 و2018، الأمر الذي يعكس تحولاً في البنية الاقتصادية للقطاع، وتوفير أزيد من 340 ألف منصب شغل إضافي، وتطوير البنيات التحتية الزراعية، وتحسين تقنيات الإنتاج والري، وغيرها من المكتسبات التي جعلت المغرب فاعلا مهما في الأسواق الأوروبية ومزودا رئيسيا لها بالخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية المصنعة، دون أغفال السوق الوطنية أو تسجيل خصاص رغم ما يمكن أن يلاحظ على الأسعار خصوصا ما بعد “كوفيد”.
إن “مخطط المغرب الأخضر” والذي رصدت له ميزانية ضخمة لم يخل من إخفاقات وإكراهات، رغم إيجابياته الكثيرة، مما جعله في مرمى انتقادات بعض الباحثين والمهتمين، فرغم إيجابياته، وُجهت إليه انتقادات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بعدم تقليص الفوارق بين الفلاحة العصرية والفلاحة الصغيرة، والتركيز على الإنتاج التصديري بدل الأمن الغذائي الوطني، وتوجيه نصيب كبير من الدعم العمومي لكبار المستثمرين، فيما ظلت شريحة واسعة من صغار الفلاحين تعاني من الهشاشة وضعف التأطير وصعوبة الولوج للمعلومة.
ويبدو أن “استراتيجية الجيل الأخضر”، من حيث ما تم تقديمه على الورق، استجابت للانتقادات الموجهة لمخطط المغرب الأخضر، وحاولت تقديم حلول عملية للنواقص المسجلة فيه، وأجوبة لسؤال الانتقال نحو فلاحة أكثر استدامة وأكثر عدالة اجتماعية، وذلك عبر تركيزها على محورين رئيسيين يتعلقان بـ”بروز طبقة فلاحية وسطى” و”تحديث سلاسل القيمة الفلاحية”، حيث يروم المحور الأول تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الفلاحين الصغار والشباب، وتحفيزهم على الاستثمار في أنشطة فلاحية مدرة للدخل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومحاربة البطالة القروية. كما تسعى الاستراتيجية إلى مواكبة 400 ألف فلاح في إطار مشاريع مقاولاتية، بهدف دمجهم في النسيج الاقتصادي وتسهيل ولوجهم للأسواق والتمويل.
أما المحور الثاني، فيرتبط بإحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية والمهنية، تعتمد الرقمنة والتقنيات الذكية، من الإنتاج إلى التسويق، وهو ما يشكل قفزة نوعية في أساليب التدبير والاستغلال الفلاحي.
وتعد هذه التوجهات متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف الثاني: “القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة”، كما تنسجم مع توصيات منظمة الفاو الداعية إلى نظم غذائية مرنة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والتوازن البيئي.
وعلى الرغم من الدينامية المؤسساتية والسياسية التي تبلورت عنها هذه المخططات الطموحة، فإن الأمن الغذائي في المغرب مازال تحديا حقيقيا واستراتيجيا متعدد الأبعاد، بفعل عوامل متعددة نذكر منها:
أولا ندرة المياه: فالمغرب يصنف من بين الدول التي تعاني الإجهاد المائي المرتفع، إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه 600 متر مكعب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو المعدل الذي يعتبر أقل من عتبة الفقر المائي المحددة عالمياً، بمقابل ذلك يتم استهلاك أكثر من 85% من الموارد المائية في القطاع الفلاحي، (حسب تقرير للبنك الإفريقي للتنمية) الأمر الذي يجعل الفلاحة المغربية رهينة لمحدودية المياه وتغيرات التساقطات.
ثانياً التغيرات المناخية: إن تأثير التغيرات المناخية أصبح ظاهرا بشكل جلي خصوصا من حيث اضطراب الفصول وعدم انتظام المواسم الفلاحية الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإنتاجية، وذلك في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والأمر الذي يتطلب تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير أصناف مقاومة للجفاف من مختلف المزروعات المتضررة، واعتماد تدابير تكيف فعالة وغير مؤثرة على جودة وسلامة المنتجات الفلاحية.
ثالثاً تفتت الملكيات الفلاحية: سجل الإحصاء العام للفلاحة لعام 2016 تراجع معظم الاستغلاليات الفلاحية إلى أقل من 5 هكتارات للكل استغلالية، وسجل أن هذا يعيق استعمال المكننة والتجميع والتسويق الناجع، ويضعف من قابلية الفلاحين للاستثمار والتجديد.
رابعاً الفوارق الاجتماعية والمجالية: لعلها إحدى أكبر التحديات التي يعانيها القطاع الفلاحي في المغرب ويحد من إنتاجية الأفراد أو يدفعهم إلى الهجرة من البوادي نحو الحواضر، خصوصا في فئتي النساء والشباب الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى التمويل والخدمات الأساسية بل وفي كثير من الأحيان إلى التعليم والتطبيب ومتطلبات العيش الكريم، مما يضعف من مردودية القطاع وقدرته على الإدماج.
في ظل هذه التحديات أصبح من الضروري الانتقال إلى نماذج فلاحية مستدامة، قادرة على التأقلم مع محدودية الموارد الطبيعية، وتستجيب لضرورة الحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والحفاظ على البيئة، ولعل وصية منظمة الفاو ومنظمات أممية أخرى بتشجيع الزراعة الإيكولوجية، وتثمين المنتجات المحلية، وتحقيق التنوع الزراعي، من بين أهم مداخل هذا الانتقال الذي بدأت أولى إرهاصاته بمبادرات تسعى إلى تعميم اعتماد الطاقة الشمسية في ضخ المياه، وتطوير وحدات الإنتاج العضوي، وإنشاء تعاونيات نسائية لتثمين الأعشاب العطرية والنباتات الطبية، وتشجيع الزراعة البيولوجية في عدد من المناطق الجبلية والهامشية، وهي المبادرات التي أصبح من اللازم تثمينها ودعمها ماديا ومعنويا وتعميمها، لما تتيح من إمكانيات للتوفيق بين الإنتاج الفلاحي والاستدامة البيئية.
إن الحديث عن الأمن الغذائي لا يجب أن يغفلنا عن “السيادة الغذائية”، وقد سبق لنا في جريدة “” أن خصصنا لهذه الجدلية (الأمن الغذائي والسيادة الغذائية) عددا ورقيا خاصا بمناسبة الدورة 15 من المعرض الدولي للفلاحة، ونقصد بالسيادة الغذائية قدرة الدولة على تحديد سياساتها الغذائية دون الارتهان والتبعية للخارج، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه، وتثمين الموارد الداخلية، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وعلى رأسها الحبوب والقطاني والبقوليات واللحوم، وإلى تقليص الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثبتت هشاشة سلاسل التوريد العالمية.
ولا يمكن أن نغفل في هذا السياق أهمية الاستثمار في البحث الزراعي وتطوير البذور المحلية والحد من استخدام البذور الهجينة والمستوردة، وإعادة إحياء وتطوير بعض الممارسات الزراعية التقليدية التي من شأنها أن تشكل رافعة قوية نحو الاستقلالية، ناهيك عن دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتسهيل ولوجهم إلى التمويل والتأمين الفلاحي، وتأهيل الأسواق المحلية واللوجستيك، وربط الفلاحة بالتصنيع الغذائي، لضمان تثمين الإنتاج وخلق فرص الشغل.
إن بناء منظومة غذائية مستدامة في المغرب يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار حكامة رشيدة وسياسات دامجة، تراعي الخصوصيات المجالية والثقافية والبيئية.
وإذا كان مخطط المغرب الأخضر قد أسس لمرحلة انتقالية مهمة، فإن الجيل الأخضر هو اختبار حقيقي لقدرة المغرب على ربط الإنتاج بالعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، وبضمان غذاء صحي ومستدام لجميع المواطنين وكافة الشرائح، وقبل ذلك وبعده بتحقيق السيادة الغذائية كأفق استراتيجي طويل الأمد.
* نشرت هذه الافتتاحية في العدد الورقي الخاص من مجلة رقم 3 أبريل 2025 والذي تم توزيعه بالمجان في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
المصدر: العمق المغربي