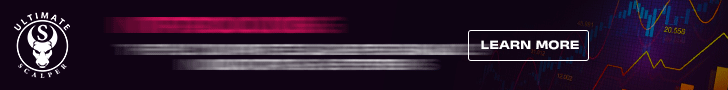آفة النزعة التمجيدية

الدكتور عبد الحميد اسماعيل الأنصاري، استاذ بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. وكم سعدت لما وجدته يقول في موقع الأيام البحرينية أن دراسة التاريخ عبر مراحل التعليم العام للناشئة، لها الأثر الكبير في صياغة عقولهم وتشكيل وجدانهم وتوجيه سلوكهم وتنمية وعيهم بتاريخ أمتهم واستخلاص الدروس والعبر منها، وبالتالي تصورهم للحاضر والمستقبل. كما أن لها الإسهام الأكبر في تشكيل نظرة شبابنا إلى الشعوب الأخرى، وفي ترسيخ التسامح وقبول الآخر في البنية المجتمعية. ودراسة التاريخ من جهة أخرى، له دور بارز في تقوية الانتماء الوطني للطلاب تجاه مجتمعهم ودولتهم ونظامها السياسي. ومن هنا كانت أهمية بناء مناهج تاريخية تقوم على رؤى مـــــتـــــوازنـــــة وموضوعية للأحداث والشخصيات التاريخية، بإبراز الجوانب الإيجابية والسلبية معًا للأعمال والإنجازات، بهدف تكوين عقلية نقدية لدى الطالب وإكسابه مهارة الفكر النقدي الحر منذ المرحلة الإعدادية المبكرة، هذه المهارة النقدية هي التحصين المعرفي ضد أمراض التطرف والغلو والكراهية والاستعلاء والغرور الكاذب. فماذا عن تداعيات تلك النزعة التمجيدية في تدريس تاريخ الأمة؟
من تداعيات الآفة
تعجبت بل استنكفت من الحديث عن “الموالاة في الشريعة الإسلامية”، في بحث أكاديمي عن الحياة الاجتماعية في عهد العباسيين، تم إنجازه سنة 2018م بجامعة من جامعات إحدى الدول العربية. وكأن للموالاة موجب شرعي في الإسلام. ولتحديد المقصود بالموالاة جاء الباحث بقول ابن خلدون في المقدمة : “كأن يقول رجل لرجل آخر ليس لي عشيرة ولا ناصر، وإني انضم إلى عشيرتك وتنصرني وتدفع عن نوائبي، وإن مت كان ميراثي لك، فيعقد بينهما عقد المولاة”.
معنى ذلك أن الأمن على حرمة كل من النفس والدين والعرض والمال الذي هو لب مقاصد الشريعة، كان ينبغي، بموجب شرعي في المجتمع المسلم، أن يشتريه الرجل الذي ليست له عشير تنصره وتدفع عن نوائبه، بعقد من أحد رجال عشيرة قوية، في مقابل أن يرثه من بعد مماته. وذلك لما كانت الدولة تنهكه وتنهب رزقه بالضرائب من دون أي عطاء. في حين، وكما ينبغي وفق مقاصد الشريعة، الأمن على حُرمات أي إنسان بالمطلق، موكول اليوم إلى مؤسسات عمومية أمنية وقضائية وعلى نفقة المال العام. فكل إنسان مهما كان، ثبت الاعتداء على حياته أو جسده أو عرضه أو ماله، تتحرك فورا وبتلقائية الضابطة القضائية من شرطة أو درك، وتحت إشراف النيابة العامة، للبحث في النازلة وتحديد المشبه به أو المشتبع بهم، وعرضهم على القضاء للتحقيق ثم المحاكنة وفق مقتضيات القانون. وهذه العدالة اليوم لا تفرّق بين مواطن وغريب ولا بين شريف ووضيع ولا بين فقير ولا غني.
فكيف تكون من الشريعة الإسلامية مؤسسة الموالاة العتيقة التي سادت في المجتمع المسلم وفق ما شرح مغزاها ابن خلدون أعلاه ؟ وكيف يصدر ذلك الحكم المعتدي على الشريعة الإسلامية عن باحث أكاديمي مسلم بدولة مسلمة وفي الألفية الثالثة وتحت إشراف أساتذة جامعيين ؟ كيف يصح من هؤلاء الأكاديميين بأن يظلوا يعتقدون هم كذلك مثل العوام أن كل تقاليد وسنن الأولين هي من صميم الدين ؟ ثم نتعجب لما يجد فيها المتطرفون ما يزكون به الأوهام التي تجعلهم يعتقدون أن الماضي كان كله أمجاد بفضل التمسك بالدين وأن الحاضر كله بؤس ومآسي بسبب التفريط في الدين ؟ كيف يصح ذلك بالمقارنة مع ما أوردناه أعلاه بخصوص الأمن على الحرمات اليوم ووفق مقاصد الشريعة، وهو أفضل وبكثير من تقاليد مؤسسة الموالاة البائدة التي سادت في الماضي؟
ومن ذلك تقاليد العبودية التي كانت من سنن الأولين وتمت كذلك نسبتها لصحيح الدين. لما اكتشفت في شهادة الصحافي الإنجليزي والتر هاريس في كتابه Morocco that was أن أسواق النخاسة ببعض مدن المغرب ظلت تقوم جهارا حتى بداية القرن العشرين، وجدت صعوبة في تصديقه. ولما قمت بترجمتها ونشرتها على صفحتي على الفيسبوك أدركت أن المفاجأة كانت عامة. اتهمه البعض بالتلفيق والافتراء والبعض الآخر بالمبالغة. وعندما اكتشفت شهادة مؤرخنا الناصري رحمه الله في كتابه القيّم الاستقصا، أدركت أن الجهل بحقيقة تاريخ بلادنا بشكل متوازن هو الذي ينبغي اتهامه، أو بالأحرى النزعة التمجيدية في تدريسه. فدعونا نكتشف شهادة مؤرخنا ومشاعره في هذا الصدد.
من بعد ما ذكّر بأن مالي وغانا كانتا بلدين مسلمين مفتوحين للتجار المغاربة، أغضبه كون هؤلاء تعوّدوا على شراء خادمات للتسرّي بهن طيلة مقامهم هناك. والذي كان يحكي له ذلك من دون حرج بل مستحسنا له، صار يتلذذ بوصفهن كمن يشهّي السامع فيهن، وهو يقول : “إن الله قد جعل فِيهِنَّ من الْخِصَال الْكَرِيمَة فِي خَلقهنَّ فَوق المُرَاد من ملاسة الْأَبدَان وتفتق السوَاد وَحسن الْعَينَيْنِ واعتدال الأنوف وَبَيَاض الْأَسْنَان وَطيب الروائح….”
فغضب مؤرخنا مما سمع وكتب يقول: “وقد تمالأ النَّاس على ذَلِك وتوالت عَلَيْهِ أجيالهم حَتَّى صَار كثير من الْعَامَّة يفهمون أَن مُوجب الاسترقاق شرعا هُوَ اسوِداد اللَّوْن، وَكَونه مجلوبا من تِلْكَ النَّاحِيَة. وَهَذَا لعمر الله من أفحش المناكر وَأَعْظَمهَا فِي الدّين. إِذْ أهل السودَان قوم مُسلمُونَ، فَلهم مَا لنا وَعَلَيْهِم مَا علينا”.
فنلاحظ أن الناصري رحمه الله، الذي كان ابن زمانه ومثل جميع الفقهاء المسلمين حتى عصره، كان يعتقد أيضًا أن للاسترقاق موجب شرعي. وبالطبع كان هناك أيضًا فقه خاص بالرق. فقه اختفى كما ينبغي له، لأنه مع إلغاء العبودية واختفائها، لم يعد لوجوده من مبرر. المسوغ الوحيد لوجوده كان مجرد الحاجة لتدبير تقليد شنيع موروث ومتجذر في النفوس منذ القدم، تعذر القضاء عليه مع مجيء الإسلام. فاختفى ذلك الفقه كأنه لم يكن موجودًا لأنه ليس له أي موجب شرعي كما كان يُعتقد حتى عهد الناصري. وإلّا كُنا وجدناه على الأقل وبالتأكيد يُدرس بالجامعية في شعبة الدراسات الإسلامية.
ومسألة العبودية في القرآن وفي تعاليم النبي الكريم خصت مجرد ما تبقى منها حتى عهده. تعلق الأمر بما تبقى من العبيد والإماء في ذلك الوقت. وما كان من مسوغ لاسترقاق المزيد منهم. وذلك وفق ما يُقال وكما ينبغي، أن الإسلام قد سدّ باب الرق وفتح باب العتق. فالإسلام جاء لتحرير البشر من عبادة العباد لعبادة رب العباد كما قيل لملك الفرس. فكيف يصح أن يسترق المسلمون بشرا أيا كان؟
فكان يجب تحرير من بين ما تبقى من العبيد عند المسلمين كل من أنس من نفسه القدرة على تحمل مسؤولية العيش كإنسان حر، وإلا وجدته من بعد تحريره يبحثَ عمّن يسترقه من جديد، كما حصل مع العديد من العبيد الذين تم تحريرهم في الولايات المتحدة إبّان ما سمي بحرب الانفصال guerre de sécession ما بين 1861 و1865. وأورد والتر هاريس السالف الذكر في شهادته مثالا على ذلك بالمغرب. وهذا هو تفسير عدم ورود الأمر بتحريرهم دفعة واحدة في القرآن الكريم. فتم تحرير الراشدين نفسيا من بينهم إما منّا أو بالمكاتبة. وتم الاحتفاظ بغيرهم مع واجب رعايتهم كأفراد من الأسرة إلى حين يتمكنون من إعالة أنفسهم بأنفسهم أو حتى وفاتهم.
وكما تقدم، ما كان من مسوغ لاسترقاق غيرهم. فلا توجد، وكما ينبغي، جنحة أو جناية يعاقب عليها الشرع بالاسترقاق. حكم أسير الحرب في القرآن الكريم هو تسريحه إما منّا أو بدفع فدية، ولا يسترق بأي حال من الأحوال. وبما أن هذا هو حكم الأسير المقاتل، فبأي حق يُسترق الأبرياء من النساء والأطفال والرجال غير المقاتلين وتستباح حرماتهم التي جاء الإسلام لحمايتها ؟ لا حق في ذلك على الإطلاق. فلولا فتح باب الرق من جديد ومن دون موجب شرعي، لكانت العبودية قد انتهت واختفت من تلقاء نفسها في المجتمع المسلم عند وفاة آخر عبد وآخر أمة ممن تبقى منهم حتى عهد الرسول الكريم. ولكن وللأسف الشديد غلبت العادة الشنيعة وسيطرت وهيمنت على قيم وتعاليم ومقاصد الشريعة النبيلة.
ومن تعود المسلمين حتى يومنا هذا على تنزيه السلف عن الخطأ وكأنهم ملائكة وليسوا بشرا، تجدهم يجتهدون في إيجاد الأعذار لإبقائهم على ممارسة الاسترقاق والاستئناس به والاستمتاع بمحرماته. وهي أعذار واهية، لأنه إذا كان العدو يقوم مثلا باسترقاق الأسرى المسلمين أو يعذبهم أو يمثل بأجسادهم أو يحرقهم أو يدفنهم أحياء، فما كان يجوز للمسلمين فعل الشيء نفسه بأسراه. المسلم هو القدوة والنموذج المتّبَع بالنسبة لغيره، وليس العكس.
وكما سنرى في بقية شهادة الناصري، فإن العبودية التي سادت في مجتمع المسلمين طيلة تاريخهم ما كانت لها على الإطلاق أية علاقة بأسرى الحرب. بل المترفون من كل أطياف خاصتهم وليس عامتهم، هم الذين ظلوا يجدّون ويجتهدون في شراء العبيد من أسواق النخاسة أو من داخل دور النخاسين كما جاء في شهادة والتر هاريس، كشرائهم السلع وبهائم الأنعام. بل كان النخاسون يجلبون لهم ما يشتهون من أصناف الرقيق من جميع أنحاء العالم. وكان لابد من إخصاء الذكور من بينهم المطلوبين للخدمة في الحريم، إما من مصدر البضاعة أو عند وصولها.
وبقية حديث الناصري مؤرخنا الجليل، عن العبودية مبني بالكامل على هذا التقليد البشع الذي أريد أن يكون له موجب شرعي لتبريره. لذلك ليس من المفيد التوسع فيه هنا، حتى لا نحيد عن موضوع هذا المقال. إلا أن هذا التقليد المؤسف وبحسب شهادة الناصري نفسه، قد تسبب كعادته في مآسي الاعتداء على حرمات البشر مثل التي حصلت في عهد الجاهلية. فماذا قال عن مآسيها في المغرب حتى نهاية القرن التاسع عشر ؟
قال في نفس الكتاب: “وَقد استفاض عَن أهل الْعدْل وَغَيرهم أَن أهل السودَان (مالي) الْيَوْم وَقبل الْيَوْم يُغير بَعضهم على بعض ويختطف بَعضهم أَبنَاء بعض ويسرقونهم من الْأَمَاكِن النائية عَن مداشرهم وعمرانهم”. ثم قال: “وَإِن فعلهم ذَلِك كَفعل أَعْرَاب الْمغرب فِي إغارة بَعضهم على بعض واختطاف دوابهم ومواشيهم أَو سرقتها”. وأضاف قائلا: “بل صَار الفسقة الْيَوْم وَأهل الجراءة على الله يختطفون أَوْلَاد الْأَحْرَار من قبائل الْمغرب وقُراه وأمصاره ويبيعونهم فِي الْأَسْوَاق جهارا من غير نَكِير وَلَا امتعاض للدّين. وَصَارَ النَّصَارَى وَالْيَهُود يشترونهم ويسترقونهم بمرأى منا ومسمع”. وهذا حتى نهاية القرن التاسع عشر. وختم استنكاره قائلا “وَإِنَّمَا الْحَامِل لَهُم على ذَلِك قلَّة الدّيانَة وَعدم الْوَازِع. فَكيف يسوغ للمحتاط لدينِهِ أَن يقدم على شِرَاء مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل ؟ وَكَيف يجوز لَهُ التَّسَرِّي بإناثهم وَفِي ذَلِك مَا فِيهِ من الْإِقْدَام على فرج مَشْكُوك ؟”.
الدروس والعبر
القول بأن هذا من الماضي، كم أريد أن أصدق ذلك. إلا أنه سرعان ما تشعر بخيبة الأمل لما تقرأ هنا وهناك أخبارًا عن اختطاف النساء والفتيات اليزيديات، على سبيل المثال ، بكردستان في شمال العراق. والذين يسترقونهم للتسرّي بهن وللعبث بأعراضهن وباسم الإسلام، والإسلام براء من أفعالهم الشنيعة مثل براءة الذئب من دم يوسف، لم يُبعثوا من القبور ولا سقطوا من السماء مع المطر. إنهم جاؤوا إلى هنالك، ليس فقط من عالمنا المسلم وتعلموا في مدارسه ومن بينهم حتى من درس بجامعاته، ولكن أيضًا من أوروبا. ووُجد من بينهم حتى بعض الأوروبيين الذين أسلموا حديثًا. وما عُرف حتى عصر الناصري بالعبودية بموجب شرعي، تواجد في أذهانهم كما كان من قبل. وببلادنا لا زلنا مع الأسف الشديد نسمع بين الفينة والأخرى أخبار تواجد من بايعوا تلك المنظمة بالعراق والشام لما يتم القبض عليهم. وسرعان ما أتصور أن العبودية بموجب شرعي معششة في أذهانهم.
لو أنهم تلقوا جميعًا وكما ينبغي دروسًا في التاريخ حول مأساة العبودية عبر العصور وفي جميع أنحاء العالم، لكانوا قد رفضوا من تلقاء أنفسهم فكرة العبودية بموجب شرعي، ولبرأوا، كما ينبغي، الإسلام منها وبقوة. ولما انجذبوا أصلا لأي تطرف على الإطلاق. لكن مع الأسف الشديد لا تزال تلك هي الحقائق الصادمة من واقع اليوم. فماذا عن الدروس والعبر؟
يبقى العلاج الشافي لكبح آفة التطرف، في نظري، في تدريس التاريخ مكتملا ومتوازنا كما هو بحلوه ومره. التاريخ الذي من شأنه أن يزيل عن الماضي تلك النزعة التمجيدية التي لا تزال تخفي عن أجيال المسلمين الصاعدة ما كان فيه من مثالب بالنسبة للرعية وحتى للحكام. وليس تاريخ السلالات الحاكمة المبثور. لماذا وصفته بالمبثور؟ فمعركة وادي المخازن، على سبيل المثال، والتي دائمًا ما يُعلي من كبرياء المغربي والمسلم، متى وأينما ذُكرت لا يتم الحديث بما يكفي عن سببها الأصلي. ذلك السبب الذي كان من أشد مثالب ماضي الأمة المسلمة، ألا وهو آفة ودوامة الصراع على الحكم.
فقد كان ذلك الصراع قُبيل معركة وادي المخازن بين السلطان عبد الملك من جهة وابن أخيه محمد بن عبد الله الغالب من جهة ثانية. خلعه عمه بدعم من الأتراك وأخذ مكانه. فذهب المخلوع للبحث بدوره عن دعم ملك إسبانيا. الملك الذي فضل الاحتفظ به لابتزاز عبد الملك. ولما فطن لذلك لجأ إلى طلب دعم سباستيان ملك البرتغال. وذلك في مقابل الوعود بالتخلي له من جديد عن بعض الموانئ. هذا من بعد أن طرد جده محمد الشيخ وعمه أحمد الأعرج البرتغاليين من عدد كبير من الشواطئ المغربية.
لذا بدلا من التوقف عند الانتصار في معركة وادي المخازن، الذي ينبغي أن يكون موضوع مادة التاريخ المتوازن هو أيضا تدريس تاريخ آفة الصراع على السلطة مثلا، والتي أثتت كل ماضي المسلمين. لأنها الآفة التي ظلت تتسبب في مآسي كل من الحكام والرعية وأعاقت تقدمهم من بعد ما أوقفته، فتخلفوا وتقدم غيرهم. ولو أنه تم توسيع تدريس مادة التاريخ إلى ماضي باقي الأمم لأدرك المسلمون أن أوروبا ما عرفت تلك الآفة. ظل المُلك فيها بيد بضع الأسر من دون صراع عليهما لا من داخلها ولا من خارجها. فلماذا ؟ وماذا ترتب عن ذلك الاستقرار السياسي ؟ هذا هو ما كان ينبغي البحث فيه وتدريسه.
وماذا عسى الطالب المسلم بالإعدادي والثانوي أن يستفيده من مثل هذا الموضوع مكتملا في مادة التاريخ المتوازن؟ أولا لن يُشمت في ماضي أسلافه الذي كان مثل ماضي باقي البشر. وبمعيار أمن العباد على حرماتهم الذي يشكل مقاصد الشريعة، يدرك أن نظام الحكم البائد كان دون مبتغى الإسلام. فلا يحن إليه ولا يفكر في إعادة إنتاجه من جديد مع ما في ذلك من تهديد لأمن البلاد والعباد. وإذا كان حال الحكم في زمانه لا يزال على نفس الحال القديم، تجده يفكر في أفضل منه حيث ما وُجد في العالم، وليس أبدا في الرجوع إلى مثله في الماضي الذي صار يعرفه جيدا. أما إذا وجده أحسن من دي قبل فيسعى للمساهمة في الحفاظ عليه وفي تطويره، وليس أبدا في هدمه وتخريبه مهما ساءت أحواله فيه. فهذا مثال على نوعية مواضيع مواد مادة التاريخ المتوازن التي من شأن تدريسها أن ييسر تثقيف وتربية الشباب السلم التربية الموسوعية المطلوبة لتحصينه ضد أي انحراف وأي تطرف.
وعلى هذا المنوال وبدلا من تاريخ السلالات التي تعاقبت على الحكم، ينبغي أن يهتم تدريس التاريخ المتوازن بتاريخ العدالة في عالم المسلمين وعالم غيرهم للمقارنة، وتاريخ الجباية وتاريخ التشريع وتاريخ الحرية. الحرية التي كانت مطلب شباب ما سمى بالربيع العربي. الحرية التي ظهر الشباب المسلم وكأنه يكتشفها لأول مرة، بسبب غياب تدريس تاريخها. فظلت تختلط في الذهن بالحرية الإباحية كما حصل مع مؤرخنا الجليل الناصري في كتاب الاستقصا. في حين قد تم تكرار الكلمة بمعناها السياسي مئات المرات، ومنذ القرن الأول للميلاد، في كتاب “تاريخ روما منذ تأسيسها”، للمؤرخ الروماني تيتوس ليف المتوفى سنة 19م.
تلك الحرية التي لو كان ماضيها من مواضيع مادة التاريخ المتوازن لعلم الشباب المسلم أنها بدأت قصتها في روما منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وبدأت قصتها منذ 697م بجمهورية البندقية التي دامت فيها إحدى عشر قرنا، ومنذ عام 1215م في إنجلترا مع دخول الميثاق العظيم Magna Carta حيز التنفيذ ومع إنشاء مجلس اللوردات ثم مجلس العموم في نفس القرن، ومنذ عام 1620م في قرية بليموث بأمريكا الشمالية لما هاجر إليها اللاجؤون البروتستانت على متن سفينة ماي فلاورس هاربين من الادطهاد بإنجلترا. وهم المعروفون بالآباء الحجاج. لو تم هكذا تدريس تاريخها في مدارسنا لما كان شبابنا من بين آخر من يدرك معناها السياسي بالعالم. ولبحثَ عما إذا كانت لها أيضا قصة في تاريخ أسلافهم.
وعلاوة على تدريس تاريخ الحرية، ينبغي تدريس تاريخ نشأة وتطور الخدمات العمومية بالغرب والشرق، وتاريخ الصحة والطب وتاريخ العلوم والتعليم والزراعة والتجارة والصناعة ولما لا تاريخ نشأة البنوك وأسواق الأوراق المالية وتطورها ؟ وتاريخ البحرية بجميع أنواعها وتطورها الخ… أي تاريخ كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بالحياة اليومية للناس ليس فقط ببلاد المسلمين بل حتى ببلاد من حولهم. ويجب تدريس كل من تلك المواضيع بطريقة شاملة، كتاريخ العدالة مثلا، في العالم المسلم مع المقارنة بتاريخها بباقي العالم ومقارنتها أخيرا وبصفة خاصة بالعدالة اليوم. ثقافة موسوعية نـــعــــم، وبقدر الإمكان، لما لا ؟ وذلك حتى تنشأ عند المتلقي الرغبة في إغنائها طيلة حياته، فلا يجده المتطرفون خاوي الوفاض ولا يصطادونه ولا يُغررون به.
منهج تعليمي أساسه الــــتـــربـــيـــة قبل كل شيء، بتوسيع المعرفة. يتم إعداد برامجه وتطويرها من قبل الأكاديميين في شعب التاريخ والجغرافيا بمختلف كلياتنا. ويتم تكييفه مع كل مستوى من مستويات التعليم الإعدادي والثانوي. وبالنظر لطبيعته الـــــتــــربـــويــــة يُكلف بتدريسه أساتذة التربية الإسلامية، حتى لا يأتي من يغرّر بالشباب باسم الإسلام. هم الأساتذة الأقدر على الحكم على الأمور بمعيار مقاصد الشريعة السمحة. مع العلم أن الجميع، أساتذة وطلبة، سيظلون دوما بحاجة إلى إثراء معارفهم، من أجل إزالة تلك النزعة التمجيدية عن الماضي وكشفه على حقيقته ومقارنته المقارنة الصحيحة بالحاضر. الحاضر الذي ينبغي تقييمه بميزان القيم والمقاصد النبيلة للإسلام والكامنة في الحفاظ على أمن حرمات البلاد والعباد. فهذا في نظري هو اللقاح الثقافي والتربوي الفعّال ضد آفة التطرف والتشدد. أليست الوقاية خير من العلاج؟
المصدر: هسبريس