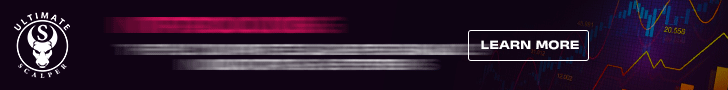مـــن هـــم الـــفـــلـــســـطـــيــــنـــيـــون ؟ أمد للإعلام

أمد/ قبل الحرب العالمية الأولى، شملت المناطق التي ستضمها فلسطين تحت الانتداب البريطاني متصرفية القدس التي استقلت عن ولاية سورية سنة 1874، ومركزها القدس، بالإضافة إلى أقضية يافا وغزة والخليل ثم بئر السبع، وسنجق عكا الذي كان جزءاً من ولاية بيروت في ذلك الوقت، ويشمل أقضية حيفا وصفد والناصرة وطبرية، وأخيراً سنجق البلقاء الذي كان أيضاً جزءاً من ولاية بيروت ومركزها نابلس، فضلاً عن أقضية جنين وبني صعب وجماعين.
هوية متعددة الأبعاد
كانت هوية السكان العرب في هذه المناطق متعددة الأبعاد؛ فجمعت بين الولاء المركزي للأمة العثمانية من جهة، والولاء الثانوي، كالانتماء إلى الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية من جهة أُخرى. ولم تنضج فكرة انفصال العرب عن الدولة العثمانية إلاّ بعد الحرب العالمية الأولى واندلاع الثورة العربية ضد الأتراك في حزيران/يونيو 1916 على يد الحسين شريف مكة، على أساس الوعود التي قدمتها إليه بريطانيا.
وتم التعبير عن الولاء المركزي للأمة العثمانية عبر التعايش المتسامح بين المسلمين واليهود والمسيحيين في متصرفية القدس، وخصوصاً بعد إعلان الدستور العثماني في تموز/يوليو 1908.
وضمّ المجلس العمومي للمتصرفية، الذي كان بمثابة الهيئة التشريعية، ممثلين عن المسلمين والمسيحيين واليهود، وكان بين هؤلاء، في خريف 1911، حاييم أفندي إليشار، من سكان القدس، وهارون أفندي ماني، من سكان الخليل. وعندما صدر قانون تجنيد غير المسلمين، تطوع الشباب اليهود للخدمة في الجيش العثماني. وعندما استعدت متصرفية القدس، في خريف 1908، لانتخاب ثلاثة نواب يمثلونها في البرلمان العثماني، كان من المرشحين العشرة إسحق ليفي، مفتش الزراعة السابق في ولايتَي سورية وبيروت، الذي أكد في برنامجه الانتخابي أنه سيبذل المستطاع، وسيعمل بكل قواه “سعياً وراء الفائدة الحقيقية نحو الوطن بنوع عام، ونحو البلاد الفلسطينية بنوع خاص.”
وخلال الاحتفالات التي نظمتها جمعية الاتحاد والترقي في القدس لإحياء الذكرى الأولى للدستور، ألقى يعقوب لافي كلمة باسم دار المعلمين الإسرائيليين في القدس، قال فيها: “قد تفضلتم بدعوتكم إيانا للاشتراك في هذا الموكب الوطني البهيج، في يوم دستورنا العزيز، فها قد لبينا دعوتكم… كيف لا وبهذا الموكب قد نرى، ونرى فعلاً إحياء معنى الاتحاد والإخاء بين أبناء الجيل الناشئ على اختلاف الأديان والمذاهب؟” بيد أن اتساع نفوذ الصهيونية ووعد بلفور والاحتلال البريطاني لفلسطين أدّى إلى تقويض هذا التعايش الذي كان سائداً في السابق.
وخلافاً للأسطورة الصهيونية المؤسِّسة لدولة إسرائيل، والتي تزعم أن أهالي فلسطين لم تكن لديهم مميزات وطنية وثقافية خاصة بهم، وأنهم كانوا أقرب إلى البدو الرُّحل، ولا تربطهم علاقة وثيقة بالأرض التي يعيشون عليها، وبالتالي يسهل عليهم تركها أو طردهم منها، فإن إنتاجهم الأدبي والفني في ذلك الوقت هو خير دليل على ارتباطهم القوي بتلك الأرض، وقد تجلى هذا الارتباط في إسباغ الهوية الفلسطينية أو “فلسطنة” هذه النتاجات في الإطار العربي، وعبر إنشاء المدارس الوطنية الحديثة، ولا سيما مدرسة روضة المعارف والمدرسة الوطنية الدستورية في القدس، وكذلك عبر نشاطات بعض الأندية الأدبية والجمعيات العلمية والمهنية والخيرية.
وعلى سبيل المثال، فقد كان الفن المسرحي من أكثر الفنون رسوخاً في مدينة القدس، وذلك بفضل الدور الذي اضطلعت به عدة مدارس وجمعيات شكلت فرق التمثيل الخاصة بها، وعرضت العديد من المسرحيات الكلاسيكية والتاريخية والوطنية، وهذه العروض المسرحية التي شارك فيها ممثلون وأحياناً عدد قليل من الممثلات، نُظمت في المدارس، كمدرسة روضة المعارف، أو في النوادي والمنتديات، كالمنتدى الأدبي، أو على خشبة بعض المسارح، كمسرح تياترو أوليمبيا، أو في المقاهي.
ويبدو أن هذه العروض المسرحية تابعها عدد لا يُستهان به من الأشخاص الذين قدَّروا هذا الفن، واعترف بعض الكتاب بدوره بالرقي الاجتماعي، ودعوا إلى تهيئة الأوضاع اللازمة للارتقاء به، فعلى سبيل المثال؛ قدمت “فرقة ناشئة الحب الوطني” مسرحية “هاملت” لوليم شكسبير في مسرح أولمبيا في أمسيات السبت والأحد في 25 و26 تموز/يوليو، و7 و8 آب/أغسطس 1909، وخُصص ريع هذه العروض لمساعدة مؤسسة خيرية، وامتلأ المسرح إلى آخره خلال العرضين في مسرح أولمبيا، وفق ما كتبت جريدة “القدس”، وهي أول صحيفة عربية تصدُر في القدس سنة 1908 (ماهر الشريف، “جريدة القدس وبواكير الحداثة في لواء أو متصرفية القدس (19081914)”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2024).
ولادة الحركة الوطنية الفلسطينية
شارك السكان العرب في هذه المناطق في نشاطات الجمعيات القومية العربية التي بدأت تتشكل في مطلع القرن العشرين في الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني، إلاّ إن الوعي القومي العربي في فلسطين اتخذ طابعاً خاصاً بسبب تزايُد الإحساس بمخاطر الهجرة والاستعمار اليهوديين، وخصوصاً بعد وصول الموجة الثانية من الهجرة اليهودية، في إثر تصاعُد المشاعر المعادية للسامية في روسيا.
لم يتحرك العرب عموماً للتصدي للموجة الأولى من الهجرة اليهودية في الفترة 18811891، وتفاقم الصراع بين اليهود والعرب عَقِب الموجة الثانية من الهجرة اليهودية في الفترة 19041914، والتي كان من نتائجها المباشرة طرد الفلاحين العرب والعمال العاملين في المستعمرات اليهودية ومقاطعة المنتوجات العربية، وقد تركت تلك الموجة بصمة عميقة في المجتمع اليهودي الناشئ.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع الإسرائيلي غيرشون شافير هذا الاستنتاج في كتابه “الأرض والعمل وأصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 18821914″، إذ يقول إن الحركة الصهيونية قدّمت نفسها منذ البداية بصفتها نسخة أُخرى أو شكلاً آخر من الحركة الاستعمارية الأوروبية، ويتابع بأن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية، عبر الشعارات التي تبنتها، كـ “احتلال الأرض” و”احتلال العمل” من أجل احتكار اليهود لفرص العمل، أوجدت سيطرة استعمارية استيطانية سمحت، مع ما تبعها من الطرد القسري للسكان الأصليين أو القضاء عليهم، باكتساب المستعمرين اليهود شعوراً بالتجانس الثقافي والإثني. وهو يرى أن الأوضاع الفريدة للصراع على الأرض وسوق العمل بين المستعمرين اليهود والسكان العرب الفلسطينيين هي التي ساهمت في تشكيل السمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الإسرائيلي (“الأرض والعمل وأصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 18821914″، مطبعة جامعة كامبريدج، 1989).
وبمجرد أن اتضحت هذه الرغبة الصهيونية في الهيمنة، وجدت المعارضة العربية إطاراً جاهزاً للالتفاف حوله، وهو إطار القومية العربية الناشئة، وأدت الصحافة العربية التي وُلدت عقب الثورة التركية سنة 1908، كـ “الكرمل” لنجيب نصار، أو “فلسطين” لعيسى العيسى، دوراً مهماً في التوعية بالخطر الصهيوني. وفي الوقت نفسه، حاولت المعارضة العربية أن تتبلور وتكتسب بنية واضحة عبر تنظيم صفوفها. وفي منتصف سنة 1911، أُنشئ حزب مناهض للصهيونية في يافا، وهو الحزب الوطني، وذلك بهدف محاربة البرنامج الصهيوني في فلسطين، وأوصى هذا الحزب بالعمل عبر وسيلتين: مقاطعة المؤسسات والمستعمرات الصهيونية، وحظر بيع المستعمرين اليهود الأراضي.
ثم غذت طبيعة المشروع الصهيوني الرفض الفلسطيني الذي اتخذ جوانب متعددة، وكانت سبباً في تعزيزه. وعلى الرغم من أن المشاعر القومية العربية في المناطق التي ستشكل فلسطين الانتداب بدأت تتخذ بعد ذلك طابعاً وطنياً فلسطينياً واضحاً، فإن الحركة العربية في فلسطين، التي اتخذت شكل الجمعيات الإسلامية المسيحية، ظلت مرتبطة بالحركة القومية العربية ومركزها دمشق، واستمرت في رؤية فلسطين كجزء من سورية العربية.
لكن كان هناك عاملان خارجيان فتحا الطريق أمام بلورة حركة وطنية فلسطينية مستقلة: من ناحية، مؤتمر سان ريمو في نيسان/أبريل 1920 الذي فرض نظام الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان والانتداب البريطاني على فلسطين والعراق، ومن ناحية ثانية، دخول القوات الفرنسية دمشق، والتي أطاحت بالملك فيصل من السلطة في 25 تموز/يوليو 1920.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1920، عُقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا، ورفع مندوبوه مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني طلبوا فيها من بريطانيا “تشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام برلمان ينتخَب أعضاؤه من الشعب المتكلم باللغة العربية القاطن في فلسطين حتى أوائل الحرب.”
ومع ولادة هذه الحركة الوطنية الفلسطينية التي رفضت وعد بلفور طوال فترة الانتداب البريطاني، سينشأ صراع يمتد لقرن من الزمن “بين حركتين قوميتين”، كما أشار النائب الإسرائيلي السابق أوري أفنيري: الأولى تهدف إلى إقامة دولة لليهود، خالية من غير اليهود، أو في أسوأ الأحوال، تضم أقل عدد ممكن من غير اليهود، والثانية تعبّر عن نضال الشعب العربي من أجل الحرّية والاستقلال الوطني. وبالتالي، فقد عارضت الثانية بشدة استعمار مجموعة سكانية أُخرى هذه الأرض التي رأت فيها وطنها الذي لا يمكن التفريط فيه.
ويتابع أفنيري أننا إذا لم ننطلق من هذين الاستنتاجين، فإننا لن نتمكن من فهم الأحداث التي أدت إلى ظهور مشكلات شائكة، ولا سيما مشكلة اللاجئين (أوري أفنيري، “حق العودة”، “مجلة الدراسات الفلسطينية”، النسخة الفرنسية، العدد 27 (79)، ربيع 2001، ص2732).
التراث الثقافي يحفظ الهوية الوطنية
عندما كان الشعب الفلسطيني يعيش في أرضه ووطنه التاريخي، كان إنتاجه الأدبي والفني متجذراً في عمق ماضيه وتقاليده.
وقبل سنة 1948، حظي الشِعر الفلسطيني بمكانة متميزة بين الأنواع الأدبية، وتميز شعر إبراهيم طوقان بالوطنية الثورية، حين تغنى بالأرض وهاجم من باعوها وحيا الثوار والشهداء. كما ازدهر الأدب الشعبي الذي عبّر عن طريقه الفلاحون الذين يشكلون أغلبية بين السكان عن تقديرهم للحكايات والملاحم والأمثال.
وفي سنة 1948، انقلبت حياة الفلسطينيين رأساً على عقب؛ إذ اقتُلعوا من أرضهم، وشُرد أغلب أبنائهم، وهًجّروا إلى الدول العربية المجاورة، وعانت الأقلية التي بقيت على أراضيها جرّاء نير الاضطهاد والتمييز القومي.
لكن نكبة 1948، على الرغم من جسامة أهوالها، فإنها لم تؤدِ إلى محو التراث الثقافي الفلسطيني، ولم توقف الفلسطينيين، في وطنهم وفي الشتات، عن العمل على إثراء هذا التراث وتنويع تعبيراته، وهو ما ساعدهم في المحافظة على هويتهم الوطنية، على نحو صارت معه ثقافتهم حاضنة لهويتهم.
وبفضل هذا التراث، تمكن الشعب الفلسطيني، على الرغم من فقدانه شخصيته السياسية المستقلة، من حماية هويته الثقافية، ومع ذلك، فإن الاضطرابات التي شهدها غيرت تماماً طُرُقه في التعبير عنها. ومنذ ذلك الحين، صار هناك تمييز بين أدب ما قبل 1948، وأدب ما بعد 1948، وبين أدب الداخل وأدب الشتات.
صار أدب الشتات الذي تطارده معاناة النزوح، أدب الحنين والانتظار، الحنين إلى الوطن المفقود وانتظار العودة إلى هذا الوطن. وهذا ما عبّرت عنه سميرة عزام، رائدة القصة القصيرة الفلسطينية التي تناولت في بعض قصصها التي نُشرت في الخمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي في بيروت معاناة اللاجئ الفلسطيني، وصوَّرت بؤس الحياة في الشتات، كما عبّر عنه هارون هاشم رشيد في أولى قصائده.
وبدأت الكتابة الروائية تعبّر عن نفسها في الشتات مع صدور رواية “صراخ في ليل طويل” للكاتب جبرا إبراهيم جبرا، الذي لجأ من مسقط رأسه بيت لحم إلى بغداد، ومع صدور رواية غسان كنفاني “رجال في الشمس” في بداية الستينيات.
وخلافاً لأدب الشتات هذا، فقد هيمن موضوع المقاومة على أدب الداخل، ولم يكن أمام الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم من خيار سوى المقاومة أو الرحيل، فاختاروا المقاومة. وفي هذا الصدد، صارت قصائد محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد أناشيد تبنّاها العرب الفلسطينيون في نضالهم ضد التمييز القومي. أمّا القصة القصيرة، فقد شهدت تجدد الاهتمام بها في الخمسينيات، بعد أن نشر إميل حبيبي وحنا إبراهيم قصصهما في صحف ومجلات الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وشجع هذا الإنتاج بعد ذلك على ظهور جيل جديد من رواة القصص الشباب، كتوفيق فياض ومحمد نفاع ومحمد علي طه الذين يتميز أدبهم بأنهم استمدوا الإلهام من الحياة اليومية للعرب الفلسطينيين في أراضي 1948، وبالاستعارات العديدة المأخوذة من الفلكلور والأدب الشعبي.
كما ظهر رواة القصص الشباب من القدس والضفة الغربية، وخصوصاً بعد صدور مجلة “الأفق الجديد” في الفترة 19611966، كمحمود شقير، وخليل السواحري، وماجد أبو شرار، وآخرين. وفي قطاع غزة، لم تنفصل مسيرة السياسي معين بسيسو عن مسيرة معين الشاعر الفلسطيني المقاوم الذي تأثر بشعر عبد الكريم الكرمي “أبو سلمى”، وتميز منذ ديوانه الأول باعتباره القصيدة أداة للتعبئة والتحفيز على النضال.
ربط النشاط الثقافي بالنضال الوطني
بعد الهزيمة العربية في حزيران/يونيو 1967 واحتلال الأراضي الفلسطينية كافة، صار النشاط الثقافي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنضال الحركة الوطنية الفلسطينية ممثَّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وصارت المقاومة الموضوع الرئيسي للإنتاج الأدبي، سواء في الشتات أو في فلسطين.
وبعد سنة 1967، اتسعت آفاق الشعر مع ظهور جيل جديد من الشعراء المقاومين، كأحمد دحبور، وعز الدين المناصرة، ومريد البرغوثي، وغيرهم. ودفع غسان كنفاني، بعد كتابة “أم سعد”، حياته ثمناً لالتزامه سنة 1972، لكن روائيين آخرين، كإميل حبيبي، ويحيى يخلف، ورشاد أبو شاور، وإبراهيم نصر الله، قرروا مواصلة المسيرة. وفي رواياتها، تحدثت سحر خليفة عن قضية شعبها وقضايا المرأة.
وعلى المستوى الفني، ظهرت أساليب جديدة للتعبير، كالفنون التشكيلية والسينما والمسرح. ومنذ سنة 1953، ومع معرض إسماعيل شموط في مدينة غزة، كان من الواضح أن الرسم سيحتل مكانة بارزة في الفنون التشكيلية الفلسطينية. وتأكد ذلك في السنوات التالية بظهور عدد كبير من الفنانين الفلسطينيين، سواء في فلسطين أو في الشتات، كتمام الأكحل، وجمانة الحسيني، وسليمان منصور، وتوفيق عبد العال، ونبيل عناني، وعبد الرحمن المزين، ومصطفى الحلاج، وسمير سلامة، وآخرين؛ فكانت فلسطين، بمعاناة شعبها ونضاله وتطلعه إلى الحرّية، حاضرة دائماً في أعمالهم عبر رموز عديدة.
وفي سنة 1968، مهّد عدد من الرواد، كهاني جوهرية ومصطفى أبو علي وصلاح أبو هنود، الطريق أولاً في الأردن ثم في لبنان، لظهور السينما الفلسطينية التي صارت سلاحاً في خدمة الثورة، ومنهم من دفع حياته ثمناً لذلك. ولم تكن الأفلام الأولى لهؤلاء الرواد أفلاماً روائية، إنما وثائقية وشهادات عن واقع معركة تحرير فلسطين، كفيلم “لا للحل السلمي” (1969) و”بالروح والدم” (1971) لمصطفى أبو علي.
وبينما وُلدت السينما في الشتات، فإن المسرح الجديد وُلد في بداية السبعينيات في الضفة الغربية المحتلة، إذ ظهرت عدة فرق مسرحية، كفرقة البلالين التي أسسها المرحوم فرانسوا أبو سالم في القدس، وفرقة مسرح القصبة في رام الله. وهذا المسرح الفلسطيني الشاب، على الرغم من ضعف موارده والرقابة الصارمة التي فرضتها عليه سلطات الاحتلال، فقد أصبح أداة فاعلة للمقاومة والتعبئة.
وفي دمشق، تأسس المسرح الوطني الفلسطيني وقدّم عدة عروض مستوحاة من نصوص رشاد أبو شاور وسميح القاسم. كما تم إنشاء العديد من الفرق المسرحية في مناطق 1948 (ماهر الشريف (تحت إشراف) “التراث الثقافي الفلسطيني”، باريس، دار لو سيكومور، 1980).
نضوج ثقافة المقاومة
شيئاً فشيئاً، راحت تنضج ثقافة المقاومة، تاركة وراءها الشعارات والخطابات السياسية، في مسعاها للانتشار وترك بصمتها على العالم. ويكتشف محمود درويش أن الشِعر “لا يستطيع أن يحارب الحرب لا بأسلحتها ولا بلغتها، بل بنقيضها، نقيضها الهش، يحارب الحرب بالهشاشة الإنسانية.” فهو يرى أن “لغة الملاحم الكبرى والانتصارات الكبرى انتهت” ويطمح إلى كتابة ما يسميه بـ “الشِعر الصافي”.
من الصحيح أن موضوع المقاومة ظل يميّز الثقافة الفلسطينية، لكن هذه الثقافة صارت تطمح إلى الوجود بصورة مستقلة عن شرطها التاريخي، ولم يعد يتم تعريفها فقط فيما يتعلق بنكبة 1948 أو بالاحتلال الإسرائيلي، بل أيضاً فيما يتعلق بإنسانيتها وانفتاحها على العالم.
إن الجيل الجديد من الشعراء والروائيين، مثل غسان زقطان، وتميم البرغوثي، وجمال ناجي، وربعي المدهون، وخزامة حبايب، وغيرهم، يميلون إلى الحياة اليومية، وإلى الواقع، أكثر من ميلهم إلى الأفكار العظيمة في كتاباتهم. طبعاً، الاحتلال قائم، وهو أمر واقع، لكن لديهم أيضاً رغبة في الهروب من هذا الواقع.
وقد عبّر رسام الكاريكاتير ناجي العلي، الذي اغتيل في لندن سنة 1989، في أعماله عن ألم شعبه ومقاومته، ويجسد طفله حنظلة ابن العشر سنوات، بشَعره الأشعث، والذي يدير ظهره إلى المشاهدين لأنه يشعر بالاشمئزاز من حياة يسودها الظلم، آلام رسام الكاريكاتير وتطلعاته، وعن طريقه آلام وتوق الشعب الفلسطيني كله إلى الحرّية.
ومنذ الثمانينيات، رسخت السينما الفلسطينية، الإنسانية بطبيعتها، نفسها كفنٍّ حقيقي يتطلع إلى الانتشار والتأثير في العالم. ففي سنة 1987، أخرج الفلسطيني ميشيل خليفة أول فيلم روائي طويل له بعنوان “عرس الجليل” يروي مواجهة سكان قرية فلسطينية مع القوة العسكرية الإسرائيلية، عندما وافق رئيس بلدية القرية على دعوة جنود إسرائيليين إلى حضور زفاف ابنه في مقابل رفْع حظر التجول خلال حفل الزفاف. وفي سنة 2002، أخرج إيليا سليمان فيلم “يد إلهية”، وفي سنة 2009 فيلم “الزمن الباقي” الذي يتتبع السيرة الذاتية للمخرج وعائلته والأحداث التاريخية التي جرت في مدينته سنة 1948 عندما وقعت النكبة الفلسطينية.
وفي سنة 2013، فاز فيلم “عمر” للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد بجائزة النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يحكي قصة عامل مخبز شاب ممزق بين حب محبوبته ومقاومة الاحتلال في ظل جدار الفصل العنصري الذي يفصل بينهما.
وفي سنة 2022، أثار عرض فيلم “فرحة” للمخرجة دارين سلّام، على شبكة “نتفليكس”، عاصفة من الانتقادات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الفيلم يحكي قصة فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاماً تحلم بالذهاب إلى المدرسة في بلدة مجاورة، والتخلي عن عادات قريتها، لكن بعد يوم واحد، تبدأ أحداث النكبة، ويُضطر والدها إلى أن يحبسها في غرفة المؤن عندما يهاجم الجنود الإسرائيليون القرية، فتشاهد، عبر ثقب صغير في الجدار، الجنود وهم يعدمون عائلة فلسطينية لجأت إلى منزلها.
صار المسرح في السنوات الأخيرة يُعنى أكثر بالقضايا الإنسانية، والأكثر تجريبية، ويميل أكثر إلى المغامرة الفنية، وخصوصاً بعد تجاوُزه الشعارات والتعبئة السياسية المباشرة.
ويقاوم الفلسطينيون الآن بأشكال أُخرى من التعبير الفني، كفنّ التطريز الذي أدرجته اليونسكو سنة 2021 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، والرسم والكتابة على الجدران، والتكوينات الفنية، والهندسة المعمارية، والموسيقى، والرقص. ولم تعد المحافظة على البيوت التراثية والمواقع الأثرية أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل أيضاً صارت شكلاً من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال، وهذا ما يلهم عمل المهندسين المعماريين الشباب من منظمة المحافظة على التراث المعماري “رواق”.
ومع بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ظهرت أشكال جديدة من الموسيقى، كموسيقى الراب، عندما قام الأخوان سهيل وتامر النفار، مع محمود جريري، بتشكيل فرقة “دام”، التي حملت منذ إنشائها رسالة التمرد على سياسة التمييز القومي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الأقلية الوطنية الفلسطينية الباقية في وطنها، وعبّرت عن طريق اسمها “دام” عن إرادة هذه الأقلية في البقاء ومقاومة محاولات الاقتلاع.
وكما لاحظت الأكاديمية الفرنسية ماريون سليتين، في أطروحتها للدكتوراه بشأن الفن الفلسطيني المعاصر وانتقاله من الأراضي المحتلة إلى المنصات المعولمة، فإن ما يوحد فناني الجيل الفلسطيني الجديد، سواء أكانوا يقيمون بالأراضي المحتلة أم يقيمون بالشتات، كمنى حاطوم، وإيميلي جاسر، ولاريسا صنصور، وبيسان أبو عيشة، وتيسير البطنيجي، وخالد جرار، وآخرين، هي الرغبة في تكييف رموز الفن العالمي المعاصر مع الموضوعات المحلية، في حركة مستمرة بين المحلي والعالمي، وإعادة تعريف مفهومَي الوطنية والالتزام.
(La Palestine en créations. La fabrique de l’art contemporain, des territoires occupés aux scènes mondialisées, École doctorale de l’École des hautes études en sciences sociales, 2018).
الثقافة الفلسطينية والمعركة الوجودية
خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية ثلاثة تقارير عن الخسائر والأضرار في المجال الثقافي، أشارت فيها إلى أن عمليات القصف الإسرائيلية أودت بحياة 41 فناناً وكاتباً وموسيقياً وشاعراً وناشطاً، رجالاً ونساء، وفقد بعضهم عائلاتهم بأكملها، وأُصيب العديد منهم بجروح خطِرة، ودُمرت المراكز الثقافية بالكامل، بما في ذلك مركز “رشاد الشوا” الثقافي الذي أنشئ في غزة سنة 1985، والمؤسسات الفنية، كمعرض “شبابيك” وكلّية الآداب في جامعة الأقصى. كما تعرضت المكتبات العامة والخاصة، بما فيها مكتبة بلدية غزة العامة التي تضم آلاف الكتب، ومكتبة سمير منصور التي تضم آلاف العناوين، والمواقع الأثرية، للتدمير كلياً أو جزئياً.
ومنذ بداية الحرب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عدداً من الشخصيات الثقافية التي تجرأت على الحديث علناً ضد الحرب في غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كالمغنية دلال أبو آمنة، والممثلة ميساء عبد الهادي من الناصرة، وناشطين آخرين. ودعا وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلبة، وتم إطلاق حملات منظمة ضد أساتذة الجامعات، كما هو الحال مع البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان من الجامعة العبرية في القدس (رنا عناني، “حرب الإبادة على قطاع غزة: الثقافة الفلسطينية والمعركة الوجودية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وجهات نظر سياسية، 2024).
وفي الختام أعود إلى السؤال: من هم الفلسطينيون؟
أجيب: إنهم نحو سبعة ملايين من الرجال والنساء العرب الذين يعيشون في وطنهم التاريخي فلسطين الانتدابية التي تمتد من نهر الأردن شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً، ويعانون يومياً جرّاء القتل والقمع والتمييز العنصري، كما أنهم نحو سبعة ملايين آخرين منتشرين في أنحاء العالم، ويتوقون إلى العودة إلى وطنهم التاريخي، وهم جميعا يشكّلون الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن قضية وطنية مصيرها أن تنتصر مهما يطول الزمن، لأنها عادلة وإنسانية.
* نص محاضرة قدمت في جامعة كونستانس الألمانية مساء يوم الثلاثاء في 10 كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن سلسلة ندوات تنظمها الجامعة في نطاق “برنامج الدراسات الثقافية”.