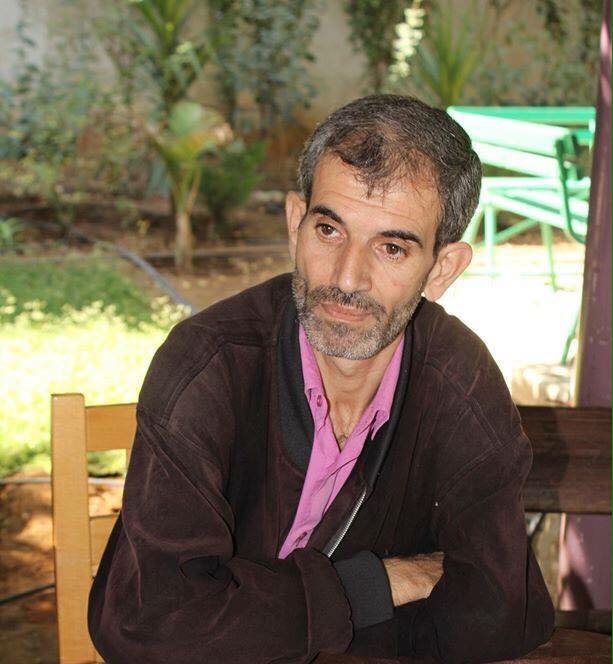أمد/ المقدمة:
لا شكّ في أن المفاهيم عامّة يتناسل بعضها من أعطاف بعض، فتنشأ بينها علاقة معينة، ولتشترك فيما بينها في جزء من المعنى قبل أن يأخذ المفهوم الجديد شرعيته بالاستقلال عن غيره في الحدود الدلالية والتطبيقات اللغوية، فالاستعارة مثلا تناسلت من مفهوم التشبيه، وظلت تعرف على أنها تشبيه حذف أحد طرفيه، وظلت هذه التبعية المفهومية تطارد الاستعارة، ولم تتخلص منها إلا في البحوث البلاغية الحديثة، وعلى ذلك يمكن أن نقيس مفهوم المقابلة المرتبط بمفهوم الطباق، وغيرهما الكثير من المفاهيم.
وبهذه العلاقة المتصلة بين المفاهيم نشأ لديّ مفهوم “الإنقاص البلاغي” خلال عملي على كتاب “سرّ الجملة الاسميّة” القائم في أساسه على فلسفة التخلص من ثلث اللغة العربية في إنشاء النصوص، أي استبعاد الأفعال وأسماء الأفعال في بناء النص الأدبي، في الشعر وفي النثر، لكنه كان أدخل في الشعر منه في النثر، لاعتبارات التكثيف ولطبيعة الشعر القائمة على التوتر العالي الذي يصاحبه الحذف، كما أشرت في الكتاب نفسه.
ولذلك فإنني أرى أن مفهوم “الإنقاص البلاغي” الناشئ بعد هذه العملية من البحث له ارتباط بمفهوم الحذف، إلا أنه ليس حذفا فقط، وله ارتباط بمفهوم التكثيف، إلا أنه أيضا ليس تكثيفا وحسب، إنه مفهوم أعمق من كليهما، وله دلالة تخلقت في ذهني، سأحاول شرحها فيما سيأتي من سطور.
أولا: مفهوم الحذف
المقصود هنا هو “الحذف البلاغي”، وله أشكال كثيرة في اللغة العربية، تظهر في المفردة، وفي الجملة، وحسب قاعدة اللغويين فإن كل تغيّر في المبنى فإنه سيؤدي إلى تغيّر في المعنى، وعليه لو تم حذف حرف فإنه سيؤّول هذا الحذف بلاغيا، كما هو في تأويل الحذف في القرآن الكريم، ومحاولة المفسرين والنحاة جعل هذا الحذف ذا قيمة معنوية بلاغية، لها ارتباط بالسياق الذي جاءت فيه.
من ذلك مثلا لو تم النظر إلى الحذف في سورة الكهف لوجد الباحث أن للحذف معنى ما، بلاغيا في الدرجة الأولى، وقد جاء الحذف في هذه السورة على أشكال متعددة، حذف حرف من سياق، وإثباته في سياق آخر في السورة نفسها، فمثلا يقول الله تبارك وتعالى “فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا”، فقد استخدمت الآية الفعل نفسه، مرة بحذف تاء افتعل ومرة بإثباتها، ولهذا عند المفسرين البلاغيين للقرآن دلالته المعتبرة، فلصعوبة النقب أكثر من إظهار السور (تسلّقه أو ارتقاؤه) أثبتت التاء، ربما كان ذلك المعنى هو المقصود وربما لم لا، لكنه تفسير وجيه، يثبت بلاغية الحذف، ناهيك عن أمر آخر متعلق بالمحافظة على الجرس الموسيقي للآية، فإنه سيتأثر في حالة إثبات التاء في الموضع الذي حذفت منه، والبلاغة القرآنية العالية يتحد فيها غير سبب تتعاضد معاً لتساهم في “شعريته” المتميزة، وسبق أن بينت ذلك في موضعه في كتاب “بلاغة الصنعة الشعرية”.
وغير ذلك، فإن سورة الكهف تحفل بأكثر من (10) مواقع حذف بلاغي، تم فيها “إسقاط” الحرف سواء أكان حرف معنى أم مبنى وحذف اسم، وحذف فعل، وحذف أسلوب، وفي كل مرة يوجد دليل على هذا الحذف؛ إما دليل بنيوي نابع من المبنى الصرفي للكلمة كما في “استطاعوا واسطاعوا”، أو بناء على التناظر بين شقي الجملة، بحذف اسم أو فعل لأنه في السياق نفسه ذكر هذا المحذوف، ولا يحسن ببلاغيّ ذكر شيء مرة أخرى إذا كان موجودا، فالعرب تكره التكرار الذي لا داعي له، ومن أمثلته في سورة الكهف حذف التمييز بعد العدد في قوله تعالى “وازدادوا تسعا”، لأنه ذكره في الشق الأول من الآية “ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين”، فمن المعروف البدهيّ أنهم ازدادوا تسع سنين، ولهذا حذفه، ولهذا الحذف أهميته البلاغية والمعنوية كذلك.
ومن اللفتات البلاغية في الحذف ما جاء في السورة في الآية الثانية والسبعين: “قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا” بعد المرة الأولى التي اعترض فيها موسى على خرق السفينة، وأما في الآية الخامسة والسبعين فقال تعالى: “قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا”، فحذف من الأولى “لك” تأدباً مع موسى، لكنه عندما كرر الاعتراض، ولم يستطع الصبر في المرة الثانية حاء بشبه الجملة “لك” لما تحمله من تنبيه، وزيادة جرعته لينتبه موسى إلى أنه بالفعل خرق الاتفاق مرة أخرى. أما في الاعتراض الثالث، فقد حذفت الجملة كاملة، فلم يقل له: “ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا”، وإنما تنازل عنها لأن العبد الصالح يعلم أن موسى لم يكن باستطاعته فعلاً الصبر، فلا داعي لجملة ترسخ معناها في الذهن، وأنه لا مجال أيضا لفرصة أخرى، معلنا انتهاء الصحبة، فجاء بالنتيجة مباشرة: “هذا فراق بيني وبينك”.
هذا هو إذاً الحذف البلاغي الذي يتعمّد فيه منشئ النص أن يحذف أمورا للفت الانتباه للمحذوف، أو عدم حصره في خيار واحد، أو لأنه معروف ضمنا، وقد تحدث البلاغيون عن ذلك كثيرا في مواضعه، فلا داعي لإعادته، وإنما ما أردت أن أقوله من خلال هذه المناقشة أن “الحذف البلاغي” حذف داخل سياق لا يقوم أصلا على شعرية الحذف بحد ذاته، وإنما حذف بعض البنى اللغوية الصرفية والنحوية والصرفية لتحقيق غاية معنوية، وهذا مما يشترك جزئياً فيه مفهوم الحذف مع مفهوم “الإنقاص البلاغي”، كما سأبينه فيما يأتي.
ثانياً: التكثيف
يتداخل معنى هذا المصطلح مع حقول معرفية متنوعة علمية واجتماعية، فالتكثيف علميا هو انتقال المادة من حالة الغازية إلى الحالة السائلة، ويستخدم في الفيزياء مع الطاقة الكهربية وعمل مكثفات لزيادة الطاقة والسعة، وفي مضخات المياه لزيادة ضخ الماء، وفي الحياة الاجتماعية المعيشة ثمة ارتباط لهذا المعنى بتكثيف الحليب والعجين وتكثير الشيء، وعليه فإن التكثيف يعني فيما يعني “تقليل ظاهر الشيء، وتجميعه في حالة معينة، ليبدو عند النظر فيه أكبر مما هو في الظاهر”، لذلك فإن التكثيف يحمل معنى الغزارة والتكثير، وكأن منشئ النص يحاول إنشاء بنية لغوية متداخلة، ومتراكب بعضها فوق بعض، لتبدو في ظاهرها جملة قصيرة، لكنها في الحقيقة عند التحليل تحمل معاني تستهلك الكثير من القول والشرح. لأن الكلمات المكونة للبنية النصية في ذاتها تحمل معاني أكثر من البنية.
وهذا المفهوم يشتبه بمفاهيم أخرى، كإيجاز القِصَر، وليس إيجاز الحذف المحسوب على ظاهرة الحذف البلاغي، فالتكثيف ليس شرطا أن يلجأ إلى الحذف، إنما يعني أن البنية اللغوية قد تكون كاملة لا حذف فيها، إنما تحتمل معاني كثيرة، وللتكثيف وسائل متنوعة كالاستعارة بمفهومها المعاصر المنبتّ عن التشبيه، وتوظيف بنى لغوية لها معاني متعددة، أو استخدام عبارات يؤدي اجتماعها معا إلى تعدد الدلالة وانفتاحها حسب الظروف والأحوال.
ومن الأمثلة على ذلك مثلا كثير من آيات القرآن الكريم المكي التي حسبها المفسرون المعاصرون على الإعجاز العلمي، وخاضوا فيها كثيرا، أو تلك الآيات القرآنية التي تعددت دلالتها بتعدد المفسرين باختلاف العصور والبيئات، مثل قوله تعالى: “ويخلق ما لا تعلمون”، التي جاءت تذييلا بعد تعدد النص القرآني لوسائل المواصلات التي كانت معروفة أيام نزول النص القرآني، فجاءت الخاتمة لتستوعب كل ما جاء بعد ذلك من وسائل مواصلات حديثة من السيارة والدراجة والقطارات والطائرات، وربما يكون وسائل أخرى تستجد على بني البشر، سيظل النص يستوعبها؛ لأنه نص مصوغ بكيفية عامة مكثفة، ملبدة، غزيرة في المعنى، قابلة للتفسير أو لضخ معاني جديدة في كل مرة.
ومثل هذه الآية في التكثيف المذهل للمعنى العظيم المتناسل غير المنتهي قوله تعالى “وإنا لموسعون” تعقيبا على قوله تعالى “والسماء بنينها بأيدٍ وإنا لموسعون”، ليوظفها علماء الفيزياء الكونية ليروا فيها نظرية تقول إن الكون يتوسع، ويأخذون بشرح هذه النظرية وربطها بالنص القرآني، وهكذا كثير من الآيات التي تحتمل تعدد المعنى.
وبذلك يلتقي التكثيف مع الحذف البلاغي في تقليل البنية اللغوية أو ما يعرف “بالاقتصاد اللغوي”، مع ضرورة أن يكون المعنى أكبر من البنية في الحالتين، وهذا ينطبق أيضا على الإيجاز والاستعارة والاختزال، لكنها تختلف عن كل تلك المفاهيم في أنها بنية لغوية مكتفية بذاتها لإحداث معاني متعددة، وأميل إلى أن العبارة القائمة على تقنية “التكثيف” لا يدخل الحذف من ضمن شروطها ولا أدواتها، وإن قال البعض غير هذا، لأن التكثيف يقتضي في معناه اللغوي طريقة جدل المعنى من ألفاظه التي تعبر عنه دون الحاجة إلى الحذف، كما في الآية الكريمة السابقة.
هذا الشرط هو ما يجعل التكثيف مصطلحا قائما بذاته، وله حدوده المعرفية التي تميزه عن غيره، ويمنح الدارسين إمكانيات تحديده ليكون مستقلا عن غيره، وليس بحاجة إلى أن يعتمد على غيره في تحققه. والتكثيف بهذا التحديد صعب للغاية، ولا يستطيع إنشاءه إلا كل من له قدرة وخبرة في عجن اللغة وأساليبها وتوظيفاتها.
وأكثر ما ألاحظه من تكثيف وينطبق عليه هذا المفهوم “الشذرات الفلسفية” التي يلجأ إليها الفلاسفة الكبار، إذ يعمدون إلى تقطير المعنى في ألفاظ قليلة جامعة، كقول باسكال: “يجب أن نعرف أنفسنا. حتى ولو لم يساعدنا ذلك على اكتشاف الحقيقة، سيساعدنا على وضع نظام في حياتنا على الأقل. لا شيء أهم من ذلك”. ففي كل جملة من هذا القول مسألة فلسفية عرضت بإيجاز واختصار وتكثيف عالٍ.
وكما ورد في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من ظاهرة “جوامع الكلم”، تلك الظاهرة التي اهتمّ بها السيد أحمد الهاشمي، فألف بناء عليها كتابه “مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية”.
ومن أهم مميزات التكثيف كما هو عند بعض المتصوفة والفلاسفة أن النص لا يشرح الأفكار، وإنما يقولها على نحو مكثف، يتكفل الآخرون بشرحها، كما في كثير من نصوص كتاب “هكذا تكلم زردشت” لنيتشه، وكما هو أيضا معمول به في شروح الحكم الكونية والإنسانية، وكلها تصاغ على نحو من البراعة الفنية التي يكون فيها منسوب البلاغة عاليا جداً، ولذلك عدّ الإيجاز أصعب من التطويل، ويعترف بهذا البلاغيون عموماً.
ثالتاً: الإنقاص البلاغي
الإنقاص مصدر الفعل أنقص، وهو مزيد بهمزة التعدية من الفعل “نقص” الذي يأتي لازما ومتعدياً، ولكنّ الهمزة منحته إمكانية أن يكون فعلا متعديا لمفعول به واحد فقط، ولم يعد يستعمل فعلا لازماً، ويحتمل أن تكون الزيادة فيه حاملة لمعنى “التعريض التي تجعل المفعول به معرضاً لمعنى الفعل”.
وأصل معنى “النقص” القلة، والضعف، والتحقير، وخفض الشأن، والخصم، وعدم الوفرة، والغياب، ويعني أيضا الحذف، كما هو في حقل علم العروض، كما أنه يعني في المفهوم اللغوي النحوي والصرفي نوعا من العلة كما في الفعل المعتل الناقص؛ ما كان آخره حرف علة، وفي الأفعال الناقصة غير كاملة الأهلية ليكون لها فاعل كبقية الأفعال التامة، فإذا صارت تامة أخذت فاعلا، وزال عنها العيب، وكذلك الأسماء المنقوصة التي تنتهي بياء مد لازمة تحذف ياؤها في حالتي الرفع والجر ما لم تعرّف بأل أو لم تكن مضافة، والجناس الناقص الذي يختل بين الكلمتين شرط العدد، وهو فرع من فروع الجناس غير التام.
هذا المعنى الموجود في الفعل الثلاثي المجرد موجود بالفعل المزيد، وكل تلك المعاني تجتمع على معنى واحد، يدور في دائرة من السلبية التي تعني العيب والضعف، فقد ورد في معجم الدوحة التاريخي هذه المعاني للفعل “أنقص”: أنقص منه: أخذ من تمامه. (والشخص) الأنقص: الأكثر نقصاً. ويطلق على الجهول وصف “أنقص”.
هذه المعاني قد لا تؤهل المصطلح ليكون مصطلحا بلاغيا يشير إلى سمو النص ورفعته، وانغراسه في “الشعرية” والأدبية التي يقصدها الكاتب عندما يكتب نصوصه الإبداعية، ولعلّ أكثر ما يزعج الأديب اتهام نصه بالنقص والعجز والضعف وعدم تمام الخلقة. فكيف إذاً يمكن لهذا المصطلح أن يكون بلاغيا، يمنح النص تفوقا ما؟ فهذا المصطلح على العكس من مصطلحي الحذف والتكثيف في مفارقته الدلالة الإيجابية للدخول في المعنى السلبي.
ولحل هذه الإشكالية في توطيد معنى المصطلح ينبغي أن ينظر إلى المصطلحات والمفاهيم على أنها تحمل في ذاتها إجراءات عملية للتوصيف بغض النظر عن أصل المعنى اللغوي كما في الجناس الناقص والأفعال الناقصة، على الرغم من أنه لا مصطلح يسكّ في الغالب بعيدا عن المعنى اللغوي الأصلي، إلا أن قوانين اللغة العربية تتيح للمشتغلين بها نقل الدلالة من معنى سلبيّ إلى معنى إيجابي أو العكس، وعند تطبيق هذا القانون على مفهوم “الإنقاص” سيصبح له معنى مفهوميّ آخر يندرج في المعنى الإيجابي، عدا أنه كل إنقاص هو قائم على الحذف والاستبعاد والانتقائية في الاستخدام اللغوي، كما هو مثلا في ديوان “هي جملة اسمية” القائم على استبعاد الأفعال الناقصة والتامة وأسماء الأفعال، وقائم أيضا على استبعاد الأساليب اللغوية التي تندرج نحويا ضمن الجملة الفعلية حتى وإن خلت من الأفعال، كجملة النداء وأسلوب التحذير والإغراء على سبيل المثال.
ولهذه الحالة من نقل الدلالة السلبية إلى الإيجابية نظائر في الثقافة العربية، كما في مثال الحنفية، فأصل الحنف الاعوجاج: “حَنِفَ الرَّجُلُ: اِعْوَجَّتْ قَدَمُهُ وَمَالَتْ”، وهو عيب فيه، لكنّ الدلالة انتقلت من هذا المعنى إلى معنى الاستقامة مع الدين الإسلامي الذي كان جديدا على العرب، ووصف بأنه “الحنيفية السمحاء”، وصار يحمل معنى الميل عن الشر إلى الخير، بل حلت هذه الصفة محل الاسمية، وصارت اسما علما إيجابيّ الدلالة، ونسي أمر العيب والعوج.
وبهذا يتحدد مفهوم “الإنقاص البلاغي” بأنه “طريقة أسلوبية في بناء النص قائمة على استبعاد بعض العناصر اللغوية، بحثا عن الانسجام العام للبنية اللغوية الجديدة”، ولهذه الحالة من التركيب النصي البلاغي القائم على “الإنقاص” عدا استخدام الجملة الاسمية في التعبير، واستبعاد كل ما له علاقة بالفعل، ما وجد في أساليب إنشائية استخدمها الكتاب، كما أثر عن واصل بن عطاء مثلا في استبعاده حرف الراء من واحدة من خطبه كونه يلثغ في هذا الحرف، فجاء الإنقاص بلاغيا، انعكس على مقدرة منشئ النص في إنتاج نص دون أن يقع في فخ إظهار العيب الخلقي الذي عنده، فصار الإنقاص ساتراً للعيب، فدخل النص بهذه الوظيفة المصاحبة، ألا وهي “ستر العيب” إلى مؤشر البلاغة العالي، ليكتسب النص شعريته اللافتة، وتدل على اقتدار صاحبها، “وقدرة فنية لا تتأتى إلا للأفذاذ من الخطباء”. وعلى أية حال، لم تكن خطبته الوحيدة في تجنب الخطيب حرفا معيّناً، فقد ورد في كتب التراث أن أحمد بن علي بن الزيات المالقي أنشأ خطبة “نزع منها حرف الألف”.
ولم يخلُ القرآن الكريم من هذه التقنية البلاغية، فقد خلت سورة الإخلاص من حرف الراء، وخلت سورة الكوثر من حرف الميم، كما وجدت في القرآن الكريم آيات كاملة مصوغة باستخدام الجمل الاسمية، كما بينت في موقعه من كتاب “سرّ الجملة الاسميّة”، ومن مظاهر الإنقاص البلاغي في القرآن الكريم ظاهرة الحروف المقطعة، وشكلت ظاهرة استنفدت جهدا معينا لدى المفسرين للوقوف عند دلالتها.
ومن الإنقاص البلاغي بناء سورة الناس على فاصلة واحدة، مكررة في لفظ “ناس”، حتى مع اختلاف كلمة الخنّاس في فاصلة الآية الرابعة إلا أنها تنتهي باللفظ نفسه، الذي تكرر في الآيات الخمسة الأخرى. وهذا النسق من اعتماد فاصلة واحدة بكلمة واحدة هو الذي أدخل التركيب النصي كاملا للسورة بمفهوم “الإنقاص البلاغي”، لأنه خالف المعهود في بناء النص المسجوع على تعدد في كلمات الفاصلة، ومع تعدد الفاصلة ذاتها، ففي المسألة استبعاد ومخالفة.
ومثل ذلك جاء في الشعر العربي عندما بنى أحدهم قافية قصيدته على لفظ “تجدني”، وهي جملة فعلية كاملة، ومن ذلك أورد هذه الأبيات:
أنا الموجود فاطلبني تجـــدني فإن تطلب سواي فلا تجدني
تجدني أيــــــن تطلبني عتيداً قريباً منــــــك فاطلـــبني تجـــــدني
تجدني في سواد الليل عبدي قريباً منــــــك فاطلبــــني تجدني
ومثل هذه القصيدة ما فعله الشاعر أبو إسحاق الألبيري الأندلسي في بناء قصيدة له مكونة (53) بيتا على لفظ الجلالة “الله” في القافية، ويقدم محقق الديوان للقصيدة بقوله: “تختلف هذه القصيدة عن أصول الشعر العربي بتكرار كلمة واحدة لا تتغير من أول القصيدة إلى آخرها في قافية البيت”. أقتبس من القصيدة أول ثلاثة أبيات:
يــــــــا أيــــــها الْمُغْــــــــــتَرُ باللــــــــــه فِـــــرّ مـــــــــــن الله إلى الله
ولذ به واسأله من فضـله فقد نجا من لاذ بالله
وقـــــم له والليل في جنحه فحــــــبذا مــــــــن قام لله
ومثل ذلك فعل في قصيدة أخرى مكونة من (37) بيتا يبني أبياتها كلها على لفظ “نار”، فهذا الالتزام في هذه القصائد ومثيلاتها يحقق نسقا واحدا في القافية محكوم بكلمة واحدة، حيث يبتعد الشاعر عن التنويع في القافية فكأنه اختار أن يبعد كل القوافي المحتملة ويبقي على واحدة فقط، مخالفا أيضا ما عرف عند علماء العروض من مغبة الوقوع في الإيطاء، وهو أحد عيوب القافية عندما يكرر الشاعر لفظا في القافية في أقل من سبعة أبيات،
وتختلف هذه الظاهرة عن بناء القصيدة على كلمة واحدة من المشترك اللفظي؛ مما اتفق لفظه، واختلف معناه في كل مرة، كما جاء في قصيدة “العين”:
إني لأذكر أياماً بها، ولنا في كل إصباح يوم قــــــرة العين
تدني معلقة منا معتقة تشجّها عــذبة من نابــــع العين
إذا تمززها شیخ به طرق سرت بقوتها في الساق والعين
مع أنه يمكن كذلك أن يكون هذا الشكل من القافية نوعاً من “الإنقاص البلاغي” كذلك، لأنه يتحقق فيه الاستبعاد والانتقاء، ويحقق شرط القافية في القصيدة القديمة في تجنب عيب الإيطاء، إذ لا يعد إيطاء تكرار اللفظ مع اختلاف المعنى في كلّ مرة.
ومن هذه التقنيات الأسلوبية الداخلة في مصطلح “الإنقاص البلاغي” ما فعله بعض شعراء العصر المملوكي من إنشائهم للنصوص المتشكلة من الحروف المعجمة أو المهملة، وهذه عملية يلزمها سعة اطلاع وقدرة فنية تجعل الكلام سلسا ذا معنى، ولا يشعر السامع أو القارئ إلى الاحتياج إلى شيء آخر لفهم النص أو تركيبته، وهي قائمة على الانتقاء والاستبعاد كذلك.
إذاً يقوم هذا المصطلح على الاستبعاد والاستبدال والإسقاط والانتقاء ومخالفة معهود بناء النص، ضمن شرط وحيد لا يمكن التخلي عنه، وهو إتمام المعنى، فالإنقاص يشترك مع الحذف ومع التكثيف في هذا الشرط، لكن يفارقه في أن الإنقاص تقنية عامة تحكم النص كاملا، لا جزئية فيه، وتخلق قانونها الخاص، كما في الأمثلة السابقة، حيث صيغت السور القرآنية والخطب والقصائد بهذه الكيفية، وهي التقنيات نفسها التي تم فيها إنتاج ديوان “هي جملة اسمية”.
وأفضل توصيف يمكن أن أطلقه على مفهوم “الإنقاص البلاغي” ما قاله الدكتور أحمد فوزي الهيب في دراسته عن “التصنع وروح العصر المملوكي”، إذ يصف أحد شكلي تلك الصنعة؛ البسيط والكلي، يقول عن الشكل الكليّ: “شكل معماري فني كلي منظم، يتبع مخططاً دقيقـاً، ويعنـي بالمظهر الكلي للعمـل، كأنه حديقة رسم مخططها مهندس قدير، فجعلها مرتبة، قائمـة أقسامها وساحاتها على التشابه والتناظر والتكامـل، ذات بدايـة ونظام لا تتعداه ولا تخالفه، بل تخضع له كل جزئياتها خضوعاً تاماً”، ويزيد المسألة وضوحا وشرحا في موضع آخر من كتابه بقوله: “ليحقق شكلاً معمارياً فنياً ذا طابع كلي، قد وضع له صاحبه خطته المحكمـة المدروسة المرسومة بعناية قبل أن يبدأ به، ثم سار في تنفيذها بخطى ثابتة دقيقة فنية”.
وهذا ما حققته في ديوان “هي جملة اسمية”، وما حققه كل شاعر لجأ إلى الصنعة الكلية، ففي الديوان بحكم أنه كتاب شعر صور أدبية واستعارات وانزياحات لغوية، وفنون من البلاغة اللفظية والمعنوية والاشتغال اللغوي على مستوى اللفظ كما في هذه الجملة: “جسدي بين يديكَ عطريٌّ، طريٌّ، رِيُّ”، فالكلمات الثلاثة الأخيرة بينها جناس عن طريق الإنقاص الحرفيّ في كل مرة، إذ ينتمي هذا المثال إلى الجناس الناقص الذي ينقص فيه عدد حروف إحدى الكلمتين عن الأخرى، وجاء هذا المثال في الكلمات الثلاثة، وليس بين كلمتين كما هو معهود الجناس الناقص.
كما ورد في الديوان مقطع لا يحسن معه أن يُسمع من القارئ، بل أن يُقرأ بالعين، لأن القراءة التقليدية لا تعطي المعنى حقه، لأن المعنى يعتمد ما هو مكتوب لإدراكه؛ فرسم علامة الترقيم التي لا يتلفظ بها في العادة ركن أساسي في المعنى، وفي هذه المخالفة أيضا خروج عن المعهود، وهذا الخروج يدخله في مفهوم “الإنقاص البلاغي” الجزئي:
هي هَذِهِ (!)
وأنا هذهْ (؟)
والحبّ فاصلة كخطوة واثقة نحو الأمام (،)
وعلامة التّنصيص ” ” عاجزة عن حفظ روح ثائرة
والطّريق انعدام الوقفِ في هذي اللغةْ
وحذف علامة الترقيم في نهاية المقطع جزء من هذه التقنية القائمة على “الاستبعاد”، تحقيقا للمعنى الذي تطلبه الجملة في السطر الأخير، فلو وضعت النقطة (.) لاختلّ المعنى وفقدت فكرته.
ومثل هذا الاشتغال المحكوم ببنية الكلمة والسطر كثيرة في الديوان، إنما المقصود منه ليس هذه الاشتغالات اللغوية والبلاغية الجزئية وإن كانت تتفق مع فكرة “الإنقاص البلاغي”، إنما القصدية الواضحة منذ البداية ليكون على هذه الشاكلة هي الفكرة الكلية التي أنشئ من أجلها الكتاب ليكون مكتوباً بتقنية الجملة الاسمية، فهو عمل فني واعٍ مدروس تماماً، مشغول بتؤدة وصبر، ليحقق شعريته المبتغاة.
وبناء على كل ما تقدم، فإن مفهوم “الإنقاص البلاغي” ليس فرعا على مسائل الحذف المتنوعة التي أشرت إليها في البند الأول، وليست محسوبة كذلك على التكثيف الوارد في المسألة الثانية من هذه المقالة، فقد يكثر معه الإطناب والتطويل لإظهار البراعة اللغوية كما في المقامات الأدبية مثلاً.
وليس هذا المفهوم بين الحذف والتكثيف، إنما الأمر مختلف تماما، يتحكم فيه نظرة شاملة في إنتاج النص، بحيث يحكم كل جزئية فيه، ولا يمنع هذا أن يأتي على مستوى السطر أو المقطع، ويقوم على تقنيات لغوية عامة ويصبح ملمحا من ملامحه المميزة، ولذا يصبح للنص قانونه الذي يعمل فيه وينطبق عليه، لكنه قائم على فكرة الإنقاص بمعنى الاستبعاد كما بينتها أعلاه برؤية واضحة لتحقيق فكرة بلاغية، لا الإنقاص اللغوي الذي يؤدي معنى النقص والعيب.