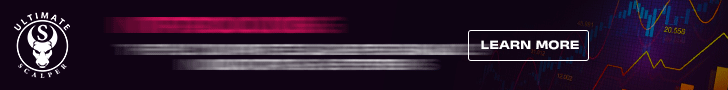توقيعات على جدران غزة” نصوص حارقة من قلب المأساة

أمد/ المتوكل طه يكتب انطباعات أليمة بعين الناثر وقلب الشاعر
“دم النار توقيعات على جدران غزة” كتاب للشاعر الفلسطيني المتوكل طه يكتب فيه نصوصاً شعرية وسردية عن مأساة غزة وشعبها.
ظل محمود درويش ورفيق دربه سميح القاسم لسنوات طويلة أبرز صوتين شعريين، تعبيراً عن القضية الفلسطينية. وعلى الدرب نفسه يبرز من بين الأجيال التالية للرائدين درويش والقاسم، صوت المتوكل طه الذي صدر له أخيراً كتاب “دم النار توقيعات على جدران غزة”، في طبعة مصرية، بغلاف للفنان أحمد اللباد، ضمن “سلسلة الإبداع العربي”، التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكما هو واضح من العنوان، فإن هذا العمل الذي يتضافر فيه السرد مع الشعر، يدور حول مأساة غزة وما تواجهه من عمليات قتل وتشريد وتدمير ممنهج للبنية التحتية في هذا الجزء من فلسطين.
ويتألف الكتاب من مجموعة نصوص تشكل في مجملها حالة ملحمية، علماً أنها تتراوح بين الحجم المتوسط الذي يبلغ 12 سطراً، والحجم الصغير الشبيه بالأبيغراما. وهو بذلك يعد امتداداً، من حيث الطول والملحمية لكثير من القصائد الدرويشية مثل “أحمد الزعتر” و”جدارية الموت”، وكذلك ديوان “ملك أتلانتس وسربيات أخرى” لسميح القاسم، الذي هو أيضاً عبارة عن قصيدة طويلة ملحمية مقسمة إلى مقاطع مرقمة.
يهدي المتوكل طه كتابه إلى “غزة التي يجرحها الماء”، باعتبارها مكان الاستباحة و”المقاومة”، أو باعتبارها الحقيقة الثابتة وسط عالم متلون، على نحو ما يبدو في قوله: “انظروا من النافذة، انقلبت الدنيا / ولم يتغير شيء في غزة”. فغزة على حالها، كما أن “الرمح على حاله”، طبقاً لعنوان ديوان سابق للمتوكل طه، حتى وإن بدا كل فلسطيني مشروع “جثة محتملة”.
الماء والنار
ويظل دال “النار” بوصفها أداة التغيير ومصدر الضوء من الدوال كثيرة التوظيف في هذا الكتاب، حين يقول طه مثلاً: “ما أروع أهل غزة / لقد جمعوا النار وألقوا بها في العتمة / فكان الفجر والعيد”. إن غزة قادرة بصمودها على فضح “عدالة” الكيل بمكيالين، “أشعلوا أيها السائرون دماءكم / لتقودوا الطريق إلى الميزان”. ويتماهى الإنسان مع المكان، أو غزة مع الفلسطينيين، حتى يغدوان هوية واحدة: “إن لم نمتلك غزة / لن نمتلك أنفسنا”. ولهذا كان لا بد من الخوض في النار بغية قطف “باقة الورد من فوهة البركان”، وذلك لأن “الوجه الخائف لا يضحك”، ولأن “المقاتل” ينبغي أن يكون مثل “أسد جائع وجد فريسته الخانعة”. واستمراراً لتوظيف هذا الدال يقول الشاعر: “إننا نكتب والنار بين أصابعنا”، بل إنه يجعل من الشهداء الذين ذهبوا هناك حيث لا ألم ولا تفكير، سبباً في أن “تهب النار مرة أخرى في الشفاه”، بعد أن جعلوا أسماءهم مثل الموسيقى أو مثل أنشودة بيضاء. هذه النار ستلتئم بسببها الجراح، “وتنبت الوردة من غصن الحريق”. ويتوازى دال “الماء” في معناه مع دال “النار”، على رغم التناقض الظاهر بينهما بعد أن يضيف مفردة الشآبيب إلى النار، على عكس ماهو شائع من إضافتها إلى الماء: “لقد ارتفعت شآبيب النار واحترق الليل تماماً / ليجد القتلة رماداً بين أقدامهم المعفرة بالضياع”، بل إنه يقوم بتشخيص الماء فيصوره واقفاً على أبواب المدينة ناظراً خلفه لكي “يتذكر الغيمة التي جاء منها / والرعد الذي صاحبه في النزول / وسيدخل دير البلح ليعطيها باقة البرق التي حملها”.
المسيح في الطرقات
من الطبيعي وسط هذه الدراما الإنسانية الدامية في غزة أن يوظف شخصية المسيح الذي خرج إلى الطرقات من “لوح الحروف في دفتر غزة، فأخذه الأطفال إلى حارة قريبة ليرى دمه هناك”، على رغم أن المقاوم الفلسطيني ليس “يسوعاً”، وليس القاضي “بيلاطس الحاكم”. كما نجد إشارة إلى “ابن عربي ” بكشوفاته الباهرة، “هل تسمعهم يا ابن عربي / لقد بلغوا حد الكشف ومقام النور”، وهو يقصد المقاومين الفلسطينيين. وفي سياق هذه الإشارات السريعة إلى المسيح وابن عربي، يقوم الشاعر بتوظيف الصورة المشهدية حين يتحدث مثلاً عن جلوس عاشقين على مقعد في رفح، بينما “الليل نهاري / الباعة المتجولون غضوا الطرف / لكن التوت البري المتساقط منهما دل على الحريق”. وتصبح المدن نفسها من خلال آلية التشخيص كائنات قادرة على الكلام والتمني، هكذا نجد بلدة بيت حانون تخاطب بلدة جنين وتسألها “متى نبكي فرحاً؟”. ويصبح العدم منتصباً فوق الشواهد، “بكامل رعبه، يجلجل مثل تنين صاعق بغيض، يتميز بغيظه ويضرب الأرض فترتج الآفاق”. كما تكثر ظاهرة التضاد بوصفها امتداداً للصراع بين الإبادة والصمود، فيرى الشاعر “الأخطاء” هي عينها “صواب الدنيا”، وتصبح غزة “قوس قزح” في مقابلة مع عالم “مطموس الألوان”. كما تصبح أشبه بلوحة “الكولاج” التي “تاهوا في ألوانها / وضاعوا بين مكوناتها / ولن يجدوا في متاهة اللوحة ما يوصلهم إلى النوم”.
يشبه الشاعر إسرائيل بالطاووس الذي لا يمتلك سوى مظهره المخادع، “على ماذا يتشاوف هذا الطاووس / لقد هزمته الظلال”. لهذا فهو على يقين بالنصر فهؤلاء القتلة الذين يتيهون بقوتهم سيخلعون الشوك الذي غرزوه في أقدام الفلسطينيين بأسنانهم، بعد أن “خلعوا ملابسهم وقيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم وجعلوهم يركعون على ركبهم”. لهذا حق للشاعر أن يرى أن الاحتلال سيسقط يوماً ما “حتى لو ساعده الإنس والجان / فلا شيء ينبت هنا دون جذور”، ويخاطب رموزه بالقول: “افعلوا ما تريدون / فلم تتركوا لنا شيئاً نخاف عليه”، “فاليد القوية مغرورة وستفقد ذات يوم أصابعها، كما أن ذلك الوحش الذي أخرجوه من خلف قمصانهم ربما ينهشنا، لكنه حتماً سيأكلهم، وربما بدت المقاومة ضرباً من المغامرة المجنونة وغير المحسوبة، لكنها رغم ذلك أصبحت ضرورية بعد أن أصبح السلاح ينبح في كل البلاد”.
وفي السياق ذاته، يعلي الشاعر من شأن ذلك “الملثم الجسور” الذي نرى عن يقين أن “اسمه يقرع الجرس / وشبحه قوي / وبعض الوحي في متناول يده”. هذا “الملثم” لا تنفد مفاجآته التي ستأتي دون شك بالعيد الكبير غداً، فعلى رغم التربة المالحة سيظل المقاومون يسقون “حديقة الحلم”، من دون أن يخشوا الموت الذي أصبح ملكاً للجميع مثل الكلمات. ويقول طه، مكرراً المعنى نفسه في نهاية الكتاب: “كل الكلام الذي أريد أن أقوله دون توقف: لا شيء وكل شيء / والموت ملك للجميع مثل الكلمات”. والشاعر يدرك تماماً أن الدم هو وحده الطريق إلى الحرية، “نعرض بضاعتنا الحمراء لنشتري حريتنا الملونة”، “سترتفع الحجارة وتغني / ويمتلئ عش الأحلام / وستخرج الطيور من تحت الأنقاض”. إنه اليقين القوي الذي يجعل الفلسطينيين قادرين على الإصرار، وصنع حياة جديدة قائمة على الحرية والعدل.