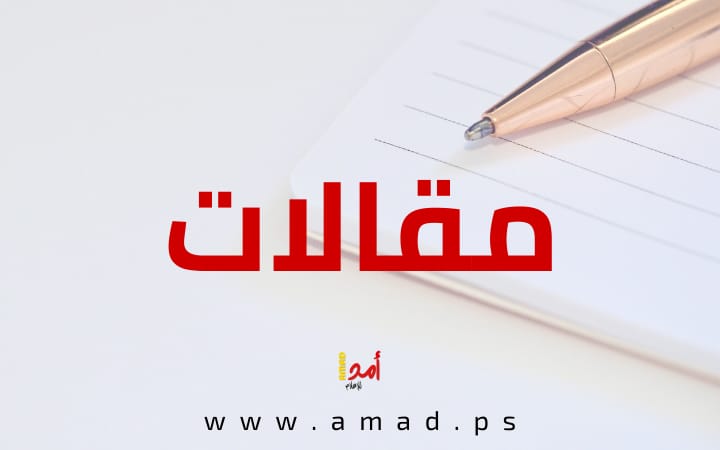أمد/ تُشكّل الرواية الفلسطينية أداة فنية بارزة في تمثيل التجربة الوجودية والوطنية للفرد الفلسطيني، لاسيما ضمن ثنائيات الداخل والخارج، والحضور والغياب، والانتماء والنفي. فهي تصور الأحداث، وتنفذ إلى عمق الشعور وتسائل موقع الذات بين الجغرافيا والسياسة والذاكرة. في هذا السياق، تطرح رواية عين التينة (2025) لصافي صافي نصًا حواريًا تأمليًا يكشف جرح الهوية الفلسطينية، ويبتعد عن السرد التقليدي ليعيد التفكير في مفاهيم الانتماء والفقد.
تعتمد الرواية على تقنيات سردية تتيح تفكيك ثنائية الذات والآخر، وتؤسس لعلاقة معقدة بين الفرد والمنفى. ومن خلال التأملات الداخلية، يُعاد تشكيل الوطن كفضاء شعري ورمزي، بالإضافة إلى كونه معطىً جغرافيا فقط. وهكذا، يتحوّل النص إلى مشروع أدبي يُعيد مساءلة المفاهيم الوطنية المستقرة، ويعكس الاضطراب الوجودي للفلسطيني بين ماضٍ مثقل وحاضر مفتت.
مدخل إلى المنهج الأسلوبي وتطبيقه في قراءة الرواية
الأسلوبية منهج نقدي يُعنى بدراسة النصوص الأدبية من خلال التركيز على البعد اللغوي والجمالي، إذ تنظر إلى اللغة الأدبية كأداة فنية تُشكّل جوهر المعنى، مع وسيلة للتوصيل. وتتميّز هذه اللغة بانزياحاتها عن اللغة اليومية من خلال أدوات مثل التكثيف والرمزية والانقطاع، مما يمنح النص عمقًا وتأثيرًا خاصًا. في السياق الفلسطيني، تتجاوز هذه الانزياحات وظيفتها الجمالية لتتحول إلى فعل مقاومة، وأداة لتشكيل الوعي والتعبير عن الذات في وجه التهميش.
ومن خلال هذا المنظور، تبدو رواية عين التينة لصافي صافي نصًا لغويًا واعيًا، يروي ، ويصوغ التجربة عبر لغة شعرية وتأملية. تستثمر الرواية المونولوج الداخلي وتكرار الصور وانزياح المعاني، لتخلق خطابًا ذاتيًا مفعمًا بالانفعال والأسئلة الوجودية. وبهذا، تتيح القراءة الأسلوبية فهم عين التينة كنص يُعيد تشكيل الوطن والذات من خلال اللغة، ويعكس تجربة المنفى الداخلي باعتبارها أزمة لغوية وشعورية عميقة.
ثانيًا: تعدد الضمائر وتناوب الأصوات: أنا وأنت/ نحن وهم
تعتمد الرواية على تقنيات الحوار الداخلي والخارجي، وتتوزع السرديات بين ضمير المتكلم (أنا)، والمخاطب (أنت)، لتوليد مساحة مشحونة بالتوتر والحميمية في آن. يقول الراوي: “لست أدري. ما دمنا تواصلنا، والتقينا، فنحن من وطن واحد، لم أنسك ولم تنسني”، ما يكشف عن حضور كثيف للذات القلقة التي لا تعثر على يقين نهائي.
التناوب بين ضمير “أنا” و”أنتِ” يُنتج خطابًا مزدوجًا بين العام والخاص، ويُكرّس لغة رمادية ترفض القطيعة، لكنها أيضًا لا تبلغ المصالحة. ويمثل هذا التوتر نموذجًا أسلوبيًا لانشطار الهوية في ظل احتلال خارجي وانقسام داخلي.
ثالثًا: الذات في مرايا المنفى وعي الاغتراب وقلق الهوية
يبدو الاغتراب، في رواية عين التينة، تجربة وجودية عميقة، لا تنحصر في البُعد الجغرافي ، بل تتسرب إلى عمق الهوية والوعي بالذات. يظهر هذا بوضوح في تساؤلات السارد: “هل تصدق أني هنا في الوطن؟ هل الوطن هنا أم هناك؟ هل تصدق أننا معًا؟ ربما هي أحلام. دعنا نحلم ونعيش في الأحلام”. هذه الأسئلة تتجلى كاستراتيجية لإعادة إنتاج القلق الوجودي المرتبط بالمنفى، والانشطار الداخلي الذي يعيشه الفلسطيني بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.
يتكرّر الاستفهام ويتخذ طابعًا إنكاريًا يُكثف الشعور بالتيه، ويجعل من الغربة حالة شعورية تتجذر في الوعي ذاته. التكرار هنا لا يخدم المعنى فحسب، بل يضاعف أثر الحيرة، ويُعمّق الشعور باللايقين، كما لو أن اللغة نفسها عاجزة عن القبض على حقيقة الانتماء.
بهذا، يتحول المنفى في الرواية من كونه مجرد وضع خارجي إلى مرآة داخلية تعكس تصدّع الذات، وتُشكّل فضاءً سرديًا تتقاطع فيه الأسئلة الكبرى حول الوطن، والهوية، والذاكرة، والانتماء. وهو ما يتناغم تمامًا مع المنهج الأسلوبي، الذي يُعنى بكيفية تجسيد هذه الأسئلة عبر البنية اللغوية للنص، بجعلها تُعاش لغويًا.
رابعًا: المكان بوصفه ذاتًا متشظية بيسان كرمز للتكوين والانكسار
تحضر بيسان في رواية عين التينة ليس فقط كحيز جغرافي محدود، بل كمكان ميتافيزيقي يُشكّل نواة للذات الساردة، ومجالًا داخليًا يتقاطع فيه الوعي بالذاكرة والحنين. في أحد أكثر المقاطع دلالة، تقول حنان: “أرى نفسي هناك. أبحث عن نفسي منذ سنين، ولا أجدها. ربما أجدها هناك”. هذا القول لا يعبّر عن شوق مكاني فقط، بل يكشف عن أزمة وجودية تمتزج فيها الهوية بالمكان، والانتماء بالغياب.
بيسان، في هذا السياق، تتحول إلى مرآة للذات، وطن داخلي يقابل الجغرافيا ، ويتقاطع مع صورة الذات المشروخة والمنفية. فهي ليست مدينة فُقدت ، بل رمز لتكوينٍ أول وانكسار لاحق، تمثّل فيها العودة الحلمية بحثًا عن الذات المبعثرة. وهكذا، تنتج الرواية دلالة مزدوجة للانتماء: انتماء إلى الذاكرة لا إلى الواقع، وإلى الرمز لا إلى الجغرافيا الفعلية. يصبح المكان وعاءً للذات، يعكس تصدّعها وتوقها إلى الاكتمال، ويعبر عن شروخ الهوية أكثر مما يدلّ على موقع مادي بعينه.
خامسًا: الحنين والانزياح الزمني: جدلية الماضي والحاضر
يتكرر في الرواية استخدام ألفاظ مثل: “ذاكرة”، “تاريخ”، “أيام الجامعة”، “أفلام المراهقة”، و”اللقاء الأول”، مما يكرّس حالة سردية تقوم على الاستعادة الزمانية عبر الحنين. فالماضي هو الفضاء الحقيقي الذي تتكشّف فيه الذات وليس مجرد خلفية. تقول حنان: “ربما لأن أغنية بيسان تشير إلى اسمي. لكنها تشير أيضًا إلى الجداول والتراب، وكأنني هناك”.
سادسًا: الحوار والتكرار والتوازي الأسلوبي: إيقاع الوجدان المنكسر
يعتمد النص على بنية تكرارية تجعل من بعض العبارات مفاتيح دلالية متكررة، مثل: “كن صديقي”، “لست أدري”، “هل الوطن هنا؟”، وهي عبارات تحوّلت من مجرد خطاب إلى لازمة شعورية توازي الغنائية الداخلية للنص.
هنا، لا يخدم التكرار الوظيفة الجمالية فقط، بل يُعيد إنتاج المعنى عبر إلحاح وجداني ينبئ عن استحالة الوصول. فالتكرار يعكس الدوران حول الذات، وغياب الفعل الحاسم، ما يُرسّخ فلسفة السكون مقابل الحركة الظاهرية.
سابعًا: الرمز والإزاحة الناموسية ككناية عن الحب المؤجَّل
تُعد الناموسية إحدى أبرز الصور الرمزية التي توظفها رواية عين التينة، إذ تتحول من عنصر مادي بسيط إلى استعارة مركبة ترمز إلى علاقة ملتبسة ومكبوتة بين العاشقين. ففي قول الراوي: “الناموسية، ترى كل شيء تحتها… لكنها تمنع الحشرات من الوصول. الحشرات؟ نعم، خاصة اليعاسيب”, تنفتح الصورة على مستويات دلالية متشابكة، يتداخل فيها الإيحاء بالعزل والحماية مع الإحباط والرغبة.
لا تكتفي هذه الصورة بتمثيل العلاقة العاطفية المؤجلة، بل تمتد لتعبّر عن ثنائيات أوسع: الحماية مقابل الانفصال، الرغبة مقابل الكبح، والحضور مقابل الغياب. وهنا، تصبح الناموسية حجابًا شفافًا يفصل الذات عن الآخر، والواقع عن الممكن، والحرية عن قيدها. وبهذا، تنجح الرواية في استخدام الإزاحة اللغوية لتكثيف الشعور بالحصار الداخلي، حيث تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى رموز لحالات وجودية أعمق.
هذه القدرة على شحن العناصر المادية العادية بدلالات رمزية ، تكشف عمق التجربة الإنسانية وتعقيدها، وتتيح للكاتب أن يلامس ما لا يُقال بشكل مباشر، بل يُفهم عبر الطبقات الخفية للنص.
ثامنًا: مفهوم الوطن من الطابو إلى الوجود
في رواية عين التينة، يتحرر مفهوم الوطن من تمثيله المألوف كوثيقة ملكية (الكوشان) أو مجرد حق قانوني، ليُعاد تصوره كحضور داخلي، ككينونة شعورية تنبض في عمق الذات. تظهر هذه النقلة بوضوح في العبارة: “وجودنا هو الكنز… وفي داخل الداخل حيث نحن”، حيث يتحول الوطن إلى تجربة حسية ومعيشة، لا يمكن اختزالها في أوراق أو حدود.
هذا التحوّل ينسجم تمامًا مع الرؤية التي تنظر إلى اللغة على أنها فضاء تتجلى فيه الكينونة . فالكلمات هنا لا تكتفي بالإشارة إلى الوطن، بل تعيد خلقه من داخل الوعي، كامتداد للذات، لا ككيان خارجي. وبهذا المعنى، تصبح اللغة وسيلة وجودية تُنتج الوطن كما يُنتج الشعور، في تداخل دقيق بين اللغة والتجربة، بين التعبير والحضور.
تاسعًا: بنية السرد المفتوح وتعدّد المستويات الزمنية
تنفتح رواية عين التينة على شكل سردي حرّ ، ولا تتقيّد ببنية سردية تقليدية تقوم على التسلسل الخطي من بداية ووسط ونهاية، بل تقوم على مقاطع متقطعة تتداخل فيها التأملات والحوار الداخلي، وكأن النص حوار طويل بين وعيين متقابلين. هذا التفكك البنيوي لا يُعدّ خللًا، بل يتناغم مع الرؤية التي تنظر إلى الزمن بوصفه تجربة ذاتية لا خطية، تتحرك فيها الذاكرة والانفعال بحرّية خارج قوالب الترتيب الزمني الصارم.
يتخذ الزمن في الرواية شكل دورة وجدانية، حيث يتداخل الماضي بالحاضر والممكن، وتتحول اللحظة إلى نقطة التقاء زمنية وشعورية. ومن خلال هذا البناء، تترسّخ الفكرة الجوهرية في الرواية: أن الذات الفلسطينية ليست وحدة مستقرة، بل كيان موزّع يتنقل عبر خرائط متشابكة من الزمان والمكان، في حالة دائمة من البحث عن التماسك والمعنى.
عاشرًا: الرواية بين الحنين وتجديد التعبير
تنجح عين التينة في تقديم تجربة سردية ذات حساسية عالية واضحة، حيث تُعالج أزمة الهوية الفلسطينية المعاصرة من خلال لغة تجمع بين الشاعرية والتأمل، بعيدًا عن المباشرة السياسية أو النزعة العاطفية الزائدة. تتقاطع الذات مع العالم عبر سرد داخلي يعيد تأطير مفاهيم الوطن والحنين والانتماء، ويقدمها في قالب فردي حميمي، دون الانفصال عن السياق الجماعي.
ومن خلال أدوات أسلوبية مثل التكرار، والانزياح، والتوازي، والرمزية، والاستفهام، وتعدد الأصوات، يُعاد تشكيل الوعي الفلسطيني داخل النص، بما يواكب التيار الحداثي في السرد الفلسطيني، الذي لا يكتفي بتوثيق المعاناة، بل يُعيد التفكير فيها من منظور لغوي وجمالي جديد. وبهذا، تندرج الرواية ضمن الأعمال التي تُمثّل نقلة نوعية في التعبير عن الذات الجماعية بلغة فردية، مشحونة بالتفكر، والتكثيف، والانفتاح على التأويل وهي تختلف عن روايات الكتاب الفلسطيين التي تركز على المقاومة او السيرة الذاتية كمكون اساسي للسرد الذي يحاول التركيز على الهوية الماضية لا الواقع المتشظي أو المنفى الواقع.
خاتمة
تقدّم رواية عين التينة معالجة عميقة للمنفى الداخلي، لا بوصفه نتيجة للاحتلال فحسب، بل كأزمة وجودية تمزّق الهوية الفلسطينية بين الانتماء والانفصال. تستلهم الرواية تقنيات سردية حداثية مثل المونولوج الداخلي وتداخل الأزمنة والنبرة الحنينية، لتعيد تأطير مفاهيم الوطن والهوية بلغة تأملية رمزية. ومن خلال تحليل أسلوبي دقيق، يتّضح أن الرواية لا تكتفي بوظيفة السرد، بل تجعل من الأسلوب بنية حاملة للفكر، تُعبّر عن تحوّل السرد الفلسطيني من الجمعي إلى الفردي، ومن الحكاية إلى التأمل