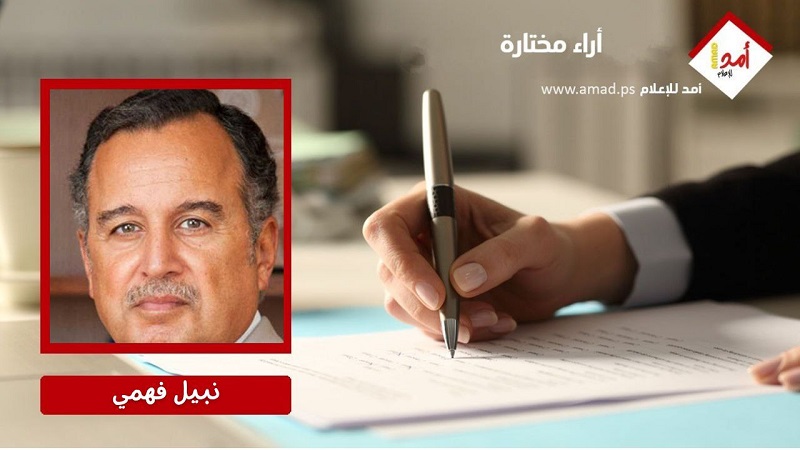أمد/ شهد أغسطس (آب) الماضي سلسلة من التصريحات والسياسات العامة التي تُقدم دليلاً دامغاً جديداً على أن إسرائيل لا تريد السلام مع الفلسطينيين، وأنها تسعى إلى تحقيق طموحات الهيمنة بالشرق الأوسط، من خلال الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتقسيم الدول القومية حولها، بخاصة في المشرق وغرب آسيا، من خلال الهويات العرقية داخل أو عبر الحدود على الهوية الوطنية العربية، وستكون لهذه الأهداف عواقب إقليمية وعالمية وخيمة إذا تُركت من دون معالجة من المجتمعين الدولي والعربي.
ومن ضمن التصريحات والأحداث الأخيرة تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، ورفض التعاون لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، أو التزام السعي في فترة ما بعد وقف إطلاق النار نحو حل الدولتين، بينما شرع صراحة في خطة لاحتلال غزة بالكامل، بذريعة محاربة “حماس”، وتجرأ على انتقاد الدول المجاورة لعدم سماحها للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي في غزة بدخول أراضيها.
وعلاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء صراحة على التلفزيون الإسرائيلي أنه يتبنى دوافع وطموحات دينية متوارثة عبر الأجيال من أجل “إسرائيل الكبرى”، وهي عبارة تُستخدم لتشمل فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتضم إليها أراضي أخرى في الأردن وسوريا ومصر وخارجها مرات أخرى، لذا من المناسب العودة بإيجاز إلى أساس فكرة ومفهوم “إسرائيل الكبرى” والتطورات والتداعيات.
التفسيرات الكتابية والدينية والسياسية
مفهوم “إسرائيل الكبرى هو تعبيرٌ يحمل معاني كتابية وسياسية عدة تطورت عبر الزمن، وغالباً ما يستخدم المصطلح بطريقة وحدوية للإشارة إلى الحدود المنشودة لإسرائيل، ويعود إلى الرؤية الكتابية لـ”أرض الميعاد”، كما وردت في سفر التكوين 15: 1821، ويتحدث عن أرض شاسعة وُعدَ بها أحفاد إبراهيم (عليه السلام)، تمتد “من وادي مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل أجزاءً من مصر وسوريا وتركيا والعراق في العصر الحديث.
ويختلف هذا التفسير الأوسع عن روايات توراتية أخرى، مثل الحدود الأكثر تقييداً لقبائل إسرائيل الـ12 الموضحة في سفر العدد 34: 115 وسفر حزقيال 47: 1320.
وفي ظل هذه الأصول التوراتية المتنوعة، اكتسب مصطلح “إسرائيل الكبرى” معنيين سياسيين حديثين مميزين، الأول يشير إلى مجموع أراضي دولة إسرائيل المستخدم دولياً، وهي الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة عام 1967، الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وغالباً ما يُعبر عنه بالعبرية بـ”أرض إسرائيل الكاملة”، أما التعريف الثاني، وهو أوسع نطاقاً، فيحافظ على الرؤية التوراتية لسيادة تمتد من النيل إلى الفرات، ونشهد الآن تنامياً في تبني هذه الرؤية المتطرفة داخل إسرائيل.
إذاً المتبنون مفهوم “إسرائيل الكبرى” يعتبرون أن له بعداً فريداً يميزه عن الحركات الوحدوية العلمانية البحتة، باعتباره لا يقوم فقط على الإقامة التاريخية أو الاستمرارية العرقية، بل كذلك على الإيمان بعهد إلهي، إذ تعتبر الأرض “إرثاً من الله” للشعب اليهودي، ويضيف هذا التكليف الديني تبريراً أيديولوجياً وأهمية للمشروع السياسي.
هرتزل إلى جابوتنسكي: نشأة فكرة سياسية
تعود نشأة فكرة “إسرائيل الكبرى” كمفهوم سياسي إلى الأيام الأولى للحركة الصهيونية، حين رافقت الرؤية السائدة والبراغماتية للوطن القومي، وفي حين ركز الصهاينة العماليون الأوائل، بقيادة شخصيات مثل ديفيد بن غوريون وحاييم وايزمان، على العمل التدرجي لامتلاك الأراضي وبناء المستوطنات داخل فلسطين، ظلت فكرة الإقليم الأقصى ومفهوم “إسرائيل الكبرى” حاضرة باستمرار.
وقد صاغ قادة صهاينة بارزون، مثل تيودور هرتزل والحاخام فيشمان، عضو الوكالة اليهودية لفلسطين، رؤية لدولة يهودية تمتد “من وادي مصر إلى نهر الفرات”، ومهّدت هذه المحادثات المبكرة الطريق الأيديولوجي لطموح وطني أوسع.
وكان صعود الصهيونية التصحيحية، بقيادة زئيف جابوتنسكي في عشرينيات القرن الماضي، نقطة تحول في التطور السياسي لهذا المفهوم، حين رفضت النهج الدبلوماسي الحذر لنظرائهم من الصهيونية العمالية، ودعت إلى رؤية أكثر تشدداً تصر على حق اليهود في السيادة على كامل أرض إسرائيل، بما في ذلك فلسطين الانتدابية وشرق الأردن. وتواصلت أيديولوجية جابوتنسكي في مبدأ أن الدولة اليهودية لا يمكن تأمينها والحفاظ عليها إلا من خلال “جدار حديدي” من القوة. وأصبح هذا الرفض للتقسيم وتبني أقصى قدر من التوسع الإقليمي ركيزة أساسية للحركة.
تجلّى هذا الموقف الأيديولوجي في منظمة الإرغون زفاي لئومي، وهي جماعة شبه عسكرية تصحيحية، وفي ملصق دعائي أصدرته المنظمة عام 1931، صوّر بوضوح خريطة كُتب عليها “أرض إسرائيل”، تشمل كامل أراضي فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني وإمارة شرق الأردن، التي طالبت بها الإرغون بالكامل لإقامة دولة يهودية مستقبلية. وكان هذا العمل تعبيراً واضحاً ومبكراً عن مفهوم “إسرائيل الكبرى” كهدف سياسي ملموس، وليس مجرد هدف روحي.
وكانت حرب 1967 الحدث المهم الذي حوّل مفهوم “إسرائيل الكبرى” من موقف أيديولوجي هامشي إلى مشروع سياسي سائد يحظى بدعم جماهيري، إذ اعتبر كثر في إسرائيل أن الغزو السريع والحاسم للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان معجزة عصرية وتحقيقاً لنبوءة توراتية. وبالنسبة إلى عدد متزايد من الصهاينة المتدينين، اعتبروا هذا النصر العسكري حدثاً مسيانياً، وقد غرس هذا الشعور بالتأييد الإلهي في المشروع السياسي حماسة دينية عميقة.
وفي غضون شهر من الحرب، جرى تشكيل “حركة إسرائيل الكبرى”، وهي منظمة سياسية دعت الحكومة إلى الاحتفاظ بالأراضي المحتلة بصورة دائمة وتوطين السكان اليهود فيها. وكان لهذه المنظمة دور فعال في حشد الدعم الشعبي لضم هذه الأراضي واستيطانها، بخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
المشروع الاستيطاني: إستراتيجية لا رجعة فيها
كان النجاح الأبرز والأطول عمراً لمشروع “إسرائيل الكبرى” هو إنشاء مشروع استيطاني قوي ومتوسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولهذا المشروع دافعان رئيسان، الأول أيديولوجي ومسيحاني، يهدف إلى تحقيق النبوءة التوراتية باستيطان أرض إسرائيل. ومع مرور الوقت جذبت أيضاً الإسرائيليين الذين لديهم اهتمامات أكثر واقعية واقتصادية ونوعية حياة، مثل انخفاض كلف السكن وتوافر المساحات المفتوحة. وقد دعمت الحكومة هذا التنويع بنشاط من خلال إنشاء وتمويل مستوطنات حضرية وتسويقها على أنها ضواحي مريحة وبأسعار معقولة في إسرائيل نفسها. وقد ساعدت هذه الخطوة الإستراتيجية في تطبيع المشروع الاستيطاني وتضييق “الفجوة المجازية” بين المستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين.
وفي الأعوام التي أعقبت حرب عام 1967، استندت سياسة الاستيطان التي انتهجتها الحكومات بقيادة حزب العمل إلى حد كبير على خطة ألون، التي اقترحت ضم غور الأردن وغوش عتصيون ومناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية، ذات كثافة سكانية عربية ضئيلة، لأغراض أمنية، أي أصبح هناك قدر من توافق المصالح بين الأيديولوجية الدينية والتطلعات والحاجات الإستراتيجية الوطنية.
وتطور الأمر مع وضع خطة دروبلز التي وُضعت لاحقاً في عهد الليكود عام 1978، التي هدفت إلى استيطان واسع النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، بهدف “منع قيام دولة فلسطينية” من خلال إنشاء سلسلة من المستوطنات اليهودية على طول سفوح التلال، مع محاصرة البلدات الفلسطينية ومنع أية تنمية حضرية فلسطينية متواصلة.
ودعمت الحكومة هذه الجهود بإعانات ومزايا مالية كبيرة، وارتفع عدد المستوطنين إلى أكثر من 700 ألف مستوطن اليوم، بمن فيهم المستوطنون في القدس الشرقية، وهو خلق متعمد للحقائق الجيوسياسية على الأرض. فمن خلال إقامة المستوطنات بصورة إستراتيجية لتعطيل التواصل الجغرافي الفلسطيني، وبناء بنى تحتية للطرق الالتفافية، جعلت الحركة حل الدولتين صعباً مادياً وسياسياً، إن لم يكن مستحيلاً. ومن وجهة النظر الإسرائيلية يمثل هذا التوسع المادي نجاحاً جوهرياً لمشروع “إسرائيل الكبرى”.
من حيروت إلى الليكود وما بعدهما
يرتبط النجاح الأيديولوجي لمفهوم “إسرائيل الكبرى” ارتباطاً وثيقاً بالصعود السياسي للصهيونية التصحيحية وخلفائها المعاصرين، بعد قيام إسرائيل عام 1948، شكّل قدامى أعضاء منظمة الإرغون شبه العسكرية حركة حيروت (الحرية). منذ انطلاقتها، اتسم برنامج حيروت بالتطرف الشديد، مُصراً على قدسية الحدود التاريخية لأرض إسرائيل، بما في ذلك الأراضي الواقعة على ضفتي نهر الأردن. في البداية، كانت حيروت منبوذة سياسياً، إنما شهدت عام 1965 خطوة حاسمة في ترسيخ هذه الأيديولوجية، حين انضم حزب حيروت إلى الحزب الليبرالي لتشكيل كتلة غاهال، التي أصبحت لاحقاً نواة حزب الليكود عام 1973. وشكلت انتخابات “الانقلاب” التاريخية عام 1977، التي أوصلت الليكود، بقيادة مناحيم بيغن، إلى السلطة، وللمرة الأولى، أصبحت أيديولوجية “إسرائيل الكبرى” المبدأَ الموجه لقيادة الدولة، إذ كان قادة الليكود اللاحقون، مثل إسحاق شامير، من أشدّ المؤيدين لهذه الفكرة، ممّن منحوا حركة الاستيطان الشرعية والتمويل الحكومي.
وعلى مدى العقود التي تلت عام 1977، رسّخ مشروع “إسرائيل الكبرى” مكانته السياسية من خلال سيطرته على مؤسسات رئيسة، وأصبحت حركة الاستيطان، على وجه الخصوص، قوة سياسية فاعلة، إذ يشغل قادتها مناصب بارزة في الجيش يكتسبون نفوذاً داخل الحكومة، بما في ذلك مناصب وزارية، ويتجلى النجاح السياسي للحركة في نفوذ شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصباً وزارياً يتمتع بسلطة مباشرة على سياسة الاستيطان، الذي صرّح بأن هدفه هو “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”. كذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إنشاء دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل، محاولاً مجدداً استخدام حجة “التهديد الأمني” الزائفة لتبرير سياساته.
ومن أحدث الدلائل على دمج هذا المفهوم بصورة كاملة هو التأييد العلني لرؤية “إسرائيل الكبرى” من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه. وبينما ربما سعى سياسيون في الماضي إلى تحقيق أهداف المشروع من دون استخدام خطاب متطرف صراحة، فإن إعلان نتنياهو عن ارتباطه “المطلق” و”الوثيق” بهذه الرؤية يشير إلى تحول علني جذري في السياسة الإسرائيلية. يُظهر هذا التأييد العلني من أعلى مستويات الحكومة أن المشروع قد انتقل من طموح هامشي إلى هدف سياسي مُعلن ومقبول.
العواقب غير المقصودة
على رغم نجاحاته السياسية داخل إسرائيل، فإن مشروع “إسرائيل الكبرى” قد واجه انتقادات قانونية ودبلوماسية دولية قوية ومتزايدة، باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويستند هذا الموقف الدولي الجامع إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكدت كثير من الهيئات الدولية هذا الموقف مراراً وتكراراً، فعلى سبيل المثال، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2334 عام 2016، الذي أعلن أن المستوطنات “انتهاك صارخ” للقانون الدولي “بلا أساس قانوني”.
وقد عزّزت محكمة العدل الدولية هذا الموقف القانوني، حين أكدت في حكم صادر عام 2024 عدم قانونية المستوطنات ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها. وخلص حكم المحكمة إلى أن سياسات إسرائيل تنتهك بصورة واضحة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبينما قدّمت إسرائيل حججاً بأن الأراضي ليست “محتلة” لعدم وجود سيادة قانونية معترف بها قبل عام 1967، وأن اتفاقية جنيف لا تنطبق عليها، فقد دحضت محكمة العدل الدولية هذه الحجج صراحة، ودانت أكثر من 31 دولة عربية وإسلامية تصريحات نتنياهو، واصفة إياها بأنها “انتهاك صارخ وخطر للقانون الدولي”، و”تهديد مباشر للأمن القومي العربي”. إضافة إلى ذلك، دانت أكثر من 20 دولة أوروبية ودول أخرى خططاً استيطانية محددة، مثلE1، واصفة إياها بأنها “انتهاك للقانون الدولي” وتهديد جوهري للسلام.
يتناسب النجاح السياسي لمفهوم “إسرائيل الكبرى” داخل إسرائيل تناسباً عكسياً مع مكانتها القانونية والدبلوماسية الدولية، فكلما ازداد نفوذ حركة الاستيطان داخل حكومة إسرائيل مما أدى إلى سياسات توسعية رسمية، ازدادت عزلة الدولة وإدانتها على الساحة العالمية. والسعي وراء “إسرائيل الكبرى”، مع تحقيقه أهدافه الإقليمية، يقوض في الوقت نفسه شرعية إسرائيل العالمية، مما يؤدي إلى فشل ذريع ومتصاعد.
الأعباء الاقتصادية والأمنية على الإسرائيليين والفلسطينيين
فرض السعي وراء “إسرائيل الكبرى” عبئاً اقتصادياً وأمنياً ثقيلاً على كل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، بالنسبة إلى الفلسطينيين، تسبب الاحتلال في أضرار اقتصادية جسيمة ومنهجية، وتشير تقارير “الأونكتاد” إلى أن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية أدت إلى خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، لقد عرقلت سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التنمية الفلسطينية بإغلاق البنوك البريطانية والعربية، وتقييد الوصول إلى الأراضي، ومنع بناء المنشآت الصناعية والبنية التحتية. وقد وُثِّقت عمليات هدم آلاف المباني المملوكة للفلسطينيين ومصادرة الأراضي على نطاق واسع.
ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على الفلسطينيين وحسب، إذ يُمثل مشروع “إسرائيل الكبرى” مفارقة اقتصادية عميقة لإسرائيل نفسها. فبينما يهدف إلى تأمين الأراضي والموارد، إلا أنه خلق حالاً من الجمود الاقتصادي الدائم والمكلف وغير المستدام. إن العبء المالي الناجم عن استمرار الاحتلال العسكري هائل، إذ تصل تقديرات الكلفة السنوية لاحتلال غزة إلى 30 مليار شيكل. وقد قُدِّرت الكلفة الإجمالية للنزاعات الأخيرة بأكثر من 250 مليار شيكل، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تعبئة مئات آلاف من جنود الاحتياط، ويبلغ الإنفاق الحكومي للمواطن الواحد في المستوطنات ضعف إنفاق الإسرائيليين في تل أبيب والقدس، حيث تُخصَّص معظم الأموال للأمن. إن تعبئة هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط لها تأثير بالغ ومدمر في الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وخسارة رأس المال البشري. إن الاستمرار في السعي وراء مشروع إقليمي يعتمد على الاحتلال العسكري والمستوطنات المدعومة يُنشئ حلقة مفرغة، إذ يتزايد العبء الاقتصادي المفروض ذاتياً مع كل مكسب إقليمي جديد مُتصوَّر من قبل البعض في إسرائيل.
المأزق الديموغرافي والتوترات الداخلية
يواجه مفهوم “إسرائيل الكبرى” على المدى الطويل تحدياً ديموغرافياً كبيراً. برفضه حل الدولتين واختياره واقع الدولة الواحدة، ويحمل في طياته أزمة هوية عميقة لإسرائيل إلا إذا لجأت إلى تهجير الفلسطينيين وبأعداد ضخمة، وتشير البيانات إلى تراجع الأغلبية اليهودية في مناطق رئيسة، مثل القدس. عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، كان اليهود يُشكلون 72 في المئة من سكان المدينة. وبحلول عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى 57 في المئة، وتشير التوقعات الديموغرافية إلى أنه من دون حل الدولتين، قد يصبح السكان اليهود أقلية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن بحلول عام 2050.
يتفاقم هذا التحول الديموغرافي بسبب الانقسامات الداخلية داخل السكان اليهود الإسرائيليين. ينمو المجتمع الأرثوذكسي المتشدد (الحريديم) بمعدل أسرع بكثير من الجماعات اليهودية الأخرى، إذ يبلغ معدل الخصوبة لدى النساء الحريديات 6.6 طفل في المتوسط مقارنة بـ2.1 للنساء العلمانيات، وفي حين أن هذا النمو يساعد على تعويض اتجاهات الهجرة السلبية، إلا أنه يخلق احتكاكاً اجتماعياً واقتصادياً. لا يخدم كثيراً من أفراد المجتمع الحريدي في الجيش، وهو أمر إلزامي بالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود الآخرين، مما يضع عبء دفاع الدولة بصورة غير متناسبة على السكان العلمانيين والليبراليين. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الصراعات الثقافية والاجتماعية بين هاتين المجموعتين. ويقدم المسار الديموغرافي خياراً أساساً لإسرائيل: البقاء دولة ديمقراطية ذات أقلية يهودية أو الاستمرار في السعي إلى دولة يهودية من خلال فرض نظام غير ديمقراطي على غالبية فلسطينية متنامية.
تناقض مفهوم “إسرائيل الكبرى” مع السلام
يتناقض السعي وراء “إسرائيل الكبرى” بصورة مباشرة ومتعمدة مع حل الدولتين، إذ لا تخصص أرض من فلسطين الانتداب البريطاني لدولة فلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة التي أنشأت إسرائيل، وتُعدّ خطة الاستيطان E1، وهي مشروع مثير للجدل قيد الدراسة منذ عقود، مثالاً واضحاً على هذا الفشل. تتضمن الخطة بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة لربط مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة بالقدس. في حال اكتمالها، ستؤدي هذه الخطة إلى قطع التواصل الجغرافي للضفة الغربية، وتقسيمها إلى قسمين، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة أمراً مستحيلاً فعلياً.
أعلن مؤيدو المشروع، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صراحة أن الخطة تهدف إلى “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”، وهذا الخطاب والإجراءات العملية على الأرض تُجسّد أيديولوجية تقوم على إنكار الهوية الوطنية الفلسطينية وحقهم في تقرير المصير. يشير تأييد كبار المسؤولين الحكوميين الصريح لهذا المشروع إلى نية ليس فقط احتلال الأراضي، بل ضمها بصورة دائمة ورفض أية صورة من صور السيادة المشتركة، هذا النهج، الذي شبهه الناشطون بـ”التطهير العرقي”، يقطع الطريق على أي إمكان لسلام تفاوضي ويضمن نشوب صراع مستقبلي ومتواصل.
الديناميكيات السياسية المعاصرة والمفهوم في العصر الحديث
أجمعت الدول العربية على أن مفهوم” إسرائيل الكبرى”، في شكله المحدود أو الأوسع الممتد إلى دول عربية أخرى يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويهدد الأمن القومي الوطني والإقليمي في الشرق الأوسط، ويمس سيادة الدول المجاورة، لمفهومه التوسعي وتجاوزاته على أراضي الغير.
مشروع “إسرائيل الكبرى” ليس مشروعاً سلمياً، بل هو أيديولوجية “حرب دائمة، وغزو، واستيطان” تقوم على إنكار هوية الفلسطينيين واحتلال أراضيهم بصورة دائمة، فضلاً عن عدم احترام سيادة الدول المجاورة، وهو يُغلق الباب أمام أي أمل في سلام دائم وعادل، وإن الإدانة الدولية المتزايدة، والتوترات الديموغرافية والاجتماعية الداخلية كلها تشير إلى مستقبل من عدم الاستقرار والصراع، وقد هيأت نجاحات المشروع في خلق حقائق ملموسة على الأرض وفي آنٍ واحد الظروف لفشله الإستراتيجي الطويل الأمد.
وتجدر الاشارة هنا مرة أخرى إلى أن التيارات الأيديولوجية والإستراتيجية الكامنة وراء فكرة إسرائيل الكبرى تمتد أبعد من الضفة الغربية وغزة، مؤثرة بعمق في الديناميكيات الإقليمية، وتصورات أمن الدول، والعلاقات الثنائية، وعلى سبيل المثال يمكن تصنيف تداعيات ذلك على الدول المجاورة على النحو التالي:
الأردن: “الضفة الشرقية” و”الوطن البديل”
إن المطالبة التاريخية للصهيونية التصحيحية بضفتي نهر الأردن، مُعرّفة أراضي فلسطين الانتدابية كوطن قومي يهودي، وضعت الأردن في موقف حساس للغاية. تضمنت رؤية زئيف جابوتنسكي صراحة الأراضي التي تُشكل الآن المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رغم أن التيار السياسي الإسرائيلي السائد قد تخلّى عن هذا الادعاء بعد استقلال الأردن ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية عام 1994، فإنه لا يزال يُمثل نقطة بلاغية للتيارات المتطرفة في اليمين الإسرائيلي. ولم ينس الأردن هذا التاريخ. النظام الهاشمي والأغلبية الفلسطينية من السكان حساسون للغاية تجاه أي تلميح إلى طموحات إسرائيلية إقليمية عبر نهر الأردن.
هذا ومن مخاوف الأردن الوجودية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو مفهوم “الوطن البديل”. وتتمثل هذه الفكرة في أنه إذا ضمّت إسرائيل الضفة الغربية بالكامل، فإنها ستسعى إلى حل التهديد الديموغرافي داخل إسرائيل بنقل السكان الفلسطينيين إلى الأردن، مما يحول الأردن فعلياً إلى دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع، ومن شأن هذا أن يُزعزع التوازن السياسي الدقيق للمملكة. ونتيجة لذلك، لا ينظر الأردن إلى توسيع المستوطنات وخطاب الضم في الضفة الغربية على أنهما قضية فلسطينية وحسب، بل تهديد مباشر لسيادته واستقراره، والأردن مدافع قوي عن حل الدولتين.
هذا ومن مؤشرات القلق الأردني العميق من تصرفات حكومة نتنياهو كانت تصريحات لوزير الخارجية الأردني الذي أشار فيها إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد مخالفة صريحة لاتفاق السلام المبرم بين البلدين ويضعها في سلة مهملات التاريخ.
سوريا: مرتفعات الجولان
إن الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان وضمها اللاحق لها هو مظهر مباشر لنسخة براغماتية من التوسع الإقليمي، تركز على الأمن، وترجمة عملية لمفهوم إسرائيل الكبرى. وبعد الاستيلاء عليها من سوريا عام 1967، قُدّرت مرتفعات الجولان في البداية لميزتها العسكرية الإستراتيجية، إذ وفرت حاجزاً ضد المدفعية السورية التي كانت تقصف سابقاً البلدات الإسرائيلية الواقعة أسفلها. ومع مرور الوقت، بخاصة بعد قانون الضم الصادر عام 1981، اكتسب الجولان أهمية أوسع. وعلى رغم ارتباطه بصورة أقل صراحة بالمطالبات التوراتية بإسرائيل الكبرى (مع أن بعض الجماعات تستشهد بوجود إسرائيلي قديم)، فإن الحكومة الإسرائيلية تبرر ضمها بأنه دائم وغير قابل للتفاوض نظراً إلى أهميته الإستراتيجية وثرائه المائي.
وكان هذا الضم هو العقبة الرئيسة أمام أية معاهدة سلام شاملة مع سوريا. بينما طالب نظام الأسد باستمرار باستعادة الجولان كاملة كشرط سابق للسلام، استبعدت الحكومات الإسرائيلية المختلفة هذا الأمر. وقد أدى تطوير المدن الإسرائيلية والزراعة في المرتفعات إلى خلق وقائع على الأرض تُحاكي مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، مما يجعل العودة مستبعدة سياسياً بصورة متزايدة داخل إسرائيل، وليس واضحاً حتى الآن مدى إمكان التوصل إلى حلول حول الجولان نظراً إلى تعنت إسرائيل على رغم تكرار الحكومة السورية الجديدة أن الصراعات الإقليمية ليست من أولوياتها.
لبنان: المياه والأمن و”الحدود الشمالية”
وإضافة إلى تداعيات المطالب والسياسات الإسرائيلية التوراتية المرتبطة بمفهوم “إسرائيل الكبرى” هناك دوافع وطموحات إسرائيلية مادية وأمنية تتجاوز الأراضي اللبنانية.
ويعتبر نهر الحاصباني مصدراً مائياً حيوياً لإسرائيل، وكثيراً ما انصبّ اهتمام السياسة الهيدرولوجية الإسرائيلية على تأمين الموارد المائية، وهو عامل رئيس في حرب عام 1967. وعلى رغم أن السيطرة على مصادر المياه ليست نزاعاً قائماً حالياً، فإنها لا تزال نقطة كامنة مرتبطة بحاجة إسرائيل إلى تأمين أراضيها الشمالية.
و من عام 1985 إلى عام 2000، حافظت إسرائيل على “منطقة أمنية” في جنوب لبنان، مبررة ذلك بضرورة حماية مجتمعاتها الشمالية من الهجمات العابرة للحدود. وكان هذا امتداداً مباشراً لمبادئها الأمنية الذي عززته عقلية إسرائيل الكبرى، أي وجوب السيطرة على جميع الأراضي اللازمة للأمن، كان الانسحاب عام 2000 انتكاسة لهذه العقيدة، لكن الحروب اللاحقة واستهداف قيادات “حزب الله” والاتفاق المبرم حديثاً برعاية أميركية وضع ضوابط أمنية مختلفة، وإن كانت المناوشات المستمرة، ولا تزال الأمور غير مستقرة عبر الحدود وداخل لبنان ذاتها، وهو ما يوفر لإسرائيل فرصة للانخراط في العمليات العسكرية حسب هواها.
مصر: احتواء ناجح للأيديولوجيا
تُمثل مصر حتى الآن أنجح مثال على احتواء تداعيات فكرة إسرائيل الكبرى من خلال السلام البارد والحدود الثابتة، إذ شكّلت اتفاقات السلام عام 1979 الاختبار النهائي لأيديولوجية إسرائيل الكبرى في مواجهة براغماتية الدولة، وكانت شبه جزيرة سيناء، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 شاسعة، وتزخر بموارد نفطية، وقد استوطنها الإسرائيليون، وغنية بالعمق الإستراتيجي، ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وهو نفسه من أصحاب التوجهات التنقيحية، الأولوية لمعاهدة سلام مع أكبر دولة عربية على حساب “مفهوم واسع لإسرائيل الكبرى”.
نجح اتفاق السلام ومفاوضات طابا في احترام الحدود الدولية مع وضع ضوابط عسكرية في سيناء، مما أدى إلى إنشاء جبهة جنوبية مستقرة لإسرائيل، بينما لا يزال الرأي العام المصري معادياً بشدة لإسرائيل، بتعاطفه ودعمه للقضية الفلسطينية، وكثيراً ما يُوصف السلام بأنه “بارد”.
وعلى رغم التزام حكومتي البلدين أحكام اتفاق السلام تجدر الإشارة هنا إلى أن التوجه التوسعي للحكومة الإسرائيلية وسعيها صراحة إلى فرض الهجرة القسرية للفلسطينيين عبر الحدود المصرية، والتصريحات الفجة لعدد من الوزراء الإسرائيليين كانت لها انعكاس بالغ السوء والخطورة بالنسبة إلى التزام إسرائيل نصوص المعاهدة، مما جعل الحكومة المصرية تنوه بصورة متكررة أن تلك التصرفات تشكل تهديداً للأمن القومي المصري، ولم تخف القوات المسلحة المصرية رفع درجة الاستعداد في سيناء مراراً.
الخلاصة
مفهوم “إسرائيل الكبرى المقصود به فلسطين الانتداب البريطاني يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، لأنه يحجم عن الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة مثله مثل بقية شعوب العالم. كذلك أثبتت التطورات التاريخية أن هذا المفهوم مرتبط ارتباطاً أساسياً ومتواصل مع “إسرائيل الكبرى” التوراتية والممتدة عبر حدود الدول المجاورة وصعوبة تحقيقه للأمان على الساحة الإسرائيلية تفرض التوسع والامتداد والهيمنة الإقليمية مما يشكل تهديداً صريحاً للأمن القومي الإقليمي.
وليس من المبالغة القول إن عدم تصدي المجتمع الدولي لهذا المفهوم الخطر والمتعارض مع كل القواعد الدولية له تداعيات خطرة على صدقية وفاعلية النظام الدولي ذاته. وتمتد تداعيات مفهوم إسرائيل الكبرى إلى ما هو أبعد من الأراضي الفلسطينية، فقد غذّى شكوكاً عميقة في الأردن، وأمام السلام مع سوريا، وأسهم في صراع دائم منخفض المستوى مع لبنان، ولم يُحتَو حتى الآن إلا على الجبهة المصرية لمصلحة السياسات الواقعية، ومن الأهمية الاستخلاص أن المبدأ الأساس للأيديولوجية والادعاءات الإسرائيلية التاريخية والأمنية يبرر السيطرة الدائمة على الأراضي المحتلة، وهذا لا يقضي فقط على احتمال قيام دولة فلسطينية، بل هو أيضاً محرك رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي، بخاصة علاقات إسرائيل مع جيرانها.
ويكشف تحليل مفهوم “إسرائيل الكبرى” عن ازدواجية عميقة ودائمة. فقد حقق بعض عناصر جوهره الأيديولوجي، المتجذر في كل من النبوءات التوراتية والقومية الوحدوية. ومن خلال مشروع استيطاني دؤوب ومدروس، خلق مؤيدوه حقائق ملموسة على الأرض جعلت حل الدولتين التقليدي مستحيلاً تقريباً من الناحية العملية. وقد أدى الصعود السياسي للصهيونية التصحيحية، من حركة هامشية إلى القوة المهيمنة في السياسة الإسرائيلية، إلى نقل هذه الرؤية المتطرفة من طموح مُعلن إلى هدف حكومي مُعلن.
ومع ذلك، ترتبط هذه النجاحات ارتباطاً جوهرياً بسلسلة من الإخفاقات الأساسية، إذ أدى السعي إلى التوسع الإقليمي إلى عزلة دولية متزايدة لإسرائيل، ودان المجتمع الدولي مراراً وتكراراً وبغالبية ساحقة المستوطنات، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، كذلك فإن المشروع خلق عبئاً اقتصادياً وأمنياً فرضه على إسرائيل، إذ حوّل موارد هائلة نحو الاحتلال العسكري ودعم سكان المستوطنات.
عن اندبندنت عربية