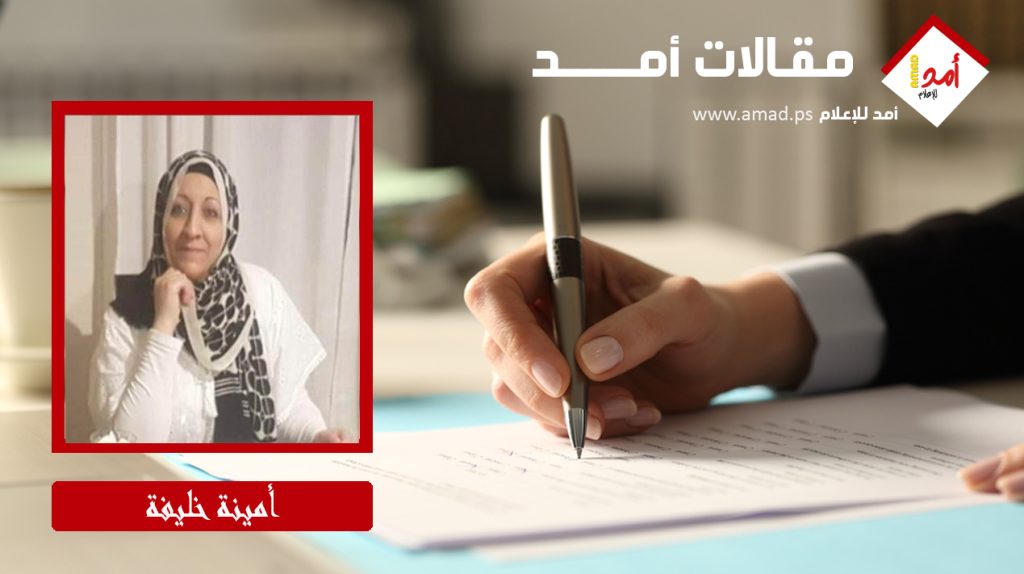أمد/ في قاعة مكتظة بالحضور في رام الله، رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى صوته محذراً من «تفاقم الأزمة الاقتصادية» التي تخنق الضفة الغربية.
هذا تحذير بدا أكثر من مجرد تصريح بروتوكولي، إذ عكس حجم القلق الذي يسيطر على القيادة الفلسطينية في ظل مؤشرات الانهيار المالي والاجتماعي.
الاجتماع الطارئ الذي استضافه المؤتمر الاقتصادي لم يكن مناسبة عادية، بل جاء على وقع أزمة خانقة تتمثل في احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب، وهو ما يشلّ قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، لأن ببساطة هذه العائدات التي تمثل شريان الحياة المالي تحولت إلى ورقة ضغط تُستخدم كلما تصاعدت التوترات السياسية أو الأمنية.
أيضا أرقام البطالة شكلت صدمة إضافية، إذ تجاوزت نسبتها 30 في المائة في الضفة الغربية، لتضع آلاف الأسر على حافة العوز، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بعدم توفر فرص عمل جديدة، بل بانهيار قطاعات قائمة أصلاً نتيجة القيود المفروضة على الحركة والتجارة.
الاقتصاديون الذين تابعوا مداخلات رئيس الوزراء أبدوا اتفاقاً عاماً مع تشخيصه للأزمة، لكنهم ذهبوا أبعد في تحليل الأسباب، فهم يرون أن المشكلة الجوهرية لا تنحصر في الموارد المالية، بل في القيود البنيوية التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، بدءاً من المعابر ووصولاً إلى التحكم في الموارد الطبيعية.
من وجهة نظر هؤلاء اء، فإن أي حلول مؤقتة كتوفير مساعدات أو قروض لن تكون أكثر من «مسكنات» لا توقف النزيف، لكن الحل الحقيقي كما يؤكدون يكمن في رفع القيود الاقتصادية، وهو مطلب يظل معلقاً بشرط سياسي وأمني بالغ التعقيد.
فالوضع الأمني، بحسب ما يجادل الاقتصاديون، ليس مجرد خلفية محايدة، بل شرط أساسي لفتح الأبواب أمام أي انفراج اقتصادي، وكلما تصاعدت المواجهات المسلحة أو ضعفت قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على إنفاذ القانون، كلما تشدد الاحتلال في إجراءاته وزاد خنق الاقتصاد.
والمعادلة تبدو إذن أشبه بدائرة مغلقة، فالاحتلال يفرض قيوداً بدعوى المخاوف الأمنية، والقيود تولد بطالة وأزمة معيشية، والأزمة تغذي بدورها نشاط الفصائل المسلحة التي تجد في تدهور الظروف بيئة خصبة لتجنيد الشباب العاطلين عن العمل.
أما الشارع الفلسطيني، فيختلط فيه النقاش الاقتصادي بالهم اليومي للأسر التي تنتظر رواتبها أو تبحث عن قوت يومها، وهناك شعور عام بأن الأزمة تجاوزت حدود المؤشرات المالية لتصبح تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، حيث تتزايد الهجرة الداخلية والخارجية، ويتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
أيضا التجار المحليون، الذين كانوا يوماً عصب الحركة التجارية في مدن الضفة، صاروا يتحدثون بلغة الإحباط. فالمعابر المغلقة والقيود على الاستيراد والتصدير جعلت من كل شحنة بضاعة مخاطرة غير مضمونة، وهو ما يضاعف خسائرهم ويقوض الثقة بالسوق.
ومع تفاقم الأزمة، يلوح في الأفق هاجس «الانفجار الاجتماعي» الذي يخشاه الجميع، فكلما ارتفعت البطالة وتعطلت الرواتب واشتدت القيود، ارتفعت احتمالات الاحتجاجات العنيفة أو اندلاع موجات من الغضب يصعب ضبطها. وهو سيناريو يرعب السلطة الفلسطينية كما يقلق الاحتلال نفسه.
ورغم ذلك، لا يغيب صوت الدعوات إلى الصمود والمبادرة، فبعض الاقتصاديين والسياسيين يشددون على أن تعزيز القطاعات المحلية كالزراعة والصناعات الصغيرة يمكن أن يخفف نسبياً من التبعية للاحتلال، حتى لو لم يحل الأزمة جذرياً.
في المقابل، يحذر آخرون من أن أي محاولة للتعويل على الذات ستظل محدودة المدى ما لم تُفتح الطرق والمعابر وتُرفع القيود. فالاقتصاد الفلسطيني، في نظرهم، لا يمكن أن ينمو داخل «قفص» مهما كان حجم الإرادة المحلية.
وهكذا تبقى الصورة مزدوجة: قيادة سياسية تدق ناقوس الخطر، خبراء يضعون أصابعهم على الجرح، وشارع يعيش كل يوم تحت وطأة الأرقام القاسية، أما الخلاص فيبدو مؤجلاً إلى أن تتغير المعادلة الكبرى بين الاحتلال والسلطة، وبين الأمن والاقتصاد، وهي معادلة لم يجد الفلسطينيون بعد مفتاح كسرها.