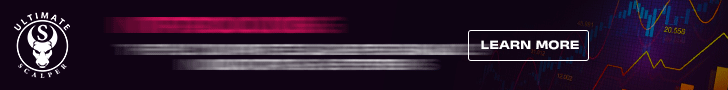إقامة العدل في الحقوق واجتناب الظلم في المستحقات

إن الإنسان خلق اجتماعيا بطبعه، ولا يمكنه أن ينفرد بمصلحة نفسه، بل لابد له من الاستعانة ببني جنسه، فواجب المعاوضة عليه ضرب من ضروب الدنيا والدين، فلو لم يجب على بني آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاجه لفسد الناس وفسد أمر دنياهم ودينهم. ومن ثم، فإن مصالحهم لا تتم إلا بالمعاوضة، وصلاح المعاوضة لا يكون إلا بالعدل الذي بعثت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وجعل هو الأصل في العقود كلها، حيث قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} الحديد:25، والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة.
فالعدل كما بيّن ماهيته ابن عاشور: (هو مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة في تعيين الأشياء لمستحقيها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير)، وقال: ولا يعتبر من العدل توزيع الأشياء بين الناس بالتساوي بدون استحقاق.
إن تحقيق العدل في الأموال يقتضي حصولها على وجه لا ظلم فيه، وذلك بأن تحصل إما بعمل مكتسبها أو بعوض مع مالكها أو بتبرعه بها أو بإرث، وبوضعها في موضعها الذي خلقت من أجله، وأمر الشارع الحكيم بالتزامه، وذلك بتأدية ما عليها من الحقوق والواجبات الدائمة والطارئة، وإتباع أرشد السبل في إنفاقها وتنميتها، ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الضرر عنها، وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق به حاجات جمهور من الناس لإقامة حياتهم.
وبناء عليه، جعل الفقهاء الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين، فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربًا دخلها الظلم وصارت محرمة من قبل الشرع، ولهذا جاء تحريمه صلى الله عليه وسلم لبيع الثمار قبل بدو صلاحها، فمتى بنيت المعاملات على هذا الأصل تحسنت طرق أدائها، وتم التبادل العادل بين المتعاملين، وحصلت الثقة بينهم، لأن العدالة في التصرفات مصلحة لحصول الضبط بها.
والعدل في المعاملات المالية وما يتعلق بها هو أن يكون التعامل في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات مبنيا على إيفاء كل طرف بما عليه من الالتزامات والشروط، فلا يبخس أحد حق أحد ولا يخدعه ولا يظلمه في صغير ولا كبير.
ولئن كانت الشريعة قد ألزمت المتعاملين بالعدل في تصرفاتهم بإيجابه عليهم، فإننا نجدها في المقابل قد ندبت إلى الفضل وحثت المسلمين عليه، حيث قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} البقرة:237، والفضل هو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، فإباحته تعالى أخذ المال من الواجد في الحال وأمره بانتظار المعسر هو العدل، ثم ندب إلى الفضل فقال: {وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة:280. ومن خلال هذا، يتبيّن لنا أن ما يقع من وجوه الفساد في المعاملات المختلفة مرجعه أو نتيجته الخروج عن حال العدل إلى حال الجور والظلم، لأنه لا يمكن أن يوجد فساد كان العدل علة وقوعه، قال الماوردي: (إنك لن تجد صلاحا كان الجور علة وجوده، ولا فسادا كان العدل علة ظهوره، وإنما تجتذب العلل إلى أصول نظائرها).
ويرجع عدم التشجيع على المقايضة لتعذر إمكانية معرفة المرء ما لم يكن خبيرا للمعادل الصحيح لسلعة معيّنة بمقياس سائر السلع الأخرى، وحتى اء أنفسهم لا يمكنهم أن يحسبوا المعادلات بين السلع إلا على وجه التقريب، ما يؤدي إلى إلحاق الظلم بأحد طرفي الصفقة. ولهذا، فإن استخدام النقود هو أفضل وسيلة لتفادي المبادلات غير المتعادلة والمتكافئة.
واعتمادا على مقصد العدالة الذي حرصت الشريعة على إقامته في كل شيء عموما وفي كل الأموال خصوصا، حكم الفقهاء بفساد العقود التي تقترن بها شروط تفضي إلى الإخلال بمقصد العدالة فيها، وبناء على هذا، جعل من الشروط المفسدة لعقد الوقف تخصيص البنين به دون البنات. وذكر ابن عبد الرفيع أن إخراج البنات من الحبس أشدّ عند الإمام مالك في الكراهية من هبة الرجل لبعض ولده، لقوله عز وجل: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} الأنعام:139.
ومن تمام عدل الشريعة في هذا الباب أنها كما حفظت أموال المسلمين، حفظت أموال الذميين وأوجبت الضمان على من أتلفها من المسلمين، حتى ولو كان المتلف مما لا يجوز امتلاكه في شريعتنا، قال ابن حارث الخشني: (من تعدى على ذمي فكسر له خمرا أو قتل له خنزيرا، وجب عليه قيمة ذلك).
وخلاصة الأمر أن الأمة يستقيم أمرها وتحفظ حقوقها وتنعم رعيتها برغد العيش عندما يسوّسها عدل شامل يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمّر به البلاد، وتنمو به الأموال، وتصان به أملاك الناس، ويأمن السلطان على حكمه، وتأمن الرعية على حقوقها، ولا يخاف فيه الضعيف من ضياع حقه، ولا يجرؤ القوي على ملك غيره، وقد قال الهرمزان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رآه قد نام مبتذلا: (حكمت فعدلت فأمنت فنمت)، ولا شيء أسرع في خراب العمران ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور.
* مدير تحرير مجلة “آفاق الثّقافة والتّراث”