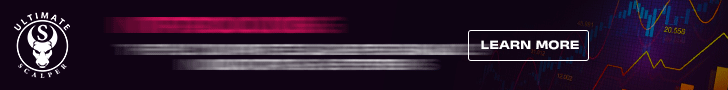عن هذه البلادة تجاه ما يحدث..

لم يكن مناسباً توجيه مثل هذا السؤال بُعيد «طوفان الأقصى» مباشرة، ولا حتى بعد عدّة أشهر منه.
والسبب الذي جعلني لا أضع كلمة، مناسباً، بين قوسين هو أن أي مجتمعٍ يتعرّض في ظروف معيّنة لضربات قاسية، وأحداث دامية وصادمة يمكن أن تتخلخل لديه هذه الأهليّة، بصرف النظر عن حقيقة أو زيف دوافع هذه الخلخلة.
المجتمع الإسرائيلي ــ وكما ثبت بالملموس، وبالدليل القاطع ــ ليس كأي مجتمع، ولا يخضع للمعايير المعروفة في قياس تلك الدوافع.
فباستثناء بعض النخب التقدمية المحسوبة على فكر وثقافة «اليسار»، بالمعنى الأيديولوجي، وليس بمعنى التصنيفات السياسية الإسرائيلية فإن غالبية كبيرة من هذا المجتمع لا تؤمن بالحقوق المتساوية مع الشعب الفلسطيني بقدر ما تعني المساواة العيش الحرّ والمستقل، والحقّ المتساوي بتقرير المصير والكرامة الإنسانية، كما هي هذه المساواة في أعراف وثقافة كل الشعوب الحيّة على هذا الكوكب.
معروف أن هذا المجتمع قد أُخضع قبل قيامه وتشكُّله إلى أكبر عملية خداع وتضليل، وعلى مدى عشرات السنين جرت عملية منظمة من غسل دماغ «اليهودي»، وخصوصاً في أوروبا، وتحديداً أثناء «المرحلة النازية والفاشية»، وما تلاها من مذابح ارتكبت بحقهم بحيث تحوّلت فكرة «الوطن القومي اليهودي»، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التأسيس بسلاسة ويُسر كبيرين.
صحيح أن الأيديولوجيا التوراتية في سياق انتقالاتها من النصوص المقدّسة إلى التفسيرات «التلمودية» قد مهّدت تاريخياً لهذا الشكل الفريد من تزييف الوعي، وغسل الدماغ، إلّا أن الأحداث السياسية التي مرّت باليهود قد جعلت وحوّلت هذا الوعي، وفعلت فعلها المباشر الفعّال وحوّلته إلى وعي «سياسي» من نوع خاص، وإلى قناعات سياسية من أعلاها وأعمقها وذلك لاقترانها وتزاوجها، بل وبسبب استيلادها من الموروث الديني «المقدّس».
هذا كلّه فيه درجة خاصة من الفرادة، وفيه أرضية خصبة للتفكير العنصري والاستعلائي، وفيه درجة غير مألوفة من الانصهار المَرَضي ما بين الأساطير الدينية والتلفيقات السياسية، وبحيث تحوّل الغالبية الساحقة من العلمانيين اليهود إلى صنف نادر، لا مثيل له، والذي «يولّف» بصورة تدعو إلى أقصى درجات الدهشة بين الميثولوجيا الدينية المضحكة في
استعاراتها وتصوّراتها، وبين أعلى أشكال العلمانية صرامة في بناء «الدولة»، وفي علاقات المجتمع، ومؤسّسات وسلطات الحكم فيه، وصلاحيات هذه المنظومات.
وخضع هذا المجتمع بمساهمةٍ مباشرة من منظماته السياسية، والتي كانت «تقاتل» على هيئة عصابات منظّمة إرهابية إلى عملية متّصلة ومتواصلة من الانفكاك التام أو شبه التام عن الواقع على مستويات ثلاثة على الأقل:
الأول، وهو الخلطة العجيبة في البعد الاجتماعي والثقافي ما بين الديني والعرقي، القومي والسياسي، وهي خلطة يسود فيها الديني الأساطيري، وليس النصوص المقدّسة المجرّدة،
والقومي العرقي، الإثني المفبرك والذي تمّ استلاله من الديني الأساطيري، والسياسي
الموغل في عنصريته وتوحُّشه، والمتحالف عضوياً مع الاستعمار الغربي.
فهذا المجتمع بصرف النظر عما وصل إليه من و»جود» واقعٌ تمّ اختراعه، تماماً كما تمّ اختراع الشعب، وتماماً كما تمّ اختراع الوطن، وتماماً كما تمّ اختراع الرواية والتاريخ، وبالتالي كما تمّ اختراع الحقوق، وتحوّل هذه الحقوق إلى شكل خاص وفريد من «الخصوصية» ومن «الحصرية»، أيضاً.
ومن هذه الزاوية، أيّ «واقعية» الوعي السائد، و»واقعية» السياق لتبلوره، و»واقعية» ما وصل إليه فعلياً من تغييب وتزييف وغسيل للدماغ، ومن «قناعات» مزوّرة على كل المستويات والأصعدة، فإنّ طرح السؤال الذي بدأنا به المقال، مباشرة بعد أحداث «طوفان الأقصى»، أو بعد عدة أسابيع وأشهر فقط من هذه الأحداث لم يكن مناسباً.
وإذا أضفنا إلى ذلك كلّه التحوّلات التي طرأت على هذا المجتمع منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، والانزياحات المتتالية في داخله نحو المزيد من التطرّف والعنصرية، وإذا ما دقّقنا في التطوّر النوعي الحاسم في العقود الثلاثة الأخيرة نحو مأسسة هذه العنصرية وهذا التطرّف، وتبلور «وعي» جديد تقوده منظمات سياسية أصبحت هي المنظمات الأكبر والأهمّ في المجتمع السياسي الإسرائيلي، وتحوّله إلى الوعي السائد والمسيطر، بعد أُفول مرحلة «اليسار» بالمعنى الإسرائيلي الخاص لهذا اليسار، وتمكّن «اليمين» الجديد في المجتمع الإسرائيلي من الإمساك والإطباق على كل أو معظم تلابيب الثقافة والتربية والإعلام فيه،
فإننا سنجد ودون عناء كبير أن الأهليّة الأخلاقية والإنسانية فيه أصبحت متنحّية وثانوية
وهامشية، وهي ما زالت، ويبدو أنها ستظلّ إلى زمنٍ بعيد مجرّد حالات نخبوية، ولم تتحوّل إلى تيّار حقيقي يمكن التعويل عليه.
العالم كلّه، بما فيه العالم الذي مهّد لقيام هذا المجتمع، وبنى وأسّس له كيانه الكولونيالي الخاص، وحماه، ومكّنه، وسلّحه، ووقف إلى جانبه ودعمه بكل السبل والوسائل، كما لم يفعل هذا العالم، مع أيّ مجتمع، أو مع أيّ شعب.. العالم هذا نفسه يرى أو بات يرى أنّ ما يقوم به هذا الكيان هو إبادة جماعية، وتطهير عرقي بحقّ غالبية ساحقة من المدنيين الفلسطينيين، وجلّهم من الأطفال والنساء، والعالم كلّه يقول، كفى لهذا التوحُّش، وكفى لسفك هذه الدماء، إلّا المجتمع الإسرائيلي، فهو مشغول بعد 16 شهراً من هذا الإجرام والتوحُّش بعدد من المختطفين أو الأسرى، وهو ليس معنياً إلّا بهم، وحولهم يتمحور الجدل، ويدور المظهر الرئيس للانقسام، وتتحدّد المواقف، وتُبنى التوجُّهات.
أكثر من 60% من المجتمع الإسرائيلي مع عقد «الصفقة» ــ لاحظوا هنا أرجوكم ــ حتى لو أدى ذلك إلى وقف الحرب..!
أي لو أن الأمر لا يتعلّق بالأسرى الإسرائيليين لما طُرح أصلاً وقف هذه الحرب، ولكان استمرارها بما انطوت عليه حتى الآن من قتل وإبادة وبطش وتطهير وتجويع وترويع وتعطيش هي من «طبيعة الأشياء»، ومن نوافل القضايا، ومن هوامش الاهتمامات، ومن سفاسف الهموم، ومن صغائرها.
أعود للقول إن الإجرام الذي مارسه «الغرب» ضد شعوب العالم لم يكن أقلّ من إجرام الصهاينة منذ «الفتوحات» الاستعمارية وحتى يومنا هذا، والإجرام الذي مارسه «الغرب» منذ إبادة الهنود الحمر، السكّان الأصليين في أميركا، ومنذ إبادات السكّان الأصليين في أميركا الجنوبية، أيضاً، وحروب التطهير والإجرام للشعوب في كلّ القارات، وفي كلّ المراحل كان همجياً ومتوحّشاً، والاستعباد وصل في مراحل تاريخية سابقة إلى ما يوازي ما قامت به إسرائيل بمساندة «الغرب»، إلّا أن التجربة الحديثة للبشرية لم تشهد مثل هذه البلادة التي نشهدها في المجتمع الإسرائيلي.
فقد وقف الشعب الأميركي عند درجة معيّنة من الإبادة التي مارسها جيش الغزو الأميركي ضد الشعب الفيتنامي ليطالب بوقف الحرب العدوانية.
صحيح أن الخسائر التي وقعت في صفوف المستعمر قد لعبت دوراً كبيراً في تحريك المجتمع ضد الحرب آنذاك ــ وهذا أمر طبيعي ــ لكن حركة معارضتها تحوّلت إلى تيّار سياسي كبير قلب الموازين، وأطاح بقيادات، وأرغم المؤسّسات على الرضوخ لإرادة المجتمع هناك.
كفانا «هبلاً»، هذا المجتمع غائب، ومُغيّب، ويعيش في غيبوبة، ويمارس دور الحاكم والجلّاد، ودور القاتل والضحيّة، والظالم والمظلوم، في آنٍ معاً.
ولهذا بالذات فإن من خرج على هذا الوعي المخيف والمرعب يعتبر من الأبطال الحقيقيين، لأنهم ينحتون في صخر من البلادة والقسوة، ومن انعدام القيم والضمير، وهم أكثر بطولة من كلّ البطولات، بما فيها بطولاتنا التي نتغنّى بها، هؤلاء فعلاً هم النموذج الفذّ في دولة الاحتلال.
يحتاج الأمر لاحقاً إلى دراسات معمقة في علم النفس الاجتماعي والجماهيري، ويحتاج الأمر إلى دراسة «ميركرواجتماعية» وليس حصر الاهتمام بالتعميمات المعروفة، ولكن ربط الانقسامات الداخلية الحادة في دولة الاحتلال بالحرب ليس سوى عرض سياسي خارج حقيقة الانقسام الداخلي، وهو عامل مساعد ثانوي على أبعد تقدير، وهذا كله لا يقلل من أهمية الانقسام، وخطورته على هذا المجتمع، وكونه بات مفتوحاً على احتمالات بما فيها الحرب الأهلية طالما أن النواة الصلبة على جانبي معادلة هذا الصراع لم تعد ترى مكاناً للحلول الوسط، وهذا ما يجب معالجته لاحقاً.