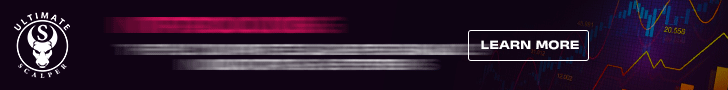دمــعــة علــى غــزة..

دمــعــة علــى غــزة..
2024 Oct,23
كانت غزة أول حاضرة فلسطينية حملت اسم فلسطين منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وظلت محافظة على فلسطينيتها رغم تقلب الحكام والغزاة، وبعد النكبة كانت الحاضنة الأهم للهوية الفلسطينية، ومنها خرجت معظم قيادات الثورة، ومنها انطلقت انتفاضة الحجارة.
قبل الحرب العدوانية بسنوات طويلة وبسبب الحصار الظالم لم تكن ظروف قطاع غزة جيدة، بل طالما وُصفت بالصعبة والمأساوية، حيث كانت مستويات الفقر والعوز والبطالة قد بلغت مستويات قياسية، إلى جانب انقطاع الكهرباء وأزمات الوقود والغاز وتلوث المياه، وتفشي الأزمات الاجتماعية، فضلا عن القمع البوليسي، ما دفع بنحو 300 ألف مواطن غزي لهجرة القطاع والبحث عن حياة أفضل في أرض الله الواسعة، العشرات منهم قضوا نحبهم غرقا أثناء مغادرتهم ما اعتبروه جحيما لا يُطاق.
ومع ذلك، فإن كل تلك الظروف المأساوية لا تُقارن بالجحيم المنصب فوق رؤوس الغزيين الآن، الذين باتوا يحنون بشوق إلى تلك الأيام، ويتمنون عودتها.. فعلى الأقل كان لكل مواطن بيت أو حتى شبه بيت، بجدران وسقف تحميه من قيظ الصيف وأمطار الشتاء، فيه شبابيك وأبواب، وحمّام، ومطبخ، وبعض الأثاث.. بل كانت هناك منازل فخمة وفلل وعمارات حديثة وأبراج شاهقة، وشوارع واسعة مشجّرة، وأزقة وحارات، وأضواء، وأسواق، ومقاهٍ ومطاعم وشركات ومؤسسات وورش ومصانع، وشاطئ جميل، وشاليهات وحدائق وبساتين ومزارع.. تقريبا كل شيء.
كانت حياة بسيطة ووادعة بالنسبة لأغلب السكان، وصعبة بالنسبة لآخرين؛ لكنها على الأقل حياة.. ورحلة كفاح وصمود، ومحاولات لقهر الصعاب، مع أمل كبير بغدٍ أفضل.
زرت غزة في العام 1997، أي قبل الانتفاضة، وقبل الحروب، كانت آنذاك في عصرها الذهبي، وفي ذروة صعودها ونهضتها العمرانية، كانت الكهرباء 24 ساعة، والمعابر مفتوحة، ونسبة البطالة لا تُذكر، والأسواق تعج بالناس، والمخيمات مثل خلايا النحل، والمشاريع تتدفق على القطاع بلا انقطاع.. كان الرهان على غزة بأنها ستكون سنغافورة، أو أقل قليلا.
ستمر على القطاع تحولات دراماتيكية ومفجعة: ما سمته حماس «الحسم العسكري»، وسيطرتها الكاملة على القطاع، وحروب إسرائيل العدوانية، والتي كانت في كل مرة تدمر وتخرب وتترك وراءها آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومعاق.
في العام 2019، زارت زوجتي خلود قطاع غزة، وعادت مبهورة ومندهشة من فرط فتنتها، ومن قدرة الغزيين على صنع الجمال وحب الحياة رغم قسوة الظروف، تحدثت طويلا عن البحر والمخيم والأسواق والناس، وعن تفاصيل كثيرة رأت فيها مواطن الجمال.. لدرجة أني حاولت بشتى السبل الحصول على تصريح لزيارة غزة.
العشرات من الأصدقاء في رام الله وغيرها زاروا القطاع وعادوا بانطباعات إيجابية، عادوا بدهشة المحب لما شاهدوه من تحديات الغزيين لظروفهم القاسية، وعلى تجاوز شروط الحصار الجائرة، وتحويلها إلى مشاهد تنبض بالحياة، وبالألوان، وتعد بمستقل أفضل.
كان المجتمع الغزي يكافح بضراوة وبعبقرية للتغلب على واقعه المرير، ولشق مسارات نحو مستقبل مشرق، لم يكن تكيفه مع شروط الحصار استسلاما، بل مواجهة مفتوحة وشجاعة وعلى كافة الجبهات: مشاريع شبابية واعدة، بناء، إصرار على الحياة، تحايل على الفقر، تمسك بالهوية الفلسطينية، وتصعيد للمقاومة.. وبموازاة ذلك اهتم الغزيون بمسارات العلم والتعليم، فكانت نسبة حملة الشهادات الأكاديمية العليا من أعلى النسب في العالم، ولم يهملوا مسارات الفنون والآداب والإبداع.
فقد ظهرت كوكبة من الكتّاب والشعراء والإعلاميين والفنانين التشكيليين، إلى جانب النشطاء والمؤثرين، مع حراك مجتمعي نشط، ومبادرات خلاقة في شتى المجالات، بما فيها الموسيقى والغناء، وقد برز الفنان محمد عساف، وجمال النجار، وظهرت العديد من الفرق الموسيقية الشبابية مثل فرقة «صول باند»، وفرقة «الطائر الجارح»، و»خطأ مطبعي»، و»دواوين»، وغيرها، حتى أن إحداها اشتركت في برنامج «Arab got talent».
ومن جهة أخرى، ولمواجهة هذا النمو والتطور المجتمعي دأبت مجموعات دينية متطرفة على خلق مسارات معاكسة، فمثلا ظهرت «واحة الوعظ والإرشاد» ومركزها جنوب غزة، لتنشر إعلانات متكررة تحت عنوان: «ماراثون التائبين وقوافل العائدين»! كما أقامت إحدى الجماعات المتشددة حاجزا على أحد شوارع القطاع، لتوقيف مركبات النقل العمومي والتأكد أن النساء لا يجلسن بجانب السائق، وأن المسافة بين الذكور والإناث كافية في المقاعد الخلفية! وقام بعض المتشددين بمضايقة ومطاردة وتهديد الفرق الموسيقية، وشاهدنا «حملات الإيمان»، و»شرطة الأخلاق»، والبعض حوّل المساجد إلى مقار حزبية، وظهرت عشرات الجمعيات التي تعمل تحت اسم جمعيات خيرية، أو لجان الزكاة، أو دور أيتام.. مثل جمعية ابن باز، ومعهد ابن تيمية، ومجلس الدعوة السلفية، وجمعية أهل السنة، وغيرها، وهي مراكز تتفق فيما بينها على نشر الفكر المتزمت.. وعلى إلهاء الناس بقضايا فرعية وهامشية، وحرف البوصلة عن القضية الأهم.
ومع ذلك، ظلت غزة مواظبة على إيقاعها الوطني والإنساني الجميل، وفي هذا السياق، من أكثر المشاهد المؤثرة فيديو لمئات الطالبات في طابور الصباح وهن يؤدين حركات رياضية بمنتهى النشاط والترتيب على إيقاع أغنية «غزة غزة»، وفيديو تخريج طلبة جامعيين يرقصون وهم في غاية الفرح، يغنون للوطن، وهم ممتلئون بالحياة، مقبلون عليها بكل حماسة وحيوية.. تداعبهم أحلام الغد، ومشاريع المستقبل، واختبار دروب الحياة، وفرصها، وصورة مثالية عن العالم ومدنه وجزره وشواطئه.. هذه المدرسة وتلك الجامعة قصفهما الاحتلال مع عشرات المدارس والجامعات الأخرى، ومن نجت تحولت إلى مركز إيواء، وهؤلاء الطالبات وأولئك الخريجون ومعهم خمسون ألف إنسان قُتلوا ظلماً وعدواناً.. مع مليوني إنسان ذُبحت أحلامهم، ومشاريعهم، وتهدمت بيوتهم، ومن نجا من الموت صار عليه أن يتكيف مع نمط حياة جديد في خيام النازحين، بين الطوابير وأكوام الردم وتحت القصف.. فقط ليعيش يوما آخر.. يوم جديد لا يعرف (ونحن أيضا لا نعرف) كيف سيكون شكله.
نام الغزيون في ليلة السابع من أكتوبر وهم لا يدرون أنهم يلقون نظرة الوداع الأخيرة على مدينتهم التي ألفوها وأحبوها.. فقد دمر شيطان التوحش الهمجي الصهيوني الأميركي كل شيء.. ولكنه سيعجز عن هزيمة الرُّوح الفلسطينية الإنسانية.. وسيعجز عن تدمير روح غزة.
غزة تستحق دمعة؛ بل أنهارا من الدموع والدماء.