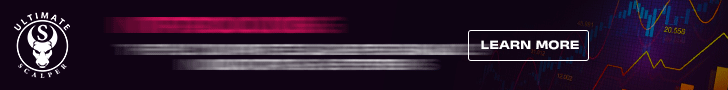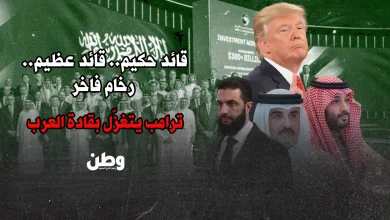جسر فوق الركام ..د. إياد أبو الهنود

يواجه الفلسطينيون في هذه المرحلة المفصلية من تاريخهم حربًا ضارية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الجبهات، حيث لا يفرّق القصف بين مدينة ومخيم، من غزة إلى جنين. في ظل هذا العدوان، أُبيدت البنى التحتية، وتضاعفت حالات النزوح والاعتقال والقتل، حتى باتت الحياة اليومية تُمارَس بين الركام، وصار الوجود الفلسطيني محاصرًا بالخوف والفقد والاستهداف المنهجي، إلى حدّ أن البقاء نفسه بات إنجازًا، لا أمرًا مُسلّمًا به.
وسط هذا الواقع الكارثي، يبرز سؤال وجودي: هل يستطيع الفلسطيني أن يبني جسرًا فوق هذا الركام؟
“جسر فوق الركام” ليس تعبيرًا مجازيًا فحسب، بل هو توصيف دقيق لحالة فلسطينية مركّبة، تتقاطع فيها آثار الحرب مع أزمات الانقسام الداخلي، وتراجع الدعم الدولي، وتآكل الثقة بالمؤسسات. فـ”الجسر” هنا لا يُفهم كهيكل مادي يربط بين نقطتين، بل كفعل إرادي يُقاوم الانهيار، ويشقّ طريقًا نحو الحياة من قلب الدمار. أما “الركام”، فلا يُختزل في الحجارة فقط، بل يشمل كل ما تخلّفه الحروب الوحشية من آثار نفسية وذهنية واجتماعية، كتآكل المعنويات، واضطراب الهوية، والشعور بانسداد الأفق. وفي مواجهة ذلك، يصبح الجسر حاجة وجودية، لا يُبنى بالإسمنت بل بالوعي؛ جسرٌ تحمله الإرادة، ويربط بين الألم والمستقبل، وينقل الشعب من حالة الانتظار إلى أفق الفعل والبناء.
النهوض من الأنقاض ليس حلمًا مستحيلًا. فقد شهد التاريخ الحديث تجارب شعوب أُنهكت بالحروب، ثم أعادت بناء نفسها من الصفر. اليابان، التي خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية بعد قصف هيروشيما وناغازاكي، لم تنتظر نهاية الحرب لتبدأ بالإصلاح، بل شرعت بمراجعة شاملة لبنيتها التعليمية والإدارية، وأقرت عام 1947 “الميثاق التربوي الجديد” الذي ركّز على قيم السلام والانفتاح والبحث العلمي. أطلقت حينها برامج مثل “المعجزة الاقتصادية” التي استثمرت في الصناعات التكنولوجية والسيارات، واستندت إلى فلسفة واضحة: “نحن لا نملك موارد، فلنُنتج العقول”. وبهذا النهج، تحوّلت اليابان في غضون عقود إلى قوة اقتصادية وعلمية عالمية.
أما ألمانيا، فبعد دمار الحرب وانهيار مؤسسات الدولة، أطلقت عملية إعادة إعمار تقودها روح مجتمعية غير مسبوقة، كانت النساء في طليعتها، حيث عُرفن بـ”نساء الأنقاض”. رفعت هؤلاء شعارًا بسيطًا وعميقًا: “لا تنتظر حقوقك، قم بواجباتك”، إلى جانب شعار آخر انتشر في الأوساط الشعبية: “من لا يعمل لا يأكل”. وفي مواجهة الخراب الكامل، لم يكن أمام الألمان سوى رفع شعار واقعي صار عنوانًا للمرحلة: “نبدأ من الصفر”، وهو تعبير عن الإصرار على تحويل الهزيمة إلى نقطة انطلاق جديدة. هذه الروح المجتمعية لم تبنِ الحجارة فقط، بل أعادت بناء أخلاقيات العمل والانضباط، وتحولت من خلالها ألمانيا إلى نموذج في الكفاءة والمواطنة الحديثة.
هذه الدروس ليست بعيدة عن السياق الفلسطيني. فالفلسطينيون يملكون طاقة بشرية هائلة، وإيمانًا راسخًا بالحق والعدالة. وما ينقصهم اليوم هو كسر عقلية الانتظار، والاعتماد على الغير، والانطلاق بمشروع وطني جامع، يستند إلى المبادرة الشعبية ويتسلح بفلسفة اللاعنف، لا كخيار تكتيكي مؤقت، بل كأداة استراتيجية للتحرر والبناء. فالتحرر لا يكون فقط من الاحتلال، بل من التبعية والانقسام الذي عطّل قدرات المجتمع.
وفي هذا الإطار، يُعدّ الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ركيزة مركزية لأي مشروع نهوض مستدام، كما تؤكد أدبيات السيادة الوطنية في سياقات ما بعد النزاع. فقد كشفت التجربة الفلسطينية خلال حربٍ تقارب عامها الثاني محدودية الرهان على النظام الدولي، الذي تتحكم به اعتبارات النفوذ والمصالح، لا مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. فالدعم الخارجي، وفقًا للمنظورات الواقعية في العلاقات الدولية، لا يُمنح من دون مقابل، بل يأتي غالبًا محمّلًا بشروط سياسية أو اقتصادية. ومن لم يسهم في وقف العدوان أو محاسبة الاحتلال، لا يُمكن الوثوق بدوره في إعادة البناء، ما لم يكن ذلك على حساب القرار الوطني الفلسطيني.
من هنا، فإن تبنّي استراتيجية الاعتماد على الذات لا يُعد خيارًا اضطراريًا، بل ممارسة سيادية ضرورية لضمان بقاء المشروع التحرري في يد أصحابه، غير مرتهن لإملاءات المانحين ولا لميزان المصالح الدولية. صحيح أن الفلسطينيين لا يمتلكون وفرة في الموارد المادية، لكنهم يملكون ما هو أثمن: طاقة بشرية هائلة، وعقولًا مبدعة، وإرادة صلبة. وإن حُسن توظيف هذه المقومات ضمن رؤية وطنية واضحة كفيل بتحويل القليل إلى مشروع بناء متكامل، خاصة حين تقترن هذه الإرادة بتحمّل جماعي للمسؤولية. فإعادة الإعمار لا تبدأ بالإسمنت، بل بتصليب الجبهة الداخلية، وتجديد العقد الوطني على قاعدة وحدانية التمثيل عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية التي تعبّر عن صوت الداخل، وتعمل على حشد التأييد والدعم من الخارج على أسس من الكرامة والسيادة، لا الاستعطاف أو التبعية.
إن بناء جسر فوق الركام ليس ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة وجودية. فالاحتلال لا يكتفي بالهدم، بل يسعى لترسيخ واقع فلسطيني مكسور، كما عبّر وزير مالية الاحتلال سموتريتش بقوله: “سندمر هناك أكثر مما يبنون”. لكن الردّ على هذا المشروع لا يكون بالصمود وحده، بل بتحويل الصمود إلى طاقة بناء، ومشروع تحرري خلاق، يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني باعتباره حجر الأساس في أي عملية تحرر وإعمار.
وكما نهض طائر الفينيق من رماده، وكما نهضت شعوب تحت النار، فإن الفلسطيني قادر على أن يشقّ طريقه من بين الركام، لا بالحطام، بل بالإرادة والوعي، وعلى جسرٍ يمتد بين الكرامة والحرية.