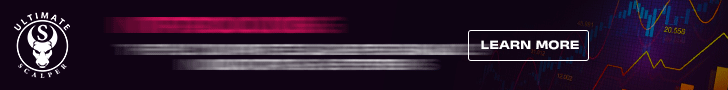سياسة ترامب بمنطقة الشرق الأوسط .. وهم الاستقرار وحتمية الاضطراب

قال الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيوإستراتيجية والأمنية، إن “العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية تمر اليوم بمرحلة اضطراب عميق، حيث تؤدي الخطوات الأحادية لواشنطن إلى تآكل التوازنات الهشة في المنطقة”، مضيفا أن المقترحات الأخيرة بشأن غزة، من التهجير القسري إلى فرض السيطرة الأمريكية، تعكس قطيعة استراتيجية عميقة تتداخل فيها اعتبارات أمنية وتاريخية وأخلاقية.
وأشار الشرقاوي الروداني، في مقال توصلت به هسبريس بعنوان “السياسة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.. وهم الاستقرار ومسار حتمي نحو الاضطراب”، إلى أن المبادرات الأمريكية الأخيرة تسببت في رفض عربي واسع النطاق، حيث عارضت مصر والأردن والسعودية هذه التحركات، موردا أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أكد على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وموضحا أن هذا الموقف ينبع من التزام ثابت بحقوق الشعب الفلسطيني.
وتناول المقالُ الموضوعَ من خلال عدد من المحاور، حيث ناقش “عدم استقرار ذي تداعيات متعددة”، مستعرضا المعضلات التي تواجه الأنظمة العربية بين التبعية الأمنية لواشنطن ومطالب شعوبها. كما تطرق إلى “الانعكاسات بعيدة المدى.. أزمة الشرعية العربية”، مُحللا تأثير التحولات الجيوسياسية على استقرار الحكومات، فيما اخُتتم بتحليل “دروس من التاريخ.. مخاطر القرارات المتسرعة والإيديولوجية”.
نص المقال:
من المؤكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية تسير اليوم في مياه مضطربة، حيث تؤدي كل خطوة أحادية الجانب من واشنطن إلى تآكل التوازنات الهشة التي ورثتها المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة. إن المقترحات الأخيرة التي قدمها دونالد ترامب بشأن غزة من التهجير القسري للفلسطينيين، إلى فرض السيطرة الأمريكية على القطاع، وصولا إلى تحويله إلى “ريفييرا الشرق الأدنى” ليست مجرد تحركات دبلوماسية عابرة؛ بل إنها تجسد قطيعة استراتيجية عميقة، تتداخل فيها إساءة فهم الحقائق التاريخية مع الحسابات الأمنية قصيرة النظر، إضافة إلى العجز عن إدراك العوامل الأخلاقية التي تشكل المخيال السياسي العربي.
يعكس هذا المنعطف الحرج توترا جوهريا بين تبعية الأنظمة العربية لحليفها الأمريكي من جهة، وبين التزامها بالقضية الفلسطينية، التي تبقى رغم موجة التطبيع الأخيرة حجر الأساس في شرعيتها الداخلية والإقليمية. ولم يكن مفاجئا أن تلقى هذه الإجراءات رفضا عربيا واسع النطاق، في موقف نادر في عالم عربي يشهد انقسامات عميقة. فمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اعتادت على الصمت إزاء التجاوزات الإسرائيلية، رفضت بحزم أي محاولة لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، مستحضرة شبح تهجير اللاجئين عام 1948. أما الأردن، حيث يشكل الفلسطينيون حوالي 60 في المائة من السكان، فقد حذر من أزمة هوية لا رجعة فيها. حتى المملكة العربية السعودية، رغم انخراطها في لعبة استراتيجية مع واشنطن حول الملف النووي الإيراني واتفاقيات أبراهام، شددت على تمسكها بالقدس الشرقية عاصمة مستقبلية لدولة فلسطين.
وبالمثل، يواصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، الاضطلاع بدور محوري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ورفض أية محاولات لتغيير هويتها. كما تعكس المبادرات الدبلوماسية المغربية، سواء من خلال الوساطات الإقليمية أو التحركات على المستوى الدولي، التزاما ثابتا بالحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. لا يمكن اختزال هذه المواقف في مجرد عاطفة سياسية أو موقف مبدئي فارغ؛ بل إنها تعكس قلقا وجوديا متصاعدا. فترامب، من خلال توظيف غزة كأداة في حساباته الجيوسياسية، لا يهدد فقط إقليما جغرافيا، بل يستهدف آخر خيوط التماسك العربي، في منطقة أنهكتها الحروب الأهلية، والانتفاضات الشعبية الفاشلة، والصعود المتنامي لنفوذ طهران.
عدم استقرار ذو تداعيات متعددة
على المدى القريب، تجد الأنظمة العربية نفسها أمام معضلة وجودية حادة. فمن جهة، تعتمد في بقائها على المظلة الأمنية الأمريكية، فمصر، المستفيد الثالث عالميا من المساعدات العسكرية الأمريكية، لا تستطيع المغامرة بقطيعة مع واشنطن، حتى عندما يتعلق الأمر بمصير ملايين الفلسطينيين. أما السعودية، ورغم خطابها الحازم، تظل غارقة في علاقة تبادلية مع الولايات المتحدة، تشمل صفقات السلاح وحماية المنشآت النفطية. لكن هذه التبعية قد ترتد عكسيا. فالرأي العام العربي، الذي بات مشحونا بمشاهد الحرب على غزة، قد يبدأ في اعتبار أي تقارب مع ترامب خيانة سافرة. وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالمقارنات بين بعض الأنظمة الخليجية وبين الحكومات العميلة في الحقبة الاستعمارية. هذا التباين بين متطلبات الواقعية السياسية والشرعية الشعبية يوفر بيئة خصبة للجماعات الجهادية أو لـ”حماس”، التي قد تستغل هذا الغضب المتزايد بين الأجيال الشابة. وليست هذه مجرد افتراضات نظرية، فقد شهدنا عام 2021 كيف دفعت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الأردن حكومتها إلى استدعاء سفيرها لدى إسرائيل. مما يؤكد أن الشارع العربي، رغم كونه لاعبا غير متوقع، يبقى عنصرا حاسما لا يمكن تجاهله. ويزداد هذا المأزق تعقيدا بسبب النهج غير القابل للتنبؤ الذي تتبناه الإدارة الأمريكية الجديدة. فمن التهديدات المتكررة بقطع المساعدات عن مصر، إلى الترويج لما يسمى “صفقة القرن”، تفتقر السياسة الأمريكية إلى ثبات استراتيجي، مما يجعل العواصم العربية في حالة ارتباك دائم بين الخوف من إثارة غضب واشنطن والحاجة إلى تهدئة شعوبها.
ومن أكثر المشاريع التي أثارت الجدل، رؤية ترامب لغزة كـ”ريفييرا سياحية”، وهو طرح يعيد إلى الأذهان مشاريع استعمارية سابقة، مثل خطط الثلاثينيات “لإزهار الصحراء”، التي كانت تخفي خلف شعارات الحداثة نزعة توسعية بحتة. وفي المقاهي من القاهرة إلى بيروت، يُنظر إلى هذه الفكرة على أنها إهانة عظمى، حيث لا يُكتفى بحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة، بل يُحول نضالهم إلى مجرد مشهد سياحي.
وهذه المشاعر ليست مجرد ردود فعل عاطفية، بل هي امتداد لوعي تاريخي طويل يرى في كل مشروع “تحديثي” غربي محاولة جديدة لفرض الهيمنة.
الانعكاسات بعيدة المدى.. أزمة الشرعية العربية
إذا تمت ترجمة مقترحات ترامب إلى سياسات فعلية، حتى ولو جزئيا، فإنها ستخلق سابقة خطيرة ذات تداعيات يصعب التنبؤ بها. فنهجه القائم على الصفقات قصيرة المدى والإملاءات الأحادية أسقط المبادئ الدبلوماسية التقليدية، وأدى إلى تغليب المصالح الفورية على حساب أي رؤية طويلة الأمد. وإجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي لن يكون مجرد تغيير ديموغرافي؛ بل سيكون إعادة إنتاج لنكبة 1948، الجرح الذي لم يندمل في الذاكرة العربية.
لقد استخدمت بعض الأنظمة العربية القضية الفلسطينية لعقود كأداة لتحويل الانتباه عن أزماتها الداخلية، من فساد وفجوة اقتصادية إلى نزعات استبدادية متنامية. ولكن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضدها إذا فُرضت حلول خارجية تعيد تشكيل واقع غزة بشكل جذري، دون أي اعتبار لوجهات نظر الأطراف العربية. في ظل سيناريو كهذا، سيكون من الصعب تبرير التضحيات السابقة، سواء في الحروب الفاشلة أو في الإنفاق العسكري الهائل، إذا أمكن تسوية القضية الفلسطينية بقرار منفرد من واشنطن. كما أن شرعية الأنظمة الخليجية، التي تضررت بالفعل بسبب تقاربها مع إسرائيل، ستتلقى ضربة قوية. فالعاهل الأردني، الذي تستند شرعية حكمه إلى دوره كوصي على المقدسات الإسلامية في القدس، قد يجد نفسه في موقف ضعف غير مسبوق. وحتى مصر، التي أبدت تواطؤا صامتا مع الحصار المفروض على غزة منذ 2007، قد تواجه اتهامات بالتواطؤ الصريح.
إن هذه الأزمة تعيد التأكيد على حقيقة غالبا ما يتم إغفالها: القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع على الأرض، بل هي معركة من أجل الاعتراف والكرامة، تمتد تداعياتها إلى مختلف أنحاء العالم العربي. فعندما يتحدث ترامب عن “تسوية المشكلة نهائيا”، فإنه يتجاهل أن فلسطين، بالنسبة لملايين العرب من المغرب إلى العراق، باتت رمزا لعجزهم الجماعي أمام نظام دولي يُنظر إليه على أنه غير عادل. لقد أثبتت اتفاقيات أبراهام، التي وُقعت عام 2020 بين إسرائيل وبعض الدول العربية، أن التطبيع السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يمحو الطابع الرمزي والمبدئي للقضية الفلسطينية. بل على العكس، فقد عمقت هذه الاتفاقيات الفجوة بين خيارات الحكومات وتوقعات شعوبها، مما زاد من تعقيد أية مقاربة متوازنة تجاه هذا الملف.
إن محاولة تحويل غزة إلى “مشروع استثماري”، بينما لا يزال سكانها يعانون الحصار والتشريد، تضع الأنظمة العربية في موقف حرج: إما التخلي عن خطاباتها التقليدية، أو المخاطرة بمواجهة ردود فعل شعبية غاضبة. وفي الحالتين، يُظهر وهم النظام الأمريكي في الشرق الأوسط أنه لم يعد ضامنا للاستقرار؛ بل تحول إلى عامل تسريع لحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، قد تعيد رسم خريطة المنطقة بأكملها.
دروس من التاريخ.. مخاطر القرارات المتسرعة والإيديولوجية
يقدم التاريخ الحديث سوابق مقلقة تظهر أن القرارات المتخذة تحت وطأة الاستعجال، أو بدوافع أيديولوجية، أو نتيجة الغطرسة السياسية، نادرا ما تقود إلى السلام؛ بل غالبا ما تغذي دوامات طويلة من العنف وعدم الاستقرار. فالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، الذي نُفذ دون تفويض دولي، زعزع مصداقية الأنظمة العربية الحليفة للغرب، كما كشف عن الأثمان الباهظة للقرارات غير المدروسة. ومثلما أدى معاهدة فرساي (1919)، التي فُرضت لإذلال ألمانيا بدلا من تحقيق توازن أوروبي، إلى تمهيد الطريق أمام النزعة الانتقامية القومية التي أفضت إلى الحرب العالمية الثانية، فإن غزو العراق، المبني على ادعاءات زائفة بوجود أسلحة دمار شامل، حل محل الواقعية السياسية بنهج إيديولوجي محافظ جديد، دمر الهياكل السياسية العراقية، ومهد لظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” في المشرق. الغطرسة التي ميزت القوى الكبرى، والتي كانت تتجاهل غالبا تعقيدات الواقع المحلي، تجلت أيضا في الغزو السوفيتي لأفغانستان (1979). ففي محاولتها فرض نظام شيوعي بالقوة، تسببت موسكو في حرب استمرت عقدا من الزمن، ساهمت في تأجيج الإسلام السياسي، وأدت في النهاية إلى ظهور “القاعدة”. هذه النماذج تكشف عن نمط متكرر: الاستعجال يُستخدم لتبرير قرارات متهورة، والإيديولوجيا تُعمي عن التعقيدات الاجتماعية والتاريخية، والغرور يحول الأخطاء إلى كوارث.
كما أن اتفاق ميونيخ (1938)، حيث ظنت بريطانيا وفرنسا أنهما تشتريان السلام بالتنازل عن تشيكوسلوفاكيا، يعكس هذا الوهم الخطير. فالتنازل عن المبادئ خوفا من مواجهة وشيكة أدى في النهاية إلى تقوية هتلر، والتعجيل باندلاع حرب أشد دموية. هذه القرارات، التي جرى اتخاذها في ازدراء واضح للقانون الدولي والذاكرة الجماعية، تركت إرثا من الحدود المصطنعة، والصراعات العرقية، والتآكل المستمر لشرعية المؤسسات، مما جعل المصالحة المستقبلية أمرا بالغ الصعوبة. إن دروس التاريخ تؤكد أن السلام لا يُبنى بالتسرع ولا بتجاهل التوازنات الدقيقة التي تربط بين الجغرافيا، والشعوب، والتاريخ.
إلا أن الأزمة الحالية أكثر خطورة من سابقاتها، إذ لا تستند إلى تدخل عسكري مباشر، بل تقوم على تآكل تدريجي لمبادئ القانون الدولي، مثل حق العودة، والسيادة الإقليمية، وحظر التهجير القسري. فإذا سقطت غزة، فما الذي سيضمن أن الضفة الغربية، أو القدس، أو حتى سيناء والجولان، ستظل بمنأى عن المصير نفسه؟ هذه المخاوف تفسر الردود القوية لدول مثل الأردن، التي تعتمد استقرارها على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وفي كواليس السياسة، يتحدث بعض الدبلوماسيين العرب عن مخاطر “تأثير الدومينو”، حيث يمكن أن يؤدي الغضب الشعبي المستوحى من القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى استغلاله من قبل قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، إلى إشعال اضطرابات واسعة في منطقة مشتعلة أصلا. كما أن الانقسامات السياسية العربية بين السنة والشيعة، والملكيات والجمهوريات، والدول الغنية بالنفط والدول الفقيرة، تمنع بناء موقف عربي موحد، مما يعزز من قدرة القوى الخارجية على استغلال هذه التناقضات.
ومع ذلك، قد تدفع هذه الأزمة الدول العربية إلى إعادة تقييم سياساتها، كما حدث في أعقاب هزيمة عام 1967، عندما أدركت الدول العربية ضرورة إعادة النظر في استراتيجياتها تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. بعض التحركات تشير إلى هذا الاتجاه، مثل التقارب الأخير بين السعودية وسوريا، ومحادثات مصر مع تركيا، والدعوات الأردنية لعقد مؤتمر دولي حول غزة. لكن يبقى السؤال ما إذا كانت هذه التحركات ستتجاوز مرحلة التصريحات الرمزية لتتحول إلى خطوات عملية ملموسة.
وفي هذا السياق، تلعب بعض الدول العربية دورا حاسما في البحث عن حلول للصراع الفلسطينيالإسرائيلي. على سبيل المثال، أظهر المغرب التزامه بدعم القضية الفلسطينية عبر وساطته في الإفراج عن أموال فلسطينية كانت محتجزة لدى إسرائيل، بتدخل مباشر من الملك محمد السادس. هذه المبادرة تسلط الضوء على أهمية الدور العربي النشط في دفع عملية السلام بطريقة عادلة ودائمة.
إعادة رسم موازين القوى.. التحالفات الجديدة ومستقبل النظام العربي
من المؤكد أن الأزمة تتجاوز حدود غزة، إذ إنها تعيد طرح تساؤلات حول موقع العالم العربي في النظام الدولي الناشئ. فمن خلال تهميش القانون الدولي، قد تسرع الولايات المتحدة عملية تفكك النظام متعدد الأطراف، وهو نظام رغم عيوبه كان يوفر للعرب منصة للدفاع عن مصالحهم الإستراتيجية. وفي ظل صعود الصين وروسيا، اللتين تريان في هذه الأزمة فرصة لتحدي الهيمنة الغربية، قد تجد الدول العربية نفسها أمام خيارات بديلة. بكين تعرض وساطتها، بينما موسكو تعزز تحالفها مع إيران لتعزيز دورها في المنطقة.
كما أن السيطرة على قطاع غزة، وما يتبعها من استغلال الموارد الغازية البحرية (حقول ليفياثان، تمار، داليت)، قد تعيد ترتيب موازين القوى الإقليمية. فمن جهة، قد تعزز هذه الخطوة النفوذ الأمريكي في مجال الطاقة، مما يؤثر سلبا على لاعبين مثل قطر وإيران. ومن جهة أخرى، قد يؤدي انتهاك القانون الدولي إلى تقويض الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعف النظام القانوني العالمي ويزيد من تآكل مصداقية المؤسسات الدولية.
يترتب على القرار الأمريكي باحتلال غزة ونقل سكانها تداعيات كارثية على مختلف المستويات، مما يهدد بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي والعالمي، ويؤدي إلى كارثة جيوسياسية تمتد آثارها إلى المنطقة والساحة الدولية. فعلى الصعيد الدبلوماسي، من المرجح أن تواجه واشنطن عزلة متزايدة، إذ ستجد نفسها أمام موجة إدانة واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وقوى عربية مؤثرة مثل فرنسا، مما سيؤدي إلى تقويض قيادتها الأخلاقية على الساحة الدولية. أما إقليميا، فإن هذا القرار قد يهدد بانهيار اتفاقيات أبراهام، خاصة إذا أصرت المملكة العربية السعودية على عدم تقديم تنازلات تمس جوهر القضية الفلسطينية، مما سيزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وحلفائها في الخليج.
وعلى المستوى المحلي، فإن الغضب الشعبي العربي قد يشتعل في مواجهة هذه الخطوة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأنظمة الحليفة للغرب، وإعادة إحياء موجات احتجاجية على غرار الربيع العربي لعام 2011، في حين ستستغل الحركات الإسلامية الراديكالية هذا الغضب لتعزيز نفوذها وتوسيع قاعدتها الشعبية. أما استراتيجيا، فإن هذه الأزمة قد تشكل فرصة ذهبية لكل من روسيا والصين لتعزيز حضورهما في الشرق الأوسط على حساب النفوذ الأمريكي؛ مما قد يؤدي إلى تسريع وتيرة تراجع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي وفق معادلات جديدة تتجاوز الثنائية التقليدية بين واشنطن وحلفائها.
وعلى المدى المتوسط، إذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيشكل تحديا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين، حيث سيؤدي إلى تصعيد المواجهات وزيادة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يخلق موجات جديدة من العنف والصراعات. ولن يكون لإسرائيل مصلحة في إعلان “نصر سياسي” عبر هذه الخطوة؛ بل على العكس، سيكون من الضروري أن تعيد تقييم استراتيجيتها بعيدة المدى وتأخذ بعين الاعتبار التداعيات المستقبلية لموقفها في المنطقة.
إن تجاهل الحقائق الجيوسياسية والارتباطات التاريخية قد يدفع بإسرائيل نحو عزلة إقليمية متزايدة، مما سيؤثر على أمنها القومي وعلى علاقاتها مع الدول العربية التي سعت إلى تطبيع العلاقات معها. وبالتالي، فإن الحلول الأحادية والقرارات المفروضة بالقوة لا يمكنها سوى تعميق الانقسامات وإطالة أمد الصراع بدلا من تحقيق استقرار دائم.
الشرق الأوسط.. بين الفوضى وإعادة التشكل
إن الإدارة الأمريكية الحالية، من خلال تبنيها سياسة الصدمة الجيوسياسية، تكشف عن انحراف خطير عن تقاليد الدبلوماسية الأمريكية، التي كانت تعتمد تاريخيا على نهج متدرج يجمع بين الواقعية السياسية والالتزامات الأمنية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية؛ لكن الولايات المتحدة باتت اليوم تتبنى مقاربة أحادية الجانب تفتقر إلى التوازن، وتدفع الشرق الأوسط نحو إعادة تشكيل جذرية لمراكز القوى، حيث لم يعد الاستقرار الإقليمي هدفا استراتيجيا؛ بل بات مجرد ورقة مساومة في لعبة النفوذ العالمي.
لا تعكس هذه الأزمة مجرد إخفاق للنظام الدولي متعدد الأطراف، بل تشير إلى إعادة توزيع النفوذ في المنطقة، حيث تستغل قوى صاعدة مثل الصين وروسيا وإيران هذا الفراغ الاستراتيجي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مما يخلق توازنات جديدة تتجاوز الثنائية التقليدية بين واشنطن وحلفائها. فالصين، التي تسعى إلى ضمان أمن إمداداتها الطاقية من الخليج، تعمل على توسيع دورها كوسيط في النزاعات الإقليمية، بينما تستخدم روسيا علاقتها الوثيقة مع إيران وحلفائها الإقليميين لإعادة فرض نفسها كلاعب رئيسي في المعادلة الأمنية والاستراتيجية للمنطقة.
في هذا السياق، إذا استمرت الولايات المتحدة في إضعاف النظام الدولي وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، فإنها ستسرع من تآكل الثقة بحلفائها الإقليميين، الذين قد يبدأون في البحث عن بدائل استراتيجية لتقليل اعتمادهم على واشنطن. إن التحركات الاستراتيجية الروسية في سوريا والتوسع الصيني في المجال الاقتصادي والدبلوماسي وعودة إيران كقوة إقليمية صاعدة كلها مؤشرات على تحول تدريجي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث لم تعد الولايات المتحدة القوة المطلقة في تحديد مستقبل الشرق الأوسط.
في الوقت الذي قد تعتبر فيه بعض الدوائر السياسية الإسرائيلية هذا القرار بمثابة نصر استراتيجي، فإنه في الواقع يشكل مغامرة غير محسوبة قد تكون لها عواقب وخيمة على الأمن القومي الإسرائيلي على المدى الطويل. فبدلا من تعزيز موقعها الإقليمي، قد تجد إسرائيل نفسها أمام تحديات غير متوقعة؛ بدءا بتصاعد المقاومة الشعبية والعسكرية داخل الأراضي الفلسطينية، مما قد يفتح جبهة طويلة الأمد من المواجهات غير المتكافئة تستنزف قدراتها الأمنية والعسكرية. كما أن تآكل دعم المجتمع الدولي سيضعها في عزلة دبلوماسية متزايدة، خصوصا مع تصاعد الدعوات داخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها عن انتهاكاتها، مما سيحد من قدرتها على المناورة السياسية في الساحة الدولية.
إضافة إلى ذلك، فإن فرض سياسات قسرية وغير مدروسة قد يؤدي إلى تفجر انتفاضة جديدة، أكثر شمولية من سابقاتها، تهدد استقرارها الداخلي وتفرض عليها تحديات أمنية غير مسبوقة. ومن هذا المنطلق، على صناع القرار في تل أبيب أن يعيدوا النظر في هذه الخطوة من منظور استراتيجي بعيد المدى، وألا ينجرفوا وراء أوهام الانتصارات التكتيكية قصيرة الأمد، حيث إن المعادلات الجيوسياسية في المنطقة لم تعد كما كانت في العقود الماضية، بل أصبحت المصالح الإقليمية والدولية أكثر تعقيدا وتشابكا؛ ما يفرض على إسرائيل مراجعة حساباتها لتجنب تحولات قد تكون لها تداعيات كارثية على وضعها الإقليمي ومصالحها الاستراتيجية.
في ظل هذه التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية العميقة، فإن السياسات الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإشعال مزيد من الصراعات التي قد تمتد آثارها إلى أبعد من الشرق الأوسط، لتعيد تشكيل موازين القوى على المستوى العالمي. وإذا كانت واشنطن تهدف إلى الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، فإنها بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في سياستها، والتوقف عن التعامل مع الشرق الأوسط كساحة مفتوحة للهندسة الجيوسياسية قصيرة النظر، حيث إن تجاهل التوازنات الإقليمية سيؤدي إلى إضعاف نفوذها لصالح قوى صاعدة تسعى إلى ملء الفراغ الاستراتيجي. فالاستقرار الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حلول دبلوماسية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد الجيوسياسي، وليس عبر فرض وقائع جديدة بالقوة تخالف الأسس التي استند إليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والشرق الأوسط لم يعد منطقة، اليوم، يمكن إعادة تشكيلها وفق إملاءات القوى العظمى؛ بل بات فضاء لحراك جيوسياسي متعدد الأقطاب، حيث تلعب التحالفات المتغيرة والتوازنات الإقليمية دورا حاسما في رسم ملامح المستقبل.
من هنا، فإن الرهان على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، كما تفعل واشنطن حاليا، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتوترات؛ مما قد يدفع المنطقة بأكملها نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث لن يكون هناك طرف منتصر، بل خسائر استراتيجية تطال الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين سيواجهون تداعيات انهيار منظومة الأمن الإقليمي على مصالحهم الاستراتيجية بعيدة المدى.
على ضوء ذلك، فقد تواجه العقيدة الأمريكية للتوازن عبر الشاطئ، التي صُممت تاريخيا لتعزيز إسقاط القوة دون انخراط عسكري مباشر، مفارقة استراتيجية معقدة في ظل السعي إلى إعادة تشكيل هيكلية السلطة في غزة عبر السيطرة الأحادية وإعادة هندسة التركيبة الديموغرافية بالقوة. هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجيا غير متماثل يزعزع الأسس الجوهرية لهذا النهج، حيث إن محاولة إعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في المنطقة من خلال فرض حلول قسرية قد تؤدي إلى تأثير الدومينو الجيوستراتيجي عبر تأجيج الصراعات الإقليمية وتنشيط التوترات الكامنة داخل النظام العربي والدولي.
إن التخلي عن نموذج الردع بالوكالة، الذي كان السمة المميزة للتدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفكك توازنات الاعتماد الاستراتيجي المتبادل بين واشنطن وحلفائها؛ مما يسرع من تآكل رأس المال الدبلوماسي للولايات المتحدة. فبدلا من أن يكون القرار الأمريكي مجرد إسقاط للقوة بطريقة تبادلية، فإنه يشير إلى انتقال نحو تدخلية فوضوية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة هندسة الحدود السياسية والجغرافية، مما يعرض قدرتها على إدارة التفاعلات الإقليمية للخطر، دون أن تتمكن من تفادي تكلفة الانزلاق نحو تورط سياسي وعسكري مكلف.
يضع هذا التحول واشنطن أمام استقطاب متزايد لمجالات النفوذ؛ فمن جهة، قد يؤدي الفراغ الاستراتيجي الناتج عن تهميش القوى العربية إلى خلق تكتل صينيروسي أكثر انسجاما حول القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى، قد تجد الولايات المتحدة نفسها تفقد دورها كمهندس للنظام الإقليمي، في مواجهة واقع جديد تتحدد فيه تحولات التحالفات والمنافسة وفق مسار يتحدى الهيمنة الأحادية القطبية.
إن إغفال التفاعلات الداخلية للصراع قد يسهم في زيادة تفكك الشرق الأوسط، ويفتح الباب أمام اقتصاد جغرافي قائم على الإكراه، حيث تعيد القوى الإقليمية والدولية ضبط استراتيجياتها وفق إطار جديد لمعادلات القوة. إذا استمرت هذه السياسة، فمن المحتمل أن تؤدي إلى تحول هيكلي في أنماط إدارة النزاعات في الشرق الأوسط، مما يسرع بروز نظام متعدد المراكز، حيث تصبح القدرة على التكيف أكثر أهمية من القوة التقليدية المجردة.
وفي هذا السياق، فإن القرار المتعلق بغزة قد لا يعيد فقط تشكيل التوازنات الإقليمية، بل قد يكون محفزا لإعادة هيكلة التموضع الاستراتيجي للولايات المتحدة على المستوى العالمي.
المصدر: هسبريس