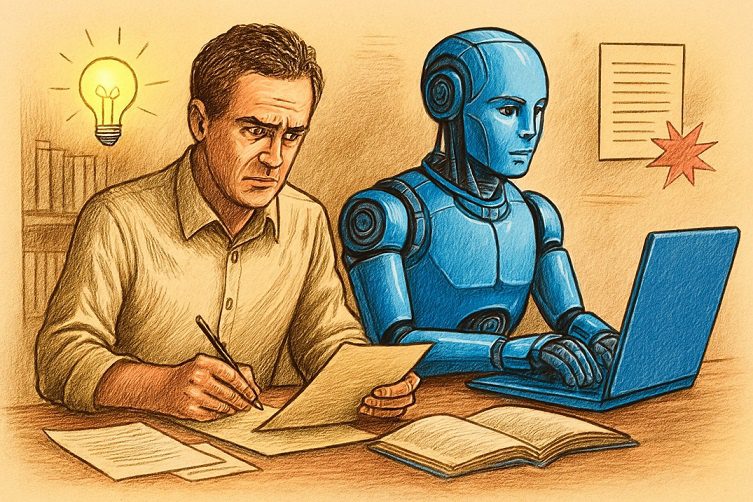كانت الكتابة، ولا تزال، واحدة من أعرق الفنون الإنسانية وأكثرها غموضاً. لطالما نظرنا إلى الكاتب على أنه ذلك الكائن الاستثنائي، الحارس الأمين للغة، وصانع المعنى الذي ينتزع الفكرة من ظلمة اللاوجود إلى نور الوجود. كان عملاً نخبوياً بامتياز، يتطلب موهبةً تعتقد أنها هبة سماوية، وثقافةً موسوعيةً تشبه مكتبة الإسكندرية في عقل إنسان. لكن الزمن يدور، والعجلة لا تقف، ها نحن اليوم نعيش في حقبة جديدة حيث لم يعد “الكتّاب” وحدهم من “يكتبون.”
لقد دخل عنصر جديد وغريب على هذه المعادلة القديمة، عنصرٌ من صلب عصرنا الرقمي: الذكاء الاصطناعي. هذا الدخيل لا يهدد مهنة الكتابة بقدر ما يقوم بهزّ أسسها وهُوِيّتها، دافعاً إياها نحو تحول جوهري ربما يجعلنا نعيد النظر في تعريفها من جديد، من مهنة مقدسة إلى حرفة قائمة على المهارة والإدارة.
جسد جديد
لم يعد مشهدا مألوفاً، أن نرى الكاتب جالساً أمام رزمة من الأوراق أو شاشة فارغة يواجه عتمة ذهنه وحده، يتلمّس طريقه نحو فكرة، يبحث في الكتب، يتنقل بين المصادر، ويخوض معركة شرسة مع الجمل الأولى. اليوم، المشهد مختلف. مازال الكاتب يجلس أمام نفس الشاشة، لكنه ليس وحيداً. بضعة نقرات تفصله عن الوصول إلى ملايين الصفحات من المعلومات، وعن تلخيص مقالة طويلة في ثوان، وترجمة النصوص بين اللغات، وتدقيق النصوص لغويا، والحصول على اقتراحات لأسلوب صياغة مختلفة، بل وحتى عن توليف نصوص كاملة بناء على توجيه بسيط.
لقد أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات اللغوية التفاعلية، الرفيق الذي لا يمل، والمعين الذي لا ينضب. لم يعد دور الكاتب ينحصر في “إنتاج” النص حرفاً حرفاً، بل تحوّل إلى دور “المهندس” أو “المخرج”. هو من يحدد الرؤية، يختار الزاوية، يوجه الأسئلة الذكية للآلة، ثم يأتي الناتج الخام ليقوم هو بتشذيبه، تنقيحه، وصقله، وإضافة بصمته الشخصية التي تميزه. إنه تحول من كونك عاملاً في خط الإنتاج إلى كونك مديراً لذلك الخط.
هذا التحول في الأدوار لا يقلل من قيمة العملية الكتابية، على العكس تماماً، إنه يعيد تشكيل قيمتها. فالكتابة لم تعد تقاس فقط ببلاغة التعبير أو التنقيب بالمعلومات، بل بقدرة الكاتب على “إدارة” المعنى. إنها حرفة جديدة بمعايير جديدة. حرفة رقمية تتطلب مهارات لم تكن موجودة في المناهج القديمة: مهارة صياغة الأمر الفعّال للذكاء الاصطناعي، ومهارة التحرير الاستراتيجي الذي يفرز الغث من السمين في النتائج المتولدة، ومهارة تصميم التأثير، أي كيفية صياغة النص النهائي لتحقيق هدفه الإعلامي أو الإقناعي أو الجمالي بأعلى كفاءة.
هذه المهارات، في تعقيدها ودقتها وحاجتها إلى الذكاء البشري، لا تقل عن مهارات أي حرفي تقليدي. الحداد يطرق الحديد، والنجار ينحت الخشب، والكاتب في عصر الذكاء الاصطناعي يصوغ الفكرة ويشكل الوعاء الذي تحيا فيه. الفرق الوحيد أن منتج الحرفي التقليدي ملموس، بينما منتج الكاتب الجديد هو أثر فكري، معرفي، وعاطفي يطير في الفضاء الرقمي ليصل إلى عقول وقلوب الملايين.
بطبيعة الحال، يقف البعض متوجساً من هذا التحول، محذراً من أن الآلة ستفترس روح الإبداع، ستحول الكتابة إلى عملية ميكانيكية جافة، خالية من الدفء الإنساني الذي يميزها. هذا القلق مشروع، ولكنه في رأيي قلقٌ ينبع من نظرة مثالية للتاريخ. فالتقنيات الجديدة دائماً ما تثير هذا الخوف. ربما قالوا شيئاً مشابهاً عندما اخترعت آلة الطباعة، أو عندما حلّ الحاسوب محل الآلة الكاتبة.
الحقيقة هي أن الذكاء الاصطناعي، في شكله الحالي، لا يلغي الإبداع، بل يعيد توزيع الأدوار. إنه يحرر الكاتب من الأعباء الروتينية والمهمات الشاقة التي كانت تستنزف وقته وطاقته، ليمنحه مساحة أكبر وأرحب لما هو أهم: التفكير الاستراتيجي، والتأمل العميق، والتوجيه الذكي، وإضفاء البصمة الشخصية الفريدة التي لا تستطيع أي آلة تقليدها. الروح لم تُفقد، بل انتقلت من مكانها القديم إلى مكان جديد. لقد اكتسبت الكتابة جسداً جديداً، أكثر مرونة، وأوسع انتشاراً، وأعلى كفاءة.
فرصة تاريخية
لا يبدو أن هناك مجالاً يشهد هذا التحول بشكل أكثر وضوحاً وحساسية من مجال الصحافة، وخاصة في عالمنا العربي. الصحفي، الناقل التقليدي للخبر، وجد نفسه فجأة أمام ثورة معلوماتية هائلة. أدوات الذكاء الاصطناعي تمنحه قدرات خارقة: الوصول الفوري إلى المعلومات، تحليل كميات هائلة من البيانات في لحظات، مقارنة الروايات، كشف الأنماط، وتقديم الخبر في قوالب تفاعلية وتفسيرية لم تكن ممكنة من قبل.
لم يعد دوره قاصراً على نقل “ماذا” حدث، بل أصبح دوره الأساسي تفسير “لماذا” حدث، وما هي تداعياته، وكيف يمكن للجمهور أن يفهمه في سياق أوسع. لقد تحول من ناقل إلى خبير، ومن مراسل إلى مهندس للسياق.
لكن هذه القفزة التقنية لا تأتي بمعزل عن واقعنا. فالصحافة العربية لا تزال تعاني من إشكاليات بنيوية عميقة: التحرير المهني الذي يصطدم بجدار الرقابة السياسية، والرغبة في الابتكار الرقمي التي تقابلها بيروقراطية وجمود مؤسسي. هنا بالذات تكمن المعضلة والفرصة في آن واحد.
إذا أحسنت المؤسسات الصحفية العربية توظيف هذه الأدوات، لا كبديل عن الصحفي، بل كمساعد له يعطيه قوى خارقة، فيمكنها أن تقفز قفزة نوعية. يمكنها التحول من منصات تعيد تدوير الأخبار إلى منصات تحليلية استقصائية تفسيرية، تبني وعياً جماعياً، تستعيد ثقة الجمهور المفقودة، وتدافع عن استقلاليتها التحريرية بقوة المحتوى العميق والشفافية.
هذا التحول لن يحدث بمجرد شراء برنامج ذكاء اصطناعي، بل يتطلب ثورة تدريبية، وإعادة هيكلة للمناهج الدراسية في كليات الإعلام، وشجاعة لتغيير الثقافة المهنية السائدة. الصحفي المستقبلي يجب أن يكون في جزء منه مبرمجاً، محلل بيانات، وخبيراً في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كونه كاتباً ملهماً.
في الختام، نحن لا نشهد نهاية للكتابة، بل نشهد ولادة جديدة لها. الكتابة اليوم لم تعد حكراً على من يُتقن قواعد اللغة وحدها، بل أصبحت فناً لمن يُجيد فنون إدارة المعنى في محيط من الضجيج المعلوماتي.
الذكاء الاصطناعي، بكل ما يحمله من قوة وإرباك، لم يُلغِ دور الكاتب، بل قام بتثويره. لقد دفعه من برجه العاجي ليكون أكثر ديمقراطية واتصالاً بالعالم. إنها فرصة تاريخية نادرة لأن تصبح الكتابة، ذلك الفن النخبوي القديم، فعلاً ديمقراطياً يتاح للكثيرين، دون أن يخسر عمقه الفكري أو مصداقيته الأخلاقية، شرط أن نتعلّم كيف نمسك بدفّة هذه التقنية الجبارة، لا كسائق سلبي، بل كقائد حكيم يعرف إلى أين يريد أن يذهب.
علي قاسم
العرب
المصدر: صحيفة الراكوبة