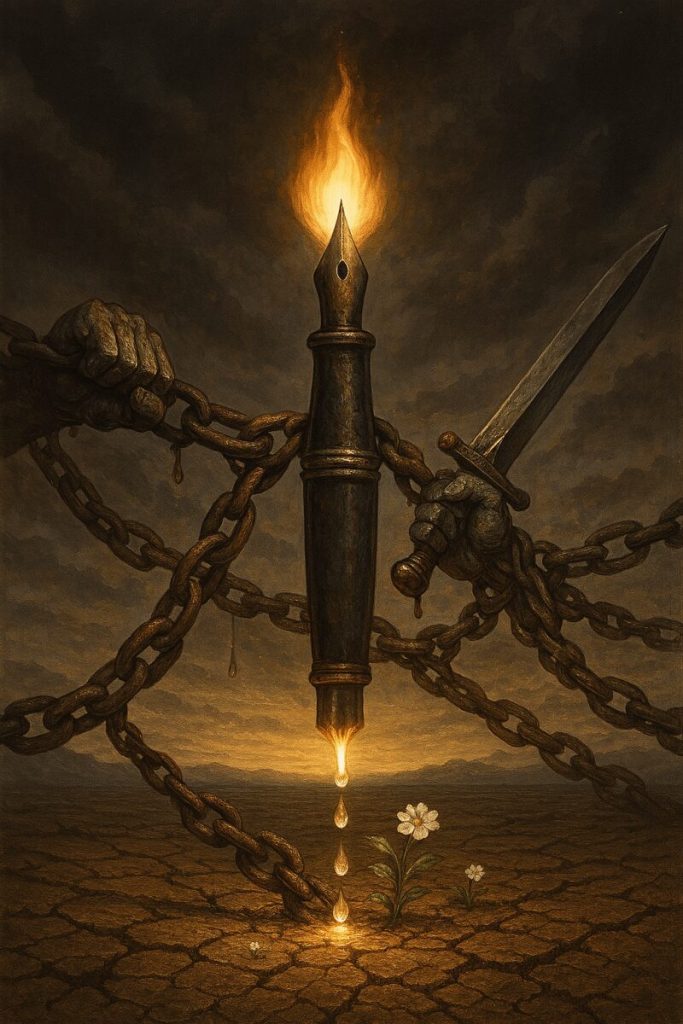مقدمة: جذور العلاقة الملتبسة المثقف الديني والسلطنات التقليدية
لفهم العلاقة المعقدة والمشحونة بالتوتر بين السلطة والمثقف في السودان الحديث، لا بد من العودة إلى الجذور التاريخية التي شكلت هذه العلاقة قبل قيام الدولة الوطنية. ففي سلطنة الفونج، المعروفة أيضاً بالسلطنة الزرقاء (15041821)، لم تكن العلاقة بين الحاكم والمثقف الديني علاقة تبعية بسيطة، بل كانت شراكة معقدة أرست أسس نمط من التوازن والتجاذب استمر تأثيره لقرون.
شكلت طبقة العلماء وشيوخ الطرق الصوفية إحدى أهم الشرائح الاجتماعية والسياسية في المجتمع السناري، حيث تمتعوا بنفوذ روحي واجتماعي كبير كان سلاطين الفونج يحسبون له ألف حساب. كان نظام الحكم في السلطنة يتسم باللامركزية، حيث كانت الأقاليم والمشيخات تتمتع باستقلال ذاتي واسع تحت السيادة الاسمية لسلطان سنار، وكان الفقهاء والقضاة يلعبون دوراً محورياً في إدارة هذه الأقاليم، ليس فقط في الشؤون الدينية والتعليمية، بل أيضاً في تدوين الضرائب وحفظ الأمن.
في هذا السياق، برز نوعان من المثقفين الدينيين: “فقهاء السلطة”، الذين ارتبطوا بالحكومة المركزية وتمتعوا بالأملاك والأراضي، و”فقهاء الشفاعة”، الذين حافظوا على استقلاليتهم وكانوا بمثابة صوت للمجتمع. لم تكن هذه العلاقة خالية من التوتر، بل شهدت لحظات تحدٍّ لسلطة الحاكم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقف الشيخ إدريس ود الأرباب، الذي رفض عرضاً سخياً من الملك بادي بن رباط بمنحه نصف مملكته، قائلاً: “هذه أرض النوبة، وأنتم اغتصبتموها منهم. أنا لا أقبلها”، مستشهداً بالحديث النبوي حول غصب الأرض. لم يكن هذا الرفض مجرد موقف شخصي، بل كان بياناً سياسياً ودينياً يضع شرعية حكم الفونج موضع تساؤل. اللافت أن رد فعل السلطان لم يكن القمع، بل محاولة الاحتواء، مما يكشف عن إدراك السلطة لحدود قوتها المادية أمام السلطة الرمزية والدينية للمثقف.
هكذا، كانت العلاقة بين السلطة والمثقف الديني في تلك الفترة أشبه بتوازن قوى؛ فالسلطان يحتاج إلى الشرعية الدينية التي يوفرها العلماء، والعلماء يحتاجون إلى حماية السلطان ورعايته. هذا التوازن خلق مساحة للمثقف الديني ليكون سلطة موازية، قادرة على النصح وحتى المعارضة الضمنية. هذا النمط من العلاقة، القائم على التوازن والاحتواء المتبادل، سيتم كسره بعنف مع ظهور الدولة المهدية، التي أعادت تعريف العلاقة بين الفكر والسلطة بشكل جذري.
الفصل الأول: الاحتلال التركي المصري (18211885) تحديث قسري ومقاومة دامية
شكل الغزو التركي المصري للسودان عام 1821 نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد، حيث أخضع لأول مرة كياناته السياسية المتفرقة لحكومة مركزية واحدة تهدف إلى “تنشيط” موارده لمصلحة الخزانة المصرية. كانت هذه الفترة مزيجاً متناقضاً من التحديث الإداري القسري، والاستغلال الاقتصادي الشديد، والقمع الدموي للمقاومة، مما أثر بشكل عميق على بنية المجتمع وعلاقة السلطة بكل مكوناته، بما في ذلك النخب التقليدية والناشئة.
1.1 طبيعة السلطة: تحديث إداري وعبء ضريبي
كانت السمة الأبرز للحكم الجديد هي فرض عبء ضريبي باهظ لم يكن مألوفاً لدى السودانيين مقارنة بعهد سلطنة الفونج. ففي ظل نظام الضرائب الثابتة، عانى المزارعون والتجار، خاصة في سنوات الجفاف، من عدم قدرتهم على السداد، مما دفع الكثيرين إلى الهجرة من أراضيهم الخصبة على ضفاف النيل إلى مناطق نائية هرباً من الأساليب الوحشية لجباة الضرائب. وقد أدى هذا العبء الضريبي، إلى جانب الفساد الإداري، إلى إرهاق الحركة الاقتصادية وتعميم الفقر.
في المقابل، أدخلت “التركية” لأول مرة أسس الدولة الحديثة، حيث تم توحيد المديريات المختلفة تحت كيان سياسي واحد، وفرض القانون والنظام، وتوسيع التجارة الداخلية والخارجية. لكن هذا التحديث كان يهدف في المقام الأول إلى خدمة أهداف الدولة المحتلة، وليس تنمية المجتمع المحلي.
1.2 سياسة التعليم: بين الاحتواء وخلق كوادر وظيفية
اتبع الحكم التركي المصري سياسة تعليمية مزدوجة. فمن ناحية، اهتم بالتعليم الديني التقليدي كوسيلة لكسب ولاء السودانيين عن طريق رجال الدين. فقد قام محمد علي باشا وخلفاؤه بدفع المرتبات للفقهاء، وتشجيع البعثات إلى الأزهر الشريف، وإعفاء رجال الدين من الضرائب.
ومن ناحية أخرى، بدأ النظام في إدخال التعليم الحديث بهدف تخريج كوادر وظيفية تحتاجها الإدارة الجديدة. افتُتحت أول مدرسة نظامية حديثة في الخرطوم عام 1855 تحت إشراف رفاعة رافع الطهطاوي، وكان الغرض منها تخريج صغار الكتبة والمحاسبين. كما شجعت الإدارة نشاط الإرساليات التبشيرية التي أنشأت مدارسها الخاصة، مما ساهم في ظهور شريحة جديدة من المتعلمين. وبهذا، بدأت تتشكل نواة طبقة مثقفة جديدة، تختلف في تكوينها وأهدافها عن طبقة العلماء التقليديين.
1.3 المثقف والمقاومة: من الزعامات التقليدية إلى الثورة الشاملة
كانت البداية الدامية للحكم التركي المصري، وما صاحبها من حملات انتقامية وحشية قادها “الدفتردار” بعد مقتل إسماعيل باشا في شندي، سبباً في مقتل العديد من العلماء والفقهاء الذين كانوا يشكلون عماد الحياة الفكرية في البلاد. لم تكن المقاومة في بدايتها فكرية منظمة، بل اتخذت شكل ثورات قبلية قادتها الزعامات التقليدية التي رأت في الحكم الجديد تهديداً لسلطتها واستقلالها.
تعتبر ثورة المك نمر، ملك الجعليين في شندي، عام 1822، أبرز مثال على هذه المقاومة المبكرة. ورغم قمع هذه الثورات وغيرها من الانتفاضات القبلية بوحشية ، إلا أنها أبقت على جذوة الرفض الشعبي للاحتلال. إن المزيج من الظلم المتمثل في الضرائب الباهظة، والعنف والقمع، وسياسة “فرق تسد” بين القبائل، والشعور العام بفقدان الاستقلال، خلق حالة من السخط العام لدى كل فئات المجتمع، من الأعيان والفقهاء إلى عامة الناس. هذه المظالم المتراكمة هي التي هيأت التربة الخصبة لاندلاع الثورة المهدية عام 1881، التي لم تكن مجرد حركة دينية، بل كانت التعبير الشامل عن رفض السودانيين للحكم التركي المصري بكل سياساته القمعية والاستغلالية.
الفصل الثاني: الدولة المهدية (18851898) ثورة الفكرة وسيف السلطة
مثلت الدولة المهدية قطيعة تاريخية مع الأنماط السابقة للعلاقة بين السلطة والمثقف. فلم تكن مجرد تغيير في الأسرة الحاكمة، بل كانت ثورة أيديولوجية شاملة أسست دولة ثيوقراطية قامت على فكرة دينية حصرية، مما جعل الخلاف الفكري معارضاً ليس فقط للسلطة، بل للدين والدولة نفسها.
المثقف كقائد أيديولوجي: تأسيس الدولة على عقيدة
قامت الثورة المهدية في جوهرها على يد مثقف ديني، هو محمد أحمد المهدي، الذي قدم نفسه ليس كحاكم سياسي فحسب، بل كشخصية دينية مُلهَمة مكلفة بمهمة إلهية. كانت المهدية حالة فريدة امتزج فيها “اليقين الصوفي بالحرب والدروشة بالسياسة”. هذا الامتزاج منح الثورة في بدايتها قوة دافعة هائلة، حيث استطاعت توحيد قطاعات واسعة من السودانيين ضد الحكم التركي المصري الذي اتسم بالفساد والضرائب الباهظة والقمع. لقد كانت ثورة تحررية ودينية في آن واحد.
أرست الدولة الجديدة نظامها على أسس أيديولوجية صارمة؛ فقد ألغت التعليم المدني والقانون المدني الذي كان سائداً في العهد التركي، وأحلت محلهما الشريعة الإسلامية كما فسرتها تعاليم المهدي ومنشوراته. وبهذا، أصبح الفكر والمعتقد هما أساس شرعية الدولة ووجودها، وأي خروج عنهما هو خروج على الدولة ذاتها.
قمع المخالفين: صراع الشرعيات
إن السمة الفارقة للمهدية، والتي شكلت سابقة خطيرة في تاريخ السودان، هي تحويلها الخلاف الفكري إلى جريمة ردة. لم يكن الصراع بين “سلطة” و”مثقف”، بل كان صراعاً بين شرعيتين فكريتين متناقضتين: الشرعية الثورية الجديدة التي يمثلها المهدي، والشرعية التقليدية التي يمثلها علماء الدين الرسميون وشيوخ الطرق الصوفية.
أصدر المهدي حكماً قاطعاً بأن “من شك في مهديتي فقد كفر”. هذه المقولة لم تكن مجرد رأي، بل أصبحت أساساً قانونياً لإباحة دم ومال كل من يعارض دعوته، وبالتالي استُحِلّت دماء وأعراض المعارضين بدعوى كفرهم بالله ورسوله. واجهت المهدية معارضة واسعة من المؤسسة الدينية التقليدية. فقد أصدر علماء الخرطوم، بتحريض من الحاكم العام عبد القادر باشا، رسائل تشكك في دعوة المهدي وتدعو إلى طاعة السلطان القائم. ومن أبرز العلماء الذين عارضوا المهدي الشيخ الأمين الضرير، شيخ علماء شرق السودان، والشيخ أحمد الأزهري، شيخ علماء غرب السودان، الذين رأوا في المهدية خروجاً على الخلافة العثمانية وشروط الإمامة المتفق عليها.
كما عارضتها طرق صوفية كبرى كالختمية، التي كانت ترى في دعوة المهدي تهديداً لنفوذها الروحي والاجتماعي. ورداً على ذلك، أصدر المهدي قراراً بإلغاء جميع المذاهب الفقهية والطرق الصوفية، معتبراً أن طريقته هي الوحيدة الصحيحة، وأن من يخالف ذلك فهو كافر. وبهذا، لم تترك الدولة المهدية أي مساحة للرأي الآخر، وحولت الخلاف الفكري إلى جريمة عقوبتها الموت.
آليات القمع في عهد الخليفة عبد الله: المحاكمات وتصفية الخصوم
بعد وفاة المهدي عام 1885، تولى الخليفة عبد الله التعايشي السلطة، وفي عهده تحول القمع من صراع أيديولوجي إلى أداة سياسية بحتة لتثبيت الحكم وتصفية المنافسين السياسيين، مع الاحتفاظ بالغطاء الديني. واجه الخليفة معارضة شرسة من داخل البيت المهدي نفسه، خاصة من “الأشراف”، وهم أقارب المهدي الذين رأوا أنفسهم أحق بالخلافة.
لجأ الخليفة إلى استخدام القوة لتجريد خصومه من نفوذهم، مثلما فعل مع محمد خالد زقل، عامل دارفور، والخليفة محمد شريف، أحد خلفاء المهدي. ولإضفاء شرعية دينية على أفعاله، استخدم الخليفة المؤسسة القضائية والدينية كأداة للقمع. ففي مارس 1892، عقد مجلساً مكوناً من 46 من الأمراء والقضاة لمحاكمة الخليفة شريف بتهمة العصيان، وأصدر المجلس حكماً بإدانته وسجنه. وبهذا، تم توظيف “محكمة الإسلام” التي أنشئت في عهده لتصفية الخصوم السياسيين تحت ستار الدين، مما أفقدها أهميتها وجعل منصب قاضي الإسلام محفوفاً بالمخاطر.
وهكذا، أرست الدولة المهدية نمطاً خطيراً من القمع، حيث تم تكفير المعارضة الفكرية، واستُخدمت المؤسسات الدينية والقضائية كأدوات لتصفية الخصوم السياسيين، وهو إرث ستكون له تداعيات عميقة على علاقة السلطة بالمثقف في الحقب اللاحقة.
الفصل الثالث: الحكم الثنائي (18991956) صناعة “الأفندي” ومقاومة المستعمر
مع سقوط الدولة المهدية وبداية فترة الحكم الإنجليزي المصري، دخلت علاقة السلطة بالمثقف مرحلة جديدة ومفارقة. فالسلطة الاستعمارية لم تقمع مثقفاً موجوداً بقدر ما صنعت طبقة جديدة من المثقفين لخدمة أهدافها الإدارية، لكنها فشلت في السيطرة على نتاجها الفكري، مما أدى إلى علاقة يمكن وصفها بـ”الاحتواء الفاشل” الذي تحول إلى قمع منظم.
سياسة التعليم الاستعمارية: أداة للسيطرة ونواة للمقاومة
كانت السياسة التعليمية للحكم الثنائي براغماتية في جوهرها. فبعد القضاء على المهدية، أدركت الإدارة الجديدة حاجتها إلى كوادر محلية لإدارة الدولة الشاسعة. تم تحديد أهداف التعليم بوضوح من قبل السير جيمس كري، أول مدير لمصلحة المعارف: خلق طبقة من الصناع المهرة، وتدريب السودانيين لشغل الوظائف الحكومية الصغرى ليحلوا محل الموظفين المصريين والسوريين الأكثر تكلفة والأقل ولاءً. لم يكن الهدف خلق مفكرين أو قادة سياسيين، بل تخريج كتبة ومحاسبين وفنيين.
كانت كلية غردون التذكارية، التي وضع حجر أساسها عام 1899 وافتتحت رسمياً عام 1902، محور هذه السياسة. ركزت الكلية في بداياتها على “الكفاءة العملية” والتدريب المهني لتلبية احتياجات الإدارة الاستعمارية. ورغم هذه الأهداف المحدودة، فإن التعليم بطبيعته يفتح آفاقاً تتجاوز الغرض الوظيفي. فقد أتاحت هذه السياسة، عن غير قصد، نشوء طبقة جديدة من المتعلمين السودانيين الذين أُطلق عليهم اسم “الأفندية”، وهي طبقة برجوازية صغيرة من الموظفين والمهنيين اطلعت على الأفكار الحديثة المتعلقة بالقومية والحرية وتقرير المصير.
مؤتمر الخريجين: ولادة المثقف السياسي
كان مؤتمر الخريجين العام، الذي تأسس عام 1938، هو التجسيد السياسي لهذه الطبقة الجديدة. لقد استخدم الخريجون نفس المهارات التنظيمية والفكرية التي اكتسبوها من النظام التعليمي الاستعماري لتحدي ذلك النظام. بدأ المؤتمر كهيئة اجتماعية وثقافية في الظاهر، لتجنب الصدام المباشر مع السلطات التي لم تكن تسمح بالعمل السياسي ، لكن هدفه الحقيقي كان سياسياً بحتاً: تحرير السودان.
نشأ المؤتمر من رحم الجمعيات الأدبية والأندية الثقافية التي أسسها الخريجون في مدن مختلفة، وبدأت الدعوة إليه عبر مقالات صحفية. وفي 12 فبراير 1938، عُقد الاجتماع التأسيسي بحضور أكثر من ألف خريج، وانتُخب إسماعيل الأزهري أول رئيس له. شكل المؤتمر تحولاً نوعياً، حيث انتقل المثقف السوداني من دوره الاجتماعي المحدود إلى فاعل سياسي منظم يقود الحركة الوطنية. وبلغ هذا الدور ذروته في 3 أبريل 1942، عندما قدم المؤتمر مذكرته الشهيرة إلى الحاكم العام، مطالباً بحق السودانيين في تقرير مصيرهم بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم أن السلطات رفضت المذكرة واعتبرت أن المؤتمر تجاوز صفته، إلا أن هذه الخطوة رسخت دوره كقائد للحركة الوطنية، وأصبح النواة التي انبثقت عنها لاحقاً الأحزاب السياسية السودانية الحديثة.
الصحافة كسلاح للمقاومة وآليات القمع الاستعماري
كانت الصحافة هي المنبر الرئيسي الذي عبر من خلاله المثقفون الجدد عن أفكارهم ونشروا الوعي الوطني. ظهرت الصحافة الحديثة في السودان مع بداية الحكم الثنائي، وكانت في معظمها مملوكة لأجانب وموجهة للجاليات الأجنبية. لكن تدريجياً، بدأت الأقلام السودانية تظهر على صفحاتها، مثل صحيفة “رائد السودان” التي أتاحت مساحة للكتابة في الفكر والأدب.
عندما أدركت الإدارة البريطانية أن “أداتها” التعليمية قد تمردت، وأن الصحافة أصبحت سلاحاً في يد الحركة الوطنية، لجأت إلى القمع القانوني المنظم. ففي عام 1930، أصدرت “قانون الصحافة والمطبوعات”، وهو أول قانون من نوعه في تاريخ السودان. كان القانون يهدف صراحة إلى “كبح جماح الوعي الوطني”. احتوى القانون على بنود تقييدية صارمة، أهمها ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لإصدار أي صحيفة، وفرض إيداع تأمين مالي باهظ لم يكن في مقدور معظم السودانيين توفيره، مما جعل ملكية الصحف حكراً على قلة قليلة. وبهذا، كان القمع الاستعماري رد فعل على فشل سياسة الاحتواء، وليس سياسة ابتدائية، حيث حاولت السلطة السيطرة قانونياً على الفضاء العام الذي لم تعد قادرة على السيطرة عليه فكرياً.
الفصل الرابع: دوامات ما بعد الاستقلال (19561989) بين الديمقراطية والديكتاتورية
شهدت العقود الثلاثة الأولى بعد الاستقلال تناوباً حاداً بين فترات ديمقراطية هشة وأنظمة عسكرية قمعية. وفي كل مرحلة، كان المثقف في قلب الصراع، إما كقائد للمعارضة ووقود للثورات الشعبية، أو كضحية للقمع والتصفية، أو كأداة في يد السلطة تستخدمها ثم تتخلص منها.
الديمقراطية الأولى (19561958) وانقلاب عبود (19581964): القمع الشامل
ورث السودان المستقل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1930، لكن فترة الديمقراطية الأولى شهدت ازدهاراً نسبياً للصحافة الحزبية والمستقلة وحرية التعبير. غير أن هذا العهد الديمقراطي لم يدم طويلاً، ففي 17 نوفمبر 1958، استولى الفريق إبراهيم عبود على السلطة في أول انقلاب عسكري في تاريخ البلاد.
اتبع نظام عبود نهجاً قمعياً شاملاً، حيث قام فوراً بحل جميع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ومنع التجمعات والمظاهرات، وأوقف الصحف وصادر دورها. لقد كان هجوماً كلياً على الفضاء المدني والسياسي الذي تشكل خلال فترة النضال الوطني. وكما في عهد الاستعمار، تحولت الجامعات، وخاصة جامعة الخرطوم، إلى قلاع للمعارضة الفكرية والسياسية.
كان المثقفون، من طلاب وأكاديميين ومهنيين، هم وقود المقاومة ضد الديكتاتورية. وبلغت المواجهة ذروتها في أكتوبر 1964، عندما قرر طلاب جامعة الخرطوم إقامة ندوة لمناقشة قضية جنوب السودان، التي كان النظام العسكري يتعامل معها بمنطق الحل العسكري فقط. قمعت الشرطة الندوة بعنف، وأطلقت الرصاص الحي على الطلاب، مما أدى إلى مقتل الطالب أحمد القرشي طه، الذي أصبح أيقونة الثورة. أشعلت هذه الحادثة انتفاضة شعبية عارمة قادتها “جبهة الهيئات”، وهي تحالف واسع من النقابات المهنية (الأطباء، المحامون، أساتذة الجامعات، القضاة)، التي دعت إلى إضراب سياسي عام شلّ الدولة وأجبر الفريق عبود على تسليم السلطة للمدنيين.
الديمقراطية الثانية (19641969): حريات هشة وصراعات أيديولوجية
أعادت ثورة أكتوبر 1964 الديمقراطية والحريات العامة ، لكنها كانت فترة مشحونة بالاستقطاب الأيديولوجي الحاد. شهدت هذه المرحلة صعوداً قوياً للأحزاب العقائدية، خاصة الحزب الشيوعي السوداني من اليسار، وجبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمون) من اليمين. ورغم أن الديمقراطية كانت مكسباً أساسياً للثورة، إلا أنها تعرضت لانتكاسة خطيرة من داخلها، حين صوتت الجمعية التأسيسية (البرلمان) على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين في عام 1965. كانت هذه سابقة خطيرة، حيث استخدمت الأغلبية البرلمانية سلطتها لقمع أقلية فكرية، مما كشف عن هشاشة الالتزام بالديمقراطية لدى بعض القوى السياسية التقليدية. أدت حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع الأيديولوجي إلى فشل الحكومات الائتلافية المتعاقبة في حل مشاكل البلاد الأساسية، وعلى رأسها قضية الجنوب والدستور الدائم ، مما مهد الطريق لانقلاب عسكري جديد.
نظام نميري (19691985): من التحالف إلى التصفية
يمثل عهد جعفر نميري النموذج الأكثر تطرفاً وتقلباً في علاقة السلطة العسكرية بالمثقف. لقد كشف هذا النظام عن رؤية براغماتية بحتة تعتبر المثقف مجرد أداة وظيفية يمكن استخدامها ثم التخلص منها عندما تصبح تهديداً.
في 25 مايو 1969، قاد نميري انقلاباً عسكرياً قام على تحالف بين الضباط القوميين العرب والحزب الشيوعي السوداني. في البداية، هيمن المثقفون اليساريون على مفاصل الدولة، لكن سرعان ما دب الخلاف بين نميري وحلفائه الشيوعيين. بلغ الصراع ذروته في 19 يوليو 1971، عندما قاد ضباط شيوعيون بقيادة الرائد هاشم العطا انقلاباً مضاداً نجح في السيطرة على السلطة لثلاثة أيام.
بعد فشل الانقلاب واستعادة نميري للسلطة بمساعدة خارجية، شن حملة تصفية دموية وغير مسبوقة ضد اليسار السوداني. لم يقتصر الأمر على إعدام قادة الانقلاب العسكريين، بل امتد ليشمل القيادة المدنية والفكرية للحزب الشيوعي. أُعدم السكرتير العام للحزب، المفكر عبد الخالق محجوب، والقيادي النقابي البارز الشفيع أحمد الشيخ، وجوزيف قرنق، وهو مثقف جنوبي بارز، إلى جانب عشرات آخرين. لم يكن هذا مجرد قمع، بل كان عملية استئصال متعمدة لقيادة فكرية وسياسية بأكملها.
وفي العقد التالي، وبعد أن فقد قاعدته اليسارية، قام نميري بتحول دراماتيكي آخر. ففي عام 1983، تحالف مع الحركة الإسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابي، وأعلن تطبيق ما عُرف بـ”قوانين سبتمبر”، التي فرضت تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية. وكما استخدم اليسار لتثبيت سلطته ثم أبادهم، استخدم الإسلاميين الآن لتوفير غطاء أيديولوجي جديد لنظامه.
كانت أبرز ضحايا هذا التحالف الجديد هو المفكر الإسلامي الإصلاحي محمود محمد طه. عارض طه “قوانين سبتمبر” بشدة، واعتبرها تشويهاً للإسلام وتهديداً لوحدة البلاد، وأصدر منشوره الشهير “هذا أو الطوفان”. على إثر ذلك، قُبض عليه وحوكم بتهمة الردة في محاكمة صورية لم تستغرق ساعات. وفي 18 يناير 1985، تم إعدامه شنقاً في سابقة هي الأولى والأخيرة من نوعها في تاريخ السودان الحديث، حيث تُعدم الدولة مفكراً بسبب آرائه الدينية. لقد كرر نميري النمط نفسه: التحالف مع تيار فكري، ثم استخدامه كأداة لتصفية خصومه الفكريين، ليؤكد أن السلطة العسكرية لا ترى في المثقف إلا حليفاً مؤقتاً أو تهديداً وجودياً.
الفصل الخامس: نظام الإنقاذ (19892019) القمع الممنهج وتفكيك الدولة
إذا كانت الأنظمة الديكتاتورية السابقة قد مارست القمع كأداة لإسكات المعارضة، فإن نظام الإنقاذ، الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989، قد ارتقى بالقمع إلى مستوى جديد، محولاً إياه إلى مشروع “هندسة اجتماعية” شامل. لم يكن الهدف مجرد قمع المثقفين المعارضين، بل إزالتهم بالكامل من بنية الدولة والمجتمع، واستبدالهم بطبقة فكرية وإدارية موالية، في محاولة “كليانية” للسيطرة ليس فقط على السياسة، بل على الفكر والثقافة والاقتصاد.
سياسة “التمكين”: التطهير الأيديولوجي الشامل
كانت سياسة “التمكين” هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع. تحت شعارات “المشروع الحضاري”، شنت الجبهة الإسلامية القومية، التي كانت القوة الحقيقية وراء الانقلاب، حملة تطهير واسعة وممنهجة داخل كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. تم فصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، أساتذة الجامعات، القضاة، الدبلوماسيين، والضباط، تحت ذريعة “الصالح العام”، وهي نفس الذريعة التي انتقدها قادة الانقلاب في بيانهم الأول.
لم تكن هذه الإقالات عشوائية، بل كانت عملية استبدال مدروسة تهدف إلى إحلال كوادر الحركة الإسلامية في كل المناصب الحيوية، من أصغر وظيفة إدارية إلى أعلى المناصب في الدولة. أدت هذه السياسة إلى تدهور كارثي في كفاءة الخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية، حيث أصبح الولاء الأيديولوجي هو المعيار الوحيد للتوظيف والترقية، بدلاً من الكفاءة والخبرة. لقد كان الهدف هيكلياً: ليس فقط اعتقال أستاذ جامعي معارض، بل ضمان ألا يصبح أي شخص غير موالٍ للنظام أستاذاً في المقام الأول. وبعد سقوط النظام، تشكلت “لجنة إزالة التمكين” في محاولة لتفكيك هذه الشبكة الواسعة من السيطرة السياسية والاقتصادية.
جهاز الأمن والمخابرات: الذراع القمعية للنظام
كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني (NISS) هو الذراع الضاربة التي نفذت سياسات القمع. تم توسيع صلاحيات الجهاز بشكل غير مسبوق، وأصبح دولة داخل الدولة، يسيطر ليس فقط على الأمن، بل على قطاعات واسعة من الاقتصاد. ارتبط اسم الجهاز في أذهان السودانيين بالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والقتل خارج نطاق القانون.
منحه قانون الأمن الوطني لعام 2010 سلطات شبه مطلقة، بما في ذلك القدرة على الاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون إشراف قضائي، كما وفر حصانة كاملة لأفراده من أي ملاحقة قانونية على الأفعال التي يرتكبونها أثناء أداء واجبهم. لقد تحول الجهاز إلى أداة بطش شاملة، لا تستهدف السياسيين والنشطاء فحسب، بل كل مواطن يجرؤ على التعبير عن رأي مخالف.
خنق الحريات: استهداف الصحافة والفنون والأوساط الأكاديمية
شن نظام الإنقاذ هجوماً شاملاً على كافة أشكال التعبير الفكري والثقافي بهدف تجفيف منابع الإبداع النقدي في المجتمع.
- الصحافة: تعرضت لأعنف حملة قمع في تاريخها. أصبحت الرقابة القبلية اليومية، حيث يقوم ضابط أمن بمراجعة مواد الصحف قبل طباعتها وحذف ما لا يروق له، ممارسة روتينية. كما كانت مصادرة الصحف بعد طباعتها، واعتقال الصحفيين، وإغلاق الصحف بالكامل، من الأدوات الشائعة لإسكات أي صوت معارض.
- الفنون: اعتبر النظام الفنون، وخاصة الموسيقى والدراما والفن التشكيلي، تهديداً لقيمه الأيديولوجية. تمت محاربة الفنانين، وتجميد نشاط معهد الموسيقى والمسرح لسنوات، وإغلاق صالات العرض، وفرض قيود صارمة على الحفلات العامة. أدى هذا الجو الخانق إلى هجرة المئات من أبرز الفنانين والمبدعين السودانيين إلى خارج البلاد، مما أدى إلى تفريغ الساحة الثقافية من رموزها.
- الأوساط الأكاديمية: تم إخضاع الجامعات لسيطرة أيديولوجية كاملة. فبالإضافة إلى عمليات الفصل الواسعة للأساتذة، تم قمع الحريات الأكاديمية، واستُخدم العنف المفرط ضد النشاط الطلابي المعارض، وتم تعيين إدارات الجامعات وعمداء الكليات على أساس الولاء السياسي.
لقد كان عهد الإنقاذ تتويجاً لتاريخ طويل من القمع، لكنه تميز بالمنهجية والشمولية، حيث لم يكتفِ بقمع المعارضة، بل سعى إلى إعادة تشكيل الدولة والمجتمع على صورته، مما ترك إرثاً مدمراً من الانقسام وتدهور المؤسسات استمرت آثاره حتى بعد سقوطه.
الفصل السادس: ما بعد 2019 آمال محطمة ومستقبل غامض
أشعلت المقاومة الفكرية والثقافية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والسياسية، شرارة ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام الإنقاذ في أبريل 2019. فتحت الثورة الباب أمام آمال عريضة بفترة انتقالية تؤسس لدولة ديمقراطية تحترم الحريات. لكن هذه الآمال سرعان ما تحطمت، ودخلت علاقة السلطة بالمثقف مرحلتها الأكثر مأساوية، حيث تحول الصراع من قمع الدولة المنظمة للمعارضة، إلى عنف انهيار الدولة الذي يستهدف وجود المثقف والمجتمع المدني نفسه.
انفتاح ما بعد الثورة وانقلاب 2021
شهدت الفترة التي أعقبت سقوط البشير انفتاحاً غير مسبوق في الحريات. تراجعت الرقابة القبلية على الصحف، وانتعشت حرية التعبير، ونشطت النقاشات العامة حول مستقبل البلاد. ومن أبرز مكاسب هذه الفترة تأسيس “نقابة الصحفيين السودانيين” المستقلة في أغسطس 2022، لأول مرة منذ أن حلها نظام الإنقاذ قبل 33 عاماً.
لكن هذا الانفتاح كان هشاً. ففي 25 أكتوبر 2021، نفذ المكون العسكري في السلطة الانتقالية انقلاباً، وأعاد فرض حالة الطوارئ. عادت مع الانقلاب كل آليات القمع القديمة: تم اعتقال الصحفيين والنشطاء، والاعتداء عليهم بالضرب، واقتحام مكاتب القنوات الفضائية، وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل متكرر لعرقلة تنظيم الاحتجاجات وتغطيتها الإعلامية. أظهر الانقلاب أن البنى العميقة للدولة القمعية، خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية، لم يتم تفكيكها، وأنها لا تزال ترى في الفضاء المدني والمثقف الحر تهديداً لسلطتها.
حرب 2023 وتداعياتها: المثقف كضحية مباشرة
أدى الصراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اندلاع حرب شاملة في 15 أبريل 2023، مما أدخل البلاد في كارثة إنسانية وانهيار كامل للدولة. في هذا السياق، لم يعد المثقف مجرد هدف للقمع السياسي، بل أصبح ضحية مباشرة للعنف العشوائي والممنهج.
ارتكبت الأطراف المتحاربة انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي. أصبح الأطباء والمسعفون والناشطون الحقوقيون والصحفيون أهدافاً مباشرة. تم اغتيال شخصيات بارزة مثل الطبيب والناشط الحقوقي آدم زكريا في الجنينة ، واغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر بعد انتقاده لقوات الدعم السريع.
كانت الصحافة من أكبر ضحايا الحرب. قُتل ما لا يقل عن 31 صحفياً منذ بدء النزاع ، وتعرض العشرات للاعتقال والاعتداء، بينما اضطر أكثر من 1500 صحفي للنزوح داخلياً أو اللجوء إلى خارج البلاد. توقفت جميع الصحف الورقية عن الصدور، ودُمرت مقرات المؤسسات الإعلامية، وتوقفت الحياة الثقافية والفنية بشكل شبه كامل، حيث فر الفنانون والمبدعون من جحيم الحرب.
تمثل هذه المرحلة تحولاً نوعياً في طبيعة التهديد. لم يعد الأمر يتعلق بدولة منظمة تقمع معارضة فكرية، بل بفصائل مسلحة في دولة منهارة تستهدف كل من يمثل بقايا المجتمع المدني. أصبح استهداف الطبيب أو الصحفي أو الناشط لا يهدف فقط لإسكات صوته أو منعه من التوثيق، بل يهدف إلى محو وجوده كرمز لإمكانية قيام بديل عن حكم الميليشيات ومنطق السلاح. إنها حرب على فكرة الدولة المدنية نفسها، والمثقف هو حامل هذه الفكرة.
خاتمة: أنماط مستمرة ورؤى للمستقبل
يكشف التتبع التاريخي للعلاقة بين السلطة والمثقف في السودان عن أنماط قمع متكررة تطورت وتصاعدت في حدتها عبر الأنظمة المتعاقبة. فمنذ الدولة المهدية التي حولت الخلاف الفكري إلى جريمة ردة، مروراً بالقمع القانوني المنظم في عهد الاستعمار، وصولاً إلى التصفية الجسدية والأيديولوجية في الأنظمة العسكرية، وانتهاءً بالقمع الممنهج والتطهير المؤسسي في عهد الإنقاذ، ظلت السلطة في السودان، خاصة في أشكالها العسكرية والعقائدية، تنظر إلى المثقف المستقل كتهديد وجودي يجب إخضاعه أو إزالته.
في المقابل، تطور دور المثقف السوداني بشكل لافت. فمن المثقف الديني الذي كان يمثل سلطة موازية في العهود القديمة، إلى المثقف “الأفندي” الذي قاد حركة التحرر الوطني، ثم المثقف الأيديولوجي الذي شكل قوام الأحزاب العقائدية، وصولاً إلى المثقف الناشط في منظمات المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان في العصر الحديث. ورغم القمع الشديد، ظل المثقفون السودانيون في طليعة الحركات الشعبية التي أطاحت بالديكتاتوريات في أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وديسمبر 2018.
توضح الكارثة الحالية التي حلت بالبلاد منذ أبريل 2023 أن قمع الفكر وتدمير المؤسسات المدنية والثقافية لا يؤدي إلا إلى انهيار الدولة وسيادة منطق العنف. إن أي حل مستقبلي ومستدام للسودان لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جذرية لهذا الإرث الطويل من القمع. ويتطلب ذلك ما يلي:
- العدالة الانتقالية والمحاسبة: يجب إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المثقفين والنشطاء والصحفيين والمواطنين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها لكسر حلقة الإفلات من العقاب.
- التفكيك والإصلاح المؤسسي: يجب تفكيك الأجهزة الأمنية القمعية وإعادة هيكلتها لتكون خاضعة للسلطة المدنية والرقابة القضائية، وإصلاح القوانين المقيدة للحريات لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- الحماية الدستورية للحريات: يجب أن ينص أي دستور مستقبلي بوضوح على حماية حرية الفكر والتعبير والصحافة والتجمع السلمي، وإنشاء آليات قضائية مستقلة وفعالة لضمان تطبيق هذه الحقوق.
- إعادة بناء الفضاء العام: يجب دعم إعادة بناء المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية المستقلة، فهي ليست مجرد خدمات، بل هي الركيزة الأساسية لإنتاج المعرفة، وتشكيل وعي نقدي، وبناء مجتمع مدني قادر على مراقبة السلطة والمشاركة في بناء دولة المواطنة والديمقراطية.
إن مستقبل السودان يعتمد بشكل حاسم على قدرته على بناء عقد اجتماعي جديد تكون فيه السلطة خادمة للمجتمع لا قامعة له، ويكون فيه المثقف شريكاً في البناء والتنمية لا عدواً يُخشى صوته.
ملحق (1): جدول مقارن لآليات القمع في الأنظمة العسكرية الرئيسية
ملحق (2): جدول زمني لأبرز وقائع استهداف المثقفين في السودان
المصدر: صحيفة الراكوبة