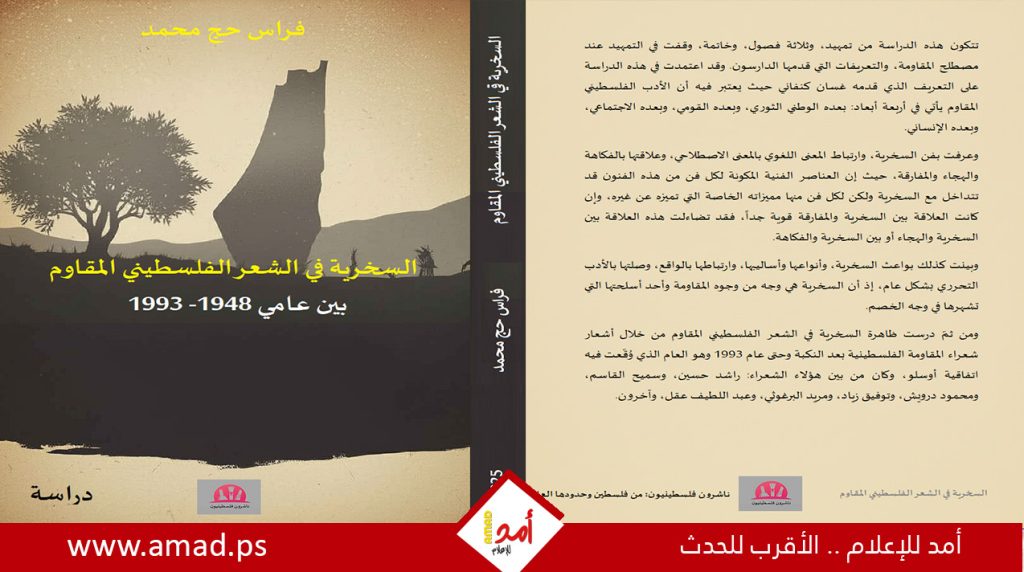أمد/ صدر حديثًا عن “ناشرون فلسطينيون” كتاب “السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم بين عامي (19481993)”، في طبعته الأولى لعام 2025 بصيغة إلكترونية (eBook)، لكاتبه الباحث والأكاديمي الفلسطيني فراس حج محمد. يقدم هذا الإصدار دراسة معمقة لظاهرة السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم، مسلطًا الضوء على دورها كسلاح أدبي في مواجهة الاحتلال والقهر. يمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة النقدية العربية والفلسطينية، كونه يتناول جانبًا حيويًا من الأدب الفلسطيني لم يحظَ بالدراسة الشاملة التي يستحقها.
رحلة البحث: دوافع وامتدادات زمنية ومكانية
يأتي هذا البحث ثمرة لجهد أكاديمي بدأه فراس حج محمد في دراساته الجامعية، متأثرًا بالروح الثورية المقاومة التي يتميز بها الأدب الفلسطيني. وُلدت فكرة البحث من اقتراح أستاذه الدكتور عادل الأسطة، الذي لاحظ بروز سمة السخرية في الأدب الفلسطيني عمومًا والشعر خصوصًا. وبناءً على ذلك، استقرت الخطة البحثية على التركيز على “السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم بين عامي (19481993)”، مستبعدًا النثر لوجود دراسات سابقة تناولت الكاتب إميل حبيبي أبرز الكتاب الساخرين في هذا المجال في ذلك الوقت.
يحدد الكتاب فترة زمنية محددة تبدأ من نكبة عام 1948 وحتى عام 1993، وهي فترة شهدت تحولات مفصلية في القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من وجود شعراء ساخرين قبل النكبة مثل إبراهيم طوقان، إلا أن البحث آثر التركيز على الفترة المحددة لتجنب التكرار، مع الإشارة إلى جهود الباحثين السابقين في هذا الصدد.
يتألف البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. يتوقف التمهيد عند مفهوم المقاومة في الأدب الفلسطيني والسخرية لغويًا واصطلاحيًا، وعلاقتها بالفنون الأدبية الأخرى. تتناول الفصول الثلاثة السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم في مراحل زمنية محددة: (19481967)، و(19671987)، و(19871993).
الأدب المقاوم والسخرية: مفهوم وتداخلات
يعتمد الباحث في تعريفه للأدب الفلسطيني المقاوم على رؤية غسان كنفاني، التي ترى فيه أربعة أبعاد رئيسية: البعد الوطني الثوري، والبعد القومي، والبعد الاجتماعي، والبعد الإنساني. هذا التعريف الشامل يؤكد أن أدب المقاومة يتجاوز مجرد المعارضة ليشمل فعل الصمود والتحدي والتعبير عن الوجود الفلسطيني بمختلف أبعاده.
أما السخرية، فينظر إليها الكتاب كجزء لا يتجزأ من الأدب الفكاهي، ولكنها تحمل دلالات أعمق تتجاوز مجرد الضحك. يوضح الباحث العلاقة المعقدة بين السخرية ومفاهيم أخرى مثل الفكاهة، والتهكم، والهجاء، والمفارقة. على الرغم من التداخلات، إلا أن لكل منها خصائصه المميزة. فالسخرية “طريقة في الكلام يعبر بها الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل”، أو “الهزء بشيء ما لا ينسجم مع القناعة العقلية ولا يستقيم مع المفاهيم المنتظمة في عرف الفرد والجماعة”.
يؤكد الكتاب أن السخرية فن أدبي رفيع يتطلب ذكاءً ومهارة فائقة، وتُعد من “أعسر الفنون الأدبية”، تنبع السخرية من انفعال الغضب وتحمل ميولًا عدوانية، مما يجعلها سلاحًا فعالًا في مقارعة المحتلين والظلم. كما أنها تتسم بالشجاعة والجرأة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأدب التحرر والثورة.
من الجوانب المهمة التي يتناولها الكتاب هي الطبيعة الاجتماعية للسخرية، حيث تُعتبر مرآة تعكس أحوال المجتمع وقيمه. فالساخر يتحدث بلسان المجتمع في نقده للسلوكيات المنحرفة، وهي “أقوى سلاح اجتماعي تحافظ به الجماعة على كيانها ومقوماتها المختلفة”. كما أن السخرية تعكس أحوال الواقع، وتُعد فنًا واقعيًا ينبع من الملاحظة الخارجية بهدف نقد تصرفات الناس وسلوكياتهم.
يتطرق الكتاب أيضًا إلى وظائف السخرية على المستويين الاجتماعي والنفسي. فعلى المستوى الاجتماعي، تعمل السخرية كمصحح اجتماعي يحافظ على الاستقرار الفكري والعاطفي، وتحارب الرذيلة، وترسخ قيم العدالة. وعلى المستوى الفردي، تُؤدي دورًا صحيًا في حياتنا النفسية، وتُعد وسيلة للتهرب المؤقت من مشاغل الحياة، وتعيد الثقة بالنفس، وتقوي الروح المعنوية. كما أن الأدب الساخر يمتلك طاقة استنهاض وتحريض، ويزرع بذور الثورة في النفوس.
تُعد العلاقة بين السخرية والمفارقة وثيقة بشكل خاص، فكلاهما ينبع من التناقض بين ما يُقال وما يُقصد، أو بين ما يُعتقد وما هو واقع الحال. وعلى الرغم من التداخل، إلا أن الباحث يوضح الفروق الدقيقة التي تميز السخرية عن المفارقة، خاصة في النبرة التي لا تقبل التردد في السخرية بخلاف المفارقة التي تتطلب إدراكًا للمعنى الظاهر والحقيقي معًا.
تتعدد أنواع السخرية وأساليبها، وتتأثر بالظروف الاجتماعية والسياسية ونفسية الكاتب. يذكر الكتاب أنواعًا مثل السخرية المرة القاسية، والسخرية الفلسفية والأخلاقية، والمتسامحة، والبائسة الحزينة. وتنقسم السخرية بشكل عام إلى سخرية إيجابية وسلبية، وتعتمد على عنصر المفاجأة والخيال والغرابة، وتقوم على فكرة المقابلة بين نقيضين.
السخرية في الشعر الفلسطيني عبر المراحل
يُقدم الكتاب تحليلًا مفصلًا للسخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم عبر ثلاث مراحل زمنية رئيسية:
1. السخرية بين عامي (19481967)
شهدت هذه المرحلة بروز السخرية في شعر شعراء المنفى وشعراء الداخل. من شعراء المنفى، يتناول الكتاب أبو سلمى، ومحمد العدناني، ومحمود سليم الحوت، ومعين بسيسو. ومن شعراء الداخل، يتوقف عند راشد حسين، وتوفيق زياد، ومحمود درويش، وسميح القاسم.
برزت السخرية عند هؤلاء الشعراء كوسيلة لمقاومة الاحتلال والتعبير عن الرفض للواقع المر الذي فرضته النكبة. على سبيل المثال، يظهر توظيف المفارقة في شعر (أبو سلمى)، حيث يسخر من اللجنة الملكية التي أوصت بتقسيم فلسطين، معتبرًا ذلك أكبر مشكلة لا حلًا. كما تناول عبد الرحيم محمود والسخرية من اللجنة البريطانية التي كانت تهدف إلى التحقيق في ثورة 1936، ومن المتوهمين بجديتها. أما إسكندر الخوري البيتجالي، فقد سخر من الظواهر الاجتماعية الطارئة، مثل ظاهرة الكعب العالي.
كانت السخرية عند راشد حسين لافتة للنظر، وعالجت موضوعات سياسية واجتماعية شتى، سواء في قصائد كاملة أو خلال مقاطع القصائد، وقد كان مجددًا في بعضها وكلاسيكيًا في بعضها الآخر. وفي شعر محمود درويش لهذه الفترة، يلاحظ وجود السخرية في عدة قصائد وفي شعر سميح القاسم، بدوره، سخر من الأنظمة العربية وموقفها المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، مستخدمًا السخرية اللاذعة من الوعود الكاذبة.
2. السخرية بين عامي (19671987)
بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أصبحت فلسطين كلها تحت الاحتلال، وشكلت النكسة صدمة عميقة. ومع ذلك، لم يستسلم الأدب الفلسطيني لليأس، بل ظل يعبر عن الثبات والمقاومة والتحدي.
في هذه المرحلة، تناول الكتاب ثلاثة من شعراء المنفى: محمود درويش، ومعين بسيسو، ومريد البرغوثي. ومن شعراء الداخل: سميح القاسم، وعبد اللطيف عقل، وفوزي البكري، والشاعرة فدوى طوقان.
محمود درويش، في ديوانه “أحبك أو لا أحبك”، يستمر في نقد الواقع العربي، ويكثف من السخرية المرة من الأنظمة العربية وسياساتهم، وتظهر هذه السخرية بوضوح في قصائد “خطب الدكتاتور الموزونة”، التي تسخر من الخطابات الجوفاء عند الزعماء وعند زعماء الأحزاب، ويبلغ التهكم في هذه الخطب ذروته، مندداً بأساليب العرب في مقاومة الاحتلال بالحروف المفخمة بينما العدو يستخدم الأسلحة الفتاكة.
معين بسيسو، في قصائده، استخدم السخرية لنقد الأوضاع العربية، مثل قصيدة “الرجل الذي كان كلامه كله نعم”، التي تسخر من الرجل الذي لا يجرؤ على قول “لا”. كما يعالج في قصيدة “المطاردة” ظاهرة الجواسيس التي تملأ الحياة العربية، حيث يتحول الشعب كله إلى جواسيس.
مريد البرغوثي، برزت سخريته بشكل خاص في ديوانه “قصائد للرصيف”، حيث تناول نقد الأنظمة العربية وملاحقتها للفلسطينيين، ونقد المجتمع العربي بشكل عام. استخدم البرغوثي التناص الساخر مع قصائد أخرى، مثل قصيدة عبد الرحيم محمود “الشهيد”، ليقلب المعنى ويعكس مرارة الواقع.
وفي شعر شعراء فلسطين المحتلة، لم يختلف الأمر كثيرًا. فقد تركزت سخريتهم أيضًا على الأنظمة العربية التي تحمل جزءًا من المسؤولية عن ضياع الوطن.
عبد اللطيف عقل، في ديوانه “أغاني القمة والقاع”، استخدم السخرية اللاذعة لنقد الأنظمة العربية التي تتخبط في قراراتها. وفوزي البكري، في ديوانه “صعلوك من القدس القديمة”، يظهر نوعًا من السخرية اللاذعة من الذات الإلهية، متأثرًا بفكره الشيوعي وسوء الأوضاع التي عاشها. كما تتخلل قصائده سخرية مريرة من الواقع العربي، ومن الأشقاء الذين تحولوا إلى ذئاب.
3. السخرية في شعر الانتفاضة (19871993)
شكلت الانتفاضة في ديسمبر 1987 تحولًا مهمًا في الشعر الفلسطيني، حيث امتزجت السخرية بعناصر التفاؤل والأمل، وتلاشت الروح الحزينة.
تُعد قصيدة محمود درويش “عابرون في كلام عابر” مثالًا بارزًا على السخرية في شعر الانتفاضة، حيث تتجه السخرية نحو الآخر (الاحتلال) الذي يحاول محو الهوية الفلسطينية، ويُطلب من العابرين (المحتلين) أن يأخذوا أمتعتهم ويغادروا. مريد البرغوثي، في ديوانه “رنة الإبرة” (1993)، يستمر في نقد الواقع العربي، ويستخدم السخرية من الأنظمة العربية التي تمنع الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم.
يلاحظ الكتاب أن السخرية في هذه المرحلة اتسمت بمواجهة أكثر حدة وتحريضًا، واعتُبرت سلاحًا يقف جنبًا إلى جنب مع البندقية والأعمال العسكرية. ولكن سرعان ما تراجعت هذه الروح المتفائلة بعد الدخول في مفاوضات غير متكافئة بدأت في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وأسفرت عن اتفاقية أوسلو عام 1993، مما أدى إلى خيبة أمل وعودة نغمة الحزن والكآبة إلى القصيدة الساخرة.
البناء الفني للسخرية في الشعر الفلسطيني
لم يقتصر بحث السخرية على المضمون، بل تناول الأشكال الفنية التي تنوعت؛ فقد استخدم الشعراء أساليب مثل التقليد الساخر والمعارضة، والمدح بما يشبه الذم، والذم بما يشبه المدح، كما اعتمدوا على عنصر المفاجأة والخيال والغرابة، والمقابلة بين نقيضين، والمفارقة، والمفارقة الزمنية.
يلاحظ الكتاب أن الشعراء لجأوا إلى استخدام الألفاظ الشعبية في بعض الأحيان، لما لها من قدرة على الوصول إلى وجدان الجماهير ومنح السخرية عمرًا أطول. كما أفاد الشاعر الساخر من التراث الأدبي والديني والشعبي، وتجاوز ذلك إلى الأساطير والآداب العالمية.
وعلى صعيد الشكل، تنوعت القصائد الساخرة بين القصائد الكلاسيكية التي حافظت على الوزن والقافية، وبين قصائد الشعر الحر التي اعتمدت التنويع في القافية، بالإضافة إلى الاستفادة من قصيدة الأبجرام.
ومن الناحية الفنية المتصلة ببناء القصيدة الساخرة، أفادت الشعراء من التراث والأساطير والآداب العالمية. وقد امتزجت السخرية بالهجاء في بعض القصائد، خاصة في المرحلة الأولى، نتيجة غلبة العاطفة على العقل في مواجهة الأحداث المؤلمة.
وفي إجابته على التساؤل حول ما إذا كان هناك “شاعر ساخر” بامتياز في الشعر الفلسطيني، يرى الباحث أن الشعر الفلسطيني احتوى على نصوص ساخرة أو مقاطع ساخرة، ولكن ليس بالضرورة أن يوصف الشاعر بالساخر ما لم تكن السخرية هي السمة الغالبة على معظم أعماله.
ومع ذلك، يشير إلى أن بعض الشعراء مثل راشد حسين ومحمود درويش وفوزي البكري يمكن اعتبارهم شعراء ساخرين، لأن السخرية كانت حاضرة في نصوصهم بغض النظر عن المستوى الفني المتعارف عليه في فن السخرية.
يُقدم كتاب “السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم” دراسة نقدية قيمة تُثري فهمنا للأدب الفلسطيني ودوره في النضال الوطني، وتُبرز كيف يمكن للسخرية أن تكون سلاحًا فعالًا في التعبير عن الرفض، ونقد الواقع، وتحفيز روح المقاومة.
إنه عمل نقدي لازم لكل مهتم بالأدب الفلسطيني المقاوم وتجلياته الفنية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر، فإن نسخة من الكتاب متوفرة في موقع الإلكتروني للمؤلف على الرابط الآتي: https://kenanaonline.com/users/ferasomar/posts/1254058،
كما أنه متاح للتحميل المجاني على منصات الكتب الإلكترونية، مكتبة نور الإلكترونية: noorbook.com/uvlq5ao، ومكتبة كتوباتي: https://www.kotobati.com/node/2893683 .