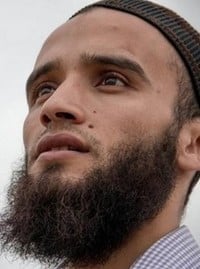الجمعة 1 غشت 2025 11:13
في مدنٍ أوروبية باردة حيث تتقاطع لغاتٌ وثقافاتٌ وأساليبُ عيشٍ متباينة، وحيث تُفرض على الأجيال الجديدة معايير اندماج قاسية تكاد تُذيب ملامح الانتماء، يظلّ شيءٌ ما في أعماق الجالية المغربية يرفض الذوبان ويبحث عن دفءٍ يعيد صياغة الهوية في زمن الاغتراب، ويجعلهم متشبثين بثوابتهم الأصيلة، وقيمهم الدينية والوطنية، ولعل ما يجب أن نذكر به وسطره علماء الغرب الإسلامي، في هذا السياق أن هذه الثوابت وفي مقدمتها المذهب المالكي الذي يتبناه المغاربة لم يكن حضوره حديثًا أو مستوردًا عابرًا أو ترعاه المؤسسات المغربية، بل إنه في الأصل نشأ وأُسست قواعده ومفاهيمه في أرض الأندلس والمغرب، حيث ارتبط وجوده بتاريخ طويل في القارة الأوروبية نفسها، وهذا العمق التاريخي يعزز من حضور هذا المذهب كجزء لا يتجزأ من ذاكرة الهوية المغربية في المهجر، فالمذهب المالكي بمرونته، والعقيدة الأشعرية بتوازنها، وروح التصوف السني بما يحمله من سكينةٍ واعتدال، تحولت في سياق الشتات إلى ما يشبه الجدار الأخير الذي يستند إليه المغاربة في مواجهة ضغط العلمنة القوي وصخب ثقافات لا تشبه جذورهم، ومع التحولات التي شهدها العالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة، وانحسار المد الوهابي وتراجع بريق الخطاب الصارم الذي روّجت له بعض المراكز الدينية في الشرق، بدا أن النموذج المغربي، بما فيه من وسطية وحكمة تاريخية، قدّم للجالية في أوروبا مرفأً فكريًا وروحيًا، ليس كمجرد طقوسٍ دينية بل كذاكرة جمعية وحماية لامتداد الهوية.
إننا عندما نتحدث عن الثوابت المغربية فنحن لا نصف منظومة جامدة أو نصوصًا فقهية فقط، بل نشير إلى تراكمٍ تاريخيّ تشكّل عبر قرونٍ من التجربة المغربية التي صهرت الدين في بوتقة المجتمع والسلطة والوجدان الشعبي، فالمذهب المالكي الذي اختاره المغاربة منذ قرون لم يكن مجرد خيار فقهي، بل كان انعكاسًا لحاجة مجتمع متنوع جغرافيًا وثقافيًا إلى فقهٍ يوازن بين النص والواقع، ويمنح مساحةً للاجتهاد دون أن يفقد صلته بالأصول، وهذه المرونة جعلته في المهجر إطارًا قادرًا على التكيف مع تحديات الاندماج دون التفريط في الجذور، أما العقيدة الأشعرية فقد منحت الهوية الدينية المغربية توازنًا فريدًا بين العقل والنقل، حيث لم يكن الإيمان في هذا السياق خضوعًا أعمى للنصوص ولا تمردًا عقلانيًا عليها، بل مسارًا وسطيًا يحمي الإيمان من الجفاف الفكري والتشدد في آن واحد، وفي أوروبا حيث تتقاطع الفلسفات المادية والنزعات العلمانية، يجد أبناء الجالية في هذا التوازن صمام أمان يعيد للإيمان بُعده المعرفي والروحي معًا.
أما التصوف السني المغربي، الذي تشكل عبر الرباطات والزوايا وتجذر في الحياة الاجتماعية والروحية للمغاربة، فقد كان ولا يزال روح هذا النموذج، لأنه تجاوز فكرة العبادة الطقسية إلى بناء علاقة وجدانية بالله وبالآخر، وفي مجتمعات يغلب عليها الفردانية والانعزال، تحولت هذه الروحانية العملية إلى مصدر دفء يربط الفرد بأسرته وبجماعته وبوطنه البعيد، ليكتشف أن الدين ليس فقط صلاة وصومًا بل خيطًا غير مرئي يجمع شتات الهوية في مواجهة برد الغربة، وفي قلب كل هذا تأتي مؤسسة إمارة المؤمنين كضامن لهذا التوازن، ليس بمعناها السياسي فحسب بل كرمزٍ لوحدة المرجعية الدينية التي تمنع الجالية من الانجرار وراء خطابات متناقضة أو تيارات متطرفة، فالثوابت المغربية هنا ليست فقط خيارًا فقهيًا أو عقديًا، بل هي منظومة حماية لهوية ممتدة تعبر القارات والأجيال دون أن تفقد ملامحها الأولى.
في السياق الأوروبي، حيث يُطرح على الجالية سؤال الانتماء بين ثقافة الأغلبية وهويتها الأصلية، تشكل هذه الثوابت مكسبًا وحصنًا يحفظ الهوية من الذوبان، فحين تتغير مواقع العمل والمدارس، وحين تتبدل اللغات والوجوه، تبقى المساجد المغربية الصغيرة ومناسبات الأعياد ومواسم رمضان كأنها تذكير حي بأن المغرب لا يزال حاضرًا بقوة في النفوس، هذه المؤسسات ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي منابر لتربية الجيل الثاني والثالث على فهم معتدل للدين يبعدهم عن التطرف ويمنحهم شعورًا بالأمان في مجتمعهم الجديد، ومقارنتها بجاليات أخرى ضاعت فيها هذه الصلة الدينية والثقافية، يجعلنا نرى كيف أن التمسك بالثوابت هو عامل حاسم في صمود الهوية وعدم انصهارها بالكامل.
تاريخيًا، لم يكن هذا التمسك وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسار طويل تميز به المغرب كبلد حافظ على استقلال مذهبه وهوية دينه وسط زوابع التغيير، فقد كانت الزوايا والفقهاء، حتى في ظل الاستعمار، يحمون هذا التراث الديني والاجتماعي، ويعيدون صياغته بما يلائم الواقع دون أن ينكسروا أمام الضغوط الخارجية، هذا التاريخ جعل المغاربة يمتلكون حصانة فكرية وروحية تعينهم على التكيف دون الانفصال، كما أن انحسار المد الوهابي، الذي روجت له بعض المراكز الدينية في الشرق، خصوصًا في السعودية، وبدأ يفقد جاذبيته بفعل تحولات سياسية واجتماعية، جعلت هذا الفكر يصطدم بالواقع وينكسر أمام التحديات، مما فتح المجال أمام النموذج المغربي ليبرز من جديد كنموذج وسطٍ يُدرس ويُثمن في الأوساط الأوروبية، بل حتى في دوائر صنع القرار، حيث تُنظر إليه كحصن ضد التطرف والتشدد.
كما أن البعد النفسي والاجتماعي لهذه الثوابت لا يقل أهمية، فهي تمنح الأسر المغربية في أوروبا دفء الانتماء والطمأنينة، خصوصًا في مواجهة شعور الغربة والفراغ الروحي الذي قد يهدد الجيل الجديد، فالثوابت الدينية ليست مجرد عقيدة تحفظها العقول، بل هي دفء يحفظ الأسرة ويقوي روابطها ويغرس في النفوس قيم الانتماء والاعتدال، وبالتالي تساهم في بناء جسر بين الهوية الأصلية والانخراط الإيجابي في المجتمع الجديد، وهذا ما يجعل تجربة الجالية المغربية في أوروبا نموذجًا فريدًا في كيفية المحافظة على الهوية الدينية والثقافية وسط بيئة مختلفة تمامًا.
إن التمسك بالثوابت الدينية المغربية لا يعد رجوعًا إلى الماضي، بل هو مشروع مستقبلي يضمن بقاء الهوية ويمنح الجالية في أوروبا قوة تحميها من الذوبان، وهذا يتطلب رؤية استراتيجية تجمع بين الدولة والمجتمع المدني والجالية نفسها، عبر استثمار الرقمنة والمنصات الرقمية التي تمثل فرصة كبيرة لنقل القيم والتقاليد المغربية إلى الأجيال القادمة، لتظل الثوابت ليست فقط إرثًا تاريخيًا، بل هي نبض حاضر ومستقبل في زمن التحديات والتغيرات.
المصدر: هسبريس