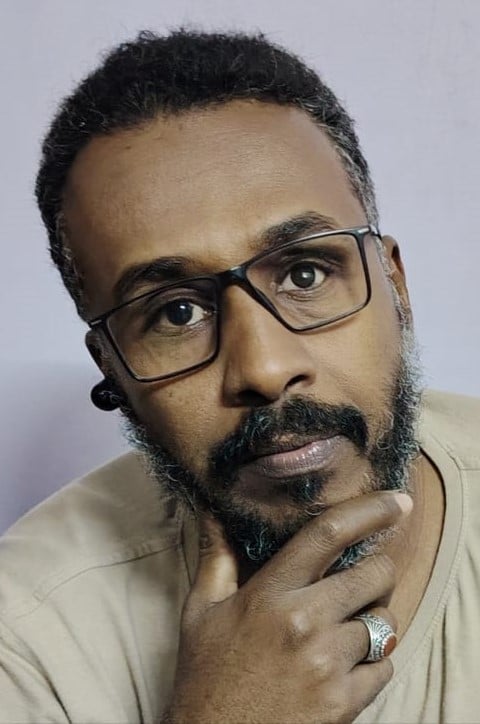محمد هاشم محمد الحسن
من قلب الحرب التي اجتاحت السودان منذ أبريل، خرج أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بخطاب لا يُعبّر عن مجرد مقابلة إعلامية ، بل يؤسس لرؤية سلطوية جديدة تتقاطع فيها مصالح المؤسسة العسكرية مع شبكات الإسلاميين. إنه خطاب يعيد هندسة السلطة تحت مظلة تحالف وظيفي عسكريإسلامي، يستثمر في الحرب كمحرّك للشرعية، لا كأزمة تستدعي حلاً.
جاءت لغة الخطاب محسوبة بدقة، فلم يستهدف جمهورًا سياسيًا واسعًا، بل خاطب دوائر النفوذ داخل الجيش، معلنًا استعداد الحركة الإسلامية للعودة (أو بالأحرى، لتثبيت حضورها الذي لم يغب أصلًا). هذا الظهور لا يُمكن فصله عن مخطط يعيد إنتاج بنية السلطوية، عبر استعادة سرديات قديمة بلغة جديدة، تُحاكي فكرة (الدعوة للتعبئة الوطنية) كمدخل ناعم للسيطرة، بما يكرّس نمطًا من الاستحواذ المُقنّع على مركز القرار.
في هذا السياق، لم يكن توقيت تصريحات أحمد هارون اعتباطيًا، بل جاء قبل اجتماع واشنطن المرتقب، الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والدولية إلى بلورة مخرج سياسي للأزمة السودانية. فالتصريحات تمثل محاولة استباقية لضرب المسار التفاوضي، وإعادة توجيه البوصلة نحو معركة الشرعية التي يسعى الإسلاميون إلى حسمها بأدوات ميدانية ودستورية. وليس عبثًا أن يتزامن حديثه عن الانتخابات واستفتاء قائد الجيش مع تسريبات تؤكد تغلغل الإسلاميين في مفاصل الدولة، لا سيما وزارة العدل والخارجية، ومليشيات إسلامية عقائدية مثل قوات البراء بن مالك ، التي شاركت في الحرب تحت مظلة تعبئة وطنية مزيفة. ما يكشف أن الخطاب ليس مجرد تعبير عن طموح سياسي، بل جزء من خطة محكمة لإعادة هندسة السلطة مستفيدًا من اللحظة الإقليمية الحرجة.
يتقاطع هذا الخطاب مع أدوات صناعة الشرعية، حيث يُروّج لاستفتاء شعبي لاختيار قائد للجيش، في مشهد يبدو ديمقراطيًا ظاهريًا، لكنه عمليًا يمثل انقلابًا داخليًا ناعمًا. الاستفتاء هنا ليس ممارسة سياسية حقيقية، بل آلية لإقصاء البرهان وفتح الباب أمام شخصية أكثر طواعية للأجندة الإسلاموية، في ظل حالة انقسام غير معلنة داخل المؤسسة العسكرية، تعمقها مشاعر تآكل السيطرة والصراع على النفوذ.
إن اختزال السيادة في مشهد انتخابي هش يُدار من غرف مغلقة بمنطق الغلبة لا التمثيل، يحول العملية الديمقراطية إلى واجهة رمزية، تُستخدم للترويج الدولي بينما يُفرغ الداخل من أي مضمون فعلي للمشاركة أو التعبير السياسي.
ولا يعود أحمد هارون، في هذا السياق، مجرد ناطق باسم تيار سياسي، بل فاعلٌ في هندسة سردية سلطوية تتسلل بهدوء عبر ثنايا الدولة. يحضر مشروعه عبر مؤسسات مثل وزارة العدل، الخارجية، الإعلام الرسمي،
2 / 2
والأمن، حيث ظل الإسلاميون موجودين منذ الثورة، دون إعلان رسمي. فغيابهم عن السلطة لم يكن واقعيًا بل إعلاميًا، وجودهم استمر كشبكة داخل الدولة، تمارس الحكم دون واجهة، وتعيد تشكيل أدوات الهيمنة بأسلوب وظيفي لا مؤسساتي.
المفارقة أن الحرب لم تُستخدم لتحقيق انتصار عسكري فحسب، بل وظفت كأداة لإعادة توزيع النفوذ داخل البيروقراطية. تُعاد هندسة الدولة إداريًا، عبر تموضع وظيفي جديد للموالين داخل المؤسسات الحساسة، بطريقة تُكرّس منطق الردة من داخل النظام لا من خارجه، بما يُقوّض الشرعية الدستورية ويحوّل الدولة إلى غلاف سلطوي منزوع المعنى الديمقراطي.
وهنا، فإن الوعي المقاوم لا ينتظر لحظة إجماع، بل يتشكّل حين يُدرك أن الكارثة ليست فقط في الحرب، بل في اللغة التي تُشرعنها، وتُجمّل الردة، وتُعفي الجناة من مساءلة التاريخ. استعادة الوعي ليست رفاهًا نخبويًا، بل ضرورة وطنية تُعيد للسياسة معناها، وتعيد للإنسان مركزه.
لم يكن خطاب الحرب يومًا محايدًا، بل جُعل أداة لإنتاج سردية (الكرامة)، كمستودع رمزي لتبرير المذابح وتوزيع الامتيازات. الشعار الذي رُوّج له لم يكن انعكاسًا لقضية وطنية، بل غطاءً بلاغيًا لحرب تُدار بمنطق التنظيم لا الانتماء الوطني. المعركة لا تحمل ملامح جامعة، بل تجسد خيارات سلطوية ضيقة. في هذا السياق، أصبحت الشعارات أداة لتخدير الوعي وتطويع الإنسان السوداني كوسيلة، ثم دفنه رمزيًا في صمت إعلامي، لتبقى السلطة قائمة فوق أنقاض المدنيين باسم سيادة مزيفة وكرامة زائفة.
هذه اللحظة لا تحتمل التأويلات الرمادية. هناك مشروع سلطوي يُصاغ بحذر ، لإعادة إنتاج سردية جديدة تُمهّد لانقضاض قادم، لا عبر السلاح فقط، بل عبر خطاب يُعيد تشكيل معاني الدولة، الوطنية، والسيادة.
ولذلك، فإن مقاومة هذا الخطاب لا تكون فقط بتفكيك مضمونه، بل بالانحياز إلى سردية مضادة تستعيد روح الثورة، وتعيد الإنسان إلى مركز السياسة، وتُقاوم تسليع الموت وتطويعه كمدخل للسلطة. المطلوب ليس تحليل خطاب أحمد هارون فحسب، بل كشف البنية السلطوية التي يحملها، والمشروع الذي يُعاد تسويقه من بوابة الشرعية الشكلية.
الحرب في السودان ليست فوهة بندقية فحسب، بل معركة سردية تُنتج فيها شرعية جديدة بلغة الاستفتاء، وتُعاد فيها صياغة الاستبداد بلبوس مؤسسي، ويُطمس فيها أثر الثورة عبر هندسة الوعي العام. ومن هنا، فإن تفكيك هذا الخطاب، وكشف تضليلاته، وإعادة كتابة سردية الثورة، ليست مهمة تحليلية فحسب، بل ضرورة تاريخية ملحّة.
المصدر: صحيفة الراكوبة