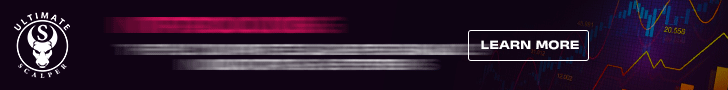ساري: الجفاف ليس العامل الوحيد لتراجع المحاصيل.. وجشح كبار الفلاحين وراء الغلاء

أكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري، أن المغرب يعاني من أزمة مياه ممتدة، خاصة وأن فترات الجفاف لم تعد متقطعة كما كان في السابق، بل أصبح الجفاف بنيويا ومستمرا، مما يزيد من الضغط على الفلاحة ويقلل الإنتاجية الزراعية.
وأضاف ساري في حوار مع جريدة “العمق”، أن “القطاع الفلاحي اليوم يعاني من عجز حاد، حيث انخفضت الإنتاجية بشكل ملحوظ نتيجة للتقلبات المناخية، مما أثر على المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والحوامض”، ويضيف أنه رغم تساقطات مطرية بين الحين والآخر، فإنها لم تساهم بشكل كاف في استقرار الإنتاج.
وتحدث ساري عن ارتفاع تكاليف المياه، مشيرا إلى أن السقي لم يعد اقتصاديا كما كان في السابق، خاصة في المناطق التي تعتمد على تحلية المياه، وذكر أن تكلفة المتر المكعب من المياه قد ارتفعت بشكل كبير، مما أثر سلبا على الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وبالنسبة للمحاصيل مثل الزيتون والحوامض، يوضح ساري أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على هذه المنتجات، وقال: “الزيتون أقل استهلاكا للمياه مقارنة بالحوامض، لكنه لا يزال متأثرا بالجفاف، كما أن أسعار المنتجات مثل البرتقال وزيت الزيتون شهدت زيادات ملحوظة بسبب هذه التغيرات”.
وأشار ساري إلى أن برامج “المخطط الأخضر” لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث تم تخصيص موارد مائية كبيرة لزراعات مستهلكة للمياه مثل الطماطم، بينما تم تقليص المساحات المخصصة للحبوب، مما يعكس خللاً في الأولويات الزراعية.
أن الحلول المستقبلية يجب أن تركز على التنمية المستدامة وتوزيع الموارد بشكل عادل، مع دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، والعمل على تغيير استراتيجيات الزراعة لمواكبة التحديات المناخية المتزايدة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
المغرب عانى خلال السنوات الماضية من موجة جفاف حادة، في نظركم كيف أثرت الاضطرابات المناخية على المجال الفلاحي بشكل عام؟
أولا، يجب الإشارة إلى أن التقلبات المناخية كان لها أثر كبير، حيث انتقلنا اليوم من أزمة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي، كما أن الإشكال الذي نعيشه اليوم بسبب التقلبات المناخية يتمثل في أن فترات الجفاف لم تعد متقطعة ومتباعدة كما كان الحال سابقا، بل أصبحنا نواجه جفافا بنوي، ومستمرا قد يمتد لسنوات، مع تساقطات مطرية متقطعة تأتي بعد أربع أو خمس سنوات.
رغم هذه التساقطات يمكن القول إن الموسم الفلاحي لا بأس به، لكن لا شك أن التقلبات المناخية أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، فقد أصبحت العديد من الأراضي تعاني من عجز حاد، كما أن الكثير من المزروعات تواجه إشكالات كبيرة، مما انعكس على الإنتاج الزراعي الذي شهد انخفاضا ملموسا، حيث أضحت العديد من المزروعات والأشجار المثمرة تعيش إشكالات كبيرة سواء تعلق الأمر بتلك المستهلكة للمياه أو غيرها.
ما نعيشه اليوم من تضخم فلاحي هو مشكل بنيوي وهيكلي، صحيح أن البعض يعزو ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية إلى المضاربين أو الوسطاء، لكن جوهر المشكلة يكمن في الانخفاض الحاد للإنتاج الفلاحي، الذي يعود إلى تحديات هيكلية مرتبطة بارتفاع كلفة المياه التي أضحت كبيرة جدا.
هل هناك تأثيرات مباشرة على إنتاجية الحوامض والزيتون بسبب التغيرات المناخية، مثل انخفاض الإنتاج أو انخفاض جودة المحاصيل؟
بالتأكيد، هناك تأثيرات مباشرة على إنتاجية الحوامض والزيتون بسبب التقلبات المناخية، فعند الحديث عن الزيتون، نجد أنه من بين المنتجات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث يتطلب إنتاج ما بين 2.5 و5 كيلوغرامات من الزيتون مترا مكعبا واحدا من الماء، بينما تحتاج الحوامض، مثل البرتقال، إلى ما بين 250 و300 ملم لكل هكتار، وبالتالي، يمكن القول إن الزيتون أقل استهلاكا للمياه مقارنة بالحوامض.
تجدر الإشارة إلى أن زراعة الحوامض لم تكن جزءا من الموروث الفلاحي المغربي، بل هي من الزراعات التي أدخلها الاستعمار، إذ لم يكن لدى المغرب تقليد زراعة هذه الفاكهة التي رغم استهلاكها الكبير للمياه، لا تزال أقل استنزافًا من الطماطم والأفوكادو ومنتوجات أخرى، ومع ذلك، نشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في أسعار البرتقال المخصص للعصير، حيث كان سعره سابقا يصل إلى درهم ونصف، بينما اليوم يتجاوز 5 دراهم، أي بزيادة تصل إلى 300%.
أما زيت الزيتون، فهو يشهد نفس الاتجاه التصاعدي في الأسعار، حيث كان سعر اللتر الواحد قبل خمس سنوات حوالي 45 درهمًا، لكنه اليوم تجاوز 120 درهما، بل أصبح المغرب يستورد هذه المادة، حتى أننا أصبحنا نلقب الزيتون بـ”الذهب الأخضر”، وهو أمر لم يكن متوقعًا في السابق.
ما نعيشه اليوم ليس فقط نتيجة للتقلبات المناخية، بل يعود إلى عوامل متعددة، من بينها طريقة التدبير، فعلى سبيل المثال، تزرع الحوامض في مناطق مثل شتوكة آيت باها، وهي مناطق تعاني من الجفاف وتعتمد على تحلية مياه البحر، حيث تصل كلفة المتر المكعب الواحد إلى 5.80 درهم، مع دعم حكومي قدره 5 دراهم، ما يعني أن الكلفة الحقيقية تبلغ 10 دراهم، وفي المقابل، كانت تكلفة السقي بالمياه المستخرجة من السدود في بعض المناطق لا تتجاوز 0.80 درهم للمتر المكعب، بينما كانت مياه الآبار تُباع بسعر 2.40 درهم للمتر المكعب.
المشكلة اليوم ليست فقط في التقلبات المناخية، بل أيضًا في ارتفاع تكاليف السقي بسبب استنزاف الفرشة المائية، ومع توسع اعتماد السقي في إطار ما يُعرف بـ”المخطط الأخضر والجيل الجديد”، ازدادت الضغوط على الموارد المائية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، لذلك، فإن التغيرات المناخية ليست العامل الوحيد وراء الأزمة، بل يضاف إليها سوء التدبير.
كيف يؤثر اضطراب الفصول على فترة الحصاد والإنتاج، خاصة بالنسبة للزيتون الذي يتطلب دورة موسمية ثابتة؟
هذا سؤال وجيه، لأن البعض لا يدرك أن تأقلم العديد من النباتات والأشجار مع التقلبات المناخية يستغرق وقتا طويلا جدا، فعلى سبيل المثال، عند الحديث عن أشجار الزيتون ومدى قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات، نجد أن الأمر ليس سهلا، خاصة وأن الإنتاجية لا تعتمد فقط على كمية الأمطار، بل تتأثر أيضًا بنوعية التربة وطريقة السقي.
وفي هذا الإطار يمكنني أن أقدم مثالا، إذ أنه في نفس قطعة الأرض، يمكن أن يؤدي الإفراط في السقي إلى مشكلات في جذور الأشجار، مما يؤثر سلبا على الإنتاجية، في حين أن استخدام تقنيات مثل الري بالتنقيط يمكن أن يعزز الإنتاج، وبالتالي، المشكلة لا تتعلق فقط باضطراب الفصول، بل تشمل أيضا أساليب السقي، حيث إن الإفراط في الري قد يتسبب في مشكلات كبيرة.
اليوم، لا ينبغي التركيز فقط على زراعة الزيتون أو الأشجار المثمرة، بل يجب الانتباه إلى مجموعة واسعة من الزراعات، خاصة مع التغيرات المناخية السريعة، حيث ترتفع درجات الحرارة عاما بعد عام بوتيرة متسارعة، وبالتالي، فإن تسارع هذه التغيرات لم يكن متوقعا، ولم يكن متصورا حتى من قبل أكبر المتشائمين بأن تؤثر التقلبات الموسمية بهذا الشكل الكبير.
حظي السقي الفلاحي بمكانة مركزية ضمن البرامج الإصلاحية الأفقية والمهيكلة الرامية إلى مواجهة ندرة الموارد المائية، ما أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز المردودية الفلاحية وهل ساهمت فعلا في تخفيف الأعباء؟
هذه البرامج التي نتحدث عنها ربما تعرضت لانتقادات واسعة، ليس فقط لأنها لم تنفّذ بشكل كامل، ولكن أيضا بسبب ما شابها من اختلالات، وهذا ما جعل الإصلاحات الحالية تؤثر على المردودية الزراعية، حيث تركزت على منتجات تستهلك كميات كبيرة من المياه على حساب زراعات معيشية أقل استهلاكا.
على سبيل المثال، عندما نتحدث عن الطماطم، نجد أنها تستنزف كميات كبيرة من المياه، ورغم ذلك يتم الاعتماد عليها بل وتوجيهها للتصدير، وفي المقابل، تم التخلي عن مساحات واسعة مخصصة لزراعة الحبوب، حيث تقلصت المساحات المزروعة بها من 3 ملايين هكتار إلى مليوني هكتار فقط، والمفارقة أنه خلال أربع سنوات، تعادل العائدات التي نجنيها من تصدير الطماطم ما ننفقه على استيراد الحبوب في سنة واحدة، وهو ما يعكس عمق الإشكال، حيث يتم اختيار المشاريع وفقا لعائداتها المالية وليس بناء على تأثيرها على الفرشة المائية.
وبالتالي فإن البرامج الزراعية التي تم تنفيذها لم يكن لها أثر واضح سوى استنزاف الموارد المائية بشكل كبير، كما أن التوجه نحو التصدير أصبح وكأنه محاولة لرفع المؤشرات الاقتصادية للفلاحة على حساب الأمن المائي، وفي نفس الوقت لا يمكن إنكار أن هناك برامج فعالة، مثل أنظمة الري بالتنقيط وتقنيات أخرى، لكنها جاءت بثمن باهظ، حيث ساهمت في استنزاف الفرشة المائية بدلًا من الحفاظ عليها.
السؤال هنا، ماذا استفاد المستهلك المغربي من هذه السياسات؟ في النهاية، المستفيد الأكبر هم كبار الفلاحين الذين يصدرون منتجاتهم إلى الخارج، في حين أن هذه المنتجات تحمل معها كميات هائلة من المياه، على حساب الزراعات المعيشية الضرورية، أو تخصيص مساحات شاسعة لإنتاج أعلاف الماشية، التي تعاني من أزمات متتالية، وقد رأينا كيف ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير منذ 2018 وحتى اليوم.
يعتبر الفلاحون من أبرز الفئات المتضررة من الوضع المطروح حاليا خاصة عند الحديث عن الفلاحين الصغار والمتوسطين، وبالتالي ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون في ظل تغيرات المناخ المتسارعة؟
الشكل الذي تسير عليه الأمور اليوم يؤكد مسألة في غاية الأهمية، إذ أنه نتيجة التقلبات المناخية وتعدد الإكراهات، قد يصبح الفلاحون الصغار والمتوسطون مهددين بالاختفاء إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر يعتمدان على دعامتين، الأولى موجهة لكبار الفلاحين، والثانية للفلاحين الصغار والمتوسطين.
لكن اليوم، في ظل التحديات المناخية التي نعيشها، ساهمت هذه البرامج في تفاقم الأوضاع، حيث زادت من تفقير الفلاحين الصغار، في حين عززت هيمنة كبار الفلاحين على السوق الوطنية ورفعت من صادراتهم إلى الخارج، ما جعل ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بالمضاربة بل تعود أيضا إلى احتكار كبار الفلاحين للسوق.
هذا الوضع انعكس على نسب البطالة التي تجاوزت 13.6%، حيث تضرر الفلاحون الصغار والمتوسطون بشكل كبير، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاع الفلاحي، لكن يجب الإشارة أيضا إلى أن الفلاحين الكبار يواجهون تحدياتهم الخاصة، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اللجوء إلى تحلية المياه والزيادة الكبيرة في تكلفة استخراج مياه الآبار.
في الماضي، كانت المياه متاحة على بعد أمتار قليلة، أما اليوم فالأمر مختلف تمامًا. على سبيل المثال، في بني ملال، أصبح الحفر للوصول إلى المياه يتطلب النزول إلى عمق 500 متر، وهو أمر غير مسبوق، أما في مناطق مثل بودنيب، فقد تجاوز العمق المطلوب 300 متر، في حين أن الوضع في فاس ومكناس بات أكثر تعقيدًا، حيث وصل عمق الحفر إلى 1000 متر للوصول إلى الفرشة المائية الاستراتيجية، وهي فرشة تحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تكوينها، بخلاف الفرشات السطحية.
يجب الانتباه إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين اليوم يعانون بشدة، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج، وأصبح الجفاف ظاهرة بنيوية، مما زاد من حدة الإجهاد المائي في المغرب، بل إن السنوات الممطرة قد تصبح مجرد استثناء، وليس القاعدة كما كان عليه الحال في السابق، خاصة أن المغرب أصبح من الدول التي تعاني فقرا مائيا حادا.
كيف يمكن للفلاحين التكيف مع الظروف المناخية المتقلبة؟
أعتقد أن التكيف مع الظروف المناخية المتقلبة لا يمكن أن يتحقق دون تغيير الاستراتيجية الفلاحية للمغرب، فلا يعقل، في ظل الإكراهات التي نعيشها اليوم، أن نستمر في تصدير الحوامض والأفوكادو والبطيخ بينما نقوم في المقابل باستيراد الحبوب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأولويات الفلاحية.
كما أن مخطط المغرب الأخضر كان بمثابة خيبة أمل، لأنه لم يراعِ مبادئ التنمية المستدامة، بل ركز على رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية على حساب الموارد المائية، مما أدى إلى استنزافها وإلحاق الضرر بحقوق الأجيال القادمة.
بالإضافة إلى ذلك فإن التكيف مع التغيرات المناخية يستوجب تبني استراتيجيات زراعية مربحة اقتصاديا ولكن بأقل استنزاف ممكن للمياه.
ولنكن واقعيين، لا يمكن التخلي عن القطاع الفلاحي، فهو يساهم بحوالي 13% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص عمل لنحو 30% من القوى العاملة، لكن من الضروري إعادة النظر في نوعية الزراعات المختارة، فلا يعقل أن يتم تقليص مساحة زراعة الحبوب، التي تحتاج سنويا إلى 300 ملمتر مكعب من المياه، في حين تمنح الأولوية لزراعات أكثر استنزافا للموارد المائية.
اليوم، القطاع الفلاحي بحاجة إلى تأطير ودعم فعلي من وزارة الفلاحة، من خلال تشجيع زراعة الحبوب، الزيتون، والنباتات العطرية التي تستهلك كميات أقل من المياه، وليس من العيب أن ننتقد بشكل صريح المخططات الفلاحية الموضوعة، بل يجب الاعتراف بأن بعضها كان “نقمة” على المغرب، لما خلفه من أضرار طويلة الأمد تمس مستقبل الأجيال القادمة.
هل تظنون أن الحلول التي تقدمها الدولة أو الشركات الكبرى فعلا تساعد المزارعين الصغار، أم أنها تصب في مصلحة كبار المستثمرين فقط؟
كبار المستثمرين يستنزفون المياه بشكل مفرط، فكيف يعقل أن شركة أسترالية، في منطقة العمامرة، تتولى زراعة الفراولة وتستهلك كميات هائلة من المياه بشكل غير منطقي؟ لقد أصبح المغرب اليوم مصدرا مغريا للمستثمرين الأجانب لاستنزاف ثرواته الطبيعية دون حسيب أو رقيب.
ما يلاحظ أن المناقصات الكبرى تستحوذ عليها المشاريع الربحية التي تستنزف الموارد المائية، فما الذي يبقى للمزارع الصغير؟ لا خيار أمامه سوى الهجرة، أو العمل كمياوم، أو الالتحاق بالقطاع غير المهيكل. وهكذا، فإن الحلول المطروحة تصب في مصلحة الشركات والمستثمرين، بينما تدفع الدولة الثمن على المدى البعيد. فمن الذي يصدر الطماطم؟ إنها الشركات الكبرى، في حين تجد الدولة نفسها مضطرة لاستيراد الحبوب، بل وتتحمل أعباء دعمها عبر الإعفاءات الضريبية والجمركية.
أما الفاتورة، فيدفعها طرفان، أولها المزارعون الصغار، الذين أصبحوا يعانون من البطالة وانعدام الفرص، ثم الدولة، التي تجد نفسها مضطرة لدعم مجموعة من المواد التي كانت تشكل جزءا من سيادتها الغذائية.
في ظل الوضع الراهن يبرز البحث العلمي والاعتماد على تقنيات حديثة في طليعة الحلول الواجب اعتمادها، وبالتالي أي دور البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة في تقليل الضرر؟ وما هي أهم المعيقات التي تقف أمام الاعتماد على هذه التقنيات الحديثة؟
اليوم، لن أتحدث عن المعيقات، بل عن خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2024، الذي كان واضحا في رسالته: الماء أصبح أولوية وطنية. لم يكن الحديث عن الماء مجرد تفصيل، بل تأكيدا على رمزيته وقدسيته، وضرورة الحفاظ عليه بكل السبل الممكنة.
ما نحتاجه اليوم، كما أشار خطاب العرش، هو دعم البحث العلمي، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، واعتماد استراتيجيات متجددة، ومن بين الحلول التي يجب التركيز عليها الرقمنة، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقرير “الماء في المغرب: إرث الماضي، إكراهات الحاضر، وفرص المستقبل الرقمي والمستدام”.
وتحدثنا في هذا التقرير عن ضرورة التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، وأتمنى أن تجد توصياته آذانا صاغية، لأنها قد تساهم في إيجاد حلول فعالة، كما أن هناك مجموعة من المقترحات المتعلقة بدعم البنية التحتية، والتي يجب أن تتماشى مع الاستراتيجية الملكية 20202027، التي خصصت لها ميزانية تقدر بـ 141 أو 142 مليار درهم.
اليوم، أصبح من الضروري اللجوء إلى تحلية مياه البحر بتكلفة أقل، مع مراعاة التأثيرات البيئية المحتملة لهذه التقنية، كما أن التفكير في ربط الأحواض المائية يجب أن يتم بطريقة شمولية، مع إشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرار.
ومن بين الحلول الفعالة الاقتصاد الدائري في استخدام المياه، خاصة أن المغرب اليوم لا يستغل سوى 7% من المياه العادمة، وهو رقم ضعيف مقارنة بالإمكانيات المتاحة، خاصة وأن إعادة استخدام هذه المياه يمكن أن يعزز السقي في العديد من الأراضي الفلاحية، مما يخفف الضغط على الموارد المائية العذبة.
وبكل صراحة يمكن التأكيد اليوم على أن المعيقات الحقيقية ليست تقنية، بل إدارية وبيروقراطية، حيث تقف الإجراءات المعقدة عائقا أمام الابتكار والاجتهاد، لذا، يجب الانتباه إلى هذه العوامل التي تعطل تنفيذ الحلول العملية والمستدامة.
المصدر: العمق المغربي