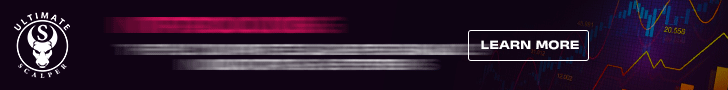تشابك الجريمة، العدالة الاجتماعية، وفشل السياسات العمومية في المغرب قراءة في الأسباب والأنماط والأزمة القيمية

مقدمة:
تشهد المجتمعات المعاصرة، ومن ضمنها المغرب، تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع منسوب الجريمة والشعور بانعدام الأمن. لا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي الأوسع. إن الجريمة ليست مجرد فعل فردي معزول، بل هي في كثير من الأحيان عرض لمشاكل هيكلية أعمق تتعلق بغياب العدالة الاجتماعية، وسوء توزيع الثروة، وفشل السياسات العمومية، وطبيعة النظام السياسي القائم، وتآكل منظومة القيم المجتمعية. يهدف هذا المقال إلى تحليل العلاقة المعقدة بين هذه العوامل في السياق المغربي، مع التركيز بشكل خاص على أنماط الجريمة والعنف السائدة حاليًا، وربطها بالإطار الأوسع لكيفية ارتباط طبيعة الجريمة بنوع اللامساواة الاجتماعية والأزمة القيمية السائدة في المجتمع، مدعومًا ببعض الأرقام والإحصائيات المتاحة.
- العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة كأرضية خصبة للجريمة:
يُعد غياب العدالة الاجتماعية والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة من أهم المحركات الكامنة وراء ارتفاع معدلات الجريمة. عندما يشعر جزء كبير من المجتمع بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وعندما تتركز الثروة والسلطة في أيدي قلة قليلة، تنشأ بيئة من الإحباط واليأس والغضب.
التفاوتات الاقتصادية: يسجل المغرب مستويات مرتفعة نسبيًا من التفاوت في الدخل. حيث أشارت تقارير للمندوبية السامية للتخطيط في السنوات السابقة إلى أن مؤشر جيني(Gini Index) وهو مؤشر إحصائي يُستخدم عالميًا لقياس درجة عدم المساواة في توزيع متغير ما، وأشهر استخداماته هو قياس عدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، كانت نسبته حوالي (0.39)، أي أن هناك مستوى ملحوظًا ومتوسطًا إلى مرتفع نسبيًا من عدم المساواة في توزيع الدخل في المغرب (مقارنة بالدول التي تسجل أقل من (0.3) مثل دول شمال أوروبا، ولكنه قد يكون أفضل من دول أخرى تسجل فوق (0.5). بالإضافة إلى تقرير أوكسفام لعام 2022 الذي أشار إلى أن ثروة أغنى ثلاثة مليارديرات مغاربة تفوق ما يملكه 375 ألف من أفقر المغاربة. هذه التفاوت تخلق شعورًا بالظلم “الحكرة” وتدفع البعض، خاصة في غياب فرص بديلة، إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية.
الفقر والهشاشة: لا تزال معدلات الفقر والهشاشة مرتفعة، خاصة في المناطق القروية والهوامش الحضرية. حيث تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى وجود ملايين المغاربة يعيشون تحت خط الفقر أو في حالة هشاشة. على اعتبار أن الفقر المدقع يمكن أن يدفع بالأفراد إلى جرائم بسيطة للبقاء، بينما تخلق الهشاشة بيئة يسهل فيها استقطاب الشباب نحو شبكات الجريمة.
2. فشل السياسات العمومية: التعليم وإدماج الشباب
تلعب السياسات العمومية دورًا حاسمًا في توفير الفرص والحد من العوامل المؤدية إلى الجريمة. إلا أن فشل هذه السياسات، خاصة في قطاعي التعليم وإدماج الشباب، يفاقم المشكلة بشكل كبير في المغرب.
أزمة نظام التعليم: يعاني نظام التعليم العمومي من مشاكل هيكلية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي (تقارير اليونيسف والبنك الدولي تشير إلى أكثر من 300 ألف منقطع سنويًا). الشباب الذين يغادرون المدرسة دون مؤهلات يجدون أنفسهم عرضة للبطالة والتهميش كما جاء في ارقام المندوبية السامية للتخطيط أكثر من مليون ونصف شاب بين سن 15 و24 سنة لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتابعون أي تكوين. ويتضح هول هذا الرقم عندما نجد في تقارير المندوبية السامية للسجون وإعادة الادماج الاجتماعي على أن الشباب الأقل من 30 سنة يشكلون 47.68 في المائة من الساكنة السجنية بالمغرب. هذان الرقمان كفيلان بأن يرسما صورة واقع الشباب المغربي القاتمة، الصورة التي تبيين الفشل الواضح في إدماج شريحة واسعة جدًا من الشباب المغربي في المنظومة التعليمية وسوق الشغل، هذا الفشل لا يقتصر على كونه مشكلة اقتصادية واجتماعية فحسب، بل له تداعيات أمنية خطيرة، حيث يبدو أنه يغذي بشكل مباشر ظاهرة جنوح الأحداث والشباب وارتفاع نسبتهم داخل المؤسسات السجنية. إنها حلقة مفرغة حيث يؤدي الإقصاء إلى الجريمة، والجريمة (وما يتبعها من سجن ووصم اجتماعي) تزيد من صعوبة إعادة الإدماج لاحقًا، مما يعمق الإقصاء.
ليس هذا فقط، فحتى حملة الشهادات من الشباب المغربي يواجهون صعوبات جمة في الاندماج في سوق العمل، حيث سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7% إلى 19,8% حسب الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، الأمر الذي يجعل هذا الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي يولد شعورًا بالانسداد والإحباط.
3. طبيعة الجرائم والعنف السائدة: انعكاس للإقصاء وأزمة قيم متفاقمة:
لعل أبرز ما يثير القلق المتزايد في المغرب حاليًا هو نوعية الجرائم السائدة، وتحديدًا جرائم السرقة المقترنة بالعنف والتهديد بالسلاح (خاصة السلاح الأبيض). فهذه ليست مجرد جرائم ملكية بسيطة، بل تحمل بُعدًا عنيفًا يفاقم الشعور بانعدام الأمن العام. ويمكن تفسير انتشار هذا النوع من الجرائم، جزئيًا على الأقل، بأنه تعبير عن درجة عالية من اليأس والإحباط لدى فئات معينة، لاسيما الشباب المحروم من الفرص الاقتصادية المشروعة. فعندما تُسد الآفاق ويشعر الفرد بأنه “ليس لديه ما يخسره”، قد يصبح اللجوء إلى العنف للحصول السريع على المال (حتى لو كان قليلاً) خيارًا مغريًا أو حتى ضروريًا في نظره. فالتهديد بالسلاح يهدف لضمان نجاح السرقة وتقليل مقاومة الضحية، ولكنه يعكس أيضًا استعدادًا متزايدًا لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الغايات.
غير أن طبيعة الجريمة وأنماط العنف المتفشية تتجاوز الآن كونها مجرد استجابة للحاجة المادية، لتعكس أزمة مجتمعية وأخلاقية أعمق تتجلى بوضوح في وحشية الأفعال وفي هوية ضحاياها، وفي توسع دائرتها. ويتضح ذلك جليًا في العنف المدرسي الرائج حاليًا ضد نساء ورجال التعليم، والذي تزامن أيضًا مع موجات عنف ضد المواطنين في الشارع العام، مما يشير إلى أن المشكلة لم تعد محصورة في “جريمة الحاجة” التقليدية، بل تدل على انتشار ثقافة عنف تتطاول على رموز كانت تحظى بالاحترام وتستبيح الفضاء العام ككل. والأخطر من ذلك، يبرز الانحدار الأخلاقي المرعب في استهداف العنف المسلح حتى للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والشيوخ، وبطريقة تنقصها “العفة” أو الحد الأدنى من الضوابط الأخلاقية التي ربما تحلى بها حتى بعض مجرمي الماضي. هذه الوحشية واستهداف المستضعفين ليسا مجرد إجرام عابر، بل هما مؤشر صارخ على أزمة قيم حقيقية وخطيرة تضرب المجتمع في الصميم.
ويأتي هذا الانحدار في سياق انهيار متسارع ورهيب لمنظومة القيم المجتمعية، حيث تخلت الأسرة بشكل كبير عن دورها المحوري في التربية والتنشئة، وتواجه المدرسة تحديات تجعلها أحيانًا مؤسسة لتفريخ العنف والضحالة بدلًا من غرس القيم والمعرفة. هذا يتقاطع مع ما قد يشير إليه شيوع العنف في جرائم الشارع من تآكل في رأس المال الاجتماعي وفي آليات الضبط غير الرسمي داخل الأحياء المهمشة، حيث تفشل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في لعب دورها بفعالية. يساهم في هذا أيضًا التعرض المستمر لمظاهر الإقصاء والتهميش وعوامل أخرى (مثل تأثير بعض المحتويات الإعلامية أو سهولة الحصول على السلاح الأبيض)، مما قد يؤدي إلى تطبيع نسبي للعنف كوسيلة لحل النزاعات أو لتحقيق الأهداف في بيئات معينة. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، نشأت قطيعة ثقافية وقيمية بين الأجيال، حيث يتبنى الشباب واليافعون مثلًا ومعايير سلوكية قد تكون غريبة تمامًا عن الأجيال السابقة، مما يتركهم في فراغ قيمي يجعل العنف سلوكًا مقبولًا أو حتى ممجّدًا في بعض الأوساط. إن هذه الأزمة المركبة ليست مجرد مشكلة آنية، بل نذير خطير بأن الأسوأ قد يكون قادمًا إن لم يتم تدارك هذا الانهيار الشامل.
- طبيعة الجريمة كمرآة لعدم المساواة: مقارنة المغرب وفرنسا:
النقطة الثانية تتعلق بكيفية ارتباط طبيعة الجريمة السائدة في أي مجتمع ارتباطًا وثيقًا بشكل وبنية اللامساواة وتوزيع الثروة فيه. المثال المقارن مع فرنسا يوضح هذه الفكرة بشكل جلي:
المبدأ العام: ليست كل المجتمعات تعاني من نفس أنواع الجرائم بنفس الحدة. فبنية الاقتصاد، وطبيعة العقد الاجتماعي، والسياسات الضريبية والاجتماعية، وشكل التفاوتات السائدة، كلها عوامل تحدد “نقاط الضغط” التي قد تولد أنماطًا معينة من السلوك الإجرامي.
المغرب: جريمة الإقصاء: كما تم تحليله، في سياق يتسم بتفاوت كبير في الفرص والثروات، وبطالة مرتفعة بين الشباب، وضعف في شبكات الأمان الاجتماعي، تصبح جرائم الشارع العنيفة المرتبطة بالحاجة المادية المباشرة (كالسرقة بالعنف) أكثر بروزًا. إنها، بشكل ما، “جريمة الإقصاء” نتاج شعور فئات واسعة بأنها مستبعدة من النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتلجأ إلى وسائل غير قانونية للحصول على نصيبها أو لمجرد البقاء.
فرنسا (كمثال): جريمة التهرب من إعادة التوزيع: في المقابل، في مجتمع مثل فرنسا التي تعرف أكبر نسبة تهرب ضريبي في العالم، وذلك لتميزها بنظام ضريبي تصاعدي مرتفع نسبيًا يهدف إلى تمويل دولة رفاه قوية وبرامج دعم اجتماعي واسعة، يظهر نمط مختلف من الجرائم الاقتصادية بشكل بارز: التهرب الضريبي وجرائم “ذوي الياقات البيضاء”. هذه الجرائم لا يرتكبها بالضرورة الفقراء أو المهمشون بدافع الحاجة الماسة للبقاء، بل غالبًا ما يرتكبها أفراد أو شركات ميسورة الحال نسبيًا تسعى إلى تجنب المساهمة في نظام إعادة التوزيع الذي تفرضه الدولة. إنها تعكس مقاومة أو رفضًا من قبل البعض لآليات تقاسم الثروة التي يعتمدها المجتمع، وهي جريمة تنشأ داخل المنظومة الاقتصادية ومن تناقضاتها الداخلية (الرغبة في مراكمة الثروة مقابل واجب المساهمة الاجتماعية).
الاستنتاج المقارن: كلا النوعين من الجرائم (السرقة العنيفة في سياق الإقصاء، والتهرب الضريبي في سياق إعادة التوزيع) مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقضية توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية. لكنهما يعكسان تجليات مختلفة للمشكلة بحسب بنية المجتمع وسياساته. هذا يؤكد أن فهم الجريمة يتطلب تحليلًا دقيقًا للسياق المحدد ولطبيعة اللامساواة السائدة فيه.
5. غياب الحكامة:
لا يمكن إغفال تأثير العيوب المرتبطة الحكامة. ضعف المساءلة، غياب الشفافية، انتشار الفساد (المغرب في المرتبة 94/180 في مؤشر مدركات الفساد 2023)، وتغليب المقاربة الأمنية، كلها عوامل تؤثر على قدرة الدولة على معالجة جذور المشكلة. الشعور بالإفلات من العقاب لدى البعض وغياب العدالة للضحايا يقوض الثقة ويشجع على انتهاك القانون. المقاربة الأمنية وحدها غير كافية دون معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
6. استغلال الدولة لظاهرة الجريمة: تعزيز القبضة الأمنية وتحويل الأولويات
إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية وفشل السياسات العمومية، يمكن النظر إلى العلاقة بين الدولة والجريمة من زاوية أخرى: وهي إمكانية استغلال الدولة لظاهرة ارتفاع منسوب الجريمة، وخاصة الجرائم العنيفة التي تثير الرعب، لخدمة أهداف سياسية خاصة بها. في هذا السياق، لا تعود الجريمة مجرد مشكلة تتطلب الحل، بل قد تصبح أداة لتعزيز السلطة وتبرير بعض الممارسات، مثل تبرير المقاربة الأمنية وتعزيز السيطرة. لأنه عندما يسود شعور عالٍ بانعدام الأمن وتنتشر أخبار السرقات بالعنف والاعتداءات، يرتفع المطلب الشعبي الأول ليصبح “الأمن قبل كل شيء”. ومن خلاله يمكن للدولة، وخاصة تلك التي تميل إلى المقاربات السلطوية، أن تستجيب لهذا المطلب (أو حتى تضخمه إعلاميًا) ليس فقط كواجب، بل كفرصة لتبرير تشديد القبضة الأمنية، ليشمل ذلك زيادة الانتشار الأمني، وتوسيع صلاحيات أجهزة المراقبة والتنصت، وسن قوانين أكثر صرامة قد تمس أحيانًا بالحريات الفردية والعامة، وكل ذلك تحت غطاء “مكافحة الجريمة” و”حماية المواطنين”. يصبح عنف الدولة، أو ما يسميه ماكس فيبر “العنف المشروع” الذي تحتكره الدولة، هو الحل الأبرز والأكثر قبولًا في مواجهة “العنف غير المشروع” للمجرمين.
تحويل الأنظار وتشتيت المطالب: يشكل التركيز المكثف على الجريمة والخوف منها أداة فعالة لتحويل انتباه الرأي العام بعيدًا عن القضايا البنيوية الأعمق مثل الفساد المستشري، غياب العدالة الاجتماعية، سوء توزيع الثروة، ضعف الخدمات العمومية (الصحة، التعليم)، والمطالبة بالإصلاحات السياسية والديمقراطية. عندما يكون هم المواطن الأساسي هو سلامته الشخصية وسلامة ممتلكاته، تتراجع في سلم أولوياته المطالبة بالحقوق السياسية، أو المحاسبة، أو تحسين ظروف العيش على المدى الطويل. ويصبح المواطنون أكثر استعدادًا لقبول الوضع القائم، بل وحتى الدفاع عن إجراءات قد تكون قمعية، ما دامت توهمهم بتوفير الأمن.
ترسيخ مقولة “الأمن مقابل الحرية”: يتم توظيف الخوف من الجريمة لترسيخ مقايضة ضمنية أو صريحة، مما يؤدي إلى القبول بتقليص هامش الحريات والمطالب مقابل الحصول على الأمن والاستقرار. يتجلى هذا بوضوح في المقولة الشعبية المغربية المتداولة “اللهم مخزن ظالم ولا قبيلة سايبة” (بمعنى: من الأفضل وجود سلطة مركزية قوية حتى لو كانت ظالمة، على العيش في فوضى وانعدام الأمن). يمكن للسلطة أن تغذي هذا المنطق بشكل غير مباشر، حيث يصبح استتباب الأمن (ولو كان هشًا أو انتقائيًا) هو الإنجاز الأكبر الذي تقدمه للمواطنين، مما يقلل من الضغط عليها لتحقيق إنجازات في مجالات أخرى كالعدالة الاجتماعية أو التنمية الحقيقية أو الديمقراطية.
بهذه الطريقة، يمكن أن تتحول مكافحة الجريمة من هدف نبيل لحماية المجتمع إلى استراتيجية سياسية تهدف إلى إدامة السيطرة، وتجنب الإصلاحات الجذرية، وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير، وذلك عبر جعل “الأمن” هو المطلب الوحيد المسموع والمقبول، على حساب المطالب الأخرى المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة والرفاه.
7. تشابك العوامل:
تتفاعل هذه العوامل وتتداخل بشكل معقد. الفقر يفاقمه فشل التعليم، والبطالة تزيد من يأس الشباب، وانهيار القيم يزيل الحواجز الأخلاقية أمام العنف، وضعف الحكامة يقوض الإصلاحات ويزيد انعدام الثقة، كما أن الاستجابة السياسية قد تركز على المقاربة الأمنية لأسباب تتجاوز مجرد مكافحة الجريمة. انتشار جرائم العنف بأشكالها المختلفة (سرقة مسلحة، عنف مدرسي، اعتداءات عشوائية) هو عرض لهذه التشابكات المعقدة والمتجذرة في أزمات اقتصادية واجتماعية وقيمية وسياسية متداخلة.
- خاتمة:
إن تحليل ارتفاع منسوب الجريمة والعنف في المغرب يتطلب نظرة شمولية تتجاوز التفسيرات السطحية والمقاربات الأمنية الصرفة. فالأمر ليس فقط سلوكًا فرديًا منحرفًا أو نتيجة حتمية للفقر، بل هو انعكاس لأزمات بنيوية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، ونجاعة السياسات العمومية، وطبيعة الحكامة، ويشير بقوة إلى أزمة قيمية وأخلاقية عميقة تضرب المجتمع وتتجلى في وحشية بعض الجرائم واستهدافها للمستضعفين وامتدادها لمؤسسات كالمدارس. وكما يوضح المثال المقارن مع فرنسا، فإن شكل اللامساواة وطبيعة العقد الاجتماعي والقيمي يحددان إلى حد كبير طبيعة الجرائم الأكثر شيوعًا. لا يمكن تحقيق انخفاض مستدام في معدلات الجريمة ومظاهر العنف دون معالجة هذه الجذور عبر إصلاحات حقيقية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، وتوزيع أكثر إنصافًا للثروة، وإصلاح جذري للتعليم يعيد له دوره التربوي والقيمي، وخلق فرص حقيقية للشباب، وتعزيز دور الأسرة، والعمل على إعادة بناء منظومة قيمية مشتركة، وتعزيز دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد بجدية، مع ضمان ألا تتحول مكافحة الجريمة إلى أداة لتقويض الحريات أو تهميش المطالب المشروعة الأخرى. الاستثمار في الإنسان وفي العدالة وفي القيم هو الاستثمار الأكثر فعالية في الأمن والاستقرار الحقيقي والمستدام.
طالب باحث في السوسيولوجيا
المصدر: العمق المغربي