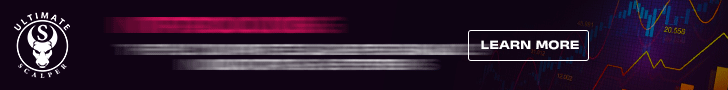الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف
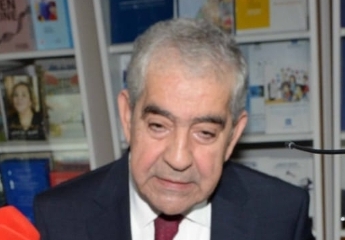
في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، اجتمع فنانان مغربيان كبيران في فرنسا، على الأرجح لتسجيل بعض أغانيهما ضمن الكتالوغات الشرقية لشركات الإنتاج الموسيقي. الأول هو شاعر سوس المعروف الحاج بلعيد، والذي يُقال إنه التقى بالفنان المصري محمد عبد الوهاب في باريس، في لقاء يبدو أقرب إلى الأسطورة. أما الثاني، فهو حسين السلاوي، أحد أعمدة الأغنية الشعبية المغربية الناطقة بالعربية. في حين خلد الحاج بلعيد تلك الرحلة الفريدة في أغنيته « سفر باريس »، عاد السلاوي إلى فرنسا في مناسبات عدة. وقد استفاد من موهبته كفنان « حلايقي » شاب ومن العلاقات الكثيرة التي نسجها مع مطربين جزائريين وتونسيين، الذين كانوا آنذاك أكثر حضورا في الساحة الفنية الفرنسية.
ويشكل هذان الفنانان نموذجين لمسار ثقافي للهجرة لا يزال قليل المعرفة، إذ طغى عليه طويلاً البعد الاقتصادي الذي يختزل الهجرة في الحاجة الاقتصادية للمركز الاستعماري وفي فقر المستعمرة. إلا أن الواقع يُظهر أن للهجرة أبعادًا أخرى، ثقافية واجتماعية بالأساس، ظلت مغيبة عن النقاش العام.
لقد لعبت الحربان العالميتان دورًا بارزا في انطلاق أولى موجات الهجرة، كما ساهم الطلبة المغاربة، منذ عشرينيات القرن الماضي، في بروز الحركة الوطنية من قلب العاصمة الفرنسية. وقد بدأ مؤرخو السينما، والفنون التشكيلية، والتصوير، والأدب في السنوات الأخيرة في تسليط الضوء على هذه المسارات الخفية، مستعرضين أسماء ومسارات عشرات الرواد المغاربة الذين أسهموا في التأسيس الثقافي للهجرة.
هذه المسارات التاريخية تُظهر أن الهجرة المغربية ليست فقط اقتصادية، بل هي أيضًا عسكرية، سياسية، اجتماعية، وثقافية. ويبدو أن إسهامها في المجال الثقافي كان محوريًا، إن لم يكن حاسمًا.
في خمسينيات القرن الماضي، توافد على باريس فنانون مغاربة جدد، من بينهم عبد الوهاب أكومي الذي جاء من القاهرة، وتبعه كل من محمد فويتح، وأحمد جبران، وغازي بناصر، وسامي المغربي، ولطيفة أمل، وإسماعيل أحمد، وأحمد سليمان شوقي، وآخرون.
أما في مجال الفنون التشكيلية، فقد حل الجيلالي الغرباوي بباريس سنة 1952، وتبعه أحمد الشرقاوي في 1956. من جهته، سافر محمد المليحي إلى إسبانيا سنة 1955، ثم استقر في روما سنة 1957، حيث كان الفنان محمد شبعة قد سبقه إليها.
وفي مجال السينما، التحق أحمد بلهاشمي سنة 1950 بالمعهد العالي للدراسات السينمائية بباريس (IDHEC)، وتبعه لاحقًا مخرجون مغاربة بارزون مثل محمد عفيفي، وأحمد البوعناني، ومحمد عبد الرحمن التازي، ومومن السميحي، وحميد بناني وغيرهم، حيث تلقوا تكوينهم في هذه المدرسة المرموقة.
أما في الأدب، فقد وصل ادريس الشرايبي إلى فرنسا سنة 1945، ونشر روايته الماعز سنة 1955. وسرعان ما تبعه عدد من الأدباء المغاربة، مثل محمد خير الدين، والطاهر بنجلون، وإدمون عمران المالح، الذين أقاموا في فرنسا فترات متفاوتة. ومع مرور السنوات، التحق بهم كتاب وشعراء آخرون يصعب حصرهم، من بينهم محمد لفتاح الذي اختار الاستقرار في القاهرة، حيث توفي سنة 2008.
منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأ أبناء الجالية المغربية في الخارج في إبراز أصواتهم الإبداعية، مضيفين أبعادًا جديدة لهذا الإرث الثقافي.
ومن هذا الجيل، برزت كاتبات مغربيات فرضن وجودهن بقوة. كل واحدة منهن، بطريقتها الخاصة، ساهمت في إثراء هذا التراث، رافضات الانصهار في قوالب جاهزة أو الانتماء لجماعة واحدة تُلغي خصوصيتهن. يكتبن بلغات متعددة: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإسبانية، الكتالانية، الإيطالية، الإنجليزية، الهولندية، والألمانية، ويرفضن حصرهن في هوية واحدة خانقة. ورغم تنوع مساراتهن وسياقات الاستقبال التي وُوجهْن بها، فإنهن يُجمعن على فكرة واحدة: لا يمكن كتابة مستقبل المجتمعات والثقافات بلغة ذكورية فقط. ومن خلال مساهماتهن في أدب بلدان الإقامة وفي الأدب المغربي، تذكّرنا هؤلاء الكاتبات بأن الحداثة المغربية مدينة، هي الأخرى، للهجرة.
المصدر: اليوم 24