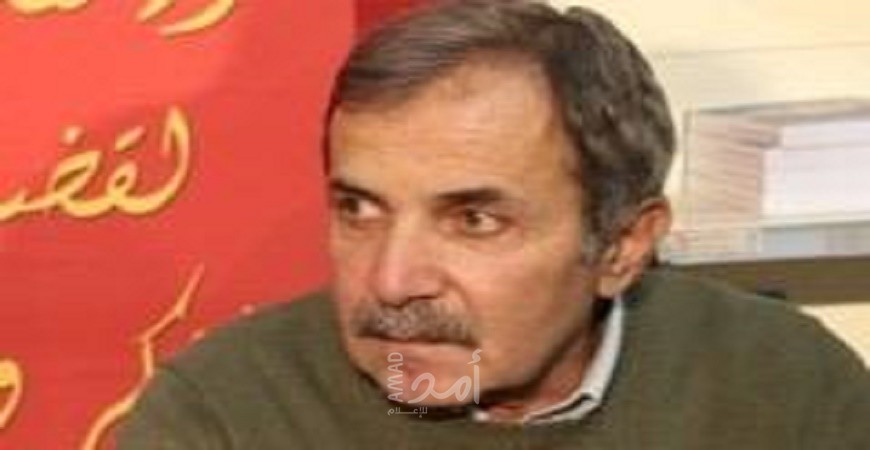منذ العاشر من تموز/يوليو 2018، نشر الصحافي والمؤرخ الفرنسي دومينيك فيدال مقالاً بعنوان: "في إسرائيل: الأبعاد الثلاثة للانحراف الفاشي"، أشار فيه إلى أن "التجاوزات الاستبدادية والفاشية لدولة إسرائيل يتم التقليل من شأنها إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام والقادة السياسيين الأوروبيين، لكنها حقيقية وتحمل مخاطر على الشرق الأوسط برمته"، محدداً ثلاثة أبعاد لهذا الانحراف.
فالبعد الأول يتمثل في "المشروع الاستعماري في فلسطين"، الذي يشهد "انعطافاً تاريخياً" في ظل توسع الاستيطان وتسارعه، وإضفاء طابع شرعي على البؤر الاستيطانية، وتصاعد الدعوات إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو مساحات واسعة منها، والسعي إلى تبني قانون: "الدولة القومية للشعب اليهودي". ويتمثل البعد الثاني في العداء المتعاظم الذي يبديه زعماء اليمين المتطرف إزاء الفلسطينيين، إذ "نشرت وزيرة العدل، أييليت شاكيد، خلال حرب غزة الأخيرة [في سنة 2014]، على صفحتها على الفيسبوك نصاً يصف "الشعب الفلسطيني بأكمله بأنه عدو إسرائيل"، بما يبرر "تدميره، بما في ذلك شيوخه ونساؤه ومدنه وقراه"، بينما دعا نفتالي بينيت إلى قتل جميع "الإرهابيين" المعتقلين بدلاً من إيداعهم السجن، موضحاً: "لقد قتلت الكثير من العرب، ولا مشكلة في ذلك"، في حين أكد أفيغدور ليبرمان أن "العرب الإسرائيليين ليس لهم مكان هنا". بينما يتمثّل البعد الثالث في تحالف بنيامين نتنياهو مع زعماء اليمين المتطرف الأوروبي، وخصوصاً في هنغاريا وبولونيا، الذين لا يخفون معاداتهم السامية والإسلام. ويخلص دومينيك فيدال إلى "أن نتنياهو وحلفاءه يعرفون أن اندفاعهم المتهور لن يؤدي، على المدى الطويل، سوى إلى تفاقم العزلة الدولية للحكومة الإسرائيلية" (1).
مستقبل إسرائيل وفقاً لليمين المتطرف
تحت هذا العنوان، نشر الباحثان نمرود فلاشينبرغ وألما يتسحاقي مقالاً، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، أبرزا فيه كيف أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عمقت الانحراف الفاشي الذي عرض دومينيك فيدال أبعاده الثلاثة. فتلك الأحداث التي سلطت الضوء "على النزعات الكامنة في دولة إسرائيل، ولا سيما اعتمادها على الجيش وطابعها العرقي"، خلقت "شعوراً بانعدام الأمن ورؤية تشاؤمية للمستقبل"، كما أثارت "غضباً انتقامياً ضد الفلسطينيين"، مقدّرين أن الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو سيكون لها "العديد من العواقب المدمرة على المجتمع الإسرائيلي". ولدى تناولهما مظاهر تعمق الانحراف الفاشي في إسرائيل، توقف الباحثان عند ظاهرة تصاعد القمع الممارس على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وانتشار الأسلحة الفردية بين المدنيين على نطاق واسع، وتوسيع الحكم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتعاظم التوجّه نحو عسكرة الدولة.
ففي الأسابيع القليلة الأولى التي تلت السابع من تشرين الأول /أكتوبر، أطلقت حكومة إسرائيل موجة واسعة من التحقيقات والاعتقالات ولوائح الاتهام ضد المواطنين الفلسطينيين المتهمين بـ "التحريض على العنف" و"دعم الإرهاب". وكان سبب اعتقال العديد منهم قيامهم بنشر "منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبارات التعاطف والحزن إزاء معاناة سكان غزة". وتعرض الفلسطينيون "للتهديد في أماكن عملهم ومدارسهم وفي الأماكن العامة، مما أشاع جواً من الترهيب والرقابة، وانتشرت المضايقات بصورة خاصة في الجامعات" (2).
وفي الأسابيع التي أعقبت هجوم حركة "حماس"، قرر وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير توسيع إمكانية الحصول على تصريح بامتلاك الأسلحة النارية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص من أجل "إنقاذ الأرواح" و"تعزيز إمكانية الدفاع عن النفس"، مما أدى إلى زيادة عدد المدنيين مالكي الأسلحة بنسبة 64%"، ووصل عددهم إلى نحو 100 ألف. كما قام بن غفير بتسهيل حصول النساء الإسرائيليات على الأسلحة، بحيث "تقدمت 42 ألف امرأة بطلب للحصول على تصاريح، وتمت الموافقة على 18 ألف طلب، وفقا للوزارة"، وهو ما انتقدته بشدة منظمة "طاولات مطبخ خالية من الأسلحة"، التي تأسست سنة 2010 من قبل ناشطات نسويات يحاربن انتشار الأسلحة في المنازل، وتضم 18 جمعية، محذرة من أن "تزايد الأسلحة في الأماكن المدنية يؤدي إلى زيادة أعمال العنف والقتل، وخصوصاً ضد النساء"، ومؤكدة "أن الوقت حان كي تفهم الدولة أن سلامة الناس هي مسؤوليتها" (3).
وعلى صعيد توسيع الحكم الاستعماري، عمل وزير المالية والمسؤول عن الإدارة المدنية في الأراضي المحتلة، بتسلئيل سموتريتش، على تسرييع الاستيطان في الضفة الغربية، بحيث "حطمت سنة 2024 أرقاماً قياسية جديدة في معدل المصادقة على مخططات لمبانٍ جديدة، ومحاولات إضفاء الشرعية بأثر رجعي على المنازل والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين"، و"تمّ بناء أربع وعشرين بؤرة استيطانية جديدة منذ بداية الحرب وشق عشرات الطرق الجديدة".
ومن ناحية أخرى، بلغ عنف المستوطنين ضد الفلسطينيينأ "أعلى مستوياته على الإطلاق، وغالباً ما كان ذلك بحماية الشرطة والجيش، إن لم يكن بمشاركة نشطة منهما"، إذ "تمّ الإبلاغ عن ما يقرب من 1,000 هجوم عنيف هذا العام"، ويفيد النشطاء "أن تجنيد العديد من المستوطنين في صفوف جنود الاحتياط يجعل من المستحيل التمييز بين المستوطنين والجنود، ويتمتع المهاجمون بحصانة شبه كاملة"، كما تمّ "طرد تسعة عشر تجمعاً للرعاة في غور الأردن ونزع أراضيهم منهم" (4).
وترافق هذا مع تجريد الفلسطينيين في قطاع غزة من إنسانيتهم، بصورة لا سابق لها، إذ "تتراوح ردود الفعل العامة على عمليات القتل والتجويع والإرهاب التي يتعرض لها سكان غزة بين هز الأكتاف والدعوات إلى القتل". وبينما أدلى القادة الإسرائيليون "بمئات من تصريحات الإبادة الجماعية، كما وثقتها محكمة العدل الدولية وتقرير حديث لمنظمة العفو الدولية"، فإن وسائل الإعلام المهيمنة في إسرائيل "تخفي، بصورة ممنهجة، الأنباء التي تتحدث عن معاناة المدنيين في غزة، ولم يذكر معظمها أي مصدر آخر غير جيش الدفاع الإسرائيلي نفسه"، ولا تظهر للإسرائيليين "الصور والتقارير المروعة المتاحة للعالم أجمع".
وبينما تقف أقلية صغيرة فقط ضد الحرب، فإن"الأغلبية الساحقة تتقبل الرواية القائلة بأن التدخل العسكري وحده كفيل باستعادة الأمن". وفي هذا السياق، فإن سنة 2024 شهدت "عسكرة لا نهاية لها لمجتمع تحكمه القوات المسلحة بالفعل إلى حد كبير"، بحيث برزت "إسبرطة يهودية في شرق البحر الأبيض المتوسط، يقودها الله في حرب صليبية دائمة ضد العرب، وهذه الرؤية لإسرائيل، التي يروج لها اليمين الديني، يتم الترحيب بها الآن بأذرع مفتوحة".
وينطوي هذا التوسع الدائم للقوات المسلحة في بلد صغير نسبياً على آثار اجتماعية كبيرة، إذ "تتطلب هذه العسكرة تمديد الخدمة العسكرية للرجال"، و"سيكون الاستثمار المتزايد في الجيش (في أنظمة الأسلحة، والتدريب، والأفراد، وما إلى ذلك) على حساب الخدمات الاجتماعية"، كما أن الأهمية المتزايدة للخدمة العسكرية "سيكون لها تأثير مباشر على إنتاجية الدولة، إذ إن الجنود لا ينتجون أي قيمة اقتصادية". وفي مواجهة هذه الصورة القاتمة، فإن العديد من الإسرائيليين "الذين لديهم الفرصة والوسائل ة المهنية وجواز السفر الأجنبي يغادرون البلاد، سواء كانوا يؤيدون الحرب أم لا، فهم لا يريدون العيش في دولة عسكرية"، ويتضح هذا الاتجاه بصورة خاصة "في القطاعات التي تحتاجها إسرائيل للحفاظ على اقتصادها إذا ما أرادت أن يكون اقتصادها قابلاً للاستمرار: التكنولوجيا المتقدمة والجامعات والطب" (5).
الحرب لن تكون وسيلة لضمان الأمن والقضاء على طموحات الفلسطينيين الوطنية
تعتقد أغلبية الإسرائيليين أن السلام مع الفلسطينيين ليس ممكناً، وأن الحل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين هو الحرب. لكن هناك قلائل من بعيدي النظر الذين لا يرون في الحرب وسيلة لضمان أمن الإسرائيليين ولا للقضاء على طموحات الفلسطينيين الوطنية، مثل ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، وأبراهام بورغ، رئيس الكنيست السابق عن حزب العمل.
ففي مقال بعنوان: "لماذا تتجه إسرائيل نحو التدمير الذاتي، نُشر قبل نحو عام وتحديداً في 15 شباط/فبراير 2024، أشار ألوف بن إلى أن يوم 7 أكتوبر "كان سوأ كارثة في تاريخ إسرائيل، ونقطة تحول وطنية وشخصية لكل من يعيش في البلاد أو يرتبط بها". ومع أن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك الهجوم "بقوة ساحقة، فقتل آلاف الفلسطينيين ودمر أحياء بأكملها في غزة"، إلا أن الحكومة الإسرائيلية "لم تأخذ في الاعتبار الكراهية الكامنة وراء الهجوم، أو السياسات التي يمكن أن تمنع وقوع هجوم آخر"، مقدّراً أن إسرائيل كي تنعم بالسلام، "سوف يكون لزاماً عليها أخيراً أن تتصالح مع الفلسطينيين، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو طوال حياته المهنية، ذلك إنه كرس فترة ولايته كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، لتقويض وتهميش الحركة الوطنية الفلسطينية، ووعد شعبه بأنهم يستطيعون الازدهار من دون سلام"، وروّج فكرة أن إسرائيل "يمكن أن تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد، دون أن يكلفها ذلك الكثير، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وحتى اليوم، بعد يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يغير هذه الرسالة".
لكن إسرائيل كما تابع رئيس تحرير "هآرتس" "لم يعد في وسعها أن تكون عمياء إلى هذا الحد، إذ أثبتت هجمات 7 أكتوبر أن وعد نتنياهو كان أجوفاً، وأن الفلسطينيين، وعلى الرغم من تعثر عملية السلام وفقدان الدول الأخرى اهتمامها بهم، حافظوا على قضيتهم حية". وأجبرت صدمة السابع من أكتوبر الإسرائيليين مرة أخرى "على إدراك أن الصراع مع الفلسطينيين يشكل أهمية مركزية لهويتهم الوطنية ويشكل تهديداً لرفاهيتهم، ولا يمكن إهماله أو التهرب منه، واستمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة، ورفض تقديم أي تسوية إقليمية (أو حتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين) لن يجلب للبلاد الأمن الدائم" (6).
أما أبراهام بورغ، فقد نشر، في 6 تشرين الأول/اكتوبر 2024 ، مقالاً بعنوان: "بعد مرور عام على 7 أكتوبر: غارقون في الكراهية والعنف واليأس"، لاحظ فيه أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي دام قرناً من الزمان، "بدأ يتغير في طبيعته، إذ أصبحت إسرائيل، في العقود الأخيرة، تعتقد أنه من الممكن إدارة الصراع من دون حله على الإطلاق"، معتمدة في ذلك على "الحفاظ على توازن دقيق للقوى من خلال مزيج من السيطرة العسكرية والإجراءات الأمنية والمساعدات الاقتصادية المحدودة للفلسطينيين"، مؤكداً أن هجوم حركة "حماس" تسبب في انهيار هذه الاستراتيجية و"حطم الوهم القائل بإمكانية الحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى"، وبيّن أن "القناعة بأن التفوق التكنولوجي والردع العسكري يمكن أن يضمنا أمن البلد هي قناعة خاطئة، بحيث كان يوم السابع من أكتوبر بمثابة دعوة صادمة للاستيقاظ"، وأظهر خطأ "افتراض مفاده أن القوة العسكرية قادرة على احتواء رغبة الفلسطينيين في الاستقلال والحرية من خلال منع أي اتفاق سلمي معهم".
وتابع رئيس الكنيست السابق أن السابع من أكتوبر أظهر أن "الاعتماد على القوة العسكرية وحدها له حدوده بالفعل"، إذ "فشلت العمليات المتعددة التي نُفذت في غزة في إرساء السلام أو الأمن الدائم"، و"أثارت الحرب أسئلة أخلاقية وسياسية حاسمة"، وخلقت فراغاً إيديولوجياً وسياسياً، جعل "الأفكار المتطرفة تكتسب المزيد من الأرض، وتدعو الأصوات الراديكالية إلى إعادة احتلال غزة، والطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية؛ وهذه الأفكار، التي كانت هامشية ذات يوم، أصبحت أكثر وأكثر أهمية، مدفوعة باليأس المتزايد" (7).
كيف يمكن تغيير هذا الواقع؟
يؤكد الباحثان نمرود فلاشينبرغ وألما يتسحاقي أن التغيير "لا يمكن أن يأتي من داخل النظام السياسي الإسرائيلي"، ذلك إن "التمزق الصادم الذي شكله السابع من أكتوبر، وموجات القمع المتتالية، وجها ضربة قاضية لليسار ودعاة السلام الذين تراجعوا إلى الهامش". وفي هذا السياق، لا يمكن التخلي عن خيار الحرب "إلا بتدخل دولي حاسم، بدءاً بحظر السلاح"، واللجوء إلى الضغط الدولي "لإحداث تغيير في المجتمع الإسرائيلي"، عندها فقط ستظهر "قوة بديلة في إسرائيل، قادرة على قول لا لليمين المتطرف، وعسكرة المجتمع، والتطهير العرقي لفلسطين وإشعال المنطقة" (8).
أما ألوف بن، فهو يعرب عن تشاؤمه من بداية "حقبة مظلمة"، معتبراً أنه "سيكون من الصعب للغاية التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار، ليس فقط لأن نتنياهو لا يريد حل الصراع الفلسطيني فحسب، بل لأن الحرب ضربت إسرائيل في الفترة الأكثر انقساماً في تاريخها، وفي السنوات التي سبقت الهجوم، تمزقت البلاد بسبب جهود نتنياهو لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى دولة استبدادية قومية ثيوقراطية"، ومقدّراً أنه "من غير المرجح أن تجري إسرائيل نقاشاً جدياً حول التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين"، وذلك بعد أن "تحوّل الرأي العام الإسرائيلي ككل نحو اليمين" و "لن يكون هناك سوى القليل من الإرادة أو الحافز لاستئناف عملية سلام ذات معنى في المستقبل القريب" (9).
بينما يرى أبراهام بورغ أن "الحل الثنائي مع الفلسطينيين ليس كافياً، بل يتطلب الصراع مقاربة إقليمية، من شأنها أن تضعه ضمن إطار أوسع من المصالح الاقتصادية والأمنية"، ويمكن "أن تساعد في موازنة نفوذ إيران المتزايد في الشرق الأوسط". لكن المجتمع الإسرائيلي وقادته –كما يتابع "ليسوا مستعدين بعد لتبني مبادرة دبلوماسية شاملة، ويؤدي الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في العالم العربي إلى خلق ضغوط داخلية على الحكومات التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل". ومع ذلك، فهو يعرب عن اقتناعه بأنه "بعد مرور عام على الأحداث المهمة التي وقعت في أكتوبر 2023، يجد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نفسه عند نقطة تحول حاسمة؛ وبدلاً من الاعتماد على المواجهات العسكرية التي لا نهاية لها، تحتاج المنطقة إلى نموذج جديد، متجذّر في التعاون، بحيث يشكل الفلسطينيون جزءاً من اتفاق أوسع مع الدول العربية؛ وهذه الرؤية، رغم طموحها، هي السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التدهور، ذلك إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل، فإن حرب أكتوبر 2023 يمكن أن تكون مجرد بداية لصراع أكثر خطورة بكثير" (10).
خـاتـمـة:
في ظل هذا التوجه القومي الثيوقراطي والاستبدادي الذي تشهده إسرائيل، كما يرى ألوف بن، والذي سيحظى بدعم إدارة دونالد ترامب، يدخل الفلسطينيون مرحلة دفاع استراتيجي عن النفس، تتطلب منهم، في اجتهادي، السعي إلى الحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية التي يمتلكونها، وأولها الصمود على أرض الوطن وتوفير مقوماته، وهي مهمة مركبة تنطوي على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وإعادة النظر في وسائل الكفاح المتبعة واللجوء إلى أكثرها تلاؤماً مع واقع المناطق الفلسطينية المحتلة، والاتفاق على استراتيجية كفاحية مناسبة ليس لمواجهة تخلي إسرائيل عن التزاماتها في الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير وإنما كذلك لمواجهة سعيها إلى إعادة احتلال الضفة الغربية وإعادتها إلى ما قبل "اتفاق اوسلو" ولكن من دون تحمل تكلفة احتلالها، وجعل "اليوم التالي" في قطاع غزة يوماً فلسطينياً موحداً من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارته، وأخيراً الاستمرار في تدويل القضية الفلسطينية وفرض المزيد من العزلة الدولية على إسرائيل، واختيار وسائل مناسبة للتأثير في المجتمع الإسرائيلي والمساهمة في تغيير توجهات الرأي العام فيه.
إنها تحديات كبيرة، لكن خطورة المرحلة تفرض التصدي لها.