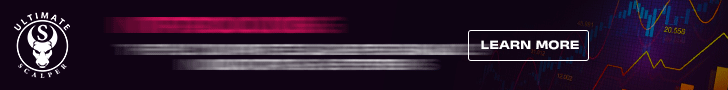الكفاءة الوطنية هي الإحساس بالانتماء للوطن

أمد/ إن أي تطور سواء كان على المستوىات الخدماتية أو المهنية والعمرانية وحتى الأمنية والإقتصادية والماليه، وهكذا بقية القطاعات المهمة التي تتألف منها السلطة الوطنية الفلسطينية، لايأتي من خلال الصدفة ولامن خلال ضربة حظ لرجال يتحكمون بها عن طريق “الريموت كنترول” وإنما يحصل ذلك التطور إذا ما إتفقنا أن نعمل جميعاً وفق قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) بغض النظر عن معتقداته الدينية وخلفياته المذهبية، والتي تعتبر حقاً طبيعياً بممارسة وفق الضوابط التي منحها له المجتمع من دون أن تؤثر تلك الطقوس الدينية والمذهبية وحتى الفكرية، على أداء عمله. فلكل فرد إنتمائه الديني والمذهبي والفكري الذي يعتز به لكن ما قيمة عملة إذا ما تخندق وتحصن بهذه المسميات وحدد نشاطه على ضوئها دون أن يضع للهوية الوطنية الفلسطينية أي اعتبار. فإن المعيار الحقيقي لإختيار أي مسؤول يتم ترشيحه لشغل أحد المناصب المهمة والحساسة في أجهزة ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية هو الكفاءة الوطنية والمهنية التي يتمتع بها، فالكفاءة الوطنية هي الإحساس الحقيقي بالانتماء للوطن والعمل من أجل خدمته وخدمة أهله دون أي تمييز عرقي، أما الكفاءة المهنية أن يتم إختيار ذلك المسؤول أو ذاك وفق المعايير الأكاديمية من شهادة وإختصاص وخبرة ودراية مهنية في مجال عمله تمكنه بأن يكون أهلا لشغل ذلك المنصب، لا أن يتم إختياره على أساس المجاملات المتبادلة بين المكونات السياسة والغير سياسية من إجل إرضاء بعضهما البعض.
إن ما نشاهده في معظم دول العالم وكذلك ما نسمع عنه من إبداعات في مختلف المجالات جاء نتيجة دراسات عميقة ودقيقة وتخطيط مسبق، لأن يأخذ أصحاب الكفاءات والإختصاصات مواقعهم الحقيقية في البلد الذي ينتمون له، كما في بلدنا الذي يزخر أيضاً بالكثير من النخب الإبداعية الوطنية وفي مختلف المجالات، ولكننا للأسف الشديد عكس كل البلدان نرى تلك الطاقات قد أكل الدهر عليها وشرب والسبب هو إنهم لم يدخلوا المعترك السياسي ولم ينضووا تحت غطاء أي مكون من المكونات والفصائل والتنظيمات والتجمعات الحزبية المشاركة في العملية السياسية، فكان الثمن هو إستبعادها وحرمانها من أداء واجبها تجاه وطنها.
إذن أصبح المعيار في الإختيار هما تحدده الميولات والاتجاهات الحزبية والتعارفات الإجتماعية، وبذلك فمن واجبنا الوطني وفي خضم هذه الفترة الحساسة التي نمر بها ويمر بها وطننا وما تمخض عنها من صراعات ومواقف متباينة بين هذا الفصيل أو ذاك فكان لها الأثر الواضح على مسيرة وطننا والتي تتقاذفه أمواج المصالح والمطامع السياسية. فعلينا أن نزيل غبار التعصب والتزمت في إتخاذ المواقف والقرارات وأن نتسامح في ما بيننا، وأن نقدم القليل من التنازلات المنصبيه، كما قدمنا الكثير من التضحيات البشرية نتيجة الدفاع عن التراب الفلسطيني المقدس على مدى عقود من الزمن، فالوطن يستحق أن نضحي أكثر من التضحية بمنصب هو زائل لامحالة ولايدوم لصاحبه أبدا.
عندما ينتمي شعب من الناس لوطن واحد، بما يعنيه الوطن من حدود جغرافية، وكيان سياسي ونظام دولة قائم على مؤسسات مختلفة، فإن هذا الإنتماء يخلق بينهم عيشاً مشتركاً ومصلحة متداخلة مما يوجب وجود صيغة عادلة للتعايش والتعاون تتحقق بها المشاركة في المنافع والمكاسب، والوحدة أمام الأخطار والتحديات، وقد تختلف الإنتماءات الدينية والعرقية والسياسية للمواطنين، لكن الوطن يجب أن يبقى إطاراً جامعاً لكل أبنائه بمختلف إنتماءاتهم، وذلك يستدعي منهم الإعتراف المتبادل بين الجميع بالشراكة والتساوي في حقوق المواطنة وواجباتها، أما أذا أختلت هذه الشراكة وحدث شئ من الإستئثار بالسلطة أو بالثروات أو التمييز بين أبناء الوطن الواحد، يسبب تنوع التوجهات واختلاف وجهات النظر أو تقاطع البرامج فإن ذلك يهدد وحدة الوطن وأمن المجتمع وإستقراره، كما تدل على ذلك أحداث التاريخ وتجاربه في الماضي والحاضر، فإن أخطر شيء على وحدة الأوطان ومصالحها هو أن تتضخم الإنتماءات على حساب الإنتماء للوطن فتنظر كل جهة للجهات الأخرى عبر دائرة إنتمائها الخاص، وهنا تضيع المصلحة العامة وتضعف وحدة الوطن!
ولمواجهة هذا الخطر لابد من وجود وعي وطني، ومساواة حقيقية بين جميع المواطنين، وتلك لا تتم إلا بوجود دستور يقر لوائح صيغة تعايش مشترك بين أبناء الوطن الواحد، فإذا ما وجدت تلك اللوائح والقوانين فيجب على الجميع العمل بها كقناعات راسخة في نفوس أبناء المجتمع، وأن تكون منهجاً في تفكيرهم وسلوكهم في حياتهم اليومية، ولا يمكن أن تتحقق تلك القوانين عبر طرحها كعنوان وشعار فقط ولا بالحديث عنها في قاعات المؤتمرات والندوات واللقاءات فقط وإنما تتحقق بالسلوك العملي والفعلي على ارض الواقع فيجب أن ننفض عن نفوسنا وعقولنا غبار ثقافة اليأس والإتكالية، وذلك سيبعث ثقافة وحدوية تنطلق من محورية حقوق الإنسان، وتركز على حرمته وكرامته وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات حيث ينظر بالنتيجة كل مواطن الى إخوانه المواطنين بمختلف إنتماءاتهم من منظار الإنسانية ، فيحترم حقوقهم كبشر، ويراعي جميع مبادئ الوطنية وضمان إطارها العام وحتى يعترف كل واحد منا بأخيه ويتعاون معه كشريك مساو له في الحقوق والواجبات.
فعندما يكون الوطن بيت للجميع، فعلى الجميع أن يدرك بأنه مسئول وفقاً لمصالح الوطن وليس على أساس ما تقتضيه حاجته هو شخصياً، فالشعور بالوطن والإحساس به طابع إجتماعي وروحاني يحدد خطوات الإنسان وتوجهاته ونظرته للأمور، غير أن ما قدمه لنا الكثير من السياسيين الذين ورثوا السلطة والحكومة، مازالوا بعيدين عن ذلك المفهوم فهم أمراء بكل شيء بالسياسة والإقتصاد والإجتماع والعلوم الحياتية، ولكنهم غير مسئولين بتاتا ويعملون من أجل أرضاء غرورهم وإشباع حاجاتهم وغرائزهم وأهوائهم الشخصية. وقلما ما كان هناك من عمل بجدية وإخلاص، فالكل بهم بما هو مخجل من فساد وظلم وغير ذلك، وهذا يفسر لماذا هذا التكالب والتسابق على الكرسي، ولماذا تنفق الأموال الطائله في الدعايات الإنتخابية التي تكون إستعراضاً للقوة قبل أن تكون عرضا للقدرات والإمكانات العلمية والعملية التي تستميل المنتخبين وتدفع بهم إلى إنتخاب هذا وليس ذاك.
فمن تولوا الأمور في الأوطان، تجار وسماسرة إستثمروا أموالا في مشاريع سياسيه هدفها الربح المؤجل وليس في خدمة شعب محروم ومظلوم، ولهذا كانت التوافقات توافقات مصالح في أغلبها وليس توافقات في الآراء والأفكار، فقبل أيام قلائل وفي مجلس إجتماعي عربي في احدى العواصم العربية دار حديث وكالمعتاد عن الأوضاع العامة في البلاد وحالة اللاإستقرار وإرتباك المشهد السياسي والأمني وحتى الخدماتي، حتى بادر أحد الحضور وهو رجل كبير في السن له مكانته بين أهلة وربعة ومجتمعة قائلا ( أتعلمون أيها الإخوة عندما حصل التغيير السياسي في البلاد العربية، تفاءلت شعوب تلك البلاد خيرا، بل وراحوا يحلمون بأوضاع وخدمات قل مثيلها في المنطقة لا بل في العالم بأسره ولم يكن ذلك الحلم ناتجا من فراغ وإنما من خيرات مستقرة ونائمة في أراضي الخير والعطاء في تلك البلاد، وما تحتاجه هم إناس خيرون صادقين في النوايا لإستخراج تلك الخيرات وتوزيعها على ابناء شعوبهم المحرومين والمظلومين والمقهورين على أمرهم، من سياسيات تجار الشعارات الرنانة. واليوم وبعد مضي سنوات وسنوات وما قدم من قبل ساساتنا العرب من وعود وعهود في البناء والتقدم والنماء والرفاهية للشعوب، والتي لم يرى شعوبهم منها أي شيء حتى يومنا هذا، حتى بات الضجر والملل واليأس والإحباط هو السمة اليوم لدى شعوبنا العربية، بعد ان كان الصبر والأمل بغد أفضل هي السمة الغالبة لدىهم خلال السنوات الماضية، والسبب هو واقع سياسيهم وقادتهم وتوضح النوايا لديهم وإنكشاف المستور من تلك النوايا .هل تعلمون أن أغلب أبناء شعوبنا العربية اليوم أحلامهم بسيطة ولا تتعدى الحدود المعقولة فمثلا لا تتعدى أحلام رب الأسرة أكثر من بيت أو شقة صغيرة تؤيه مع أسرته من حر الصيف وبرد الشتاء، ووسيلة تنقل يتمكن من خلالها من ترفيه أسرته في أوقات المناسبات السعيدة إن وجدت , وأحلام شبابنا وطلائعنا وشاباتنا اليوم لا تتعدى الحصول على فرصة في بناء مستقبلهم وبناء أسرة جديدة لهم، وغيرها من الأحلام البسيطة التي يحلم بها أبناء الشعب العربي، والتي تبددت بسبب تكشف النوايا لدى متنفذيهم ومختطي ساستهم في عروبتهم الجديدة، ميزانيات تصرف ومليارات تهدر والواقع هو نفسه وفساد مستشري وعصابات إنتشرت وواقع مرير يعيشه وطننا العربي الجديد، فأين أصبحت تلك الأحلام العربية “إنها في مهب الرياح” فهناك وراء الكواليس تعيش الأمراض الفتاكه التي أهلكت شعوب العرب حرثاً ونسلاً وطافت عليه كما يطوف الموت بصرعى حرب ضروس.