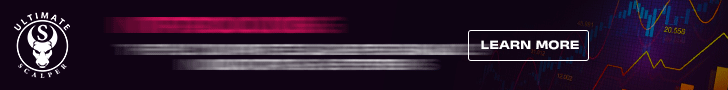بنكيران يكشف أخطاء الإسلاميين ويدعو إلى الإصلاح السياسي

يرى الباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كشف عن رؤى وتحليلات جديدة تهم الحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي، وطرح قناعاته الفكرية والسياسية، مشيرا إلى “أخطاء المنهج السائد بين الإسلاميين، سواء في المغرب أو خارجه، والذي يتسم بالصراع مع السلطة بدلا من العمل على الإصلاح”، ومؤكدا أن “دور الحركات الإسلامية يجب أن يقتصر على الإصلاح لا السعي للسلطة، وهو ما اعتبره البعض طرحا غير مألوف في أدبيات الإسلاميين”.
وسجل الكنبوري، في مقال عبارة عن “دعوة للنقاش”، توصلت به هسبريس بعنوان “عن الملكية وبنكيران والإسلاميين”، أن تصريحات رئيس الحكومة الأسبق تناولت إشكالية العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية وتأثيراتها السلبية المتبادلة”، منتقدا “السقف العالي الذي ترفعه هذه الحركات في مطالبها مقارنة بما تستطيع تحقيقه عند وصولها للحكم”، لافتا إلى أن “المقابلة الحوارية رغم جرأتها أبانت عن قصور الحركة الإسلامية في تحقيق التوازن بين الإصلاح والعمل السياسي، مما جعلها عرضة للانتقادات الداخلية والخارجية، لتبقى هذه النقاشات محورا أساسيا لفهم أدوار الإسلاميين في المشهد السياسي”.
نص المقال:
في مقابلة غير مسبوقة أجرتها معه قناة “الجزيرة” القطرية في برنامج “المقابلة” الذي يجريه الإعلامي علي الظفيري، أوضح عبد الإله بنكيران عددا من القضايا الهامة المرتبطة بالحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي، وكشف عن جملة قناعاته التي شكلت شخصيته كأحد أقطاب العمل السياسي الإسلامي في المغرب والمنطقة المغاربية.
ورغم أن المقابلة ليست مذكرات، ولكن يمكن اعتبارها شذرات متناثرة من مذكرات سياسية وفكرية لبنكيران، الذي لا يزال يخفي الكثير من الحقائق حول تجربة العمل الإسلامي في المغرب الذي هو شاهد عليه وعلى تحولاته وانتقالاته، ونظرا لأهمية ما ورد في المقابلة آثرنا أن نتوقف عند تلك القضايا والأفكار التي باح بها بنكيران إغناء للنقاش حولها، منطلقين من أن الحركة الإسلامية في المغرب تهم جميع المغاربة، بل ربما كانت الوحيدة بين التنظيمات السياسية التي يجب أن يهتم بها المواطنون والمثقفون والمفكرون لارتباطها بالمشترك العام للجميع، على أساس أن الحركة الإسلامية ليست قضية الإسلاميين وحدهم، نظرا للتقاطعات الكثيرة بينها وبين هموم المسلمين على مستوى التصور والعقيدة والعمل.
لقد كشف الأستاذ بنكيران عن رؤية محددة فيما يتعلق بالمنهج السياسي والإيديولوجي لدى الحركة الإسلامية، حيث اعتبر أن المنهج الذي يسير عليه الكثير من الإسلاميين، سواء في المغرب أو في العالم العربي، منهج خاطئ ينبغي أن يخضع لمراجعات، وقال إن هذا المنهج أدى إلى إضعاف الحركة الإسلامية للدولة وإضعاف الدولة للحركة الإسلامية بسبب الصراع الثنائي الذي لا يوجد فيه خط وسط في الغالب الأعم من التجارب، كما بين أن دور الحركة الإسلامية ليس هو الوصول إلى السلطة أو أخذ الحكم، بل الإصلاح، مضيفا أنه لم يجد في القرآن الكريم ما يشير إلى أهمية السلطة للدعوة.
هذه خلاصة كلام الأستاذ بنكيران، الذي اعترف بعظمة لسانه أن هذه القناعات لا يقاسمه الكثيرون إياها، سواء في المغرب أو العالم العربي؛ ويمكن القول هنا بأن هذه المرة الأولى التي يكشف فيها بنكيران عن تلك القناعات من الناحية الفكرية بشكل صريح، وإن كان ما قاله سبق أن ذكره في مناسبات عدة، لكن في تصريحات سياسية، وهو ما جعل الكثيرين يفهمون بأنه رجل مزاجي، لأنهم كانوا ينظرون إلى تلك التصريحات والمواقف بعيدا عن أسسها الفكرية التي ينطلق منها.
مشكلة بنكيران ـ كما أعرفه جيدا عن قرب ـ أنه رجل لا يكتب، وفي قناعتي أنه لو كان يزاوج بين العمل السياسي والكتابة مثل حسن الترابي، على سبيل المثال، لجدد الكثير من المفاهيم والأسس الفكرية لدى الحركات الإسلامية في العالم العربي، فهو رجل ذو بعد نظر، ويؤمن بالواقعية، وليس من الذين يرفعون السقف على الصعيد النظري ثم يسقطون في أول الطريق كما فعل الكثيرون من جيله، ولا يعني هذا أنه على حق في كل شيء، فالرجل له أخطاؤه وهفواته كما لدى غيره، ولكن يحسب له أنه يتصرف وفق قناعات لم يغيرها.
ما قاله الأستاذ بنكيران في تلك المقابلة هو المعضلة التي تعيشها مختلف الحركات الإسلامية في العالم العربي، وقد بينت أحداث الربيع العربي جوانب من تلك المعضلة. فقد انطلقت الحركة الإسلامية في بداياتها الأولى في مصر وبلدان المشرق من الحلول الجذرية التي لا تقبل الوسط، ولم تؤمن بالإصلاح بقدر ما آمنت بالاقتلاع، فكان طبيعيا أن يحصل الصدام بينها وبين الحكام منذ الخطوة الأولى، ومن ثم أسست لمزاج ثقافي خاص التصق بالحركة الإسلامية في كل قطر، وهي أنها حركة جذرية، إما قاتلة أو مقتولة، الأمر الذي فسح الطريق أمام تيارات سياسية وإيديولوجية أخرى لإجراء مصالحات مع الدولة على حسابها، فأصبحت هي العدو المشترك للجميع؛ ولن نقول شيئا مثيرا إذا قلنا إن الدولة في العالم العربي كسبت الكثير من التيارات والولاءات بسبب الحركات الإسلامية، بل لا نقول جديدا إذا قلنا إن العديد من التيارات الإيديولوجية في العالم العربي قدمت تنازلات للدولة بسبب الحركات الإسلامية أيضا؛ وقد يبدو أمرا غريبا أن تصبح حركات لديها قواسم مشتركة مع الشعب والدولة في العالم العربي منبوذة، فيما غيرها يجنون ثمار القرب من الحكام.
هذا التقييم ليس صحيحا في مجمله، إذ لا ينبغي أن نزيح دور الغرب في دفع الحركات الإسلامية إلى الصدام مع السلطة، وهو أسلوب ممنهج لإضعاف الطرفين معا، فلا هو يريد أن تكون الدولة قوية ذات شرعية عليا، ولا هو يريد حركات إسلامية متصالحة مع الدولة، وإنما هو يشتغل بسياسة التفكيك لأن قوته في ضعف مختلف الأطراف، وهذا موضوع آخر ليس من أهداف مقالنا الذي نريد منه الاختصار.
إن أسلوب العمل السياسي الذي ارتضته الحركة الإسلامية منذ ظهورها هو نفس أسلوب اليسار في العالم العربي، فقد كان اليسار يريد إسقاط الدولة لبناء مشروعه الاشتراكي، وإزاحة سلطة الحكام لإحلال سلطة البروليتاريا محلها، وبناء المجتمع اللاطبقي؛ واستنسخت الحركات الإسلامية هذا التصور الإيديولوجي وألبسته اللبوس الديني، فبدل المشروع الاشتراكي أرادت بناء المشروع الإسلامي، وبدل سلطة البروليتاريا أرادت إحلال سلطة “المؤمنين”، وبدل المجتمع اللاطبقي أرادت مجتمع العدل المطلق. أما على المستوى الوسائل فقد توسلت الحركات الإسلامية نفس وسائل اليسار، أي الثورة من أسفل والمراهنة على الجماهير لقلب أنظمة الحكم، وكما كانت لليسار خلاياه السرية كانت للإسلاميين خلاياهم، وكما لجأ اليسار إلى العمل المسلح لجأ إليه الإسلاميون، وكما أراد اليسار الحزب الوحيد، حزب الطبقة العاملة، أرادت الحركة الإسلامية حزب المؤمنين.
بهذا المنهج عزلت الحركات الإسلامية نفسها عن محيطها التاريخي الذي سارت عليه سنن التغيير في الإسلام، كما عزلت نفسها عن منهج العلماء المسلمين في الإصلاح والتغيير. فقد علمنا التاريخ الإسلامي أن العلماءـ الذين كان كل منهم “حركة إسلامية” بمفرده أو مع تلامذته ـ كانوا ينبذون السلطة، والشاهد على ذلك كثرة الأدبيات التي تنفر من الاقتراب من أبواب السلاطين، لكن مع أخذهم بالنصيحة للحكام، فلم يكن شعارهم “الإسلام هو الحل”، بل “الدين النصيحة”.
والنصيحة ليست أمرا سهلا كما قد يتبادر إلى الأذهان، والدليل أن آلاف العلماء في تاريخ الإسلام دفعوا أرواحهم بسبب النصيحة للحاكم، بل ربما نقول اليوم إنها أبلغ من الحركة الاحتجاجية في الدولة الحديثة لأن النصيحة تصل مباشرة إلى الحاكم، بينما الحركة الاحتجاجية قد تأخذ ساعة أو ساعتين ثم ينتهي الأمر ولا يصل خبرها إلى الحاكم ولا ينتفع بها؛ ولنأخذ حالة عبد السلام ياسين، فقد نظمت جماعته المئات من الاحتجاجات طيلة عقود، لكن رسالته إلى الحسن الثاني رحمه الله، التي ضمنها نصيحته المسماة “الإسلام أو الطوفان” كان لها تأثير رسمي وشعبي وانتشرت أخبارها في العالم.
لقد غيرت الحركة الإسلامية منذ ظهورها في بدايات القرن الماضي المعادلة التي كانت قائمة تاريخيا في العالم الإسلامي، إذ قطعت مع أساليب العمل التي كانت تنهجها مؤسسة العلماء، وربطت نفسها بأسلوب العمل العلماني واليساري الجديد، فهي مثلا تهتم بالشعبية على حساب الحق في بعض الأحيان، وبرفع سقف الاحتجاج على حساب الإصلاح الهادئ في أحيان أخرى، وتضع جميع رهاناتها على الشارع، وتؤمن بالتجييش الجماهيري على حساب الإقناع؛ وكل هذه الأساليب انتهت بالحركات الإسلامية إلى فتح أبوابها أمام الانتهازيين وغير المتخلقين بأخلاق الدين وطلاب المناصب، وهو أمر طبيعي طالما أنها تحولت إلى تنظيم ينشد الجماهيرية ويسعى إلى كسب تأييد الشارع، وقد حصل أن فتحت الحركات الإسلامية أبوابها أمام بعض هؤلاء الذين وظفوها، بدل أن توظفهم، لأهداف انتخابية، وحققوا أغراضهم بها، ثم غادروها غير آسفين، أو بقوا غير مكترثين. فالحركة الإسلامية ليست حركة علماء بالمعنى الشرعي للكلمة، وإنما حركة “مناضلين”، وبهذا المعنى فإن فلسفة الإصلاح لديها تختلف عن فلسفة العلماء ومنهجهم، فالتبرير السياسي لديها مقدم على التأصيل الشرعي، وهذا ما يفسر بأن جل المهتمين بنظرية مقاصد الشريعة من الحركات الإسلامية اليوم، بعد أن تمت علمنتها تقريبا وصارت قريبة من نظرية “الغاية تبرر الوسيلة”، وخرجت عن الأصول التي أصلها فقهاؤها.
والحقيقة أن الحركات الإسلامية في العالم العربي فشلت في التصالح مع العلماء أنفسهم قبل المصالحة مع الدولة، وهذا الفشل هو ما جعل الدولة توظف العلماء للنيل من الحركات الإسلامية، على الرغم من القرب المفترض بين هذه الحركات والعلماء على مستوى العقيدة والمبادئ والأهداف، ولا يزال العلماء قادرين على إقناع الناس على الرغم مما تعرضوا له من تهميش تاريخي طويل، وما زالت كلمتهم مسموعة، ولم تنجح الحركة الإسلامية في تشكيل نظرة الناس إليها وموازنتها مع نظرتهم إلى العلماء.
إن منهج الإسلام في الإصلاح هو ترميم ما أفسده الزمان، أي التكميل والإتمام، ولم يبتعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النظرية عندما قال: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، كما لم يبتعد عنها علماء الأصول عندما قالوا إن جلب المنفعة خير من دفع المفسدة، أو العكس، حسب سياق الظروف، أي أن هدف الإصلاح هو تحصيل مكاسب للمسلمين، مهما كانت صغيرة، وليس من فلسفة الإسلام أن يظل المسلم أربعين أو خمسين عاما ينتظر سقوط الدولة ليقوم مقامها حتى ينفذ الإصلاح لأن الإسلام ليس مع تعطيل مصالح الناس وتجميد الإصلاح إلى أن تتوفر الشروط التي يريدها المسلم الفرد أو التنظيم، ووفق هذه القاعدة فإن بناء أربعة مستشفيات في مناطق تحتاجها أكثر نفعا من مناكفة السلطة عشرين عاما، بعد أن يكون المسلمون في تلك المناطق قد ضاعت مصالحهم.
بيد أن القضية لو تأملناها جيدا ليست قضية إصلاح لأن المنهج الذي تنطلق منه جل الحركات الإسلامية في العالم العربي ليس منهجا إصلاحيا وفق القواعد الشرعية، بل هو منهج للتغيير الجذري المضاد لمفهوم الإصلاح بالمعنى القرآني والنبوي؛ والمشكلة هي أن هؤلاء الإسلاميين يقولون إنهم تخلوا عن النزعة الانقلابية، وهم يعتبرون أن هذه النزعة تعني قلب نظام الحكم، إلا أن ذلك المنهج المشار إليه هو نفسه المنهج الانقلابي لكن بأسلوب سياسي، أي عدم الدخول إلى السياسة إلا بعد مسح الطاولة.
غير أن الأنكى من هذا كله هو أن الحركات الإسلامية التي تنطلق من هذا المنهج في التغيير ترفع سقف الأهداف والمطالب، ثم سرعان ما تقلص تلك الأهداف عندما تصل إلى الحكم، فهي تعمل بمعادلة ثنائية هي المزاوجة بين السقف الانتخابي والمستوى التنفيذي، مثلها مثل سائر التنظيمات التي تعتبرها علمانية تفصل بين الدين والسياسة، وبالتالي تسقط في نفس ما تذمه على الآخرين، وهو إقصاء البعد الأخلاقي في العمل السياسي، أي عدم الالتزام بالوعود، وكم من حركة إسلامية شغلت الناس بالتنظير أزمنة طويلة وعندما وصلت إلى الحكم شغلتهم بالتبرير.
لكن الحركة الإسلامية، التي تعتبر نفسها منطلقة من مبادئ الدين، ليست تنظيما كسائر التنظيمات، بل هي حركة لديها مسؤولية شرعية تجاه الناس، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وليست تنظيما سياسيا ككل تنظيم هدفه إعلاء كلمته والانتصار لنفسه ورفع شعبيته والتغني بعدد الأتباع، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وقد قال عمر رضي الله عنه: “والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها”، فكيف بحركة تنسب نفسها إلى الإسلام في مجتمعات متخلفة غارقة في الفساد ترى ملايين المواطنين ضائعة الحقوق كل يوم؟ فهذه كمن لا ينجد غريقا أمامه بدعوى أنه ليس من فريق الإغاثة.
لقد وضع الأستاذ بنكيران أصبعه على واحد من الجروح الكبرى في الحركة الإسلامية، وما قاله تشهد عليه تجربة اليسار المغربي، على سبيل المثال، وتشهد عليه تجارب اليسار والقوميين والاشتراكيين في العالم العربي، فقد ظل هؤلاء سنوات طويلة يرفعون شعارات براقة سرعان ما تحولت إلى هشيم. وقد ضيع اليسار في المغرب عقودا من عمر المواطنين في مدافعة السلطة تحت شعارات خلابة، فكان عقبة أمام ما كان يمكن للدولة أن تنهض به من إصلاحات لو حصلت لاختلف الوضع اليوم عما هو عليه، فلا هو أخذ الدولة ولا هو تركها تعمل، بل إن جزءا منه انتقل إلى الصف الآخر وصار عقبة أمام الإصلاح من داخل الدولة نفسها، وهو ما حصل مع بعض الإسلاميين، وما سيحصل مع بعضهم الآخر، وقد قال الفيلسوف والأديب الألماني يوهان جوته: “النظرية رمادية اللون يا صاح، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد”.
المصدر: هسبريس