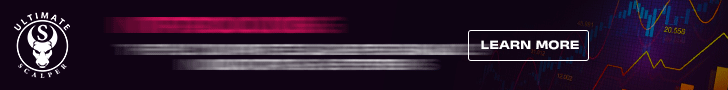على هامش جنونهم المتدحرج أما آن الأوان للعرب والمسلمين أن ينهضوا للدفاع عن وجودهم.. في المحل الأوّل..؟!
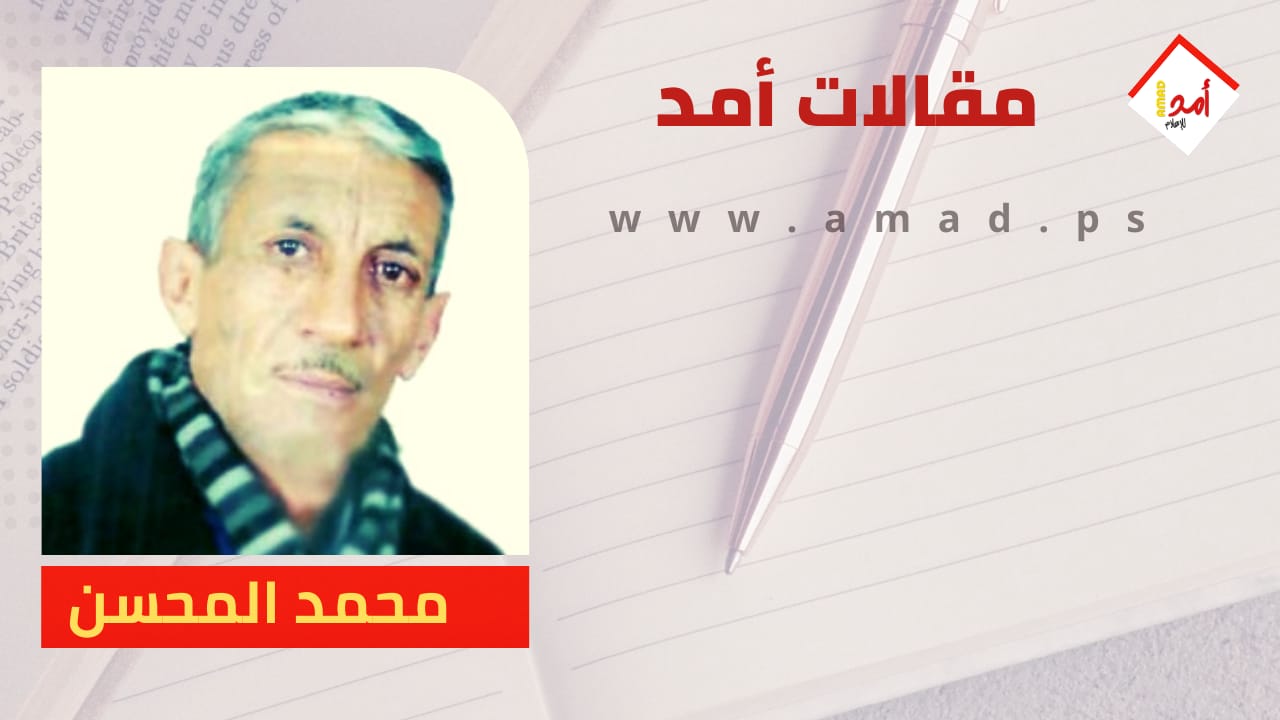
أمد/ “نحن أمّة لو جهنّم صُبّتَ على رأسها..واقفة “(مظفر النواب)
حين نشر صموئيل هنتنغتون مقالته الذائعة الصيت، التي أثارت اهتماما واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم عامة والوطن العربي خاصة، «صدام الحضارات» في عدد صيف 1993 من مجلة «الشؤون الخارجية» وطوّرها في ما بعد إلى كتاب أصدره عام 1996، يحمل العنوان نفسه، ليرسم فيهما ملامح مرحلة جديدة في السياسة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، ويعلن فرضيته بأن المصدر الرئيسي للصراع في هذه المرحلة لن يكون آيديولوجيا في المحل الأوّل ولن يكون اقتصاديا، بل أنّ المصدر الرئيسي للصراع بين البشر سيكون ثقافيا وستكون الصراعات الأساسية في السياسات العالمية صراعات بين الأمم والمجموعات الحضارية المختلفة، لا بين دولة ودولة، فصدام الحضارات، على حد قوله، هو الذي سيسود المشهد السياسي العالمي.. وحين أكّد بصورة خاصة أنّ الصراع الحضاري الأساسي في العالم سيكون بين الإسلام والغرب، لم يكن ينطلق من فراغ ولم يأت بجديد مخترع، بل كان تلميذا وفيا لتراث من الفكر الإستشراقي وكان قوله هذا تصريحا جليا لما أضمرته الدراسات الإستشراقية أحيانا، وما كشفته أحيانا أخرى من مواقف استعلائية وعدائية تجاه العرب والإسلام.
ويعتمد هنتنغتون أساسا في تناوله مسألة الصراع والصدام بين الإسلام والغرب على مقالة المؤرخ المستشرق برنارد لويس المعروف بعدائه للعرب والمسلمين ودعم «اسرائيل»، صادرة عام 1990 بعنوان «جذور الغضب الإسلامي».
بدّأت صورة العرب والإسلام تتشكّل في العصر الحديث في الغرب، من خلال عمل المستشرقين، الذي استهلّ من أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا مع بداية الحملات الاستعمارية الأوروبية على الشرق ومازال مستمرا حتى اليوم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي انتقل إليها ولو بصيغ مختلفة بعد الحرب الكونية الثانية، والاستشراق، كما وصفه الراحل إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق»(1978) ، أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعادة صياغته وممارسة السلطة عليه، وقد أظهر سعيد في هذا العمل المبدع كيف تمثّلت في دراسات المستشرقين آفات الاستعلاء والعنصرية والإمبريالية، وبيّن العلاقات بين المعرفة والقوّة والسيطرة، للبرهان على عدم إمكانية فصل السياسي والاقتصادي عن الثقافي، فعدد كبير من الباحثين المستشرقين كانت لهم مناصب سياسية في دولهم في زمن الاستعمار الغربي للشرق، أو في المستعمرات البريطانية والفرنسية بالأخص، ولطاما كان ومازال لرؤاهم وأبحاثهم الأثر الكبير في تشكيل السياسات الخارجية للدول الغربية تجاه الدول العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، فضلا عن أنّ الصورة السلبية التي رسمها المستشرقون للعرب والإسلام مازالت شديدة الرسوخ في الذهن الشعبي الغربي، لأنها استندت إلى جذور دينية عميقة في الوجدان الغربي، إذ صوروا الإسلام على أنّه المنافس للمسيحية. وكشف سعيد أنّ ادعاءات المنهجية والرّوح العلمية في دراسات المستشرقين ليست في حقيقة الأمر سوى مواقف ايديولوجية معادية للعرب والإسلام ووصفها في حديثه عن برنارد لويس تحديدا بأنّها أقرب ما تكون إلى الدعاية ضد مادة موضوع بحثه وسمى ذلك آخر فضائح «البحث العلمي وأكثرها في الغرب منأى عن التعرّض للنقد».
وإذا أخذنا في الاعتبار عدد الكتب التي تتناول الشرق الأدنى التي وضعت بين 1800 و1950 تقدّر بستين ألف كتاب، كما يذكر إدوارد سعيد، أنّ الكم الهائل من الكتب مازال يكتب حتى اليوم بالرّوح العدائية نفسها بل أكثر بكثير منذ إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين وتأجّج الصّراع العربي الإسرائيلي، بسبب ما قامت به اسرائيل وجماعات الضغط الصهيونية، وما يقومون به من عمل في الساحات الثقافية والإعلامية الغربية لتزوير التاريخ وتشويه صورة العرب، بالاعتماد خاصة على تراث المستشرقين وعلى الصورة المشوّهة التي نجح الاستشراق في رسمها للعرب والإسلام والحضارة العربية والإسلامية في الذهن الغربي، وأنّ تلك الصورة المشوّهة هي السائدة حتى اليوم في الكتب المدرسية الغربية والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والدور الذي لعبته وتلعبه الصحافة الغربية الواقعة عموما تحت السيطرة الصهيونية في تناولها قضية هذا الصراع وغيرها من القضايا العربية والإقليمية، وأنّ وسائل الثقافة والاتصال الحديثة في الغرب تثبت الصورة النمطية والاختزالية والسلبية التي رسمها الاستشراق للعرب والإسلام في السينما والتلفزيون والوسائل الإلكترونية الإعلامية، وفي السنوات الأخيرة في شبكات الاتصال المعلوماتية، وإذا أضفنا إلى ذلك الغياب التام لسياسة ثقافية إعلامية عربية موجهة إلى الغرب، لإعادة تشكيل صورة حقيقية مشرفة للعرب والإسلام، والرد على حملات التشويه المخططة والمنظمة الموجهة إلى العرب والمسلمين وإلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والغياب التام للحضور الإعلامي الثقافي العربي المنظم في الساحات الثقافية والإعلامية الغربية، لأدركنا أبعاد المأزق الذي حُشر فيه العرب في العصر الحديث والوضع التاريخي الخطير الذي يواجهونه أو الذي لابد أن يعوا أنهم يواجهونه.
هذا الوضع الخطير والدقيق لا يمس العرب في صورتهم، ثقافة وحضارة فحسب، بل يصل إلى وجودهم ذاته، ولئن برز الخطر المحدق بهم بعد أحداث سبتمبر 2001 في امريكا بصورة أكثر جلاء وعنفا، فإنه ليس جديدا فالصورة المشوهة المغلوطة التي نجحت «إسرائيل « وجماعات الضغط الصهيوني في الغرب في رسمها للفلسطينيين والعرب وقدرتهم على تشويه الحقائق وتزوير التاريخ وتصوير ذاتها الضحية والفلسطينيين بالمعتدين، وفي ضوء فراغ شبه تام في الساحة الثقافية والإعلامية الغربية من وجود عربي مضاد، مخطط ومنظم وفاعل وقادر على رسم الصورة الحقيقية المشرقة للعرب وللثقافة العربية والإسلامية، التي مازالت إسرائيل تنفرد في رسمها، تسمح اليوم لها أن تستمر في احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، وأن تواصل عدوانها على الفلسطينيين بقتل الأبرياء وهدم البيوت واقتلاع الأشجار، وأن تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية بدون أن يحرّك العالم ساكنا. كما أنّ الصورة المغروسة في الخيال الغربي والثقافة الغربية للعرب مستقاة من التراث الاستشراقي، وما نبع منه من دعاية موجهة ضد العرب، تسمح لأمريكا وحلفائها الغربيين، خصوصا بريطانيا باحتلال العراق وقتل أبناء الشعب العراقي، بدون أن يشعر الضمير الغربي بأي تأنيب
أردت القول بأنّ الاعتداءات على نيويورك وما تبعها مباشرة من اتهام العرب والإسلام بالإرهاب والعنف والوحشية، أعادت بقوة إلى التداول مقولة هنتنغتون في الصدام بين الحضارات والصراع الثقافي بين الإسلام والغرب. وكُتبت بعد تلك الاعتداءات مقالات عديدة في الصحف الغربية تثني على «نبوءة» هنتنغتون ورؤيته المبكرة لذلك الصراع، الذي أصبح في الذهن الغربي الرسمي صاحب القرار والشعبي على حد سواء، المشبع بالصورة السلبية للعرب، بمثابة الحقيقة التي لا تقبل الجدل، واعتبرت أحداث مانهاتن دليلا قاطعا على صدق تلك «النبوءة» وبرهانا على صحة نظرية هنتنغتون. من هنا لم يكن صعبا على الرئيس الأمريكي الأسبق بوش ومع الحليف الأكبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أن يلقيا الاستجابة الشعبية الكاسحة من الشعب الأمريكي بالأخص ومن الشعوب الغربية عامة، وهو يوجّه الاتهام مباشرة إلى العدو التقليدي للغرب، العرب والإسلام، ويتحدّث عن حملة شاملة طويلة لابد أن يخوضها الغرب ضد العدو التاريخي مستخدما مصطلحcrusade الذي يثير أوّل ما يثير في الذهن العربي معنى الحروب الصليبية، وأن يختصر تلك القضية البالغة التعقيد والتشعب التي يواجهها العالم اليوم إلى ثنائية بسيطة واختزالية ساذجة تتمثل في «صراع الخير والشر» الأسود والأبيض «نحن وهم»، ويقسّم العالم قسرا إلى جبهتين: العالم الغربي المتحضّر والإرهاب العربي الإسلامي المتخلّف والمتوحش، ويدعو دول العالم إلى الاختيار، معنا أو مع الإرهاب، السلامة أو الانسحاق، مفترضا بالطبع بصيغة الفكر الأسطوري الساذج غلبة عنصر الخير واندحار الشر، وكأنّ المنطق الغربي الحديث القائم على الرّوح العلمية والعقلانية والذرائعية يتوقّف، بل ينقلب عندما يصل الأمر إلى العرب والإسلام. وللسبب نفسه لا يجد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني حرجا في الانتقال بالموضوع من دلالته السياسية الجلية إلى أبعاد ثقافية وحضارية لم تعد خفية، ليتحدّث عن تفوّق الغرب وتخلّف الحضارة الإسلامية و»عدم قدرة الإسلام على أن يكون جزءا من الحداثة».
واليوم.. وبعد أن قرّر الغرب على المستوى السياسي والعسكري الأعلى وعلى لسان الدولة العظمى الأوحد في العالم الساعية إلى سحق كل من لا تستطيع استقطابه معتبرة إيّاه العدو الرئيسي، عدو الإنسانية والحضارة والتقدّم،وفي ضوء الاتهامات الموجهة إلى العرب والإسلام.. وفي ضوء التشويه المتزايد الذي تتعرّض له صورة العرب وصورة الإسلام وكذا صورة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في الغرب..وفي ضوء أيضا الإبادة الدموية والجرائم النكراء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد مجرمي الحرب في تل أبيب..أما آن الأوان للعرب والمسلمين أن ينهضوا للدفاع عن وجودهم في المحل الأوّل وأن يسعوا إلى أن يثبتوا للعالم أنهم أمّة مازال فيها نبض الحياة وأن الجرح مازال يؤلمها، وإلى رد الاعتبار إلى الثقافة العربية والحضارة العربية الإسلامية وتصحيح الصورة المشوهة المغلوطة التي رسمها للعرب والمسلمين تراث من الفكر الغربي الإمبريالي الساعي إلى الهيمنة والدراسات المغرضة طوال ما يزيد عن قرنين من العمل الاستشراقي المعادي، وما ولّده ونتج عنه في الساحة الثقافية والإعلامية العربية؟!