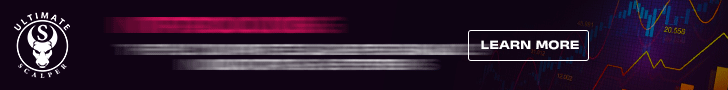قصة نكبة “آل الجامعي” على يد الحاجب با حماد في عهد السلطان عبد العزيز

يتعلق الأمر بكل من الصدر الأعظم المعطي الجامعي وأخيه العلاف أو وزير الحرب محمد الصغير في عهد السلطان الحسن الأول. وكتاب الإنجليزي والتر هاريس هو المصدر الفريد في رواية أحداث نكبتهما. وقبل سردها، فمن هو التر هاريس؟ وكيف عرف القصة؟
والتر بورتون هاريس (Walter Burton Harris) صحافي وكاتب ورحالة. اشتهر بكتاباته عن المغرب حيث عمل لسنوات عديدة مراسلا خاصا لصحيفة “تايمز” اللندنية. وما كان يُخفي أنه كان يخدم مصالح بلاده من باب التطوع.
انتقل إلى المغرب في سن التاسعة عشرة. وبنى لنفسه ڤيلا جميلة في طنجة حيث عاش معظم حياته. عرف بإتقانه اللهجة المغربية وبكثرة اختلاطه بالمغاربة، حتى صار يظهر كأنه واحد منهم. فكان يستطيع التجوال بينهم بأمان حتى في المناطق التي كانت تعتبر محظورة على الأجانب. واشتهر بكتابه عن المغرب المنشور باللغة الإنجليزية تحت عنوان “المغرب كما كان” (Morocco that was). ومما جاء فيه قصة الوزيرين المنكوبين كما سمعها من أحدهما، وهو محمد الصغير، الذي كان يراه ويتحدث معه بشكل شبه يومي منذ أن خرج من السجن واستقر بطنجة.
فقال إن والدة مولاي عبد العزيز كانت من أصل تركي. وكانت امرأة تتمتع بذكاء وقوة شخصية كبيرين. وقد لعبت دورًا في سياسة البلاد لما كان زوجها يستشيرها في بعض شؤون الدولة. وحافظت على نفوذها حتى يوم وفاته. وتلك مهمة غير سهلة وسط حشد من المنافسين. وبذلك ضمنت خلافة ابنها. وقد روى ﯕابرييل أنطوان ڤير، المصور الفرنسي بدار المخزن، الدور الحاسم الذي لعبه الحاجب با حماد في تنصيب ابنها عبد العزيز سلطانا من بعد أن أمر حلفاءه بمكناس بالقبض على غريمه وأخيه الأمير محمد وسجنه. محمد الذي كان مفضل خصومه من عليّة القوم بالعاصمة فاس.
ثم قال والتر هاريس إنه قد كان من الطبيعي أن تثير خلافة الشاب القاصر جميع أشكال المكائد في البلاط. فقد كان هناك فصيلان رئيسيان في القصر، هما حزب الحاجب با أحماد الحاكم القوي من جهة، وحزب كل من المعطي الجامعي، الصدر الأعظم، وأخيه محمد الصغير الجامعي، وزير الحرب، من جهة أخرى. الأمر الذي خلق المنافسة على النفوذ بين هذين الفصيلين في مطلع العهد الجديد.
كان الوزيران ينتميان إلى أسرة آل الجامعي الأرستقراطية من فاس، التي شغلت مناصب حكومية رفيعة. فكانا مدعومين من السكان ذوي النفوذ في المدن. وكان لهما الحق في المطالبة بالحفاظ على المناصب السامية بدار المخزن في العهد الجديد. أما با حماد فقد كان ابن عبد زنجي، وبالتالي لم يكن بإمكانه الاعتماد على أي تأثير قبلي أو عائلي. لكن والتر هاريس أغفل هنا ذكر حلفائه من جنسه الأقوياء من بقايا جيش بخارى الذين ظلوا نافذين في العاصمة الإسماعلية مكناس بقدر ما ظلوا خصوما لأهل فاس.
با حماد، بصفته حاجب القصر، منحه منصبه امتياز التواصل المباشر والمستمر مع السلطان الجديد الذي كان له الفضل في تنصيبه. وبسبب صغر سنه كان عبد العزيز على اتصال قليل بوزرائه. ولا شك في أن با حماد كان يعتمد أيضًا على نفوذ حليفته والدة السلطان. لقد كان أمين سر زوجها الدائم والموثوق به، وساعد، كما تقدم، في وضع ابنها على العرش. كما أن مصيرها كان يتوقف على بقائه نافذا بدار المخزن.
وبمجرد أن تم تنظيم الحكومة الجديدة بما يكفي للسماح لمولاي عبد العزيز بالسفر، غادر البلاط الملكي مدينة الرباط إلى فاس، العاصمة الحقيقية للبلاد. لأنه ما كان لأي سلطان جديد أن يأمن على عرشه حتى يتم قبوله من قبل رجال الدين والأرستقراطيين الفاسيين ويقيم في مدينتهم. كانت فاس هي مركز الدين والمعرفة وأيضا الدسائس التي كان لها تأثير كبير جدًا على القبائل. فكان من المهم جدًا أن يصل السلطان الشاب إلى فاس في أسرع وقت ممكن.
وقد كان با حماد يعي جيدا قيمة قدره ومقامه في نظر خصومه بفاس. بالنسبة للفاسيين كان الحاجب با حماد رجلا مغرورا. فكان يعلم أن نفوذه سيتضاءل بمجرد وصول السلطان إلى العاصمة. ويمكن لخصومه حينها الاعتماد على دعم سكانها وكبار رجالاتها لإسقاطه والفتك به من دون رحمة.
لكنه بتواطؤ مع حلفائه من جند مكناس وخصوم أهل فاس تعمّد المرور من مكناس والتوقف فيها قبيل الوصول إلى فاس. وعند وصوله استقبله سكان المدينة بترحاب شعبي. ولم يبق هناك سوى هذه المرحلة الأخيرة للوصول إلى العاصمة. فكان على با حماد إثبات وجوده الآن وإلا فلا. بعد أيام قليلة كان لا بد من عقد جلسة البلاط الصباحية المعتادة. ولم تكن هناك علامة على اقتراب العاصفة. ولا شك أن الأخوين أولاد الجامعي كانا ينتظران وصول السلطان بين أبناء شعبهم في فاس لبدء تدبير المكيدة المدبرة ضد خصمهم با حماد. أما هو فقد بدا حينها مهذبًا ووديعًا معهما.
فصعد الحاج المعطي الصدر الأعظم إلى المشور ملتحفا بردائه الأبيض. وكان محاطا بمؤيديه وسط انحناءات المسؤولين وتحية العسكر. فتم استدعاؤه على الفور للمثول أمام السلطان مولاي عبد العزيز الذي كان بمعية الحاجب با حماد من دون غيره. وعندما دخل الحاج المعطي انحنى وانتظر السلطان ليتحدث معه. وبصوت خافت، سأله مولاي عبد العزيز سؤالاً. وكان رد الحاج المعطي غير مرضٍ. فبادر با حماد بإلقاء سلسلة من اللوم على الوزير، واتهمه بالخيانة والجشع والابتزاز والجرائم السياسية. وناشد السلطان فجأة، وطلب منه الإذن بالقبض عليه. فأومأ مولاي عبد العزيز برأسه كإشارة منه بالموافقة.
وهكذا من بعد بضع دقائق، تم جر المخلوق الأشعث، يقول والتر هاريس، وهو يئن ويبكي وسط موجات من الضحك والسخرية عبر ساحة القصر من طرف الحشود التي انحنت قبل قليل إلى الأرض تحية له. فمزقت ثيابه، لأن الجنود كانوا خشنين معه. فظهر بعمامته ملتوية ومائلة فوق رأسه. وبمجرد إخراجه من القصر، أمسك الحارس عند الباب بعمامته البيضاء النظيفة ووضعها على رأسه ووضع على رأس المحبوس قبعة الخدمة الخاصة به. موجة من الضحك استقبلت هذا الفعل. ولم يكن شقيق هذا الوزير سي محمد الصغير، وزير الحرب، قد غادر منزله بعدُ إلى القصر حتى تم القبض عليه بباب منزله، فاستسلم من دون مقاومة وتم اقتياده إلى السجن. وقد كانت بقية قصة هذين الرجلين هي الأحلك في حياتهما.
تم إرسالهما إلى تطوان في السلاسل. وحُبسا هناك في زنزانة ببرج. مات فيها الحاج المعطي من بعد عشر سنوات. وخشي حينها والي تطوان دفن الجثمان خوفا من اتهامه بإطلاق سراح سجينه. فكتب إلى البلاط للحصول على التعليمات. وكان الجوّ صيفا فكانت الزنزانة بالبرج ساخنة. وجاء الجواب من بعد أحد عشر يومًا، ظل خلالها محمد الصغير مقيدًا بالسلاسل إلى جثة أخيه المتفسخة.
وفي عام 1908 تم إطلاق سراحه من بعد أن قضى أربعة عشر عامًا في السجن. خرج منه رجلا يائسا ومحطما ومدمّرا. خرج من زنزانته المظلمة شبه أعمى وأعرج بسبب القيد القاسي بالسلاسل. وقيل إنه كان قاسياً أيام كان في السلطة. فيا له من ثمن باهظ ذلك الذي دفعه. فقد تمت مصادرة كل ما كان يمتلك. وماتت زوجاته وأولاده نتيجة الفاقة والاضطهاد.
استقر في طنجة حيث كُنت أراه بشكل شبه يومي، يقول والتر هاريس. كان يعيش في فقر مدقع، سوى أن جميع أصدقائه ساعدوه بالرغم من أنه لم يكن يريد سوى القليل. أمَةٌ عجوز من العائلة، نجت في زاوية منعزلة، جاءت لعلاجه وتدليك معصميه وكاحليه. وأخيرا مات. وقبل يومين من وفاته رأيته للمرة الأخيرة. كان من الواضح حينها أنه ما بقي له من نصيب في الحياة سوى مدة قليلة. جلست معه مطوّلا. وعندما نهضت لأتركه، قال: “اسمع! عندما يغسّلون جسدي للدفن، أريدك أن ترى يدي ورجلي في القيود والأصفاد التي كانت فيها مدة أربع عشرة سنة من عمري والتي أرغب في الظهور بها أمام الله لكي أسأله عن الظلم الذي طالني، وحتى يفتح لي أبواب الجنة برحمته الواسعة وبعفوه”. وكان بالطبع من المستحيل تلبية طلبه. لكن بأقسى أشكال السخرية، تلقى دفنًا عسكريًا رسميًا، حضرته جميع السلطات والمسؤولين المحليين. فقبل كل شيء قد كان وزيرًا للحرب!
المصدر: هسبريس