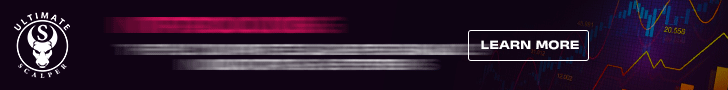الشريعة بين الأخلاق والأحكام والقدرة على استيعاب حوادث الزمان

إن الله أنزل شريعته على خلقه وبعث فيهم رسلا وأنبياء ليبيِّنوا للناس ما نزل إليهم من الحق، وورث الأنبياء في هذا البيان علماء اجتهدوا في الشريعة واستنبطوا منها للناس فقها، واجتهد الناس في تطوير حياتهم، وعملوا لازدهار معاشهم، فأنتجوا واقعا متنوّعا ومختلفا من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصر، والفقيه من يحسن تطبيق الفقه على الواقع فيحكمه بلجام الشريعة، لا من يوجد العداوة بينهما فلا يبقي للتعاون مجال.
وإن عموم الشريعة وديمومتها لسائر البشر في كل الأمصار والأعصار مما أجمع عليه علماء الإسلام، وقد أجمعوا أيضا على أنها مع عمومها صالحة لحياة البشر في كل زمان ومكان. وأن هذه الصلوحية المشار إليها في كلام العلماء تحتمل صورتين:
الأولى: أن هذه الشريعة تتضمن أصولا وكليات ومقاصد تمكّنها من الانطباق على مختلف الأحوال، حيث تساير أحكامها ومكارم أخلاقها جميع الأحوال والأوضاع المختلفة دون حرج ولا مشقة ولا عسر. وشواهد هذه الصورة ما نجده ونلاحظه من اجتهادات العلماء الكثيرة والمتلاحقة تلاحق حوادث الزمان في محامل أدلة كثيرة من أدلة الأحكام على مختلف الأحوال. والثانية: أن تكون أحوال تلك الأمم المتنوعة والمختلفة وعبر العصور المتعاقبة المتباينة قابلة للتشكيل على نحو شريعة الإسلام عقيدة وأحكاما وأخلاقا دون حرج ولا مشقة ولا عسر، وشواهد ذلك في التاريخ ناصعة حيث تمكن الإسلام من تغيير أحوال وأوضاع لأمم عديدة دخلت فيه من العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجدوا حرجا ولا مشقة ولا عسرا في الإقلاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة، ومن دون أن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما اعتادوه وتعارفوه من العوائد المقبولة. وهاتان الصورتان قد جمعهما معًا مغزى قوله تعالى: {وما جعل عليكم فيِ الدين من حرج} الحج:78.
وبناء عليه، فإن معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان أن تكون أحكامها كليات ومعان، مشتملة على مصالح ومقاصد صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد. ولذلك، كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد كما قال الله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} النساء:16، ولم يذكر ضربًا ولا رجمًا كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه “مقاصد الشريعة”، ويستثنى من هذه الكليات ما اقتضى تفصيلا لازما لأمرين: الأول: لعدم تأثير تغير الزمان والمكان في حكمه التفصيلي، والثاني: لو أتت به الشريعة كليات وأحالت تفاصيلها لاجتهاد الناس، لوقع فساد عريض، كأحكام الميراث، وتحديد المحرمات من النساء.
ويعزز هذه المنظومة التشريعية منظومة أخلاقية واسعة وشاملة تمتاز عناصرها بالثبات والانضباط والاطراد، حيث لا يختلف ذوو الفطرة السليمة والعقول الراجحة في قبولها والاتفاق عليها، وبناء عليه، كان امتزاج الأحكام بالأخلاق هو المعنى الذي أسرت به الشريعة قلوب الداخلين تحت لوائها من الأمم والشعوب، وأبهرت به كل فقهاء القانون في مختلف الأمم وعبر كل العصور.
وبناء عليه، فإن أصلا الشريعة الأمر والنهي وما يتعلق بهما من أحوال، لا يقوم حكمهما إلا إذا شاركتهما جهة التعاون المبنية على البر والتقوى والإحسان وإقامة للمصالح العامة المطلوبة شرعا، ودفعا للمفاسد المطلوب دفعها شرعا، ولا يبلغ هذا الأمر تمامه إلا إذا امتزجت منظومتا الإحسان والأحكام وشارك في امتثالها وإقامتها جمهور الناس الذين يعيشون في مجتمع واحد وتحت سلطة واحدة من جهة، والشعوب والمِلل التي تربطنا بهم صلة التعارف من جهة أخرى، ومن ثم كان تبادل المصالح والمنافع ووجوه البر وأعمال الخير والمواساة وبذل المعروف وحسن الخلق وإكرام الناس، من الأمور التي يستحب من المسلمين بذلها لجميع الناس والملل.
وبناء عليه، فإن الناظر المدقق في شريعة الإسلام يجد أن عمود الأحكام وعمود الأخلاق فيها منفتلين إلى حد الامتزاج، حيث لا يمكن الفصل بينهما، فالأخلاق ويجمعها البر والإحسان حامية للأحكام من الانخرام، والأحكام حامية للأخلاق من الاختلال والانعدام.
* مدير تحرير مجلة “آفاق الثّقافة والتّراث”