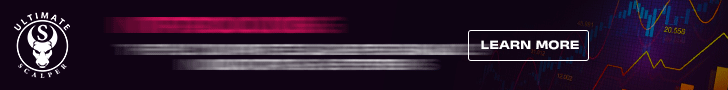دور علماء الجزائر في استقرار إفريقيا
كان لأعلام الجزائر ورجالاتها وأئمتها وسلاطينها وملوكها وتجارها، على مرّ التاريخ، دور بارز في نشر الإسلام بمنطقة غرب إفريقيا، التفوا حول ملوكها وسلاطينها وحبّبوا إليهم الإسلام، وشرحوا لهم أحكامه، إلى جانب المصاهرة لما لها من دور كبير في نشر الإسلام، الأمر الذي جعل الأمراء ورؤساء القبائل يدخلون في الإسلام؛ وتحمّسوا بدورهم لنشر الإسلام بين جيرانهم الوثنيين.
لقد مثّل علماؤنا الجزائر أحسن تمثيل في غرب إفريقيا أو ما يعرف بالسودان الغربي، الممتد من الحدود الشمالية لدولتي النيجر ومالي إلى نقطة التقاء اليابسة بماء المحيط عند سواحل غانا والتوغو وبنين جنوبا، ومن ساحل المحيط الأطلسي عند كاب فرد وغينيا والسينغال غربا حتى الحدود الشرقية لدولة الكامرون المعاصرة ضمن رقعة مكانية قدّرها الجغرافيون بما لا يقل عن سدس المساحة الإجمالية لقارة إفريقيا، وتبلغ مساحتها ستة ملايين كيلومتر مربع تقريبًا. وتضم هذه المنطقة ست عشر دولة وهي: مالي، السنغال، غامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، غانا، بوركينافاسو، توغو، بنين، تشاد، النيجر ونيجيريا. وعُرفَت هذه المنطقة في العهد القديم ببلاد التكرور، ثم اشتُهرت باسم السودان الغربي قبل الاحتلال الأوروبي الذي سمّى كل دولة باسمها المعروف اليوم.
إن العلاقة الدينية بين شمال إفريقيا والسودان الغربي عميقة الجذور تعود إلى وقت مبكر، حينما نفد الإسلام إلى غرب إفريقيا على إثر دخوله إلى شمالها. ويروي العلامة ابن خلدون أن موسى بن نصير ولّى على مدينة طنجة البطل الإسلامي العظيم طارق بن زياد، وأنزل معه عددا من المسلمين العرب والبربر إلى السودان، وذلك منذ الربع الأخير من القرن الأول الهجري.
ويُروى أن رجلا من علماء المسلمين نزل ضيفًا على ملك دولة مالي (منسا نوفن تروري) الوثني، وأقام عنده مدرسة يقرئ فيها القرآن ويعلّم السنة، وظل في ضيافة الملك حتى نجح هذا العالم في تحويله هو ورجال دولته إلى الإسلام، فأخذ يقرئهم القرآن ويعلّمهم السنة.
وجاء إلى السودان الغربي كثير من العلماء الصالحين المصلحين الأخيار من شمال إفريقيا وسكنوا مدينة (بير)، وبعد إنشاء مدينة (تمبكت) تحوّل أكثرهم إليها، ومنهم علامة الجزائر سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي.
ولم يكن شأن ملوك دولة السنغاي الإسلامية (مالي حاليًا) أقلّ ممن سبقوهم، بل حرصوا كل الحرص على توطيد العلاقة الدينية بين دولتهم وبين الشمال الإفريقي، وشجّعوا الثقافة الدينية، فأخذ العلماء والفقهاء يتدفقون على بلاد السودان الغربي من شمال إفريقيا وغيرها، خاصة من الجزائر، فازدهرت الثقافة والعلوم في مدارسهم ومعاهدهم، ونافست مدارس ومعاهد المشرق والمغرب.
ومما زاد هذه العلاقة قوة ومتانة وحدة المذهب الفقهي بين هذه الدول، فكل هذه الدول تتمذهب بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه، والثقافة الدينية التي غلبت على إفريقيا هي التقاليد المالكية التي تدور حول فقه الإمام مالك، والعلوم المساعدة الأخرى التي تخدم هذا الفقه هي نفس الثقافة الدينية في السودان الغربي، فلا يوجد فيه مذهب إلا مذهب مالك ولا فقه إلا فقه الإمام مالك رضي الله عنه.
ويؤكد المؤرخون أن مدارس الثقافة الدينية في بلاد السودان الغربي تكاد تكون مدارس جزائرية بحتة، نفس الكتب؛ ونفس الأسلوب؛ ونفس الوسائل؛ حتى طريقة الكتابة تأثرت بالطابع الجزائري، فالقلم العربي المستخدم في بلاد السودان هو القلم الجزائري.
ومع مجيء الاستعمار الأوروبي، سعى وحاول وقام بطمس حقائق الإسلام وآثاره وحضارته من هذه المناطق الإسلامية، وفصل حاضر القارة عن ماضيها، بل فصل أجزاءها بعضها عن بعض بتقطيع كل أواصر الترابط الإسلامي، وإقامة حواجز وحدود صناعية خطتها أغراض استعمارية.
لكن الجزائريين، أثناء الفترة الاستعمارية، ظلّوا ينقلون البضائع، خاصة الكتب من تونس وطرابلس لبيعها في عواصم السودان الغربي مثل: غانا، مالي، كانو وغيرها من بلاد غرب إفريقيا، كما كانوا يعودون منها إلى بلادهم وإلى جانبهم دعاة ومرشدين ومعلمين وأئمة ينتشرون في دول غرب إفريقيا لنشر الثقافة العربية الإسلامية في سائر تلك الأرجاء، فانطبعت غرب إفريقيا بما في شمالها من العقيدة والمذهب والطريقة والمشرب.
لقد ساهم علماء الجزائر مساهمة فعالة في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في السودان الغربي، وأحدثت تغييرا وتأثيرا ملموسا في حياة المجتمعات هناك، ومن أبرز هؤلاء العلماء نجد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، وهو أول من أنشأ مدارس قرآنية في شمال النيجر، فأنشأ في منطقة أير مدرسة قرآنية للصغار وأخرى لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية للكبار في تيغدا؛ وبقي فيها فترة قبل مواصلة رحلته إلى كتشنا التي أسّس فيها مسجدًا ومدرسة؛ وألقى حلقات علمية فيها في مختلف الفنون، ليلتحق بعدها بكانو مع عشرة أشخاص من تلاميذه، معهم من الكتب عدد غير قليل ومكث فيها طويلا، بنى فيها المدارس العلمية للدراسات الإسلامية والعربية، وقام بتدريس الناس العلوم المختلفة. وتخرّج على الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي علماء أجلاء حملوا لواء العلم من بعده، كالشيخ العاقب الأنصمني الأغدسي والشيخ شمس الدين النجيب بن محمد التيجداوي الأنوسماني والشيخ محمد بن أحمد التراخي.
ولم يقتصر تعليمه على عامة الناس، بل كان أستاذا ومستشارا ومفتيا لحكام المناطق التي زارها كسلطان سنغاي الحاج أسكيا محمد، وحاكم كانو أحمد رمفا. كما تشهد عليه الرسائل الحوارية التي دارت بينه وبينهم. وكان من دقّة فكر هذا الإمام وفقهه للواقع أنه لما مكث ببلاد الهوسا (شمال نيجيريا)، درس أوضاعها دراسة مكّنته من فهم خصائصها واتجاهات أهلها، الأمر الذي أداه إلى إصدار الفتاوى للنّوازل الواقعة في هذه البلاد بما يناسب ما شاهد وتحقّق من أوضاعهم، ومثال ذلك فتواه في التّعامل مع غير المسلمين تنصب على مقتضى الأحوال، حرّم بشدة التعامل مع اليهود في توات، ولكنّه أباح التعامل مع المجوس في مدينة كانو، شريطة أن يمتنعوا من إظهار الشرك، وأكل الحرام وشرب الخمور.