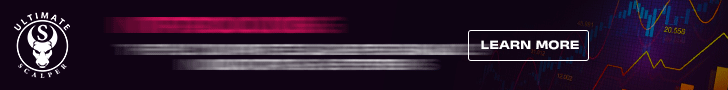تموقع استراتيجي أم استباق براغماتي؟

تناول الوزير السابق ابنو عتيق عبد الكريم مجموعة من القضايا السياسية الدولية المرتبطة بـ”الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا”، و”العلاقات الأمريكية السعودية”، و”الأسباب التي دفعت الرياض في غشت 2021 إلى توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو”، و”الشراكة الموجودة بين الصندوق السيادي السعودي والصندوق الروسي السيادي”.
وتطرق ابنو عتيق، عضو مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، في مقال له، إلى “اتفاق التبادل التجاري الحر بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي”، و”استفادة طهران من المواجهة العسكرية الروسية الأوكرانية”، و”ارتباط الفاعل التركي بحلفائه التقليديين في المعسكر الغربي وانفتاحه على موسكو”.
هذا نص المقال:
هناك شبه اتفاق خليجي على اعتبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا شأنا أوروبيا محضا، هذا الاختيار فسره البعض على أنه نوع من التوازن الاستباقي يؤسس لنظرية عدم التورط، وذلك برفض تقديم أي دعم مباشر لأوكرانيا، مع عدم مساندة روسيا في هجومها على كييف، ثم الإلحاح على إيجاد تسوية سلمية لإيقاف النزاع الحربي، هذه القناعة تنطلق في اعتقادنا من إدراك قادة الخليج أن الخريطة الكونية بعد هذه الحرب ستعرف متغيرات جيواستراتيجية تقتضي حسن القراءة من أجل تموقع استباقي.
في منطقة الخليج، مخطئ من يظن أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية هو نهاية العقيدة التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق كارتر سنة 1980، والتي تؤكد أن واشنطن إذا اضطرت لحماية مصالحها، ستلجأ إلى استعمال القوة العسكرية، أكيد أن هذا الاختيار الثابت في منظومة العلاقات الخارجية لواشنطن تعرض إلى نوع من الانكماش بعدما تنصل الرئيس أوباما من بعض التزاماته تجاه حلفاء واشنطن، استمر مع ترامب، هذا الأخير لم يحرك ساكنا عندما تعرضت المنشآت البترولية السعودية سنة 2019 لهجومات ارهابية، ضف إلى ذلك وجود علاقات عادية، بل باردة أحيانا بين الرئيس الأمريكي بايدن والأمير محمد بن سلمان، هذا الأخير عبر عن ذلك بصراحة في مقال منشور في “ذو أتلنتيك” (The Atlantic)، في مارس 2022، مقدما تنبيها مبطنا لواشنطن قائلا: “أين يوجد الثقل العالمي اليوم، في المملكة العربية السعودية، إذا أردتم تضييعه، فإن آخرين في الشرق مستعدون لاحتضانه بفرح وسرور”. زيارة الأمير بن سلمان في غشت 2022 إلى فرنسا، ترجمت هذه القناعة، تبعتها رسالة مشفرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية في 5 أكتوبر 2022، عندما قررت الرياض، كباقي أغلبية أعضاء منظمة “أوبيب” (OPEP)، خفض إنتاج البترول بـ 2 مليون برميل يوميا، وهو بالمناسبة أكبر تخفيض لم يحدث على الأقل منذ سنتين، رغم تحفظ جزء كبير من الدول الحليفة للسعودية، تم ذلك بالرغم من زيارة بايدن إلى جدة في يوليوز 2022، هذا القرار قرأته بعض الأوساط في واشنطن على أنه ضربة قاسية من طرف حليف استراتيجي لأمريكا، ونوع من الخيارات التي تخدم مصالح روسيا.
هذه الخلافات حسب الجنرال الأمريكي ماكنزي، القائد السابق للقوات الأمريكية بالمنطقة، ليست وليدة اليوم، فالمنافسة الأمريكية الروسية الصينية لا تقتصر على المحيط الهادي، بل حاضرة بقوة في الشرق الأوسط كذلك، متوقفا عند تطور العلاقات السعودية الروسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا إبان حكم أوباما، الذي دعم بشكل غير مباشر الربيع العربي، فتح حوارا مع طهران أدى إلى توقيع اتفاقية حول مشروع تطوير السلاح النووي الإيراني سنة 2015، مما خلق نوعا من الشك والارتباك ضمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. في المقابل، لاحظ الجميع متانة التحالف المباشر والميداني المطلق بين بوتين والرئيس السوري بشار الأسد.
ومعلوم أن هذه الأسباب دفعت الرياض في غشت 2021 إلى توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو، هو مكمل للاتفاق العسكري السابق الذي وقع في فبراير من السنة نفسها، مباشرة بعد سقوط كبول في يد طالبان والانسحاب المفاجئ لأمريكا من أفغانستـان. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل هناك تعاون على المستـوى الاقتصادي من خلال الشراكة الموجودة بين الصـندوق السيادي السعودي (PIF) “le public Investment fund” والصندوق الروسي السيادي (RDIF) “Russian Direct Investment Fund”، التي توجت بتوقيع اتفاقية سنة 2015، الهدف منها استثمار 10 مليارات دولار في روسيا، مما فتح المجال لشركات أخرى، من بينها شركات الأمير الوليد بن طلال التي استثمرت في غشت 2022 مبلغ 500 مليون دولار في مؤسسات بترولية روسية مثل “غاز بروم” (Gazpron) و”ليكوال” (lukoil). موسكو، حسب المتتبعين، ليست البوصلة الوحيدة للأمير محمد بن سلمان لمواجهة التعقيدات الكونية الحالية، بل هناك الصين التي أصبحت في السنوات الأخيرة أول مستثمر في منطقة الخليج، فمنذ سنة 2020، السعودية هي المزود الرئيسي لبكين بالبترول، بل إن الرياض وبذكاء تستفيد من التمويلات الصينية لبعض المشاريع على مستوى البنية التحتية المندرجة في برنامج طريق الحرير، مشاريع مست ميادين عديدة، مثل الطاقة والموانئ والفضاء والصحة، هذا التواجد قد يعرف تطورا مهما في حالة الوصول إلى توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وجدير بالذكر هنا أن السعودية كانت قد اقتنت صواريخ باليستية صينية، كما فتحت المجال “لبكين” للمساهمة في بناء مصنع لإنتاج الدورن في مدينة الملك عبد العزيز العلمية والتكنولوجية. كل هذا جاء مصحوبا بإجراء تمارين عسكرية بحرية مشتركة بين الطرفين. التزود بالصواريخ البالستية الصينية قد يكون، حسب البعض، مجرد مرحلة لاقتناء نوع آخر من الأسلحة لها دور ردعي. أكيد أن تعويض بعض أنواع الصواريخ مثل “D F3A” بأخرى تتميز بالسرعة والفعالية له ما يبرره، لكن اختيارات المملكة العربية السعودية هي الاستمرار في تطوير ترساناتها البالستية، هذا ما عبرت عنه الأمريكية “واشنطن بوست” سنة 2019، التي أشارت إلى رغبة الرياض بامتلاك قاعدة صناعية تخص هذا النوع من الأسلحة. سنتان بعد نشر هذا الخبر، وبالضبط في دجنبر 2021، أكدت الاستخبارات الأمريكية وجود هذه الرغبة لدى صناع القرار في السعودية، وأن ترجمتها على أرض الواقع ستتم بتعاون مع الصين. التوفر على ترسانة من الأسلحة الباليستة قد يكون مقبولا لدى الأمريكيين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هاجس الرياض خلق نوع من التوازن مع إسرائيل وإيران، لكن واشنطن تتخوف من انتقال السعودية إلى مرحلة أخرى في حالة عجز الغرب عن حسم الملف النووي الإيراني، وذلك بالانفتاح على باكستان، التي تملك بالإضافة إلى السلاح النووي، تقدما علميا في هذا المجال.
القيادة السعودية تنظر بعين الرضى لتشبث الصين في سياستها الخارجية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلدان التي تتعامل معها اقتصاديا وتجاريا، بخلاف الدول الغربية، الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل هناك بعض الأخيار الرائجة تلمح إلى رغبة السعودية في الالتحاق بمجموعة “بريكس” (BRICS)، التي تضم كلا من روسيا والهند والصين وإفريقيا الجنوبية، والتي تتحكم مجتمعة في ربع الناتج الداخلي الخام عالميا، و16% من التجارة الدولية.
يجب الاعتراف هنا بأن الحرب الأوكرانية الروسية لم تخدم كثيرا الاختيارات الجديدة للأمير بن سلمان، خاصة على مستوى التعاطي مع الملف الإيراني، إذا استحضرنا استفادة طهران من المواجهة العسكرية الروسية الأوكرانية، مما سمح لها بإيجاد موقع قوي قصد التأثير في الأحداث الجيوإقليمية، التي بدأت بتقارب براغماتي مع الصين، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين البلدين في مارس 2021، ضف إلى هذا أهمية إيران بالنسبة لروسيا، لا سيما بعد تزويدها موسكو بالــدرونات من نوع “شهيد2″، مع التهديد ببيعها صواريخ بالستية، هذا دون إغفال تواجدها في اليمن عن طريق الحوثيين، وفي لبنان بواسطة حزب الله، ودعمها للنظام السوري، مع تمكنها من خيوط اللعبة السياسية في العراق. بعض التخوفات بدأت تطفو على السطح تتمثل في أنه في حالة غياب الجدية في التعامل مع السلاح النووي الإيراني، السعودية، ومعها جزء كبير من دول الخليج، ستكون مجبرة على البحث عن غطاء نووي، مما سيحول الخليج إلى بؤرة للتوتر.
وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد دشنت حوارا غير مباشر مع إيران عن طريق بغداد في أبريل سنة 2021، مع قبولها التحاق ثلاثة ديبلوماسيين إيرانيين بجدة لمزاولة مهامهم داخل مقر منظمة التعاون الإسلامي في يناير 2022، إلا أن هذه اللقاءات توقفت في نونبر الماضي بمبادرة من الرياض، بسبب غياب ضمانات واضحة حول المسألة اليمنية. هذه التحولات بالرغم من أهميتها، لا يمكن أن تحجب عن صناع القرار في السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية لها اهتمام استراتيجي بمنطقة الخليج، بدليل أن جل المراكز الكبرى التي لها تأثير في القرارات الاستراتيجية الرئيسية لواشنطـن، مثل مؤسسة (Cnas) “center for a new American Security”، التي تناولت في 10 نونبر 2022 موضوعا يتعلق بالتفكير في هندسة جديدة لخريطة العلاقات بالمنطقة، مقترحة الشروع في تنسيق دفاعي يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مقرونة بعملية تعاون أمني واسع بين كل الفاعلين الأساسين في منطقة الشرق الأوسط، لكن، وحسب مجموعة من الملاحظين، السعودية حاسمة في أمر الانخراط في أي مبادرة أو تقارب أو تعاون، دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وصول اليمين الإسرائيلي المحافظ إلى الحكم أضعف هذه المقاربة، مما دفع بجزء من أهل الاختصاص في العلاقات الدولية إلى طرح سؤال مركزي حول تحركات ومبادرات المملكة العربية السعودية، هل تدخل ضمن تموقع استراتيجي دائم أم استباق براغماتي؟
فيما يخص تركيا، الجميع يقر بأن الفاعل التركي بتبني منذ مدة سياسة مغايرة لمساره التاريخي، متأرجحة بين الارتباط بحلفائه التقليديين في المعسكر الغربي، وبين انفتاحه على موسكو، انطلاقا من علاقات تحكمها مصالح طاقية، لكنها تطورت في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات حساسة وصلت إلى درجة اقتناء تركيا صواريخ روسية “S.400″، مما خلق نوعا من التحفظ الأمريكي على هذا التوجه الجديد، بل تسبب في حرمان أنقرة من صفقة الطائرة الأمريكية “ف 35″، خاصة وأن وصول الرئيس بايدن إلى الحكم عقد من مهمة القيادة التركية الحالية. هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام ساكن جديد للبيت الأبيض له قراءة واضحة للوضعية الدولية، عبر عن ذلك مند البداية، خلال قمة حلف الناتو ببروكسيل في أواسط شهر يونيو 2021، عندما حدد المعالم الكبرى لخريطة العلاقات الكونية، معتبرا الصين وروسيا تحديا جديدات للغرب.
وبالعودة إلى مسار الأحداث بالمنطقة، تركيا كانت سباقة في 24 فبراير 2022 إلى إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، معتبرة ذلك بمثابة خرق واضح للقانون الدولي، لكنها رفضت تطبيق العقوبات الغربية على موسكو. لفهم هذا الموقف، ضروري أولا استحضار العلاقة الخاصة التي كانت تجمع تركيا بأوكرانيا؛ فالاثنان كان لهما وعي بضرورة خلق نوع من التوازن الجيوإقليمي مع الفاعل الرئيسي في المنطقة، ونقصد هنا موسكو. علاقة الطرفين قبل الحرب كانت شاملة، اقتصادية وعسكرية، بحيث وصلت سنة 2021 إلى 7.4 مليارات دولار، تقوت ابتداء من سنة 2015، مستفيدة من بعض الخلافات الروسية التركية، وصلت إلى القمة سنة 2018، بعد التوقيع على اتفاق مهم خلق حساسية استراتيجية لدى موسكو، ونقصد هنا بيع أنقرة طائرات الدرون “TB2” لأوكرانيا. علاقة الطرفين انتقلت بعد ذلك إلى تعاون صناعي عسكري مؤطر بأكثر من أربعين اتفاقية، أهمها التعاون بين الشركة التركية “بيكار مكينا”، والشركة الأوكرانية “ايكرس اكسبور”، الذي سمح لكييف بالحصول على درونات تركية. في المقابل، استفادت أنقرة من المحركات الأوكرانية التي تستعملها لتجهيز طائرات الدرون، وبعض الدبابات.
الملاحظ هو أن هذا الوضع تغير بعد اندلاع الحرب في القارة الأوروبية، بحيث أصبحت تركيا تميل إلى نوع من المواقف، ظاهرها الوساطة وباطنها التموقع والتأثير في التعقيدات الواقعة في المنطقة، مع التواجد ضمن مجموعة الدول التي رفضت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والبقاء على مسافة مع مواقف الدول الغربية الداعمة لكييف.
وبإطلالة سريعة ثانيا على العلاقات التركية الروسية، يمكننا استيعاب أكثر هذا الاختيار، فالمصالح المشتركة بين الطرفين بدأت قبل نهاية الحرب الباردة، قاعدتها الصلبة، كما ذكرنا سابقا، هي تزويد موسكو أنقرة بالغاز. التبادل التجاري بين البلدين تطور بحيث وصل سنة 2021 إلى 34.7 مليار دولار، عدد السياح الروس الوافدين على تركيا قفز إلى أكثر من 7 ملايين زائر سنويا، وهو بالمناسبة أعلى رقم إذا ما قورن بالدول الأخرى. موسكو تستفيد من الخلاف الأمريكي التركي، لا سيما على مستوى الملف السوري، بحيث ترى أنقرة في مساندة واشنطن للأكراد السوريين نوعا من التخلي عن الحليف التاريخي لها، بعكس روسيا التي أصبحت طرفا أساسيا في الإشكال السوري، تسعى دائما إلى خلق آليات التنسيق مع تركيا من خلال مبادرات عديدة مثل مسلسل أسطانا، بل إن الرأي العام الدولي تابع كيف أن بوتين كان من الزعماء الأوائل الذين اتصلوا بأردوغان إبان انقلاب سنة 2016.
من هذا المنطلق، أنقرة كانت سباقة للقيام بأدوار الوساطة قبل الهجوم الروسي بثلاثة أسابيع، أي في 3 فبراير 2022، عندما زار أردوغان أوكرانيا وصرح بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، هذا الإلحاح استمر فيما بعد عندما حاول الأتراك تهيئة الظروف في المنتدى الديبلوماسي الذي انعقد في 10 مارس 2022 بأنطاليا، إلا أن وزير الخارجية الروسي وزميله الأوكراني رفضا حتى مصافحة بعضهما، مما اعتبر من طرف الأعلام الغربي فشلا ذريعا للديبلوماسية التركية. هذه الأخيرة لم تستلم؛ نظمت في 29 مارس من السنة نفسها اجتماعا بين الطرفين، عرف هو الآخر تعثرا بعدما نشرت الدول الغربية وثائق تثبت وجود بعض حالات جرائم حرب خلال التدخل العسكري الروسي.
محاولة ثالثة وبالضبط في 8 يونيو 2022، عندما حل وزير الخارجية الروسي لبروف بأنقرة، لكن هذه المرة تم الاقتصار على مفاوضات روسية تركية بموافقة أوكرانية؛ اتفق الطرفان على ممر بحري في البحر الأسود، من خلال مفاوضات أدت في 22 يوليوز 2022 إلى التوقيع في إسطنبول على ما أطلق عليه “مبادرة الحبوب للبحر الأسود”، كييف رفضت توقيع الاتفاق بشكل مباشرـ مما دفع بتركيا إلى اقتراح توقيع النص نفسه لكن بشكل متفرق تحت إشراف الرئيس أردوغان وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، هذه العملية سمحت بتصدير 12 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، غادرت البلد على متن أكثر من 500 باخرة، نحو مجموعة من الدول التي تعودت التعامل مع سوق المنتوجات الزراعية الأوكرانية. جاءت بعد ذلك وساطة تركية أفضت إلى تبادل أكثر من 200 أسير حرب بين الطرفين. على جبهة أخرى مغايرة انطلقت عندما قررت كل من السويد وفنلندا الالتحاق بالحلف الأطلسي، تحركت أنقرة رافضة انخراط هذه الدول، بدعوى مساندتها للأكراد بشكل غير مباشر، عن طريق منح اللجوء السياسي لبعض العناصر القيادية المحسوبة على تنظيم “Pkk”، تنازل أردوغان عن هذه المعارضة، سيسمح له بإمكانية التوصل بطائرات “ف 16” الأمريكية، لتحديث الأسطول الجوي العسكري التركي. بهذا التموقع، تحول الفاعل التركي إلى طرف ضروري لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه محاور إقليمي لروسيا، مع استمراره كقاعدة خلفية لا يمكن الاستغناء عنها في الهندسة العسكرية للحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا دون إغفال الحنكة التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي في تدبير إشكالية تدفق المهاجرين على القارة العجوز.
المصدر: هسبريس